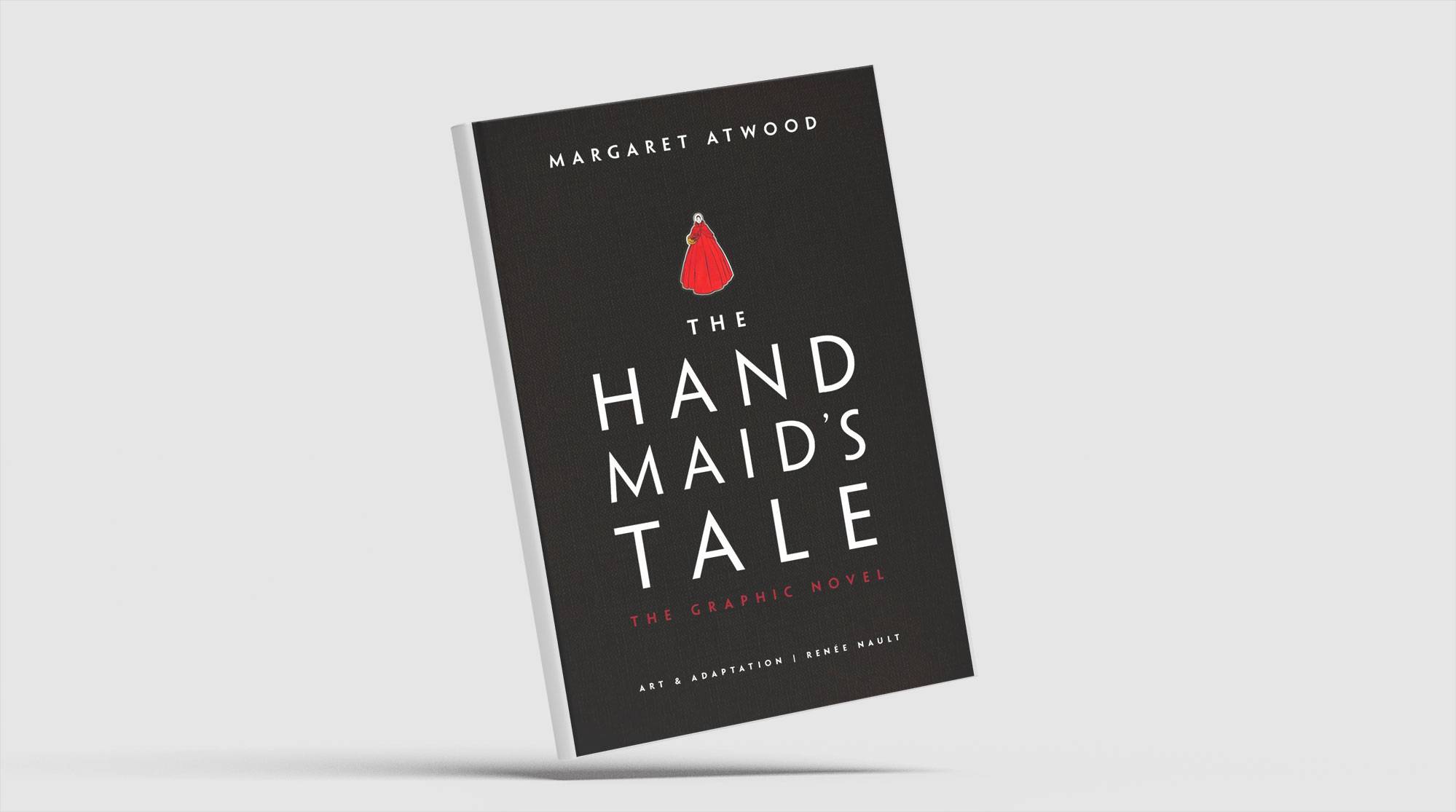«هذا المرض جعلني ألبسُ قناعاً... لكن تساقطت حولي كثيرٌ من الأقنعة... كل كلمة نابية وُجهت لي في مرضي كانت كسهمٍ في صدري وكطعنة في ظهري، فكم من مريضٍ يعاني من الأثر النفسي... لكن لا أحد يدري».
لم تكن معاناتها مع «كورونا» وحدها، لكن ما هو أشدّ وقعاً، المشاعر العدوانية المتنمرة لبعض أفراد المجتمع، التي كان وقعها أشد فتكاً من الوباء نفسه، بهذا الوصف شرحت الدكتورة السعودية ياسمين الدوسري، رحلتها مع مرض «كورونا»، التي انتهت بالشفاء، لكنها أبقت على جروح غائرة في الصدر، من الصعب تجاوزها بسبب «التنمر» الاجتماعي الذي واجهته، حيث كتبت تقول: «التنمر وضيق الأنفس العارض الأصعب الذي يترك ندبة تبقى مع المريض للأبد».
بعد إصابتها بالفيروس، انهالت عليها الاتهامات بأنها تسببت بنقل العدوى للآخرين، سالتها إحداهن: «كيف يمكنك النوم ليلاً؟»، تقول: «كان خوفي وتوتري من ملامة الناس يفوق خوفي على نفسي من المرض...»، «أدركتُ حينها أنّ المرض وحده لا يؤثر على الصحة لكنّ بعض الأشخاص مُضرين أكثر من كورونا»، فـ«كيف لي أن أُلام على شيءٍ خفيٍّ كهذا؟!»، «يبدو أن للمرض جانباً آخر لم ندركه بعد، ففي الوقت الذي فقدت فيه بعض حواسي كان هنالك من فقد إحساسه وإنسانيته ومبادئه ضارباً بخصوصية المريض والأدب والذوق عرض الحائط».
حين ينقشع هذا الوباء، ستبقى بعض الصور موشومة في جدار الزمن، لن تُمحى؛ صور لمآسٍ وأحزان، وبطولات أيضاً، واحدة من هذه الصور التي ستبقى دهراً خالدة في الذاكرة، مشهد جنازة الطبيبة المصرية سونيا عبد العظيم، ذات الـ64 عاماً، التي قضت بهذا الفيروس، بعد أن انتقلت لها العدوى من ابنتها، حيث هرع سكان قريتها لمنع سيارة الإسعاف من دخول القرية لمواراة جثمانها، ولم تكن قرية زوجها المجاورة أكثر رأفة بها، مشهد مفجع وصادم للضمير الإنساني، لا يلقي اللوم على الأهالي فحسب بل على منظومة الوعي التي تركتهم فريسة الشائعات المغلوطة.
هل يصبح المرض وصمة عار...؟ يجيب عالم الاجتماع الكندي أرفنج غوفمان، في كتابه «وصمة العار: ملاحظات حول إدارة الهوية الفاسدة»، محدداً ثلاثة أنواع للوصمة: وصمة العار الشخصية، ووصمة العار الجسدي، ووصمة العار المتعلقة بالهوية الجماعية. وبالتالي حين يؤدي المرض إلى تمييز أو رفض اجتماعي يصبح «وصمة»، مثله مثل الاعتلال الجسدي والنفسي وحتى السلوك الجرمي.
خلال جائحة «كورونا» امتلأ الفضاء الإلكتروني بسيل من التوبيخ والتهكم والشماتة على أصناف محددة من الضحايا، البعض مارس شوفينية وعنجهية وعنصرية تجاههم، وبلا رحمة جرى توجيه اللوم إليهم بنقل الوباء أو التسبب في انتشاره، كان البعض الآخر أيضاً ينقّب في هوية المرضى قبل أن يمنحهم التعاطف والتضامن الإنساني، في سلوك أناني لا يمتّ إلى الإنسانية بصِلة، بعض النعرات العنصرية عبّرت عن نفسها وعن طبيعة أصحابها في هذه الجائحة، ولم يلتفت أحد إلى التأثير المدمر على نفسيات المرضى أو عائلاتهم ومجتمعاتهم.
حبّذا لو تنفّس المرضى المتعافون من هذا الوباء الصعداء، وسردوا لنا تجاربهم، ورحلة الألم والأمل التي قطعوها. داووا جروحكم بالكتابة، فالكتابة دواء، وقد أحسنت الدكتورة ياسمين الدوسري أنها كتبت قصتها في الفضاء العام، حيث نفّست عن معاناتها، لكنها أيضاً ساعدت الآخرين على الاقتراب من عالم المرضى، وتحسس آلامهم النفسية قبل أوجاعهم الجسدية.
8:32 دقيقه
الكتابة دواء لألم الوباء
https://aawsat.com/home/article/2246131/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1



الكتابة دواء لألم الوباء


الكتابة دواء لألم الوباء

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة