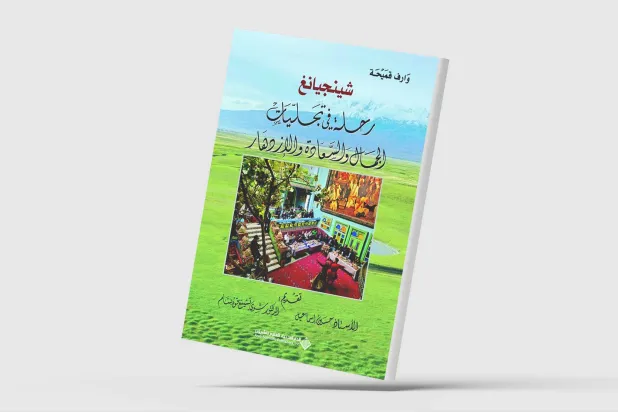يبدو ديوان «عواء مصحح اللغة» للشاعر عبد الرحمن مقلد، الصادر حديثاً عن «دار الربيع»، وكأنه مظاهرة احتجاج ضد أخطاء البشر، في عالم لا يكف عن صناعة الكوارث والمآسي، وافتعال الصخب والضجيج، حتى لم يعد العواء صرخة الذئب تحت وطأة الشعور بالجوع، بل أصبح صرخة الذات الشاعرة ضد العبث والفوضى والجنون وانتهاك حرية الإنسان. تطل الصرخة برمزيتها ودلالاتها في معظم قصائد الديوان، وتشتبك مع الأمكنة والأزمنة والشخوص الذين تتقاطع معهم، وتحيل إلى عوالمهم على سبيل التناص الصريح، والمضمر أحياناً، فهناك الشعراء: رامبو وبودلير وييسوا، ومن التراث الشعبي سيف بن ذي يزن، يحضرون كإشارات خاطفة في طوايا القصائد. ويهدي الشاعر إحدى القصائد إلى الفنان التشكيلي الليبي الراحل على الوكواك، المعروف بنحات الثورة الليبية، بينما يتصدر دون كيخوته المشهد عبر نصين طويلين نسبياً، يفيضان بالسخرية من العالم المليء بالأشرار واللصوص، كما يحضر في قصيدة مواساة لعازف الكمان الإيراني الشهير ناصر علي الذي عاش أواخر أيامه مجروحاً بالحب والموسيقي، بعد أن كسرت زوجته كمانه، وهو ما جسده الفيلم الفرنسي «عشاء بالخوخ».
تنفتح هذه التناصات على فضاء الديوان بروح من التراجيديا والكوميديا والمحاكاة الساخرة، ما يخف من وطأة الدوران في فلك كتابة التفعيلة بنسقها العروضي الغالب على جل قصائد الديوان البالغ نحو 106 صفحات، حيث تحد أحياناً من نمو الصورة الشعرية، وتسيج أفقها الدلالي، ومن ثم لا يصبح شرط الكتابة هنا هو سلامة البنية العروضية فحسب، وإنما مدى سلاسة الصورة الشعرية، ونموها بتلقائية وعفوية، حتى تبدو التفعيلة بإيقاعها المتراوح مجرد سياج شفيف ينداح في خلفية الصورة، بعلاقتها اللغوية القادرة على التقاط الشعر من حفر الحياة وعثراتها المباغتة التي لا تنتهي، لنصبح إزاء رؤية شعرية متنوعة النغمات، وهو ما ينجح الديوان في تحقيقه في كثير من القصائد.
ويمهد الشاعر لصرخته الاحتجاجية باللعب شعرياً مع ابنته «ماريا» عبر ثلاث قصائد، تبدو فيها الطفولة وكأنها مفتاح لحياة أخرى مفعمة بالمرح والمزاح والحيوية، بعيداً عن خواء العالم، حتى أنه يتمنى أن تصبح الابنة رئيسة الكون:
«ماذا لو أعطيتِ الجندَ بنادقَ من خرزٍ
وتبادلنا اللهوَ الكونيَ
هنا في الغرفة
وأدرنا المعركة
قذفنا نحو الأعداء قنابلَ من عَلكٍ
ورصاصاتٍ من ماء
ودفعنا (البطة) في الصفّ الأوّل
وتساقط سربُ الطائرات الورقيّة
ماذا لو طاوعنا الأعداء
وخروا صرعى
وأعادوا الكرّة وسقطنا
نحتبس الأنفاسَ
ونضحك بهدوء
كي يحتفلوا بالنصر
وينكسر الحزنُ الدائم في قلب أبيكِ
لو أصبحت رئيسة هذا الكون
وناديتِ الشعراءَ من الشباك».
يمتد هذه اللعب إلى قلب الذات الشعرية، مشكلاً رنيناً خاصاً من الصراخ المكتوم والعواء الهش، وينفتح الديوان على هموم وحيوات مغموسة في إيقاع الواقع وتناقضات العيش على حوافه البائسة الخطرة، ولا شيء سوى مرآة اللغة يمكن أن يشكل جسراً للوصل والقطع بين ما مضي وما هو كائن وما ينبغي أن يكون، لكن اللغة لا تحيا في مخزن القواميس والمعاجم، بعيداً عن تحولات الحياة ووتيرتها المتقلّبة المرعبة التي تمنح المشهد والمرآة أكثر من زاوية للسقوط والصعود معاً:
«كان اللصُّ على الشباك
يراقبُ...
كان الخنجرُ فوق الرقبة
كنت أجنُّ وأعوي
وأنا أبصر ما يتطاير من أشلاء
والدبابة تنهش جسد المار
وكنت أرتب للتنوين الدورَ الأمثلَ
كنت أزيل النونَ وأضع النقطة».
تعزز هذه المشهدية من بلاغة المفارقة الساخرة في الديوان، التي تعد حجر أساس لأفق الرؤية والمضمون معاً، ولا تخلو من كونها لعبة لغوية ماهرة، يتبادل فيها الأقنعة والأدوار صانع المفارقة الشاعر نفسه والقارئ. لكن من الأشياء اللافتة في الديوان أن النص الشعري لا يحيل إلى المفارقة لتوكيد المعنى أو الدلالة أو الرمز حتى تستقر في النص، وإنما لتوكيد المعنى الضد للمفارقة نفسها، بحيث يصبح النص مفتوحاً على احتمالات شتي، قادراً على استثارة القارئ ليصنع هو مفارقته مع النص، ولو بضحكة أو صرخة يتكسر صداها في الحلق والروح. تطالعنا هذه الأجواء على نحو خاص في عدد من قصائد الديوان، وتأخذ طابعاً مرحاً إلى حد الأسى، ومنها قصائد: «وهو يغازل موظفات البن»، و«صلاة إلى (Atm)»، و«صراخ الرجل ونباح الكلب - معركة المستشفى العام» التي يقول فيها:
«قالوا في أوراق الشرطة
إن الرجل ذا القدم (الورمة)
والكلب (الجربان)
اقتحما غرفة مسؤول الكشف الدوري.
وقالوا: إن الرجل أقام على الكرسي
ومزق أذونات الصرفِ
وألقى رأس طبيب الباطنة بكوب الشاي الساخن
والكلب عوى، عضّ ممرضة
وأصيبت مسؤولة صرف دواء السُّكر بالإغماء
بروح الحكاية يحتفي الديوان بالتفاصيل اليومية البسيطة، محولاً واقعيتها المألوفة إلى رذاذ من التهكم والسخرية. فعبر التفاصيل ثمة أصابع خفية تلعب في المشهد، تكمن في بداهتها أسئلة حارقة، يتقاطع في ظلالها المصير الإنساني الباحث عن الحقيقة والحرية والأمان. أيضاً يتقاطع الشعري مع العادي العابر، وتبدو مهمة الشاعر هي انتزاع الصور وتطويعها لتترك صداها في الداخل والخارج معاً، مدركاً أن ممازحته لماكينة صرف العملة وموظفات البنك لا تنفصل عن استدعائه شخصية دون كيخوته بحمولاتها الأسطورية التي تصنع من عبث الحياة كينونة خاصة لصراع أبدي مع الزمن، مع الخير والشر، مع الجمال والقبح، مع الكراهية والحلم بواقع أفضل للإنسان وللحياة معاً. ربما لذلك تتحول الصرخة في الديوان من مجرد علامة رخوة، وزفرة ألم، إلى سؤال دائم لاهث، مسكون بالفلسفة والتأمل في معنى الوجود والعدم، ومسكون في الوقت نفسه بمعنى التضحية والخلاص في «الجنود - نشيد بديل»، ومعنى الونس والمحبة في كنف البيت والعائلة، بخاصة في قصائد: «العمة تزورني في الليل»، و«إلى العائلة»، و«مواساة العازف الإيراني» التي يقول فيها:
«في الغرفة...
و(دون كيخوته) رفيقي
أسألهُ
هل ينجو صاحبنا الموسيقي
الملقى فوق سريري
والراكضِ خلف كمانٍ مسلوبِ الصوت
ومحطوم الجسدِ؟».
إن هذا السؤال المسكون بفكرة مواجهة الموت بالموسيقى ليس بعيداً عن الرجاء المخاتل على لسان مصحح اللغة في ختام الديوان وهو يتساءل باستنكار يصل إلى حد الشعور بالتواطؤ ضد نفسه، وكأن ثمة مناخاً لجريمة ما تتسرب روائحها في النص: «أنا مصحح اللغة الذي طالما ابتلعَ لسانه وغطى فمَهُ| حري به أن يدفع الأبوابَ المغلقة| يدفعها بكل أنفة وبذاءة| طالما حلمت أنا ابن الحقول المتسعة».
ثمة أسئلة كثيرة تظل حيرى معلقة في الديوان، لكن ليس مهمة الشاعر أن يجعل قصائده تستنطقها، أو يراهن على الواقع، معتبراً أن علاقته بالنص تحتم عليه وضع تصور لإجابة عنها، إنما المهم أن يحقق النص من خلال هذه الأسئلة المقدرة على الحلم، واتصاله بذاته وتجربته عبر تخومه التي لا تنتهي فيها الأسئلة. لقد نجح الديوان في هذا المسعى إلى حد كبير، رغم ما شابه أحياناً من اجترار جعل الصورة الشعرية المنتزعة مشدودة إلى الواقع بفجاجته، تراهن عليه على حساب الشعر.
13:22 دقيقه
شعرية الصرخة والتفاصيل
https://aawsat.com/home/article/2133291/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84



شعرية الصرخة والتفاصيل
عبد الرحمن مقلد في ديوانه «عواء مصحح اللغة»


شعرية الصرخة والتفاصيل

مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة