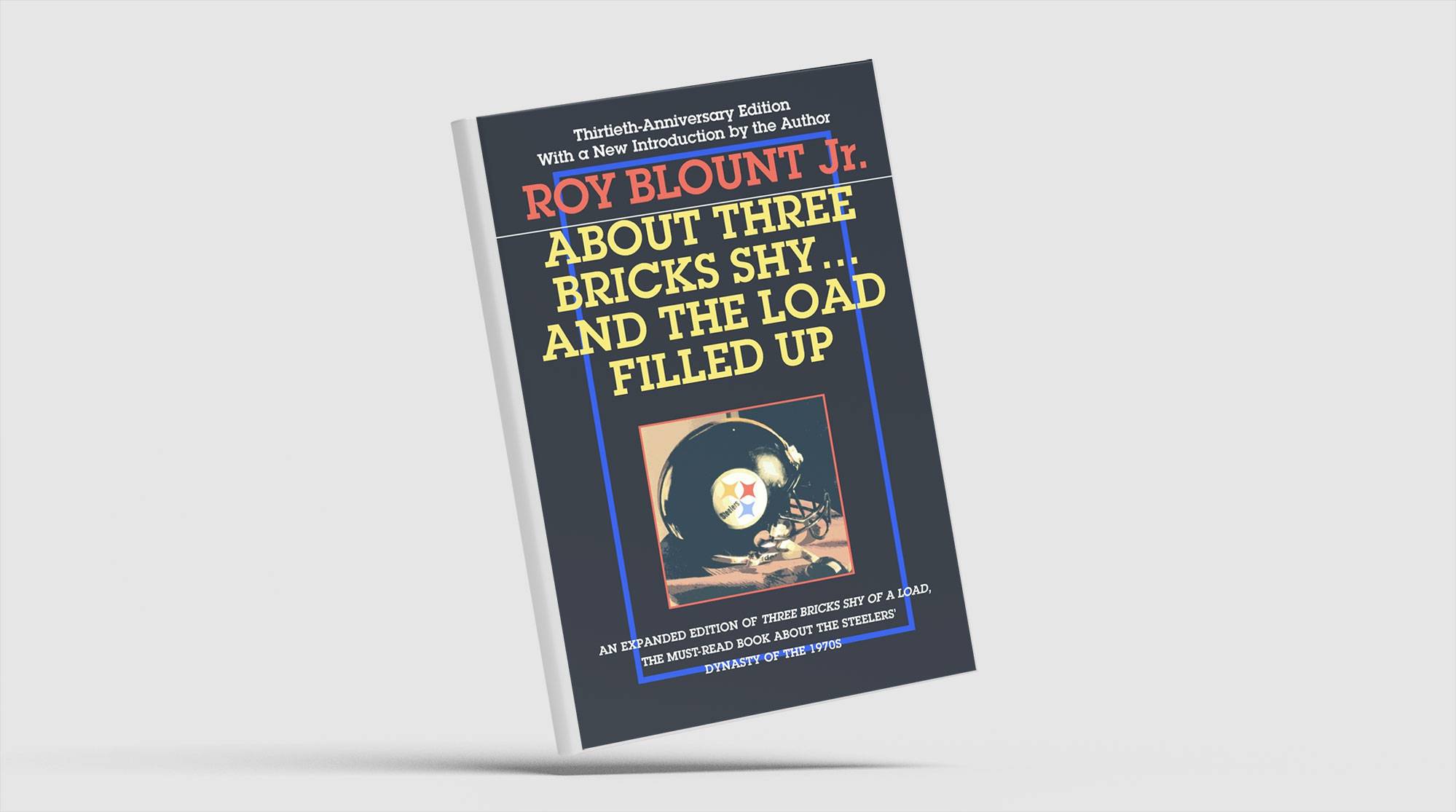يعتبر رجل الأعمال الكُردي، والسياسي السابق فاروق مصطفى رسول، راوياً نادراً للتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي مرّ بها العراق منذ أوائل النصف الثاني من القرن العشرين. فهو بالإضافة إلى البيئات الاجتماعية الدينية والثقافية إلى نشأ فيها في مدينة السليمانية بكُردستان، عاش وواكب التحولات العنيفة التي اتسم بها العراق في فترته الملكية، وجمهورياته المتعاقبة «المتوارمة» حيث أصبحت الانقلابات فيها ثباتها الدائم. في البدء أراده والده الشيخ مصطفى رسول في بداية الخمسينات وريثا لمكانته الدينية والاجتماعية، كما أراد أن يُسمَع صوته عبر مُكبرات مآذن السليمانية، إنما جذبته السياسة وأدخلته في قلب الحركة اليسارية التي تميز بها مشهد العراق السياسي والثقافي.
بعد العام الأول من النصف الثاني من القرن العشرين كما يرويه في كتاب «ذكرياتي» الصادرة عن الدار العربية للعلوم ملايين/بيروت، كان يطلب منه والده البقاء بالقرب منه في الجامع، وهو لا يزال شاباً يافعاً يركض وراء أي فكرة جديدة في حياته؛ ويحضر الجلسات حول الشعر والأدب والدين في جامع أبيه من جانب، فيما كانت توجهه بيئات المدرسة والأصدقاء والحارّة نحو عالم السياسة الساخن من جانب آخر. وهذا ما حصل مع أخيه الأكبر الراحل البروفسور عز الدين مصطفى رسول، حيث قدم للدراسة في كلية الشريعة ببغداد في بداية الخمسينات نزولاً عند رغبة الأب، حيث آثر أن يصبح أحد أبنائه أو أبناء إخوانه رجلاً يخدم الدين. بيد أنه لم يكمل السنة الأولى في الدراسة وعاد إلى السليمانية محملاً بأفكاره الشيوعية.
في ذات الفترة، جمعت علاقة الصداقة فاروق بالشاعر الكُردي الراحل شيركو بيكَس وانتميا للاتحاد العام لطلبة العراق. كان ذلك في مدينته، السليمانية؛ حيث جمعه فيها النشاط السياسي اليساري في أعوام لاحقة بالكتاب والشعراء الكرد المعروفين مثل الشاعر الحداثي عبد الله كوران الروائي حسين عارف والقاص رؤوف بيكَرد وجلال ميرزا كريم. ولئن كان الكاتب فاعلاً سياسياً في المشهدين الكُردي والعراقي ناهيك بعمله في فترة دراسته الجامعية في وزارة المعاريف والصحافة الكُردية الصادرة في بغداد، إلا أنه يلقي الضوء من خلال الكتاب على الكثير من جوانب المجتمع العراقي ووجوهه الثقافية، الأدبية والاجتماعية، ويتذكر في هذا السياق كيف تعرّف على المفكر العراقي الراحل هادي العلوي في وزارة المعاريف. وكان العلوي يعمل في صفوف الإخوان المسلمين قبل أن يصبح يسارياً ومفكراً نادراً في نقد التاريخ والفلسفة الإسلاميين.
تعد رواية فاروق رسول للأحداث الاجتماعية والثقافية والسياسية مصدراً مهماً من مصادر كتابة تاريخ البلاد، فهو حين يكتب عن طفولته في مدينة السليمانية، إنما يلج في تفاصيل حياة المدينة بوجوهها وشخصياتها ونطاق نشاطها اليومي. ويتطرق في سياق سرده للأحداث والأنماط الثقافية السائدة عهدئذ إلى دور الجامع في نشأة أجيال من الكتاب والشعراء والمثقفين الكُرد: «بعد عصر كل يوم كان عدد من المثقفين والشعراء؛ خصوصاً نخبة من رجال دين وأصدقاء آخرين لوالدي يؤمون مضيفه في الجامع.. ورغم توقي الشديد إلى اللعب مع أصدقائي، إلا أن أبي كان ينصحني أن أبقى معهم في الجامع لأستفيد من أحاديثهم الدائرة أغلبها حول الشعر والأدب والدين والثقافة ومواضيع جديدة وطرية». وفي الجامع أيضاً، اجتذبته غرف طلبة العلوم الدينية (الفقهاء) ودرس (القواعد والبناء) رغم أنه كان ملتحقاً بالمدرسة الحكومية.
تم تأسيس صالات للسينما لعرض الأفلام في بدايات النصف الثاني من القرن بمدينة السليمانية، الأمر الذي أضاف مصدراً آخر لمعارفه الثقافية والفنية إلى جانب المدرسة والجامع. إنما لم تدم تلك الصور السينمائية التي شاهدها في الصالات الحديثة في مشهد المدينة الثقافي، ذاك أن العراق قد أدخل مرحلة جديدة لم تهدأ فيها عناوين السياسة والحكم. وما يمكن استنتاجه في سرد الراوي للأحداث حيث تتغير اهتماماته من مشاهدة الأفلام السينمائية وجمع طوابع البريد والحضور في الجلسات الأدبية الدينية إلى ناشط في الحراك السياسي، هو طغيان العنوان السياسي على كل شيء في الحياة الدراسية والاجتماعية. ويتبدى ذلك في مرحلة الدراسة الإعدادية، إذ يروي كيف كانت تتحول الرحلات المدرسية إلى مناسبة للخطابات السياسية. كان الروائي الكُردي المعروف حسين عارف واحداً من الذين يلقون الخطابات في تلك السفرات المدرسية. أما في مرحلة الحياة الجامعية ببغداد، بعد حكم النظام الملكي تحديداً، إذ كان يهيمن النشاط اليساري على النشاط الجامعي والأكاديمي، فكانت تلوح في النظام الجمهوري علائم حصول تغيير دموي، ويبدو ذلك من خلال خصائص تلك المرحلة التي أزيحت فيها الملكية دون إزاحة الخوف من القادم، فتفجرت طاقة عنفية نتجت عنها بسنوات قليلة فيما بعد، ثقافة صناعة «قطار الموت».
الصورة الاجتماعية والثقافية التي تركها الشاب المتحمس خلفه في السليمانية، إن كانت تنم عن شيء، فهي تنم عما يمكن تسميته بصورة «المجتمع اللاهث» وراء الأحداث السياسية العنيفة التي أبقت الجميع في حالة الترقب لقادم مجهول غير واضح الملامح. كان الجميع يبحث عن شيء يساعد على تفريغ الحمولة السياسية، فيما كانت بغداد في تلك المرحلة توفر مساحة للانطلاق والوقوف على عتبة الأحداث أو بالقرب منها. هذا ما نلاحظه في صورة يعود تاريخها إلى 1958 ويظهر كاتب هذه السيرة في وسط المتظاهرين.
على رغم ثباته السياسي داخل الحزب الشيوعي العراقي، يصبح الكاتب مع دخوله إلى كلية التجارة عام 1959، جزءاً من حالة الترقب ذاتها. ونستنتج من خلال سرده للحياة الجامعية الممتزجة بالسياسة والصراعات الآيديولوجية، بأن الاستثمار البشري في تلك المرحلة التي انتهت بانقلاب البعثيين الدموي عام 1963، اقتصر على نزاعات واصطدامات بين الشيوعيين وبين القوميين والإخوان المسلمين. وبدا عبد الكريم قاسم ميالاً إلى جانب البعثيين والإخوان المسلمين تاركاً حلفاء الأمس (الشيوعيين) لمصير مأساوي لم ينج منه هو نفسه فيما بعد.
في سياق روايته للتحولات السياسية والثقافية والاجتماعية في عراق العهد الملكي، وعهود الجمهوريات العسكرية بطبيعة الحال، يخصص الكاتب مساحة وافية للحديث عن قطار الموت كصناعة بعثية بامتياز. فبعد نجاح انقلاب 1963 ووصول البعثيين إلى السلطة، تمخضت فكرة القضاء على الضباط والمثقفين والناشطين الشيوعيين واليساريين عبر شحنهم كحقائب بشرية حية في قطار شحن سُدت منافذه بالزفت وتم دفعهم في قيظ شهر تموز إلى مدينة السماوة الجنوبية ومنها إلى سجن نقرة سلمان السيئ الصيت. وكان يأمل البعثيون بأنهم سيموتون بلا شك من الحرّ ولا ينجو منهم أحد. ويذاع الخبر لاحقاً كحدث من الأحداث المدرجة ضمن القضاء والقدر، فيتخلصون وتخلصوا بذلك من فكرة قتل كل تلك الأعداد بالرصاص الحي تجنباً لإثارة العام العالمي. وكان البعثيون قد أعلموا السائق عبد عباس المفرجي بأن القطار مُحمّل بقضبان حديدية وعليه إبطاء السرعة وإطالة الزمن، لكنه اكتشف في وسط الطريق بأنه يقود أعداد كبيرة من البشر داخل «تنور حديدي متحرك» نحو موت محتم.
فأوقف القطار في أقرب محطة، وهرع الناس بالماء والطعام لينقذوا مئات السجناء.
سيرة سياسة... سيرة عنف
فاروق مصطفى رسول راوياً لتحولات العراق العنفية


سيرة سياسة... سيرة عنف

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة