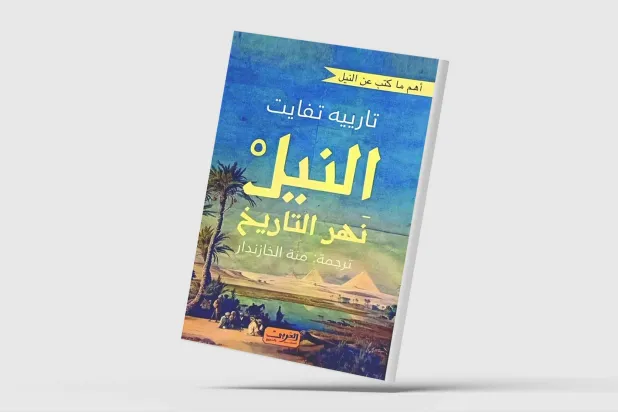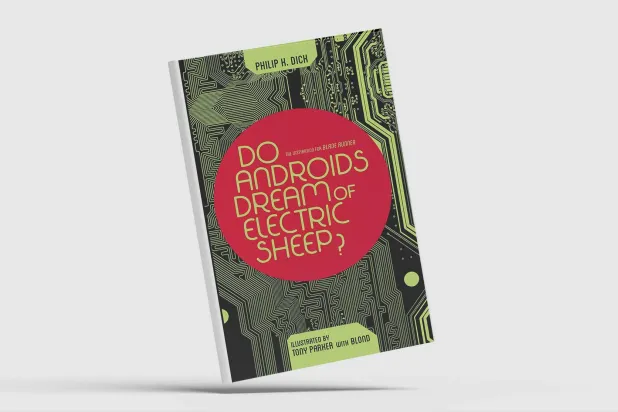بعض الكتب يعرف كيف يدافع عن نفسه في مواجهة قارئ غشاش. من هذه الكتب رواية نجوى بركات الجديدة «مستر نون»، الصادرة عن دار «الآداب». شخصياً، حاولت أن أغش وأقرأ فصلاً من هنا وفقرة من هناك، ولم أنجح، لأن كل حدث صغير في الرواية يتشابك مع حدث صغير سابق ويفسره.
ولست غشاشاً بطبعي، لكنها كانت محاولة انتقام من كاتبة تغامر بالرهان على صبر القارئ، حيث يبدو الإيقاع في الصفحات الأولى بطيئاً، لا يوحي بأن شيئاً مهماً سيحدث، بل ويقدم خطاً سردياً لن يكون موضوع الرواية.
يبدأ السرد بقول السيد المسيح لتلاميذه: «حبيبنا لعازر قد نام، ولكنني أذهب فأوقظه»، ويمضي مفتتح الرواية في ذلك الدرب، ونعتقد أننا بصدد رواية عن معجزة إحياء لعازر، تكتبها نجوى بركات، ثم نكتشف أن قصة لعازر مجرد بداية لرواية داخل الرواية، يكتبها «مستر نون» الذي سيصبح هو نفسه الموضوع، ولن يُكمل الرواية التي يكتبها أبداً.
لا نعرف عمره بالضبط، وهو يعيش في غرفة من نُزل اختاره بديلاً لبيته، لأنه لم يحتمل قيام برج قبيح أنشأه واحد من بارونات الحرب في مواجهة البيت. يبدو الرجل في البداية واحداً من ضحايا الكتابة الذين يحبونها من طرف واحد، ويضطر أحبابهم لمسايرتهم في إشباع جنونهم قليل الضرر. وهكذا، تفعل «مس زهرة» التي تهتم براحة «مستر نون»، وتوفر له أقلام الرصاص والورق الأبيض. تبدو مس زهرة مشرفة على خدمة الغرف، لكننا نتوقع أنها تميل عاطفياً إلى الكاتب الغامض.
ويمضي وقت مستر نون في عالمه الضيق: محاولة يائسة للتقدم في الكتابة، ومراقبة الشارع من الشباك، وانتظار مس زهرة التي تطرق الباب بين وقت وآخر لتتفقده. وشيئاً فشيئاً، يتسع العالم لنتعرف على شخصيات أخرى في إدارة النُزل، ونزلاء ونزيلات يتسمون بالغرابة، كما نتعرف على ذكريات «مستر نون» مع نساء أخريات: «ثريا» التي كانت تزدريه، و«ماري» التي تحتضنه بحب، كما نتعرف على أبيه الطبيب، وشقيقه سائد معشوق أمه، ثم نعرف أن ثريا هي الأم، وماري خادمة تتعاطف معه.
وتدفع الكاتبة بموجات من الضوء، موجة وراء موجة، لنرى أننا بمواجهة مريض فصام، وما يظنه نزلاً اختاره بنفسه، هو في الحقيقة مصحة يدفع شقيقه تكلفة إيوائه فيها. وبعد هذا التنوير، يحسن أن نعيد قراءة الفصل الأول، لننتبه إلى الإشارات الخفيفة التي ناثرتها الكاتبة للتأسيس لهذا الفصام: «نظرت إليه الذبابة وغمزت بطرف عينها، قبل أن تحلق ويختفي أثرها»، أو اعتبار الحقنة التي تغرس مس زهرة سنها في ذراعه مهارشة حب: «أخذت مس زهرة ذراعه برفق، ضربت خفيفاً على مرفقه، ومررت أصابعها على عروقه النافرة الزرقاء، ثم انحنت... آه، صرخ السيد نون، لقد غرست أسنانك في شراييني التي تحبين».
سنعرف بعد ذلك أن «مستر نون» ليس من ضحايا الكتابة، فهو مؤلف كتب سابقة مرموقة، ويُعلِّم الكتابة الإبداعية في الجامعة، ونتأكد من مستواه عبر تنظيره للكتابة في مواضع من الرواية. وعندما نرى فظاعات الحرب الأهلية اللبنانية، ثم صورة بيروت الفاسدة التي خرجت من بين الأنقاض، نتأكد أن السبب في فصام مستر نون هو الأم والأخ والحرب التي سحقته، وسلبته الحب بوحشية، وقبَّحت مدينته.
يمكننا اعتبار «مستر نون» رواية نفسية، وبالقدر نفسه يمكننا اعتبارها رواية حرب، أو رواية «ديستوبيا» تعري مدينة أفسدتها الحرب، كما أنها رواية وجودية تقدم عقدة البطل المعتزل للمجتمع، الخائف، الرافض غير المبالي، لكن في الوقت نفسه الباحث عن الاعتراف، ولو من خلال الإهانة!
يمضي «مستر نون» بقدميه إلى العشوائيات والحارات الشعبية لكي يحظى بالإهانة، ما يذكرنا بسعي بطل نوفيلا «في قبوي» لدوستويفسكي، عندما لمح مشاجرة في حانة، فاقتحمها لكي ينال صفعة، لكن المعتدي لوى عنه بإهمال، فظل يترصد حركته في المدينة، ويتعمد أن يواجهه. وفي كل مرة، يشيح الرجل القوي عنه، فيزداد غيظاً.
مثل بطل «في قبوي»، يعاني مستر نون من ألم ألا يكون موجوداً، ويريد الاعتراف بوجوده، لكن صبية بيروت كانوا أكثر كرماً من القبضاي الروسي المترفع، ومنحوا مستر نون ألواناً من الإهانة والجروح أرضته، وجعلته يتوقف عن جولاته!
المأزق الوجودي لمريض فصام لم يجعل الرواية تقبع داخل الأماكن المغلقة، لكنها تهتم بما تستقبله الحواس من وصف للطقس، وشكل الشوارع وحياة المدينة، بتفاصيل مفعمة بالصدق الفني، يرصدها راو يظهر قليلاً، ثم يفسح لصوت البطل أسير المصحة الذي يرى الأشياء من النافذة!
ومن النوافذ تأتي كذلك الكوارث الأكبر في حياة مستر نون. رأى، عندما كان صبياً في التاسعة، أباه الطبيب معالج الفقراء ينساب من النافذة منتحراً. ومن النافذة، يُلقي القواد بالفتاة النيبالية التي أحبها «مستر نون» وأخذها لتعيش معه. ومن النافذة في المصحة، يشاهد انتحار نزيلة بمساعدة نزيل آخر، وتمنعه مس زهرة من الإدلاء بشهادته.
الرواية حافلة بالمفارقات السوداء التي تؤسس لها الكاتبة على مهل، ومنها رعب مستر نون من اسم «لقمان»، ولا نفهم سر ذلك الرعب إلا قبل نهاية الرواية بقليل. سنعرف أن لقمان المخيف يسكن حكاية من طفولته سحقت أباه قبل أن تسحقه. كان اسم لقمان لمسلح اقتحم مستشفى الأطفال، حيث يعمل والد مستر نون. قبل وصول المسلح، طلب الطبيب من الممرضة تخدير الأطفال، والممرضة فلسطينية الأصل، ناجية من مذبحة 1948، ولا تريد أن ترى مذبحة أخرى، لذلك زادت الجرعة التي حقنت بها الأطفال، ثم حقنت نفسها في النهاية. وعندما دخل لقمان، وجد الأطفال ميتين سلفاً، فإذا به ينحني ليحيي شجاعة خصمه: «نشكرك أيها الطبيب، لقد قدمت لنا خدمة لا تقدر بثمن. فمهما يكن، يبقى قتل الأطفال صعباً يتطلب مقدرة كمقدرتك!».
في هذه الرواية، كما في رواياتها السابقة، يبدو هاجس اللغة قوياً لدى نجوى بركات. لغة فحلة، لكن فحولتها لا تخفي أنوثتها البادية في أبسط سلوك تأتيه امرأة في الرواية، في تشبيه لحظة سكينة البطل بـ«راحة العجين». وفي ظني، لم تكن الرواية بحاجة إلى صفحة الختام الأخيرة، وهي عبارة عن تقرير كتبه الطبيب أندريه للشرطة، نعرف منه أن «مستر نون» سيدة تعاني التباساً في الهوية، وتظن نفسها رجلاً.
وفيما يزعم رولان بارت، فإن «في كل رجل يحكي أنوثة تفصح عن ذاتها»، وما يعانيه السيد أو السيدة نون شيء أكبر من التباس الهوية؛ هو افتقاد الحب الذي جعل موته أو نومه أعمق من نوم لعازر، ويحتاج إلى معجزة كي ينهض.
- روائي مصري