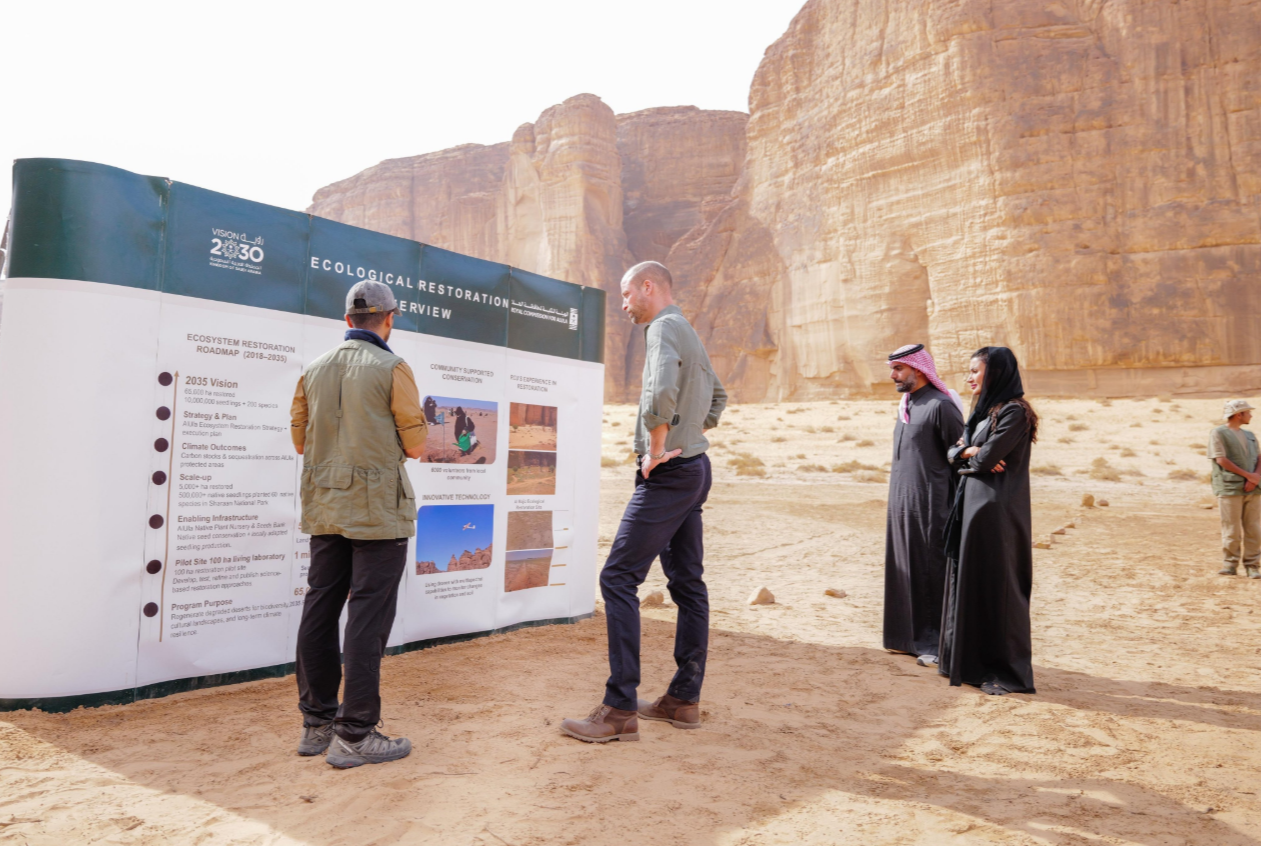إذا كان الشعر من بعض وجوهه هو محاولة رمزية لرأب صدوع العالم، أو تعويض باللغة عما خسرناه من فراديس الطفولة والحياة الهانئة والأماكن المفقودة، فإنه ليس من المستغرب أن يحتل الرثاء ذلك الموقع المتقدم بين ضروب القول الشعري وأغراضه، ليس في الإطار العربي وحده، بل في الإطار العالمي والإنساني بوجه عام.
وسواء تعلق الأمر بالمنازل والمدن والأوطان، أو تعلق بالأزمنة الهاربة، أو بغياب الأحبة والأهل والأصدقاء، فإن فن الرثاء هو من أكثر الفنون التصاقاً بالنفس البشرية، وتعبيراً عن حاجتها إلى الإفصاح عن أنينها ومكنوناتها العميقة وصراخها الاحتجاجي في وجه الفقدان. وليس صدفة تبعاً لذلك أن يكون الرثاء هو الموضوع المشترك والأثير لمعظم الملاحم والنصوص الشعرية التي تناهت إلينا منذ القدم، بدءاً من رثاء البطل السومري كلكامش لصديقه أنكيدو، وإنانا لديموزي، وعشتار لتموز، وليس انتهاءً بمراثي إرميا لأورشليم في العهد القديم. ومع أن الشعر الغربي لم يخلُ من هذا الفن ذي الطبيعة العابرة للقوميات والكيانات السياسية، فإن أياً من الشعوب لم يحتفِ على الأرجح بهذا الفن كما هو الحال مع العرب. ليس فقط بسبب طبيعتهم العاطفية والانفعالية التي يسهم ضوء الشمس في إنضاجها بشكل مفرط، بل لأن الحروب شبه المتواصلة التي تسببت بها ندرة الماء والكلأ وشظف العيش كانت ترفع منسوب الموت قتلاً إلى حدوده القصوى، فضلاً عن أن حياة الترحل وهلامية الأماكن العابرة كانت تحول الحياة برمتها إلى طلل واسع، وتشرع أمام الشعر أبواب التفجع والحنين ورثاء الذات والعالم. هكذا، غص ديوان العرب الشعري بعشرات القصائد المؤثرة التي حملت إلينا رثاء المهلهل لأخيه كليب، والخنساء لأخويها الراحليْن، وابن الرومي لولده الأوسط كما لحريق البصرة، والمتنبي لجدته الراحلة ولخولة التي أحبها بصمت، وصولاً إلى الشعر الحديث الذي يحفل بعشرات المراثي المماثلة.
ولأن الفقدان هو القاسم المشترك بين الموت والحب غير الممتلك، فقد اتسمت قصائد الحب العذري عند العرب بنبرة رثائية مثقلة بالحسرة والتفجع والشجن العاطفي. فإذا كان الحب بحد ذاته نوعاً من «الموت الصغير»، وفق مقولة ابن عربي، فإن الحب المحكوم بالفراق يفوق في وطأته آلام الموت البيولوجي، باعتبار أن الحبيبة الميتة تذهب إلى كنف التراب، فيما الحبيبة الحية تذهب إلى كنف شخص آخر، تتكفل الغيرة بتحويله إلى جحيم حقيقي، وهو ما يعكسه بوضوح قول بشار بن برد: «من حبها أتمنى لو يصادفني \ من نحو قريتها ناعٍ فينعاها \ كيما أقول: فراقٌ لا لقاء له \ وتضمر النفس يأساً ثم تسلاها». ويتحول الرثاء من جهة أخرى إلى محاولة يائسة لردم الهُوى العميقة الفاصلة بين ضفتي الحياة والموت، أو إلى محاولة مماثلة لانتشال الغائب من عهدة الصمت وإحيائه بالكلمات. وإذا نظرنا إلى الأمر من زاوية فقه اللغة، لرأينا شبهاً واضحاً بين كلمتي «رثى» و«رفا»، أو بين رفو الثياب ورثاء الموتى. وبما أن الفاء تُقلب ثاءً في بعض اللهجات العربية، فإن الخياط الذي يرفو الثياب الممزقة تُطلق عليه تسمية «الراثي» أو «الرثّاء». وقد أكد أبو العلاء المعري على مبدأ العلاقة بين الجسد والثوب في قولته الشهيرة: «جسدي خرقة تخاط إلى الأرض \ فيا خائط الخلائق خطْني». وإذ يدرك الراثي في صميمه أنه آيل كالمرثي إلى زوال محتّم، فإن بكاءه على الآخر هو في الآن ذاته بكاءٌ على مصيره المماثل، وهو حين يرثي الآخر إنما يرثي نفسه في الوقت ذاته.
على أن اللافت في هذا السياق هو أن بعض الشعراء العرب، قدماء ومعاصرين، لم يكتفوا برثاء أحبتهم وأصدقائهم الراحلين، بل عمدوا إلى رثاء أنفسهم بالذات حين يئسوا لسبب أو لآخر من الحياة، أو شعروا بدنوّ الأجل، وهو ما جعله عبد المعين الملوحي موضوعاً لأحد مؤلفاته المميزة.
ومن يتتبع سير الأقدمين من الشعراء العرب لا بد أن تستوقفه هذه الظاهرة التي لا تصدر، في الأعم الغالب، عمن زهد بالحياة وعزف عن ملذاتها، بل عمن أحبها وشغف بها حتى الثمالة. ومعظم هؤلاء هم من الشعراء الفرسان الذين أصيبوا إصابات قاتلة في حمأة الحروب، أو ممن قضوا اغتيالاً، أو من الذين داهمهم مرض قاتل لا شفاء منه. وإذ يبدو الرثاء هنا احتجاجاً بالكلمات على مصير مباغت لم يحسبوا حساباً له، أو رحيل مبكر حلّ قبل أوانه، يستدعي في الوقت نفسه مشاهد وتفاصيل من اللحظات التي تعقب الموت، حيث تجهد أنا الشاعر «الطفولية» في الاحتفاء بغيابها عبر تخيل موكب التشييع، واستدرار دموع الباكين والباكيات من أحبته وذويه، قبل أن تُسدل الستائر ويحل الظلام الكلي.
فطرفة بن العبد، الذي حمل إلى والي البحرين رسالة عمرو بن هند التي تحثه على قتل حاملها، واجه قدره بشجاعة نادرة حين رفض الفرار من السجن، مخاطباً من وراء القضبان حبيبته خولة بالقول: «ألا اعتزليني اليوم خولة، أو غضّي \ فقد نزلتْ حدباء محْكمة العضِّ \ إذا متّ فابكيني بما أنا أهلهُ \ وحُضّي عليّ الباكيات مدى الحضِّ \ ولا تعدُليني إن هلكتُ بعاجزٍ \ من الناس منقوضِ المريرة والنقْضِ». أما هدبة بن خشرم، شاعر بني عذرة الذي حُكم عليه بالموت إثر قتله لزيادة بن زيد، فقد اختار في رثائه لنفسه أن يستخدم صيغة المثنى التي استهلها أمرؤ القيس في معلقته الشهيرة «ألا علّلاني قبل نوْح النوائحِ \ وقبل ارتقاء النفس فوق الجوانحِ \، وقبل غدٍ، يا لهف نفسي على غدٍ \ إذا راح أصحابي ولستُ برائحِ \ إذا راح أصحابي تفيض عيونهم \ وغودرتُ في لحدٍ علي صفائحي \ يقولون: هل أصلحتمُ لأخيكمُ؟ \ وما القبر في الأرض الفضاء بصالحِ».
لكن قصيدة مالك بن الريب التي رثى بها نفسه بعد أن أصيب بلدغة أفعى في أثناء مشاركته في فتح بلاد فارس زمن معاوية بن أبي سفيان لا تُعتبر ذروة من ذرى رثاء النفس عند العرب فحسب، بل هي في الآن ذاته واحدة من أفضل ما تركه لنا الأقدمون من فرائد الشعر وأيقوناته. ليس فقط بسبب صدقها المفرط، والتصاقها الحميم بمكابدات الشاعر في أثناء احتضاره، وليس لطزاجة صورها وحدبها على التفاصيل فحسب، بل لمكاشفاتها الوجودية العميقة التي دفعت البعض إلى إدراجها في خانة الحداثة الشعرية، أو إلى استلهام مناخاتها عبر تناص أسلوبي ورؤيوي، كما فعل يوسف الصايغ في قصيدته المميزة «اعترافات مالك بن الريب».
ولعل اختيار مالك لقافية الياء المفتوحة في قصيدته لم يكن بفعل الصدفة، بل لأنه أراد أن يحول القافية إلى نداء استغاثة حار يطلقه يائساً في خلاء الوجود العاري: «تذكرتُ من يبكي علي فلم أجد \ سوى السيف والرمح الرديني باكيا \ فيا صاحبي رحْلي دنا الموت فانزلا \ برابية إني مقيمٌ لياليا \ وخطأ بأطراف الأسنة مضجعي \ وردّا على عيني فضْل ردائيا \ يقولون: لا تبعد، وهم يدفنونني \ وأين مكان البعد إلا مكانيا \ وبالرمل منا نسوة لو شهدنني \ بكين، وفدّين الطبيب المداويا».
وإذا كان الشعر العربي الحديث قد أرسى مفهوماً للكتابة تتشابك فيه الموضوعات والهواجس المختلفة، متجاوزاً الأغراض التقليدية القديمة، كالفخر والمديح والهجاء، فإن الرثاء، بوصفه صرخة احتجاج في وجه الفقدان والموت، ظل يشغل حيزاً غير قليل من تجارب الشعراء المعاصرين، سواء كان رثاءً للحضارة العاجزة عن النهوض، كما فعل خليل حاوي في «لعازر»، أو رثاءً لأصدقاء وأقرباء وشهداء، كما عند السياب ونزار قباني وعبد الصبور وحجازي والفيتوري ودرويش وأمل دنقل وكثر غيرهم. على أن رثاء النفس لدى الاستشعار بدنو الرحيل يتمثل على نحو خاص لدى السياب وأمل دنقل ومحمود درويش. فالسياب المتيقن في أواخر أعوامه من تفاقم مرضه العضال، ومن المآل المأساوي الذي ينتظره وهو في ريعان شبابه، حوّل نصوصه الأخيرة إلى ما يشبه المراثي الشخصية المخترقة بصور الموت وتداعياته المتخيلة: «ويا مرضي \ قناع الموت أنتَ \ وهل تُرى لو أسفر الموتُ \ أخافُ؟ \ ألا دعِ التكشيرة الصفراء والثقبينِ \ حيث امتصت العينينْ \ جحافلُ من جيوش الدود يجثمُ حولها الصمتُ».
ومن داخل غرفة العناية المركزة، كتب أمل دنقل مجموعته الأخيرة «أوراق الغرفة رقم 8» التي لم تكن رثاءً لنفسه الذاوية فحسب، بل رثاء لبراءة العالم وكائناته وحيويته المتداعية، وصولاً إلى تماهيه المأساوي مع الخشب الهش لسرير المرض «وهذا السريرْ \ ظنني مثله فاقد الروح \ فالتصقتْ بي أضلاعهُ \والجماد يضمّ الجماد ليحميَهُ من مواجهة الناس \ صرتُ أنا والسريرْ \ جسداً واحداً في انتظار المصيرْ».
أما محمود درويش الذي لم يتردد في بعض مقاطع «الجدارية» في التعويل على الإبداع كسلاح ناجع في مواجهة الزوال: «هزمتك يا موت الفنون جميعها»، فهو يكشف في مقاطع أخرى عن أن التأسّي بالشعر لن يغير شيئاً من حقيقة الزوال المادي للإنسان.
وهو إذ يرسم بنفسه مشهدية رحيله، يزود مشيعيه بكثير من الوصايا التي تتلاءم مع ذائقته الجمالية ومزاجه الشخصي «صبّوني بحرف النون \ حيث تعبّ روحي سورة الرحمن في القرآن \ وامشوا صامتين معي على خطوات أجدادي \ ووقع الناي في أزلي \ ولا تضعوا على قبري البنفسجَ \ فهو زهر المحبطين \ يذكّر الموتى بموت الحب قبل أوانهِ \ وضعوا على التابوت سبع سنابلٍ خضراءَ إن وجدتْ \ وبعض شقائق النعمان إن وجدتْ».
رثاء الذات كمحاولة يائسة لرتق ثوب الوجود الممزق
قدماء ومعاصرون رثوا أنفسهم قبل الموت

محمود درويش - أمل دنقل - بدر شاكر السياب - صلاح عبد الصبور

رثاء الذات كمحاولة يائسة لرتق ثوب الوجود الممزق

محمود درويش - أمل دنقل - بدر شاكر السياب - صلاح عبد الصبور
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة