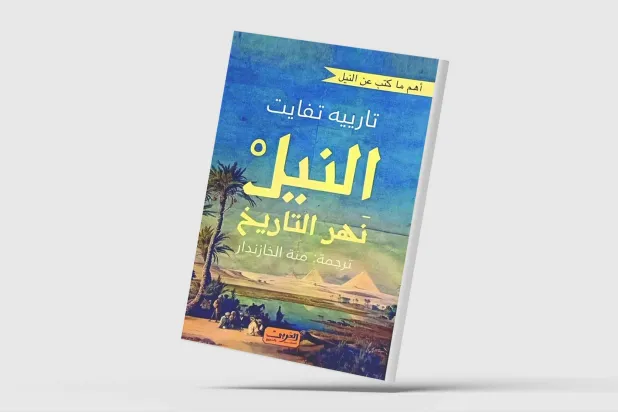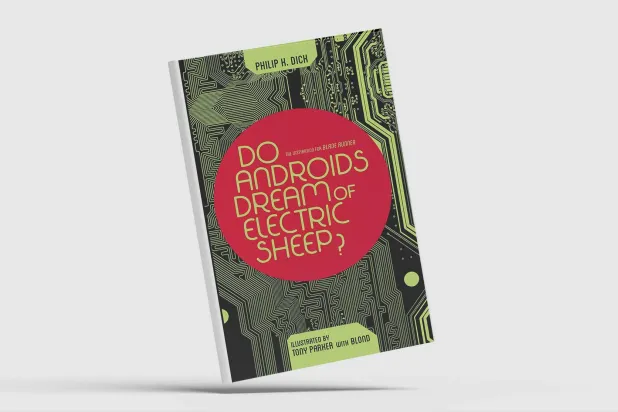في ذلك الزمان، عندما كان اليوم طويلاً جداً، سمعت من يقول: «كلما أنظر إلى مكتبتي، أشعر بالأسى لمصيرها»، وقد كان لا بد من الانتظار لنحو ثلاثين عاماً كي أفهم ما تعنيه تلك العبارة الواضحة.
لا أعرف، هل كان قدراً أم اختياراً أن تكون صداقاتي في محيط رجال كانوا بعمر أبي يوم عرفتهم؛ لن تغيِّر معرفة السبب شيئاً من حقيقة أن صداقاتي كانت بين جيل الستينات من الكُتَّاب. وكان محمد البساطي العذب - إذا احتدم الخلاف بيننا - لا يجد ما يناوشني به سوى تذكيري بأنني «عيِّل»، وكنت أقول له إننا أبناء جيل واحد (هم كتبوا في الستينات، وأنا ولدت فيها).
بالنتيجة، لا أنصح شاباً بمثل هذه الصداقة، فسريعاً يغرب أصدقاؤك ويتركونك وحيداً، وبقدر ما تستفيد من صحبة الأكثر خبرة، تبقي هناك أشياء عصية على فهمك، أشياء لا تستطيع أن تستقبلها كمثل استقبال صديقك الأكبر سناً، ولا يمكن أن تشاطره الإحساس بها. من هذه الأشياء الحسرة على مصير المكتبة؛ أولاً لأن فكرة الموت نفسها تكون بعيدة عن إدراكنا في السن الصغيرة، وثانياً لأنك عندما تكون شاباً لا تفصل بين ذاتك والعالم، تتصور أن الجميع على شاكلتك، وبالتالي سيكبر أولادك على حب الكتب.
باختصار، كان صعباً على شاب محب للكتب - كالشاب الذي كنته أنا - أن يتصور مصيراً حزيناً لمكتبته.
كان أصدقائي يفكرون بذلك المصير، بينما كنت سادراً في الغي، أتنقل من بيت لبيت ومكتبتي معي، دون أن أشعر بأن وجودها مهدد، بل بالعكس، كانت في كل نقلة تحظى بفضاء أرحب. ومثلما أفرح بإطلالة البيت الجديدة التي قد تكون أسوأ من سابقتها، لكنها جديدة، كنت أفرح بالمساحة الأوسع التي أتيحت لمكتبتي التي أعاملها وكأنها خالدة، وأدللها كما أدلل أبنائي، وأكافئها بقطعة أثاث جديدة.
ولا يصبح البيت بيتاً إلا عندما يستقر كل كتاب في المكان اللائق به، مثلما يستقر أبنائي في غرفهم. أيام جمع الكتب من المكان القديم، وإعادة تسكينها في الجديد، هي أيام تجديد للارتباط، ومراجعة وثائق النسب التي هي ذكرياتي عن أول قراءة، مناسبة لمواساة الكتب المصابة على الجراح، وتضميد الممكن منها بلاصق لا يشوه جمالها. أيام النقل هي كذلك أيام لتقليم ذلك البستان، وإزالة الغصون اليابسة، وهذا عمل مهم ينبغي أن يتم بشكل دوري، لكننا قد نهمله بسبب انشغالنا.
ونحن لا نتخلص من الكتب السيئة فحسب؛ بعض الكتب جميلة لكنها تفتقر إلى العمق أو الغموض، أو السر الذي يجعلها تصلح لقراءات متكررة، هي أغصان تثمر مرة واحدة، للقارئ الواحد، ومن الخير إهداؤها إلى قارئ جديد يقطف منها هو الآخر قطفته. سأكتشف لاحقاً أن التخلص من الكتب الغامضة والواضحة على السواء هو أول ما يفعله معظم الورثة بعد موت مورثيهم، بعضهم يسعى إلى جامعة أو مكتبة عامة لتقبلها باسم صاحبها، وبعضهم يتخلص منها بالكنس.
يبدو أن الحمض النووي البشري لا يحتمل ثقل «حب الكتب»، لذا لا تتوارث السلالة الواحدة دائماً هذا الحب. لكن من حسن الحظ أن الكتاب بوسعه استئناف حياته مثل قط أُلقي به إلى الشارع. في الغالب، سيصادف قارئاً عطوفاً على أقرب ناصية، ما دام لم يتعرض للحرق.
وإذا كان الكاتب واثقاً من أنه لن يترك وراءه ذرية متطرفة تقيم محرقة لكتبه، عليه ألا يقلق على مصير كتبه، وأن يسعد بصحبتها حتى النهاية.
أثق في أحكام الأذكياء، وبينهم شيزار بافيزي الإيطالي الذي عرف الحياة جيداً فانتحر، يقول في يومياته «مهنة العيش» إن مصدر سعادتنا بالأشياء هو اليقين بأننا على اتصال بشيء سيعمر بعدنا.
ستبقى الكتب بعدنا، وتتلقى لمسات من أياد جديدة - حتى لو كانت غريبة - توقظ لمساتنا وعلامات مرورنا التي تركناها هناك.
الكتب، على أية حال، ليست مجرد «أشياء»، ربما كانت كذلك عندما اشتريناها، وربما هي كذلك لدى من يؤثثون مكتبات كنوع من الواجهة الاجتماعية، دون أن يقرأوا كتبها المجلدة بألوان تتماشى مع الديكور (بعضهم يضع مكتبات خلابية، رفوف مصمتة بتعريجات تبدو وكأنها كعوب كتب)، هؤلاء ليسوا في حسابنا لأنهم لم يلتقوا بالكتاب أصلاً.
يظل الكتاب «شيئاً» حتى نقرأه، فيصير كتاباً. آنذاك، يصبح جزءاً من وجودنا: الخبرة التي اكتسبناها منه، والسعادة التي عشناها، والخلاف في الرأي معه. بعد ذلك، سيصبح ما نحتفظ به على الرفوف ليس مجرد عدد الأوراق المقصوصة بالتساوي بين غلافين، لأن صفحاته تتحول إلى صفحة من حياتنا. من يدرك هذا المعنى لا يترك لأحدٍ غيره تنظيف مكتبته، فلا أحد غيرك بوسعه أن ينفض الغبار عن حياتك.
قد يكون إدراك هذا التطابق بين الكتب وذواتنا هو أصل القلق على مصير المكتبة. ويبدو أنني أسوأ حظاً من أصدقائي الكبار الذين لم يعرفوا سوى الكتاب المطبوع؛ لم أخطُ نحو الغروب إلا وقد ابتكرت لي التكنولوجيا الكتاب الرقمي، الذي أصبحت أقتني منه أكثر مما أقتني من الورق، لكنه كتاب شبح يتواصل مع العين وحدها دون أن تختلف في إصبعي - عندما أقلب الصفحة - لمسة أمينة زوجة السيد أحمد عبد الجواد من لمسة إيما بوفاري، والأسوأ أن وجوده أكثر هشاشة من وجودي، إذ يمكن أن يبدده عطب في جهاز القراءة، أو حتى في الشاحن الكهربائي.
تركني الصحاب بين كتاب يجرح برسوخه هشاشة وجودي، وآخر هش بدرجة مفرطة يُذكِّرني بسرعة الزوال، وما من سبيل إلا العيش مع الكتابين بأقل أسى ممكن!
9:41 دقيقه
المكتبة وجودنا الجارح... وجودنا الهش
https://aawsat.com/home/article/1399906/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4



المكتبة وجودنا الجارح... وجودنا الهش
يظل الكتاب «شيئاً» حتى نقرأه فيصير كتاباً


المكتبة وجودنا الجارح... وجودنا الهش

مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة