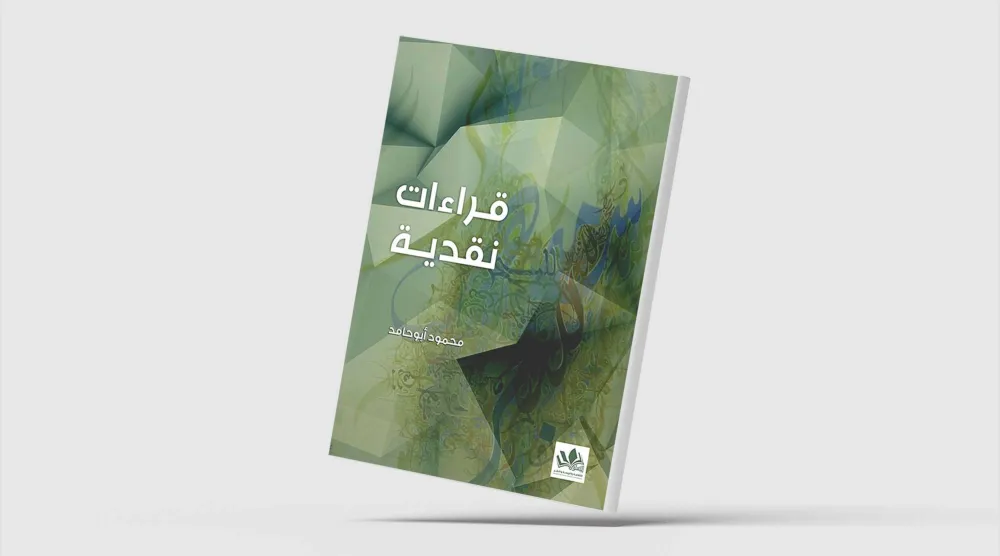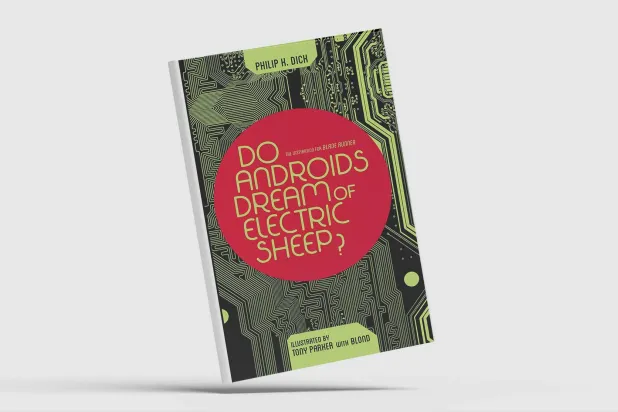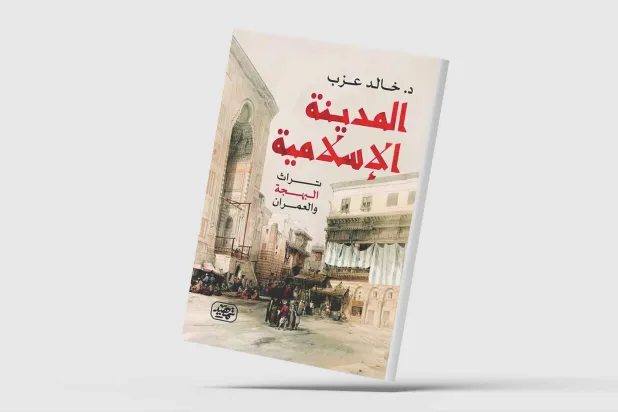نشرت «ثقافة»، بتاريخ 31 - 7 – 2018، مقالاً بعنوان: «عودة أدبية فرنسية لاستلهام الحروب الصليبية»، لكاتبه د. رياض معسعس. وننشر هنا التعقيب التالي، مع رد كاتب المقال عليه.
فوجئت بعنوان مثير للغاية يتصدر الصفحة الثقافية في جريدة «الشرق الأوسط»، بتاريخ 31 - 7 - 2018، للكاتب رياض معسعس، يحمل حكماً قاطعاً يشير إلى «عودة أدبية فرنسية لاستلهام الحروب الصليبية»، مع عنوان فرعي «آخرها قصة قصيرة عن الصليبية والجهاد».
أولاً، لا يوجد في هذا المقال، المنشور على مساحة كبيرة، ما يثبت صحة هذه الدعوى سوى الإشارة إلى «قصة قصيرة حول الصليبية والجهاد»، للكاتب الإيطالي ألساندرو باربيرو، ثم حديث مطول عن خلفية هذا الاهتمام الغربي بالحروب الصليبية، ومتى استخدمت كلمة الحروب الصليبية للمرة الأولى في القواميس والمعاجم الفرنسية، وكذلك الإشارة إلى بعض الكتب والدراسات من هنا وهناك، المتعلقة بهذا الأمر.
عندما يعود القارئ إلى مطالعة هذه القصة القصيرة التي استند إليها كاتب المقال لتبرير دعواه بوجود عودة أدبية فرنسية للحروب الصليبية، نكتشف أنها ليست بقصة قصيرة، وإنما دراسة عنوانها بالإيطالية «الحرب المباركة: الحرب المقدسة والجهاد»، وتحتوي على تاريخ موجز لأهم محطات وقضايا الحروب الصليبية، موزعة على أربعة فصول صغيرة: يتضمن أولها تعريفاً دقيقاً للحروب الصليبية، ويحمل ثانيها عنوان «الملحمة»، وثالثها بعنوان «بين الحرب المقدسة والجهاد، أما رابعها فيحمل عنوان «الغرب في عيون الآخرين».
ولا يوجد في أي صفحة من صفحات الكتاب ما يشير إلى أن المؤلف يسعى لاستلهام الحروب الصليبية، ناهيك عن كونه أستاذاً جامعياً متخصصاً في تاريخ العصور الوسطى، وله كتب كثيرة في هذا المضمار، كان آخرها كتاب «كلمات البابوات التي غيرت العالم»، أضف إلى ذلك أن الكتاب الذي ينظر إليه كاتب المقال على أنه قصة قصيرة لم يصدر هذه الأيام، وإنما صدر منذ عقد من الزمان تقريباً باللغة الإيطالية، وليس بالفرنسية حتى يكون ضمن العودة الأدبية الفرنسية لعام 2018! وقد تمت ترجمته إلى الفرنسية عام 2010، عن دار «فلاماريون»، ثم قامت الدار ذاتها بإعادة طبعه في طبعة ثانية، في مايو (أيار) 2018. وربما كانت هذه الطبعة الثانية هي التي اطلع كاتب المقال على عنوانها، دون أن يطلع عليها، ولا على الطبعة الأولى، وإلا ما كان قد وقع في هذا الخطأ الفادح في الحديث عما اعتبره قصة قصيرة. وربما ما أوقع كاتب المقال في هذا الموقف الذي لا يُحسد عليه أن الدار الفرنسية لم تحتفظ بالعنوان القديم للطبعة الأولى، وهو «تاريخ الحروب الصليبية»، وجعلت عنوان الطبعة الثانية «الحروب المقدسة: تاريخ موجز للحروب الصليبية والجهاد».
من يطلع على الكتاب، في طبعته الفرنسية الأولى أو الثانية، لن يجد اختلافات سوى في عناوين الطبعتين، ولن يجد في الكتاب، وهو صغير الحجم، لا يتجاوز 124 صفحة من الحجم الصغير، ما يمكن أن نعده استلهاماً للحروب الصليبية، وإنما دراسة تقدم رؤية عامة - وبلغة في متناول الجميع - لمسار ومحطات الحروب الصليبية وملامحها الرئيسية. كما يؤكد مؤلف الكتاب أن الحكم على الحروب الصليبية قد تغير بالفعل مع مرور الزمن (ص29). ورصد مؤلف الكتاب لحظات من تطور الوعي الغربي إزاء هذه الحروب، من بداية الحماسة لها والاحتفاء بها إلى مرحلة الشعور بالعار منها، عندما أدرك الغربيون مدى ما صاحبها من قدر هائل من العنف والحقد تجاه الآخر، ليس فقط المسلم، وإنما أيضاً الآخر اليهودي، حيث قامت الجماهير الهائجة المشاركة في الحرب الصليبية الأولى بارتكاب المذابح الأولى ضد اليهود، وأن النموذج المثالي للحروب الصليبية قد توقف في بعض الفترات عن أن يجذب إليه الغربيين، وكان هذا في عام 1270 (ص40)، إلى أن يصل مؤلف الكتاب إلى مرحلة العودة من جديد إلى النظر للحروب الصليبية بوصفها ملحمة ينبغي الإشادة بها، وليس كتراجيديا ينبغي إدانتها، وهو أمر يستحق أن يناقش عندما نتناول الانعكاسات الراهنة والمحتملة لهذه الحروب الصليبية (ص10). وأكثر من ذلك، فإن المؤلف عندما يتناول الأبعاد الدينية لهده الحروب، فهو يتناولها بمنهجية المؤرخ الأكاديمي فحسب (ص55).
يشير مؤلف الكتاب أيضاً إلى تطور وعي المسلمين تجاه هذه الحروب، ويستخدم في ذلك اللغة ذاتها التي كان يستخدمها المسلمون، حيث يقول في فقرة لا تخلو من دلالات: «لم يقف المسلمون مكتوفي الأيدي أمام قبيلة من البرابرة الدمويين الذين لا يعرفون من أين جاءوا، ناهيك عن شعورهم بأنهم من الكفار الذين دخلوا الأراضي الإسلامية، ونشروا فيها الخراب، واستولوا على مدنهم المقدسة. وشعر المسلمون أن هذه الحروب الصليبية كانت عدواناً صارخاً عليهم، وعلى ربهم، عندما استولى كفار الغرب هؤلاء على القدس، وقبر السيد المسيح، الذي هو بالنسبة للمسلمين نبي كبير جدير بالتقدير. وسرعان ما تحرك العالم الإسلامي لاستعادة المدينة المقدسة، وطرد الغزاة منها» (ص16).
ويقرأ مؤلف الكتاب حدث الحروب الصليبية بمصطلحات معاصرة أحياناً، مثل صدام الحضارات (ص83)، أو سوء الفهم الثقافي (ص114)، ولا سيما في الفصل الأخير من الكتاب الذي يتحدث فيه عن «الغرب بعيون الآخرين»، ويقول في هذا الشأن: «بالطبع، ليست أنشودة رولان، رغم شاعريتها العظيمة، هي المثال الأخلاقي الذي يمكن أن نقتدي به في القرن الحادي والعشرين، إلا أنها تعكس بصورة واضحة الطريقة التي كانوا يفكرون بها آنذاك، إذ كان الجميع، من المسيحيين والمسلمين، ومن بين المسيحيين، سواء كانوا من الكاثوليك اللاتين أو الأرثوذكس اليونان، يفكرون بالطريقة نفسها التي تحتوي على التعارض الثنائي بين الـ(نحن) والـ(هم)» (ص87).
أسهبنا بعض الشيء في تقديم الأفكار والملامح الرئيسية لهذا الكتاب الصغير، لكي نقول للسيد رياض معسعس، كاتب المقال، إنه تحدث دون دراية، وارتكب سلسلة من الأخطاء ما كان ينبغي أن يقع فيها، ليس أقلها أنه لم يفهم طبيعة الكتاب الذي أشار إليه، واتخذه مرتكزاً لدعواه بعودة أدبية فرنسية تستلهم الحروب الصليبية، بارتكاب كثير من الزلات التي لا يمكن تبريرها عندما تحدث عن التأثير الشرقي على الغرب، دون أن يذكر الأمثلة المناسبة على ذلك، باستثناء مثال تأثر دانتي بأبي العلاء المعري، وكذلك عندما أشار إلى أسماء ثلاثة من كبار المؤرخين، وزعم أنهم من معاصري الحروب الصليبية، بينما أحدهم فقط الذي يمكننا القول إنه كان معاصراً لها، بينما المقريزي والقلقشندي لا يمكن أن يندرجا تحت صفة معاصرين لها، بل جاءا بعد قرن من الزمان على نهايتها تقريباً. كما أخفق السيد رياض معسعس عندما أشار إلى أحد المراجع الرئيسية في تاريخ الحروب الصليبية، الذي تشرفت بترجمته إلى العربية عام 1995، وصدر في القاهرة بعنوان «الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية»، بينما السيد رياض معسعس يترجم العنوان بصورة خاطئة ويسميه «مشرق ومغرب في زمن الحروب الصليبية»، وثمة بون شاسع بين العنوانين.
خلاصة القول، إن كاتب المقال بجريدة «الشرق الأوسط» لم يوفق تماماً في دعواه بوجود عودة أدبية فرنسية لاستلهام الحروب الصليبية، وذلك بالاستناد لكتاب وحيد (مترجم عن الإيطالية)، لم نتمكن عند قراءته من التثبت من هذه العودة الأدبية. وكان على كاتب المقال أن يقوم بتقديم استعراض لهذه الأعمال الأدبية الفرنسية، وأن يتثبت من تلك الأعمال التي ادعى أنها تعود للحروب الصليبية، وأن يحدثنا عن نسبتها، بالمقارنة مع العدد الكامل لمثل هذه الأعمال.
- رد الكاتب رياض معسعس
> يبدو من مقال السيد الشيخ أنه لم يفهم ما هو مغزى مقالي، وقد أخطأ كثيراً، ذلك أن ما قلته في المقال يخالف تماماً ما ورد في مقالته، فأنا لم أقل أبداً إن هناك عودة للحروب الصليبية في الأدب الفرنسي، بل قلت إن الأوروبيين بشكل عام، والفرنسيين بشكل خاص، ما زالوا إلى اليوم يهتمون بالحروب الصليبية، ويقيمون فيها أبحاثاً تاريخية واقتصادية ودينية وأدبية، ويسردون قصص أبطالها، وكل من شارك فيها من ملوك وأمراء وسواهم! وقد أعطيت أمثلة كثيرة في أزمنة مختلفة، تم فيها التطرق للحروب الصليبية، ولا يمر عام إلا ويصدر أكثر من كتاب حول الموضوع، حتى وصلت المؤلفات إلى أكثر من ألف وخمسمائة مؤلف، وهذه مسألة إيجابية لأنها تبحث في إيجابيات الحملات الصليبية وسلبياتها، بل هناك من أثنى على أبطال عرب، كأندريه ميكيل في ترجمته لمذكرات أسامة بن المنقذ. وليسمح لي السيد شيخ، فأنا درست الإعلام والآداب في السوربون، وقضيت اثني عشر عاماً على مقاعدها، وأحمل شهادتي دكتوراه دولة منها، وأعي تماماً ما أكتب وما أقول.
- أحمد الشيخ: كاتب مترجم مصري مقيم في باريس