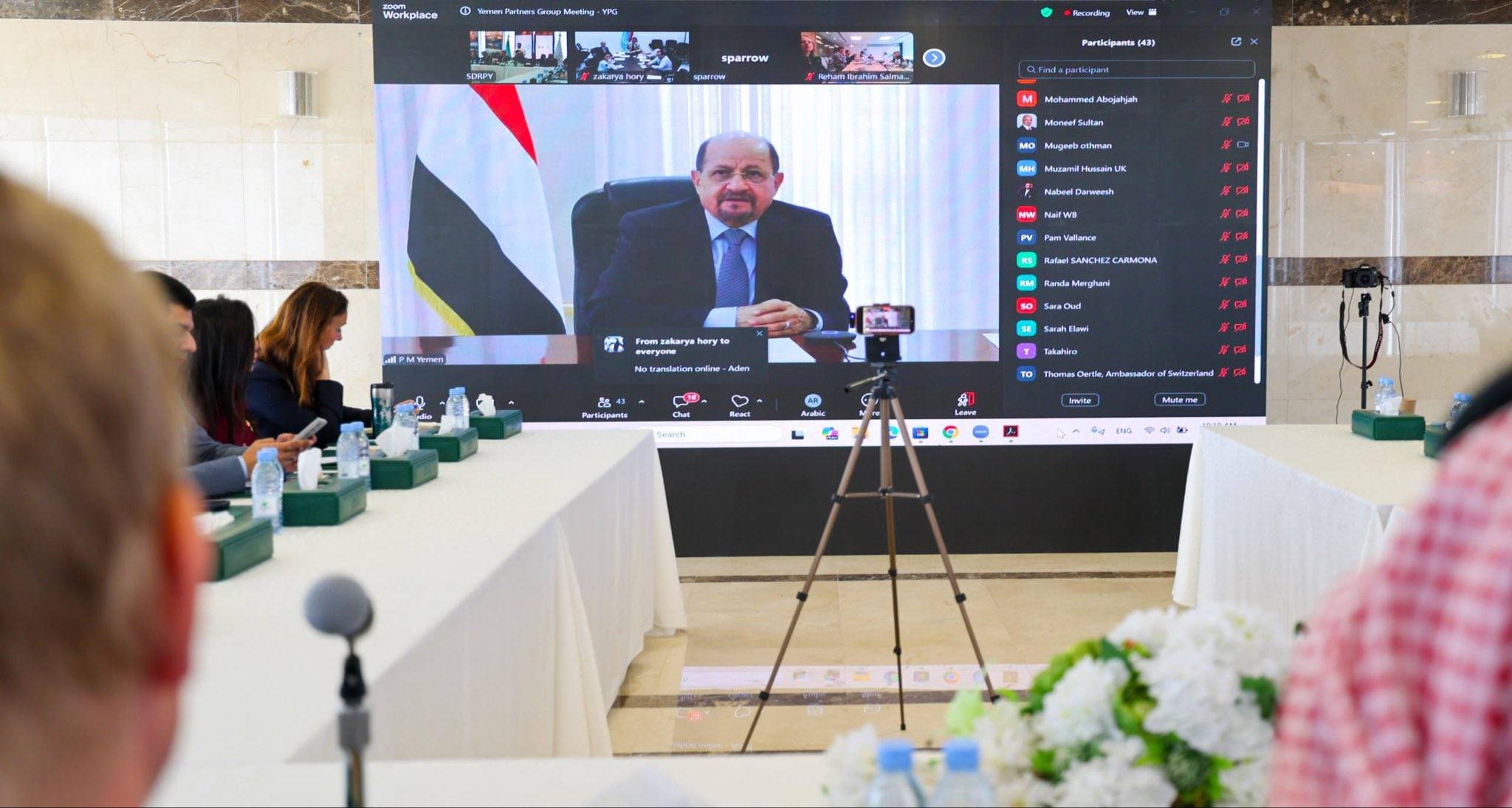يقف أحمد مصطفى، وهو أحد عناصر الشرطة الاتحادية العراقية مع ثلاثة من زملائه في نقطة تفتيش في جانب الرصافة وسط بغداد لتأمين السلامة الأمنية وعدم نقل أي سيارة لمواد متفجرة أو أسلحة.
ومثل هذه النقاط التي يطلق عليها العراقيون تسمية «السيطرات»، تنتشر بكثافة في جميع شوارع العاصمة العراقية الرئيسية والفرعية وتمثل مصدر إزعاج للمواطنين كونها تؤخر انسياب حركة السير، لكن مصطفى (28 سنة) الذي كان بذل جهدا كبيرا لقبوله في الشرطة الاتحادية وتأمين حياته ماديا، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نبذل جهودا كبيرة من أجل تأمين سلامة المواطنين وهم غير راضين عنا، نقف هنا في ظروف جوية صعبة خاصة في الصيف ونقرأ في عيون سائقي السيارات الاستياء نتيجة تأخرهم لدقائق».
الجانب الأخطر في عمل القوات الأمنية في بغداد وبقية المدن العراقية هو أنهم الأكثر تعرضا للموت حيث غالبا ما يفجر الإرهابيون الانتحاريون سياراتهم المفخمة قرب نقاط التفتيش هذه، يقول الملازم نصيف الساعدي، وهو شاب (24 سنة» لـ«الشرق الأوسط» وهو يقف تحت أشعة شمس حارقة: «نحن بمثابة الدرع أو المصدات أو الدروع البشرية التي تتحمل الضربة الأولى للإرهابيين عندما يعجزون المرور بوسائل الموت من المتفجرات من خلال نقاط التفتيش»، مشيرا إلى أن «غالبية الإرهابيين خاصة أولئك الذين يخططون للهجوم على أبنية مؤسسات حكومية أو أمنية يفجرون سياراتهم المفخخة بنقاط التفتيش أو الحراسة لقتل العناصر الأمنية ومن ثم يمر من معهم إلى داخل البناية كما يحدث في مثل هذه العمليات الإرهابية».
في نقطة تفتيش أخرى عند جسر الجادرية يمر العنصر الأمني قرب السيارة وهو يحمل جهاز الكشف عن المتفجرات، هذا الجهاز المثير للجدل بسبب ما قيل عن عدم جدواه أو عدم تمكنه من الكشف عن المواد المتفجرة، نسأل العنصر الأمني عما إذا كان هذا الجهاز يعمل بالفعل أو مجديا أم لا، يقول: «بالتأكيد يعمل ومفيد للغاية وإلا فلماذا نستخدمه؟»، مشيرا إلى أن «الشائعات التي قيلت ضد الجهاز انطلقت من سياسيين وأن العملية عبارة عن مناكفات سياسية»، وقال: «نحن لا علاقة لنا بما يقولون، السياسيون يتشاركون مع بعضهم ونحن بعيدون عن السياسة»، بينما قال الملازم الساعدي إن «ما يثير السخرية بالفعل هو أن الحكومة هي التي استوردت هذه الأجهزة ووزعتها في جميع مناطق العراق وأصدرت الأوامر باستخدامهما، حتى الأجهزة الأمنية في مدن إقليم كردستان تستخدم هذه الأجهزة، ثم انطلقت الأقاويل من مصادر في الحكومة ذاتها بأن الجهاز لا يعمل وهو ليس ذا جدوى».
وعندما سألناه إن كانت هناك أجهزة تعمل وأخرى بلا جدوى، أجاب قائلا: «هي الأجهزة ذاتها التي تستخدم في جميع مناطق العراق وحتى عند بوابات ونقاط تفتيش المنطقة الخضراء التي يقيم فيها كبار المسؤولين بالحكومة وبينهم رئيس الوزراء والسفارات العربية والغربية فهل تعتقد أنهم يكذبون على أنفسهم ويعرضون حياتهم وحياة عوائلهم للخطر».
ويرفض الشرطي خضير كامل التعليق على هذا الموضوع ويقول: «نحن لا نناقش مثل هذه الأمور، نحن ننفذ الأوامر، والأوامر تقول لنا بأن نستخدم هذا الجهاز ولهذا علينا أن نستخدمه». وعندما نسأله عن جدوى الجهاز يعود ويكرر رفضه الإجابة ويقول: «اذهبوا واسألوا المسؤولين».
«الشرق الأوسط» اتصلت بمسؤول كبير سابق في وزارة الداخلية وكان طرفا في صفقة استيراد جهاز الكشف عن المتفجرات لسؤاله عن مدى فاعلية هذا الجهاز، قال: «إن دولا كثيرة غيرنا تستخدم هذا الجهاز ونحن جربناه وشكلنا لجنة فنية لفحص الجهاز وقد اجتاز الاختبار وإلا كنا سحبناه من الاستعمال». وتساءل قائلا: «هل تتصورين أننا نعرض حياة مواطنينا لخطر التفجيرات الإرهابية لمجرد التغطية على فشلنا أو فشل الجهاز؟».
ويضيف المسؤول السابق في وزارة الداخلية الذي رفض نشر اسمه، قائلا: «في الأشهر الست الأولى من استخدام جهاز الكشف عن المتفجرات انخفضت العمليات الإرهابية وانحسر مرور المتفجرات من خلال نقاط التفتيش، لكن هناك جهات سياسية استخدمت القصة ضد خصومهم وادعوا أن هذه الأجهزة لا تعمل، مما أدى إلى اختلاق وسائل للتحايل على الأجهزة من جهة، وإلى اعتقاد عناصر الأمن أنهم يحملون أجهزة لا تعمل، لهذا لم يأخذوا الأمر بعين الاهتمام، لكن غالبية منهم يتعاملون مع هذه الأجهزة باعتبارها عاملا مساعدا للكشف عن المفخخات والعبوات الناسفة».
وفي رده على سبب محاكمة صاحب الشركة البريطانية التي صدرت هذه الأجهزة إلى العراق وسجنه مع تغريمه، قال المسؤول السابق في وزارة الداخلية: «هذا موضوع يتعلق بالحكومة والقضاء البريطاني، ربما هم حاكموه بسبب عدم دفعه للضرائب»، مضيفا: «ليس من العدل والمنطق أن نحمل هذه الأجهزة سبب الخروقات الأمنية والتفجيرات وفشل المسؤولين عن الملف الأمني في العراق؛ فهناك إخفاقات في الاستخبارات وفي أداء المسؤولين الأمنيين، ثم إن هناك أجهزة غالية (سونار) متطورة وغالية الثمن تستعمل في مناطق حساسة في بغداد».
9:41 دقيقه
شرطيو نقاط تفتيش بغداد يشكون من صعوبة مهمتهم وعدم رضا الجمهور
https://aawsat.com/home/article/89331



شرطيو نقاط تفتيش بغداد يشكون من صعوبة مهمتهم وعدم رضا الجمهور
ملازم في إحدى النقاط: نقف في ظروف جوية سيئة ونقرأ في عيون سائقي السيارات الاستياء

لجان فرز الانتخابات تواصل عملها في العاصمة بغداد أمس (أ.ب)
- بغداد: معد فياض
- بغداد: معد فياض

شرطيو نقاط تفتيش بغداد يشكون من صعوبة مهمتهم وعدم رضا الجمهور

لجان فرز الانتخابات تواصل عملها في العاصمة بغداد أمس (أ.ب)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة