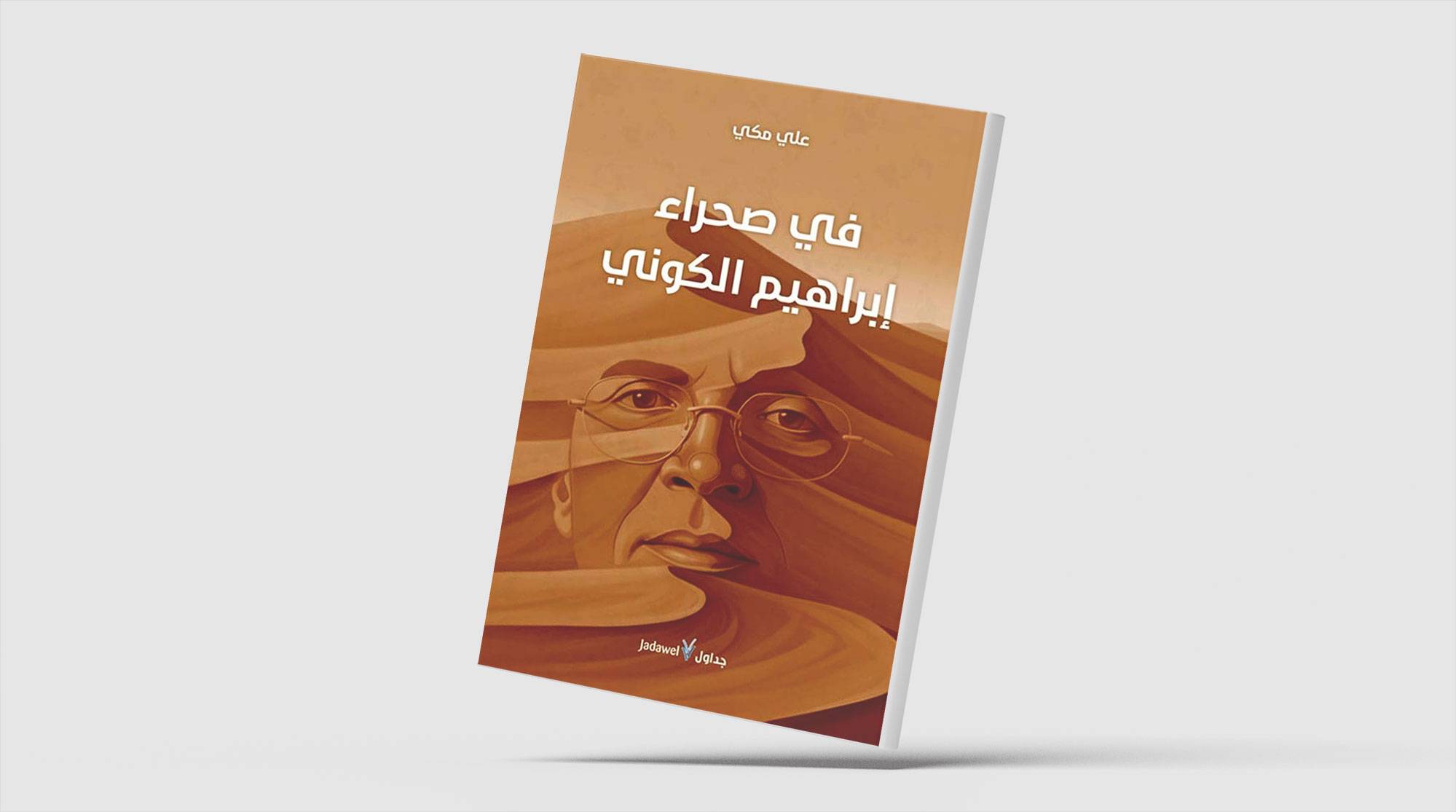الطريقة الكلاسيكية لرسم نظرية سياسية يراد بها أن تكون عادلة هي أن يتم رسمها لتكون تطبيقا لنظرية أخلاقية أولية. بمعنى أن تكون النظرية السياسية عبارة عن استنباط من مبادئ أخلاقية سابقة عليها ومؤسسة لها. سياسات الدول الدينية نموذج مناسب لتوضيح هذه الصيغة. السياسة الدينية هي عملية تطبيق خاضعة لقواعد ومبادئ دينية سابقة وراسخة. صحة وسلامة النظرية السياسية هنا خاضعة لمدى موائمتها للمبادئ والقيم الدينية العليا. الفلسفة يمكن أن تكون مرجعا أخلاقيا للنظرية السياسية أيضا. على سبيل المثال السياسة الماركسية تخضع لما تم إقراره مسبقا في الفلسفة الماركسية لمفاهيم الخير والحق والعدل. يمكن أن نمد الأمثلة لسياقات مختلفة كثيرة. لكن جون رولز لا يريد أن يؤسس نظريته في العدالة على هذا المنهج.
كفيلسوف ليبرالي يعتقد رولز أن النظرية السياسية الليبرالية يجب أن تواجه حقيقة جوهرية في كل المجتمعات الديمقراطية وهي حقيقة التنوع. المجتمعات الديمقراطية تحتوي أفرادا مختلفين في خلفياتهم الدينية والعرقية والجنسية والفلسفية.. إلخ. هذه الحقيقة تفرض على نظرية العدالة أن تبحث عن مبادئ تحظى بالقبول من أفراد هذا التنوع. بمعنى أن رولز يبحث عن نظرية للعدالة يمكن أن يقر بها المسيحي واليهودي والمسلم والبوذي والملحد والعلماني والرجل والمرأة والأبيض والأسود إلى آخر عوامل التنوع البشري. هذا تحد هائل لأي نظرية سياسية، ولكن رولز يعتقد أنه ممكن ولكن بشروط. أول هذه الشروط أن تكون هذه النظرية سياسية لا ميتافيزيقية شاملة. بمعنى أنها نظرية خاصة بعمل مؤسسات البنية الأساسية ولا تتدخل في سلوك وقرارات الناس الخاصة. بمعنى أنها نظرية متعلقة بالمكونات الأساسية للمجال العام وتترك المجال الخاص لأصحابه. هذه المساحة تترك مجالا واسعا للتنوع والاختلاف وضريبتها أن تتخلى النظرية عن ادعاء تقديم مفهوم شامل للخير والحق ينطبق على سلوك الأفراد كما ينطبق على سلوك مؤسسات الدولة. هذه المعادلة قد توفر معدلا أكبر من الانتماء من فئات المجتمع المختلفة للقانون العام. هذا الانتماء يمثل مفهوما جوهريا عند رولز، فنظرية العدالة يجب أن لا تقوم على ما يسميهmodus Vivendi أي الاتفاق القائم على توازن معين للقوى. هذا التوازن يمكن أن يختل في يوم من الأيام ليختل معه استقرار المجتمع. الاستقرار الذي يبحث عنه رولز هو الاستقرار المبني على قواعد سليمة. هذا الاستقرار يتأسس على إجماع ناتج عن منطلقات مختلفة ومتنوعة. بمعنى أن فئات المجتمع المختلفة تجد في هذه الصيغة من نظرية العدالة قبولا يجعل منها ملتزمة ومقتنعة بالسير عليها وتطبيقها بصدق وأمانة.
تصور رولز للمجتمع يقوم على أنه مجتمع قائم على التعاون. أي أنه دون تحقيق شروط عادلة للتعاون بين أفراد هذا المجتمع فإنه لا يمكن الوصول إلى نظرية حقيقية للعدالة. الأفراد هنا يحضرون داخل علاقاتهم الاجتماعية وفي حالة تواصل مع الآخرين، وفي هذا السياق تحديدا ترتكز قدرتهم على تحقيق تعاون مؤسس على مبادئ العدالة. بحسب رولز يحتاج الفرد إلى قدرتين أساسيتين للقيام بهذا الدور. القدرة الأولى هي امتلاك حس العدالة، أي قدرة الفرد على فهم وتطبيق والانطلاق من مبادئ للعدالة تحدد الشروط العادلة للتعاون الاجتماعي. القدرة الثانية هي القدرة على تكوين مفهوم للخير. أي قدرة الفرد على أن يرسم مخططا لحياته مبنيا على تصور معين للخير والحق. القدرة الأولى تتضمن كذلك قدرة الفرد على إدراك أن الآخرين لهم الحق ذاته في امتلاك وتطبيق مفاهيمهم الخاصة للخير والحق. هنا تصبح المعادلة: كيف يمكن أن أعيش وفقا لمفهومي للخير وتعيش أنت كذلك وفقا لتصورك للخير؟ وبما أن مفاهيم الناس للخير والحق تتعارض فما يراه أحدهم حقا يراه الآخر باطلا فإن الاستعداد للتنازل والتسوية والوصول إلى مساحات وسطى هو أمر جوهري وقدرة أساسية لكل مواطن داخل علاقات اجتماعية محكومة بنظرية للعدالة.
هذه المعادلة التي تراهن على عدم الانطلاق من مفهوم ميتافيزيقي أو أخلاقي شامل تظهر في منطلقات تأسيس رولز لنظريته في العدالة وتحديدا من خلال الموقف الأصلي وحجاب الجهل. الموقف الأصلي هو الموقف الذي يفترض أن يتحقق فيه التعاقد على مبادئ العدالة. والأفراد فيه يقعون خلف حجاب الجهل، الذي يحجب عنهم مواقعهم الدقيقة في معادلة القوى داخل المجتمع ولكنهم يعلمون في ذات الوقت أنهم ينتمون لديانات وأعراق وأجناس وطبقات مختلفة. الفرد هنا يعلم أن هناك قويا وضعيفا وفقيرا وغنيا ومؤمنين بأديان مختلفة وغير مؤمنين، ولكنه لا يعلم إلى أي جماعة ينتمي تحديدا. هذا الموقف، يراهن رولز، سيدفع كل أطراف التعاقد لوضع مبادئ تجعل من حياتهم عادلة حتى لو كانوا ضمن الطبقات والجماعة الأقل حظا. حجاب الجهل هذا يدفع الفرد، وهو يفكر في مصلحته الذاتية أولا، أن يفكر في الجميع وخصوصا المتضررين والأقل نفعا من الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الحالي. الفرد خلف حجاب الجهل يعلم أنه يمكن أن يكون امرأة، ولذا يحرص على أن تكون مبادئ العدالة منصفة للمرأة. أيضا الفرد يعلم أنه يمكن أن يكون فقيرا ولذا يحرص على إنصاف الفقراء. هذا الفرد يعلم أنه يمكن أن يكون من المؤمنين بدين الأقلية ولذا فهو يحرص على إنصاف الأقليات. مبادئ العدالة الرولزية تقوم على هذا التفكير الفردي والجماعي والذي يراهن رولز على أنه وإن كان لا يتعارض مع امتلاك الأفراد لمنظومات ورؤى مختلفة للحياة والخير والشر إلا أنه لا يتأسس على هذه المنظومات بقدر ما يتأسس على الاشتغال على هدف توفير شرط سياسي يجعل من وجود كل هؤلاء المختلفين بشكل منصف كمواطنين أحرار ومتساوين ممكنا. معادلة رولز هذه تمكنت من جلب اهتمام هائل من فلاسفة السياسية وبالتالي جلبت انتقادات واسعة ستكون موضوعا للمقالات القادمة.
7:17 دقيقه
رولز بين الأخلاق والسياسة
https://aawsat.com/home/article/8102



رولز بين الأخلاق والسياسة
آمن أن النظرية السياسية الليبرالية يجب أن تواجه حقيقة جوهرية وهي حقيقة التنوع


رولز بين الأخلاق والسياسة

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة