يلقب «جيل دولوز» الفيلسوف سبينوزا بـ«أمير الفلاسفة»، ويعتبره نيتشه سلفًا حقيقيًا له، حين يقول: «أنا مندهش جدا، فقد اكتشفت أخيرا أن لي سلفا». فمن هو هذا الفيلسوف؟
ولد سبينوزا (1632 - 1677) في أمستردام، لأسرة يهودية كانت قد فرت من بطش محاكم التفتيش البرتغالية واستقرت في هولندا. درس العبرية واللاهوت والتعاليم اليهودية، وتلقن التلمود أيضا. فوالداه كانا يطمحان في يصبح حاخاما. لكن ميوله كانت تسير على خلاف ذلك. فتعلم اللاتينية، وكانت مفتاحا جعله يخترق النصوص التي تكون في الغالب للنخبة. التهم فلسفة مفكري القرون الوسطى، وعلى رأسهم توما الأكويني، وفلاسفة عصره، وأهمهم فرنسيس بيكون وتوماس هوبز وديكارت.
ونظرًا لشدة أسئلته وجدله داخل الكنيس اليهودي، سيطرد، بل ويجري فصله ولعنه من طرف الطائفة اليهودية، وحرمانه من حقوقه الدينية، وهو في الرابعة والعشرين من عمره. والأكثر من ذلك، ستجري ملاحقته والتحريض ضده في كل مكان، إلى درجة أن كاد أحد المتعصبين يقتله. فما كان من سبينوزا، إلا أن ينفي نفسه متنازلاً عن كل شيء بما في ذلك ثروة أبيه. فقد كان رجلا هادئا لا يحب المال والصخب والملذات والمناصب. اختار عزلة في إحدى ضواحي أمستردام، واشتغل بحرفته، وهي صقل عدسات زجاج النظارات، ليضمن بقاءه، وينكب كلية في العمل على إكمال مشروعه الفلسفي. لكنه لسوء الحظ، مات صغيرا في عمر الخامسة والأربعين، بمرض السل الذي زاد من حدته استنشاقه لكميات هائلة من غبار الزجاج. وعلى الرغم من ذلك، خلف لنا كتبا لا يزال صداها وتأثيرها قائما إلى الآن، ومنها: «رسالة في إصلاح العقل»، و«رسالة في اللاهوت والسياسة»، و«علم الأخلاق».
وفي الكتاب الأخير هذا، قدم سبينوزا تصورا هائلا ونسقيا للعالم، بأسلوب كتابي خاص جدا، جاء على شاكلة رياضية، تجعل من يقرأه يشعر بأنه يقرأ «الأصول» لإقليدس. ففيه التعريف والقضية والبرهان واللازمة والحاشية.
أما فلسفته، فسأختار منها قضية واحدة، هي قضية السعادة، والسبيل إليها لمناقشتها. ولمعالجة هذا الأمر أطرح السؤال التالي: كيف نتحكم في الانفعال السلبي ونحقق الغبطة؟
* الإرادة مجرد وهم
جاءت فلسفة سبينوزا، في معظمها، كنقاش مع الفيلسوف ديكارت، الذي أعلن وبقوة، إن الإنسان حر حرية مطلقة ودونما قيود، ما دام قادرًا على إثبات الشيء أو نفيه، على الفعل أو عدم الفعل، على الإقدام أو الإحجام. فالشك دليل مهم عند ديكارت على إرادة الإنسان، إذ من يمكنه من تعليق الأحكام وعدم إصدارها حول القضايا، ناهيك بأن الحرية هي الضامنة للمسؤولية، ومن ثم إعطاء مسوغ العقاب والثواب بجميع أنواعه الديني «العقاب الأخروي»، والاجتماعي «العقاب القانوني»، والأخلاقي «تأنيب الضمير». كل ذلك هو مؤشرات يجعل منها ديكارت، حجته في إثبات أن للإنسان إرادة حرة. وهذه الإرادة موطنها النفس لا الجسد. لأن الجسد مثل الطبيعة، خاضع للآلية والسببية أي للحتمية. فهو قاصر وعاطل، ومحكوم لا يفكر ولا يختار أبدا. بينما النفس بها الإرادة الموجهة والمتحكمة، بل المسيطرة. هذه الفكرة الديكارتية التي يؤمن بها تقريبا كل الناس، يرفضها سبينوزا رفضا قاطعا. فكيف ذلك؟ يقول سبينوزا: «ليست النفس (إمبراطورية داخل إمبراطورية)، بل هي تتحرك والجسد بطريقة متوازية وبشكل متزامن. فما يحدث في الجسم، يحدث في العقل، والعكس صحيح. فكل فعل أو انفعال في أحدهما، يوازيه ما يماثله في الآخر. إنهما وجهان لعملة واحدة. لذلك كلما استطاع العقل، كقوة طبيعية في الإنسان، أن يوضح أفكار الأشياء وصورها الذهنية، وجعلها منتظمة ومرتبة وواضحة، فإن انفعالات الجسم ستكون على نظام العقل نفسه».
فإذا كان ديكارت يرى أن حدوث الفعل في النفس يؤدي إلى حدوث انفعال في الجسد، والعكس صحيح، فإن سبينوزا يؤكد على العكس تماما. ففعل النفس كصفة فكرية، يوازيه فعل جسدي كصفة امتدادية والعكس صحيح. باختصار الفعل أو الانفعال يحدث للإنسان في كليته، وكل ما هنالك أنه يتجلى في النفس بصفة التفكير، أي كإدراك، وفي الجسم بصفة الامتداد، أي كتجسد ملموس. فالخجل يوازيه مثلا احمرار الوجه. إن النفس بحسب سبينوزا، ليست شيئًا متعاليًا ومفارقًا ومتحكمًا ومسيرًا ومبثوثًا في الجسد. بل هي وجه آخر للجسد و«بشكل محايث».
ويبقى الأقوى في أطروحة سبينوزا، قوله بوهم الإرادة، ليؤكد عوضًا عن ذلك، على شيء واحد هو الرغبة. أي الجهد والقدرة، أو ما يسميه سبينوزا «الكوناتوس» الذي يسري وبطريقة متساوية في الإنسان وفي كل موجودات العالم. إن الإنسان عند سبينوزا، هو جزء من الطبيعة، وهو ليس مملكة للنفس قابعة داخل مملكة الجسد. بل المملكتان هما مملكة واحدة بعنصرين أو بصفتين، تارة الفكر وتارة الامتداد. فالإنسان ليس كائنا غريبا عن هذا العالم أو استثناء، أو مفارقا. بل هو يخضع للقوانين الصارمة والمحركة للطبيعة، ولموجوداتها التي تسعى كلها نحو الاستمرار في الوجود. فهمّ الإنسان الأول والأخير، هو البقاء وبذل الجهد والطاقة للاستمرار. لهذا ليس هناك حرية، بل حتمية مطلقة وقانونية صارمة، نابعة من الطبيعة الكلية التي نحن مجرد جزء منها. وما نعتقده نحن أنه إرادة، هو، في الأصل، رغبة لا نعرف سببها. فالطفل يعتقد أنه يشتهي الحليب بحرية، والسكير يظن أنه يقوم بقرار حر منه، والأمر نفسه ينطبق على الهذائي والثرثار. فهم يرون أنهم يتصرفون بحريتهم، وأنهم لا يخضعون لأي إكراه. لكن الحفر في السبب، سيظهر أنهم مسيرون بقوى خفية تجبرهم. فلا وجود لإرادة تسلك من تلقاء ذاتها. فالإنسان قوامه «الكوناتوس»، أي الجهد. فعندما يقول أحدنا إنه يريد ممارسة الجنس، فهل الأمر أمره حقًا، والقرار قراره؟ إنه في الحقيقة يلبي نداء أقوى منه، هو نداء البقاء، ومحركاته مجهولة لديه. وهذا الجهل هو الذي يدفعه، وهمًا، إلى الاعتقاد في كونه حرًا ويختار.
* الانفعال والعبودية
هل يعني هذا أن سبينوزا من دعاة الحتمية؟ الجواب: نعم. لكن يبقى هناك أمل في التحرر من الحتمية، إذا جرى إدراكها ومعرفتها. بعبارة أخرى، متى ضبط الإنسان الأسباب تمكن من التحكم والتوجيه، فالخلاص في المعرفة.
ولكي نفهم قصد سبينوزا، نقدم المثال التوضيحي التالي: لنتصور شخصا مريضا بالسكري لكنه غير مدرك لحقيقة مرضه. نتيجة ذلك أن المرض سيعبث به ويتحكم بمسار حياته. لكنه بمجرد اكتشاف العلة، سيبدأ في العلاج، وتلقي الإنسولين، ويحرص على الحمية الغذائية، ومن ثم التحكم، والتحكم كما نعلم حرية. يقال الأمر نفسه أيضا، عن مريض نفسي تستبد به عقدة معينة، فهو لن يتحرر منها إلا إذا جرى الحفر بعيدا في أعماق النفس مع محلل نفساني، لإيجاد السبب المتحكم. فالإنسان يتحرر ويتحكم في الطبيعة، عندما يدخل مغامرة البحث عن الأسباب.
إن مأزق الناس ومعاناتهم، يكمن في ماهيتهم المتمثلة في الرغبة. فمعظم الناس يجهلون الميكانيزمات المتحكمة فيهم، لأنهم خاضعون لقوانين الطبيعة. فحين ينطلق الجهد كفعل خارج الذات، تصطدم قوة هذا الجهد بالقوى الخارجية المتناثرة في كل العالم، التي تعرقل سيرها. فينعكس ذلك عليها بانفعال سلبي (حزن، غضب، قلق، تذمر، تشاؤم... إلخ) يكدر عليها صفو حياته.
يرى سبينوزا أن قدر الإنسان هو أن لا يهزم الانفعالات، لأنه باختصار، محاط بوابل من القوى العارمة التي تصطدم بقوته في كل حين، وقد يكون الاصطدام محطما. لكن، وعلى الرغم من ذلك، بإمكان الإنسان أن يحسن توجيه تلك القوى عن طريق العقل. فالعقل كقوة طبيعية أيضا، موكول له مهمة استيعاب آليات اشتغال الطبيعة وقوانينها وأسبابها. وهو ما يسمح بتقليل الانفعال السلبي وأخذه نحو الإيجاب. بكلمة أكثر تبسيطًا، يمكن إزالة الانفعال السلبي إذا استطعنا تكوين فكرة واضحة ومتميزة عن الأسباب المحركة للانفعال. آنذاك نحصل على الهدوء، ونكتشف أن الأمر طبيعي. فلم القلق إذن؟ إن الناس تحترق بالسلب نظرا لجهلها الأسباب. ولا خروج من عبودية الانفعالات، ولا تحقيق للغبطة إلا بالمعرفة. وهنا يعلن سبينوزا تفوق الحكيم على الجاهل.
في الختام نقول، إن فكر سبينوزا وجد له صدى هائلا، حيث تحركت البشرية بحمى، نحو الاشتغال العلمي، بما هو استخدام للعقل بحثا عن الأسباب القريبة للظواهر.
وهو ما مكن من مجابهة كثير من المشكلات في كل المجالات، وتوجيه الأشياء لصالح الإنسان وليس ضده. فاكتشاف البنى الخفية الموجهة للسلوكات الإنسانية، سواء البيولوجية (الطب)، أو النفسية (علم النفس)، أو الاجتماعية (علم الاجتماع)، مكن من مزيد من التحرر.
سبينوزا ومواجهة الانفعال السلبي
يمكن إزالته إذا استطعنا تكوين فكرة واضحة عن الأسباب المحركة له
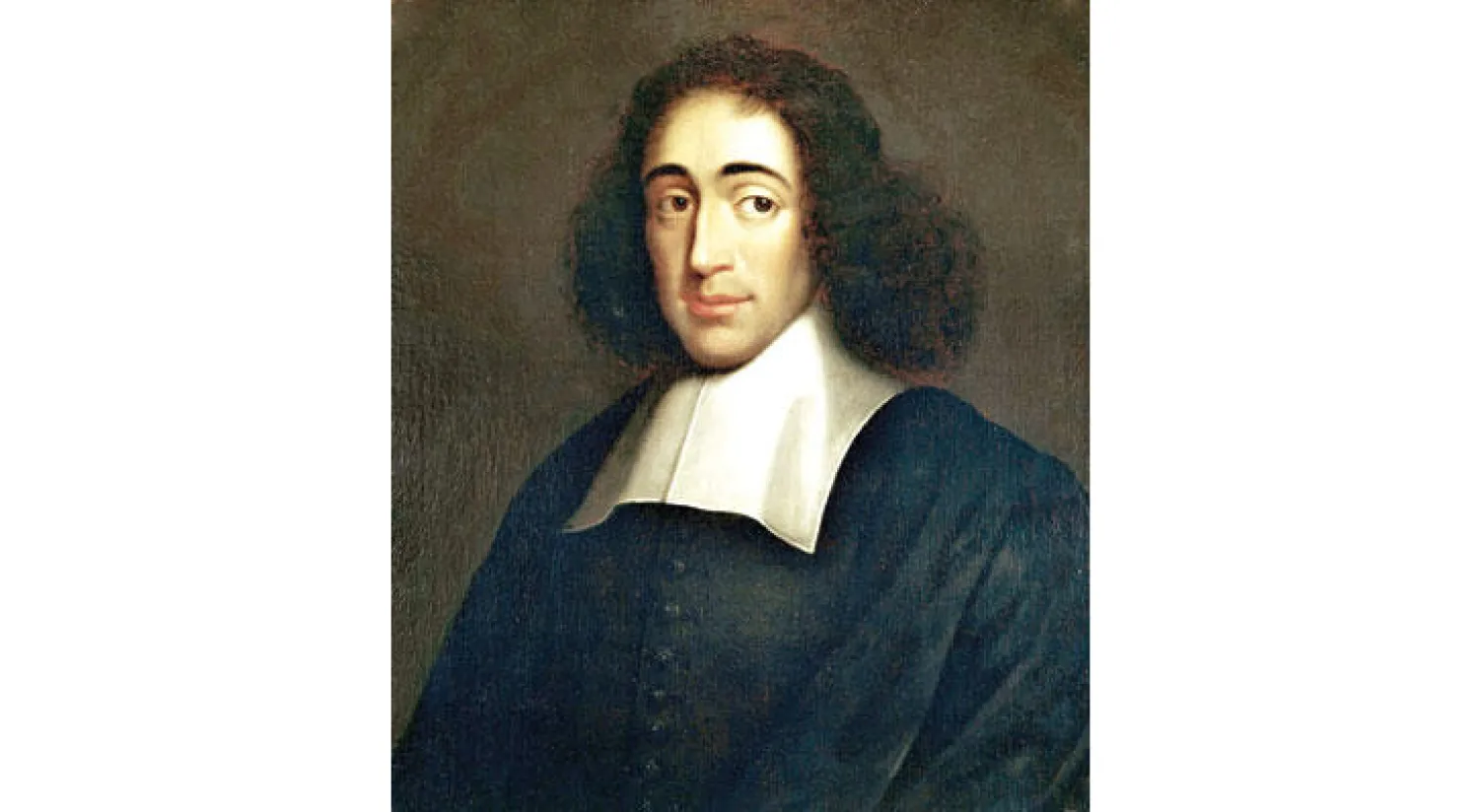
سبينوزا

سبينوزا ومواجهة الانفعال السلبي
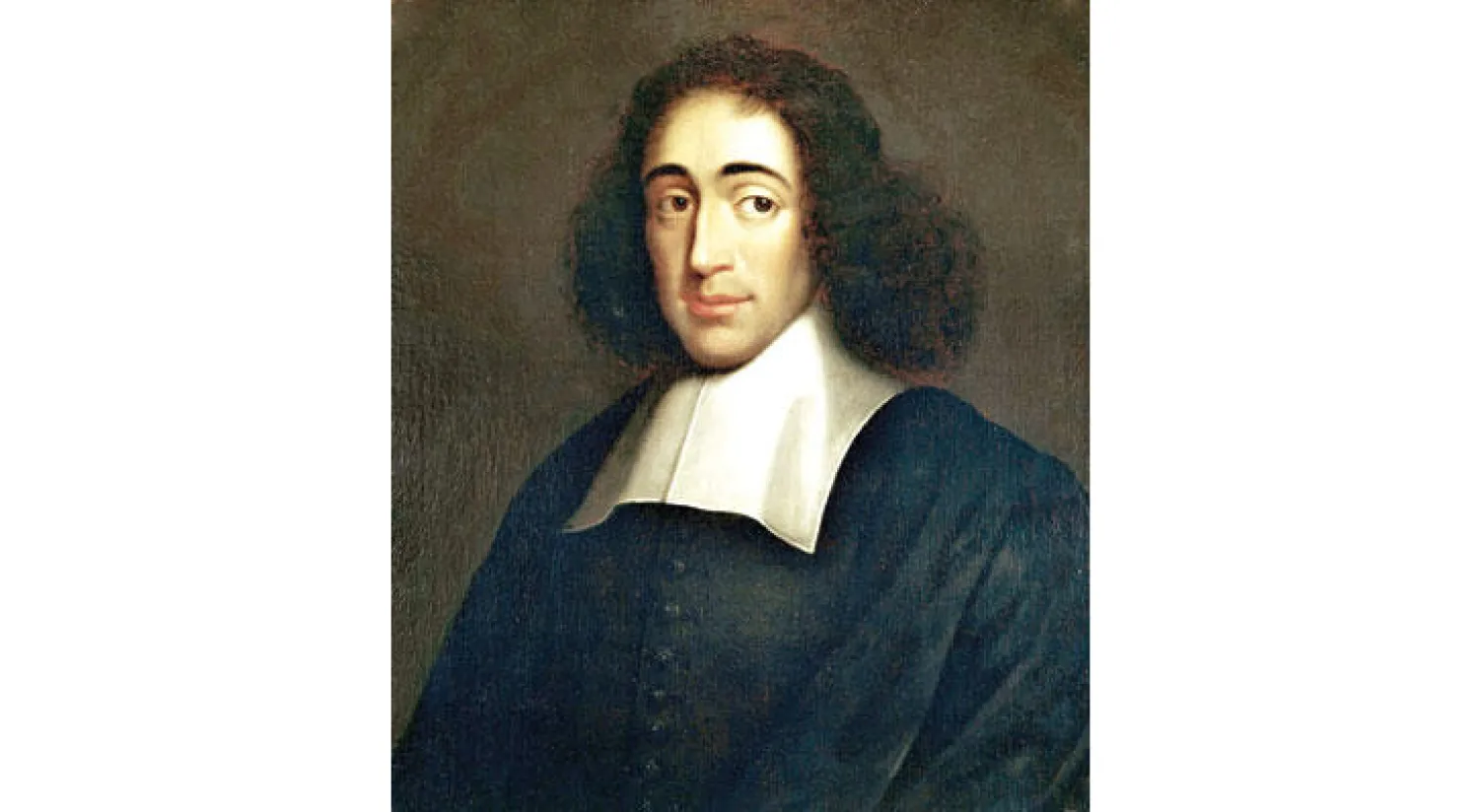
سبينوزا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة










