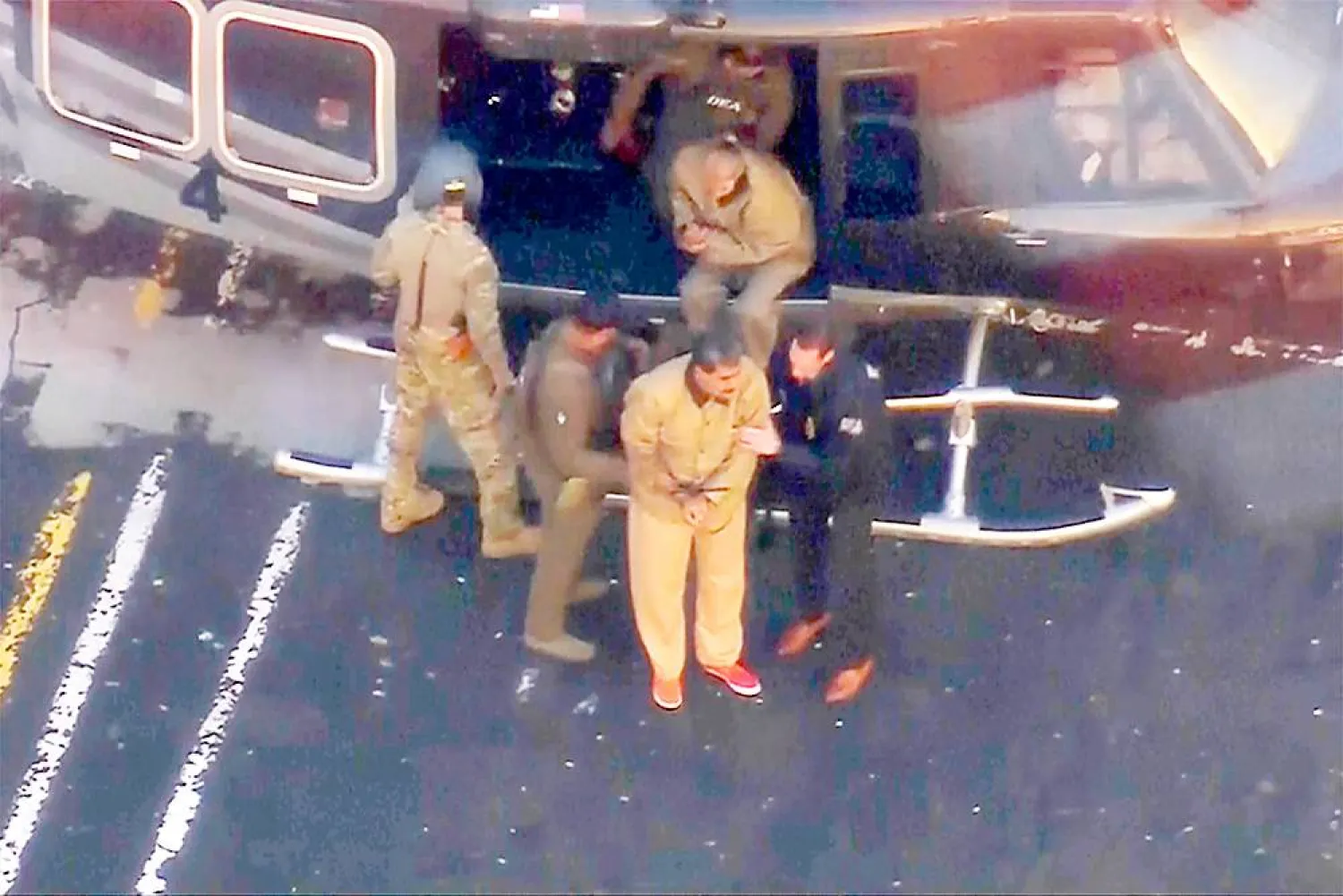تحلق طائرة تصوير من دون طيار (درون) فوق عشرات الكيلومترات من الكتل العمرانية المدمرة في مدينة حلب، عاصمة سوريا الاقتصادية وثاني كبرى مدنها، وتنقل صورًا مروّعة لحجم الدمار الذي لحق بأحيائها الشرقية. المشهد لا يشبهه في سوريا اليوم إلا مشهد الدمار الواسع الذي ضرب أحياء حمص القديمة وحي جوبر الدمشقي، رغم التفاوت بين المساحات الجغرافية للمناطق الثلاث. والحقيقة أن المدن الثلاث، دمشق وحلب وحمص، تكاد تختصر الصورة المؤلمة للمدن السورية المتشظية بفعل الحرب، والقصف الجوي العنيف الذي تعرّضت له على مدى خمس سنوات من الاقتتال، وأسفرت عن تدمير ما قيمته 300 مليار دولار أميركي من المنشآت الحيوية والكتل السكانية والبنى التحتية السورية.
غير أن حلب، قاعدة الشمال السوري، تفوق المدن السورية الأخرى دمارًا وتهالكًا، إذ يحتل الدمار فيها نحو 58 في المائة من حجم الدمار الذي حل بالمدن السورية. ذلك أنه كان التعداد السكاني لحلب يفوق الخمسة ملايين نسمة وتضم أكثر من ألفي مصنع، غير أن ضواحيها ومدن ريف محافظتها وبلداته وقراه، المنتشرة على مساحة جغرافية واسعة، تحوّلت إلى ساحة مواجهات عصية على قوات النظام يصعب حصارها. وبالتالي، تعرّضت لأعنف حملات قصف جوية، بدأت في عام 2013 بقصفها بالبراميل المتفجرة، ثم إلى ساحة اختبار لأعتى الذخائر الروسية من نوع صواريخ «جو - أرض».
تأخرت مدينة حلب بالانضمام إلى الاحتجاجات ضد النظام السوري، لكنها كانت الأسرع في خروج أحياء منها عن سيطرة قوات النظام.
في عام 2012، بدأت أحياء في المدينة تخرج تدريجيًا عن سيطرة النظام، وشهدت خريطة السيطرة الميدانية متغيّرات كثيرة بين حصار قوات النظام في أحياء خاضعة لسيطرته، وحصار أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة، حتى استقرت في أواخر عام 2013 على الخريطة الحالية: خطوط تماس على تخوم المدينة القديمة، وأحياء شرقية وشمالية تسيطر عليها قوات المعارضة، ويسكنها الآن ما يُقدر بنحو 150 ألف نسمة. وفي المقابل، يحكم النظام سيطرته على 60 في المائة من مساحة المدينة تتركز في الأحياء الجنوبية والغربية، التي يسكنها نحو 800 ألف نسمة.
* تدشين عهد البراميل
خروج الأحياء عن سيطرة قوات النظام كان ذريعة مباشرة لقصفها يوميًا بالمدفعية، قبل أن تتحول إلى ساحة اختبار للبراميل المتفجرة المعروفة بسقوطها الحرّ وغير الموجه. ولقد دشّن النظام ذلك السلاح لأول مرة خلال العام 2013 في أحياء حلب الشرقية، ونتج عن القصف دمار واسع وجد فيه النظام «فعالية لإخراج مناطق واسعة عن الخدمة»، بحسب ما يقول معارضون. وعليه، كان الردّ من قوات المعارضة بالتكتيك نفسه، إذ لجأ هؤلاء إلى تفجير الأنفاق تحت أبنية تسكنها قوات النظام على خطوط التماس مع الأحياء التراثية.. وتسببت التفجيرات من قبل الطرفين بدمار هائل طال البنى التحتية والتجمّعات السكانية.
يقول مصدر عسكري معارض إن تفجير الأنفاق «كان أبلغ رد ردعي على القصف النظامي العنيف»، مشيرًا إلى أن قوات النظام «حين شعرت بعجزها عن العودة إلى أحياء المعارضة اتبعت سياسة «الأرض المحروقة لحرمان المدنيين في أحياء المعارضة من ملاذات آمنة، بهدف تهجيرهم، وإفقاد الثوار حاضنة شعبية». ويؤكد المصدر أن القصف «الممنهج لتدمير كل ما في المنطقة، لم يدفع السكان لإخلائها نهائيًا، كما أن المساحات الجغرافية الواسعة، حالت دون محاصرة المدينة، وهذه نقطة استراتيجية أوجدتها الجغرافيا، في حين يعتبر النظام أن فقدان سيطرته على عاصمته الثانية، أبلغ دليل على ضعفه وعجزه».
* تدمير ممنهج
خمدت المعارك في أحياء حلب الداخلية منذ أوائل 2014 مع انسحاب قوات النظام من معظم تلك الأحياء، وأهمها أحياء صلاح الدين وسيف الدولة والصاخور والسكّي ومساكن هنانو والحلوانية وقاضي عسكر وباب الحديد والقاطرجي وكرم الجبل وطريق الباب. كذلك همدت المواجهات المباشرة داخل مدينة حلب مع بروز خطوط تماس قرب أحياء مساكن هنانو وباب النيرب والمرجة، وهي المواجهات التي أسفرت عن احتراق أكبر سوق تراثية في حلب، وأحيائها القديمة، والجامع الأموي الكبير في حلب. وبعدها، باتت الأحياء عرضة للقصف الجوي الذي «يعوّض النظام عن خوض معارك مباشرة، بسبب عجزه عن الوصول إلى تلك الأحياء».
أمام هذا الواقع، تنجلي أسباب تعرّض حلب لهذا الحجم من الدمار الذي أصاب الكتل السكانية والبنية التحتية بما يتخطى ما تعرّضت له سائر المناطق السورية. وهنا يشرح الدكتور أسامة قاضي، رئيس مجموعة «عمل اقتصاد سوريا» الوضع لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «مدينة حلب لها أهمية تجارية وصناعية ولوجيستية كبيرة جدًا، وتمركز (الجيش السوري الحرّ) وتحريره بشكل جزئي مناطق كبيرة منها يُعد تهديدًا كبيرًا للنظام. ومن ثم، عندما لم يستطع النظام دحر الجيش الحر في تلك المناطق برًا وجوًا، استعان بالروس والإيرانيين والميليشيات الموالية من أجل استعادة مدينة حلب، مما جعل منها مَكسر عصا وأسهم النظام بالحجم الأكبر من تدمير مدينة عمرها 12000 سنة. ولقد جرّب النظام والروس أعتى الأسلحة التدميرية التي ستترك آثارها حتى بعد انقضاء هذه الأزمة على البشر والزرع».
وأردف أن حلب نالت بحسب آخر دراسة من البنك الدولي، 58.10 في المائة من إجمالي الأضرار حسب المدن السورية، وتضاعفت الأضرار التي حلّت بحلب خلال العامين الماضيين.
* هلاك المدن الصناعية
إلى جانب القطاع العمراني والبنى التحتية، يشير القاضي إلى أن «مدينة حلب مدينة صناعية بامتياز فيها نحو 38 ألف منشأة صناعية، وتعرضت منطقة الشيخ نجار الصناعية التي تبلغ مساحتها 4412 هكتارًا، وكذلك 15 مناطق صناعية أخرى، مثل العرقوب والليرمون وطريق المطار وجبرين والشقيف وباقي مناطق المدينة والريف الحلبي إلى عمليات سلب وحرق وتدمير. ويقدّر أن الضرر قد نال ما لا يقل عن أكثر من 60 في المائة من قدرتها التصنيعية، التي كانت تنتج تقديريًا ما لا تقل قيمته عن خمسة مليارات دولار سنويًا». ويؤكد القاضي أن «حجم الأضرار المادية التي لحقت بتلك المنشآت تقدر بأكثر من 20 مليار دولار على أقل تقدير».
إلى جانب ذلك، يضيف الدكتور القاضي: «نال التدمير جرّاء قصف النظام لأحياء حلب الكثير من الأحياء الأثرية التي تعود عمارتها لمئات السنين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالجامع الأموي الذي شيّد عام 715 ميلاديًا، وكذلك سوق المدينة التاريخية التي تعود إلى القرن الميلادي الرابع عشر، والتي يبلغ طول حواري أسواقها مجتمعة نحو 13 كيلومترًا، وهي تتضمن خانات المدينة التاريخية التي تعود لمئات السنين. وأمكن حتى الآن إحصاء تدمير ما لا يقل عن 1500 متجر إلى الآن، وهو ما يُعد كارثة إنسانية وحضارية وتاريخية يستحيل أن تقدّر بثمن مالي».
* حمص وداريّا وجوبر
من جهة أخرى، فإن الدمار الذي لحق بحلب، مع أنه يعد الأعنف والأشد قسوة، يظل جزءًا من الدمار الذي حل بمدن سورية كثيرة، أهمها أحياء المدينة القديمة في حمص، ومدينة داريا (التي غدت ضاحية) في جنوب دمشق، وحي جوبر الدمشقي في شمال العاصمة. وأظهرت صور بطائرات معدة لتصوير تلك المدن الحجم البالغ للتدمير الذي سوّاها بالأرض. ومن شأن ذلك الدمار أن يدفع لتقديرات حول حجمه، وتكلفة إعادة إعماره.
يشير الدكتور القاضي إلى أن التقديرات الأولية للخسائر في أنحاء سوريا تفوق 300 مليار دولار، إلا أن عمليات إعادة إعمار سوريا وترميم مصانعها وإعادة الحياة الاقتصادية قد تكلف ضعف هذا المبلغ على مدى خمس سنوات على الأقل. ويوضح: «تحتاج الحكومة الانتقالية لأفكار إبداعية وبدائل تمويلية وطنية وشراكات مع الشركات العربية خاصة ما أمكن، حتى لا تغرق سوريا بالديون بعد هذا الدمار الكارثي الذي يفوق في حجمه الكارثة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية باعتراف رئيس النظام نفسه في خطابه الأخير».
ويشرح أن قطاعات «الإسكان والتعليم والصحة من أكثر القطاعات التي نالها التدمير خلال السنوات الخمس الماضية، حيث استهدف القصف الجوي وعشرات ألوف البراميل المتفجرة أحياء يسكنها مدنيون مما اضطر إلى نزوح وتهجير أكثر من 12 مليون سوري خمسة ملايين منهم خارج سوريا»، موضحًا أن «الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور أسهم في تدمير وتعطيل القطاع الصناعي الذي يعمل ما تبقى منه بأقل من ربع إنتاجيته، وتعرّضت مئات المعامل للنهب والسرقة والتدمير، فضلاً عن هروب القوة العاملة بسبب انعدام الأمن، وأيضًا نال التدمير القطاع الزراعي، خصوصًا أن أرياف سوريا كلها مشتعلة ما عدا الساحل السوري. ثم هناك قطاع النفط الذي خرج بشكل شبه تام عن سيطرة حكومة النظام والمعارضة ووقع في يد تنظيم (داعش) الذي لم يكتفِ بالسيطرة على آبار النفط، فحسب، بل سيطر أيضًا على صوامع الحبوب والمحاصيل الزراعية في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا. وأما القطاع السياحي فقد أصابه الشلل التام، في حين تضرّرت التجارة الداخلية بشكل كبير جدا بسبب ازدياد المخاطر الأمنية على الطرقات. وفيما يخصّ التجارة الخارجية فإنها اقتصرت على المرافئ ومعبري لبنان والعراق، بينما خرجت بقية المعابر من يد حكومة النظام بشكل كامل فضلا عن التضييق على الطيران السوري».
* مبادرة البنك الدولي
أمام هذا المشهد القاتم، ورغم استمرار الصراع على أرض الواقع، أعدت مبادرة للبنك الدولي وهي «مبادرة المعلومات والبحوث المتعلقة بسوريا» (SIRI) رسمًا تخطيطيًا للدمار الذي حل بستّ مدن رئيسية في سوريا - ومواقع هذه الأضرار - والمنشآت والخدمات التي ما زالت تعمل وتلك التي توقفت عن العمل. وفيما يساعد تطبيق «سيري أبل» (Apple’s Siri) على العثور على المعلومات، فإن مبادرة المعلومات والبحوث المتعلقة بسوريا يمكنها المساعدة على تقدير تكلفة إصلاح الأضرار، بحسب ما أعلن البنك الدولي.
وراهنًا، يسعى البنك الدولي للاستفادة من التكنولوجيا المتاحة، ويقول فريد بلحاج، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي «إن البنك يستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا والأساليب التي سبق تجريبها ليكون على أتم الاستعداد لبدء العمل في سوريا في الوقت المناسب عندما تخف حدة الصراع. فالتكنولوجيا يمكن أن تتيح أيضًا وضع خطط واقعية وقابلة للتطبيق في سوريا قبل أن تنتهي الحرب، وبطريقة لم تكن في وسعنا من قبل».
غير أن التخطيط وحده لا يُعد كافيًا، ذلك أن التدهور الاقتصادي في سوريا يطرح علامات استفهام كثيرة حول كيفية معالجة الوقائع وترتيب استراتيجية لإعادة الإعمار.
وهنا يؤكد رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا إن إعمار سوريا قد يحتاج لأكثر من 300 مليار دولار، ولا يرى حلاً بالشراكة مع رجال الأعمال السوريين وغير السوريين وبالتعاون مع حكومات الأصدقاء والأشقاء. ويؤكد القاضي على أن «يقع عاتق الإشراف على إعادة إعمار سوريا بالمقام الأول على الحكومة الانتقالية السورية المقبلة. وهذا يستلزم رؤية اقتصادية واضحة من قبل تلك الحكومة حول قبول الشراكات العربية والعالمية في إعادة إعمار سوريا، إضافة إلى تأمين كل القوانين اللازمة للترحيب بالرأسمال الوطني والأجنبي ضمن شروط تأخذ في عين الاعتبار خلق فرص للعمالة الوطنية، والسرعة والإتقان في الإنجاز».
آثار قصف المدن السورية تفوق في حجمها الكارثة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية


آثار قصف المدن السورية تفوق في حجمها الكارثة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة