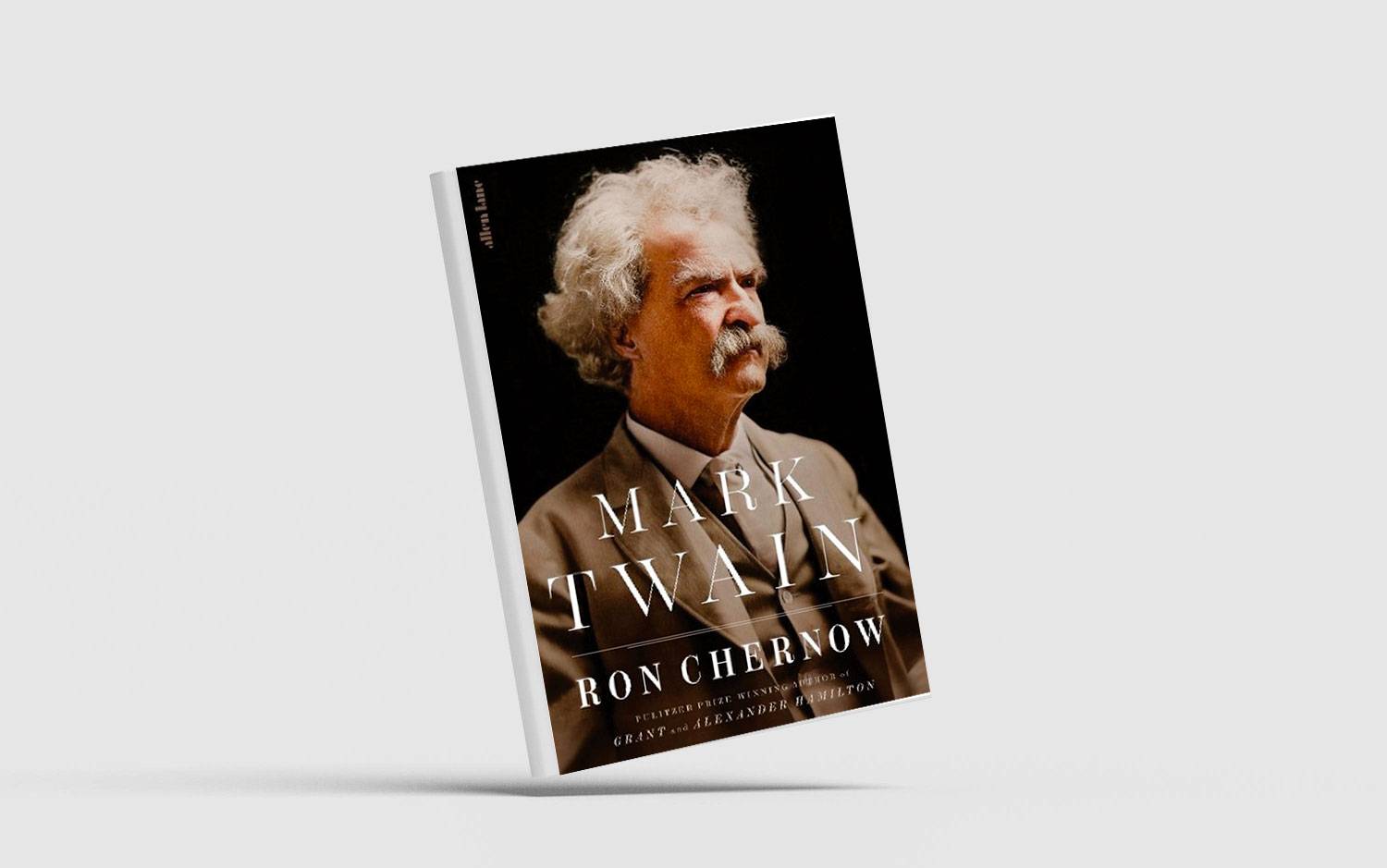استطاعت اللغة العربية أن تستوعب العلوم اليونانية والفارسية والهندية بسرعة هائلة. وبمجرد أن بدأت عملية الترجمة، وبخاصة في عصرها الذهبي مع الخليفة العباسي المأمون، أصبحت العربية تتخذ شكلا مطواعا لتستجيب لما ندبت إليه، حيث اتسع صدرها للكثير من الكلمات والمعاني الاصطلاحية والتراكيب الفنية والألفاظ العلمية الأجنبية، إلى درجة أن تحولت من لغة ضيقة ذات طابع قبلي، إلى لغة عالمية. فأصبحت لغة العرب هي لغة الدين والحكمة، والقانون والسياسة، والإدارة والتجارة، والكتابة والتأليف. بكلمة واحدة، أصبحت هي لغة الحضارة بامتياز، حيث اكتسحت اللغات المحلية آنذاك، واستطاعت أن تحد من أخواتها الساميات. وكانت اللغة السريانية (وريثة الآرامية لغة المسيح) إحدى ضحاياها، رغم أنها كانت الوسيط المعتمد لعملية نقل العلوم آنذاك.
ولمعرفة حال العربية في القرون الوسطى، نذكر بشغف الأندلسيين بالعربية، إلى درجة نسيانهم اللاتينية، بل تسربت العربية إلى الكنائس، حتى اضطر أحد القساوسة من أهل اشبيلية، إلى نقل الكتاب المقدس إلى العربية ليقرأه تلاميذه. ولتوضيح الأمر أكثر، نستحضر تلك القصة التي يستشهد بها الباحثون، وهي، أن كاهن قرطبة إلفارو، في أواسط القرن التاسع للميلاد، كان يستغيث ويجأر بالشكوى من أبناء دينه الذين يطالعون أشعار العرب، ويستغرقون في دراسة كتابات الفقهاء وعلماء الكلام المسلمين وفلاسفتهم. لا لتفنيدها، بل لتعلم أسلوب عربي بليغ. وهكذا نسي المسيحيون لغتهم، وحذقوا اللسان العربي، وأقبلوا على كتب العرب في نهم وشغف، بل كتبوا بها وبتفوق عن العرب أنفسهم.
هذا يدل على المستوى الرفيع الذي بلغته العربية، وكيف أن جواز مرور العلمية كان لا يتم إلا بها، بل حتى العلماء المسلمون الكبار ذوو الجذور الفارسية، كانوا يكتبون بالفارسية، لكن وقصد الذيوع والانتشار والحصول على القبول العلمي كانوا يخصصون نسخة أخرى بالعربية. وهو ما قام به مثلا الخواجة نصير الدين الطوسي في القرن الثالث عشر الميلادي، بل هو ما قام به، وفي وقت مبكر، المترجم المتميز والحذق، المسيحي النسطوري، حنين بن إسحاق. فإبان القرن التاسع للميلاد، كان ينقل، أحيانا، التراث اليوناني إلى السريانية في نسخة، وٳلى العربية في نسخة أخرى. لكن رغم ذلك، احتضرت السريانية أمام قوة العربية، فلم تعد الكتب المنتشرة إلا بها.
بعد الاصطدام بالمختلف عن طريق الرغبة في اقتحام عوالمه بالترجمة، كانت العربية مطالبة بمواجهة الأمر بأفق رحب يعمل على توسيع رداء اللغة، وعلى المزيد من الاشتقاق فيها، ونحت مصطلحات جديدة، وتكييف لبنيتها كي تلبي حاجات الحضارة. وبالفعل، أصبحت تعبر وبسلاسة عن جميع ما تفرضه العلوم، من طب ونبات وفلك وفلسفة ومنطق. وإذا ما أردنا معرفة ما تركته الترجمة من أثر في اللغة العربية، فلنقارن بين الأدب العباسي والأدب الجاهلي لنكتشف ما حصل من تبدل. فالتلاقح الحضاري لا يبقي الأمور كما هي، بل يخصبها ويجعلها تدخل في تركيبات جديدة، ويقحمها في مواضيع لم تكن معهودة. وطبعا لم يكن الثمن سهلا، بل إن التطور في اللغة أفقدها صفاءها ونقاءها الأول. يقول الجاحظ في هذا الصدد: «فاللغة إذا دخلت على أختها أفسدتها».
إن العلوم والفلسفة كانت تعد أعجمية، وهي دخيلة تم استيرادها واستجلابها من الحضارات القديمة. ومع إرادة تأسيسها من طرف السلطة، وبخاصة زمن الخلافة العباسية، وإقحامها في التربة الإسلامية، كان لزاما أن يحدث تجديد في اللغة نفسها كي تستوعب المعاني غير المألوفة. وهذا ما حدث بالفعل، بحيث اكتسبت العربية سلاسة وجزالة ومرونة، فأصبحت قادرة على أن تعبر عن منطق أرسطو وفلسفة أفلاطون وطب أبقراط وغالينوس، وفلك ٳبرخس وبطلميوس ورياضيات ٳقليدس.
لقد مكن الاختلاط بالشعوب الأخرى، عن طريق الترجمة، من جعل الكثير من الكلمات اليونانية والفارسية والقبطية والسريانية، تتسرب إلى العربية وتصبح جزءا منها، حيث بقيت على حالها مع بعض التحوير، لكي تتناسب والوزن والجرس العربي. فمثلا، أخذ العرب عن اليونانية كلمة (هيولي)، بمعنى مادة و(ٳسطقس) بمعنى عنصر، وعن السريانية (الميمر) بمعنى الباب أو الفصل، وعن الفارسية (الهندسة)، لقد نفذت الكثير من الكلمات الأجنبية مثل كيمياء وموسيقى وزنديق وديباج وٳزميل وإبريق وغيرها، بل تم الاشتقاق منها وفق الأوزان العربية، فنجد: تفلسف وتزندق وتمنطق.
إن الترجمات الأولى كانت في بداياتها رديئة وضعيفة إلى درجة أن بعض الكلمات نقلت كما هي، وتم الاحتفاظ بها بأصلها الأجنبي. لكن مع مزيد من النضج في عمليات الترجمة، تم تعويض بعض تلك الكلمات رويدا رويدا بألفاظ عربية خالصة أكثر دلالة ورشاقة، بحيث يستسيغها اللسان العربي. ولتوضيح الأمر نضرب المثال التالي: أنالوتيقا: التحليل - سوفستيقا: المغالطة - كاتيغورياس: المقولات - أرتماتيقا: التعاليم (الرياضيات) - ياري أرمينياس: العبارة - توبيكا: الجدل - ريتوريكا: الخطابة - بولتيكا: السياسة.
إذن، وكما نلاحظ من المثال أعلاه، فإن المترجمين الأوائل تركوا بعض الألفاظ كما هي في لغاتها الأجنبية. لكن سرعان ما ستتحول هذه الكلمات الأجنبية إلى ترجمات عربية مبينة، عندما اكتشف العرب أن العربية قادرة على أن تعبر عنها بيسر وبدلالات أعمق.
وفي الحقيقة، تجب الإشارة إلى أن هذه الطفرة التي وقعت للعربية جراء الترجمة، لم تكن هي الأولى، بل هي الثانية. فمع ظهور الإسلام ونزول القرآن الكريم، وقع تغير دلالي هائل لبعض الكلمات، وتم ضخها بشحنات جديدة لم تكن معهودة من قبل: فالصلاة والزكاة والجهاد والإيمان والكفر والجنة والنار، كلها أخذت معاني تتلاءم والدين الجديد. بل حتى النحاة استخدموا ألفاظا كالرفع والجر والنصب والضم وغيرها، والمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول به والإسناد. بالتأكيد لن يفهمها العربي في الجاهلية بالمعنى نفسه، فالأفق اختلف مما يلزم عنه تغيير في المعنى أيضا.
وبعودتنا إلى الترجمة وتخصيبها للعربية، سنجد أن الكلمات قد تناسلت بطريقة متسارعة. قيل مثلا: مادة وصورة، جوهر وعرض، ماهية وهوية، كم وكيف وأين، وموضوع ومحمول، وقضية وفصل، وحد ورسم، وتصور وتصديق، ومقدمة ونتيجة، وقوة وفعل، وعلة ومعلول، وهيئة وكواكب متحيرة وأفلاك تدوير وأزياج ومعدل مسير. وهكذا من الألفاظ التي كثرت سواء جراء نضج العلوم المسماة شرعية وحاجتها إلى الضبط والتدقيق، أو جراء الترجمة التي أغرقت العربية بمصطلحات وألفاظ جديدة، إلى درجة كان من الطبيعي أن تبدأ عملية وضع معاجم متخصصة لضبط هذا السيل من الكلمات التي تحتاج إلى تفسير، وما «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي و«التعريفات» للجرجاني و«مفاتيح العلوم» للخوارزمي، إلا أمثلة على ذلك.
ما أشبه اليوم بالبارحة، فما تزال لغتنا تحدث فيها التغيرات على الدوام، جراء التلاقح مع الغير. فلغتنا العربية الحالية، هي أيضا، قد حدث لها طفرات وتغيرات ضخمة جراء الاقتحام الأوروبي لثقافتنا. فمثلا لم تعد السيارة لها فقط معنى القافلة. وهكذا يقال عن الدبابة والمسدس، والذرة والجرثومة، والعنصر والهاتف، والصاروخ والطائرة، والمكتب والمحافظة، وغيرها من الألفاظ التي تغلفت بطبقات جديدة من المعاني لم يعهدها السابقون أبدا. فبالتأكيد لن يفهم الجاحظ ولا ابن المقفع ما المقصود منها.
إذن، اللغة بصفتها أوعية تبقى، لكن بصفتها دلالات تتبدل جراء فعل التاريخ والتلاقحات مع المختلف. فمع مرور القرون والتجارب والخبرات، نجد أن اللفظ يشحن ويعبأ، وتعلق به معان تكون مختلفة أحيانا عن الأصل، فيصبح اللفظ بدلالات مغايرة كأنها طبقات فوق طبقات، وكل طبقة تشوش على الأخرى. وتظهر مشكلات في المعنى. فنجد أنفسنا نردد الألفاظ نفسها، لكن ليس بالدلالة نفسه. وهذا تكون انعكاساته وخيمة على التواصل السليم. وأكيد هنا تصبح اللغة قاتلة. فالمشكلة على الدوام ليست في المبنى، بل في المعنى.
أثر الترجمة في اللغة ودرجة استيعابها العلوم
تبقى أوعية وتتبدل بوصفها دلالات جراء فعل التاريخ والتلاقحات


أثر الترجمة في اللغة ودرجة استيعابها العلوم

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة