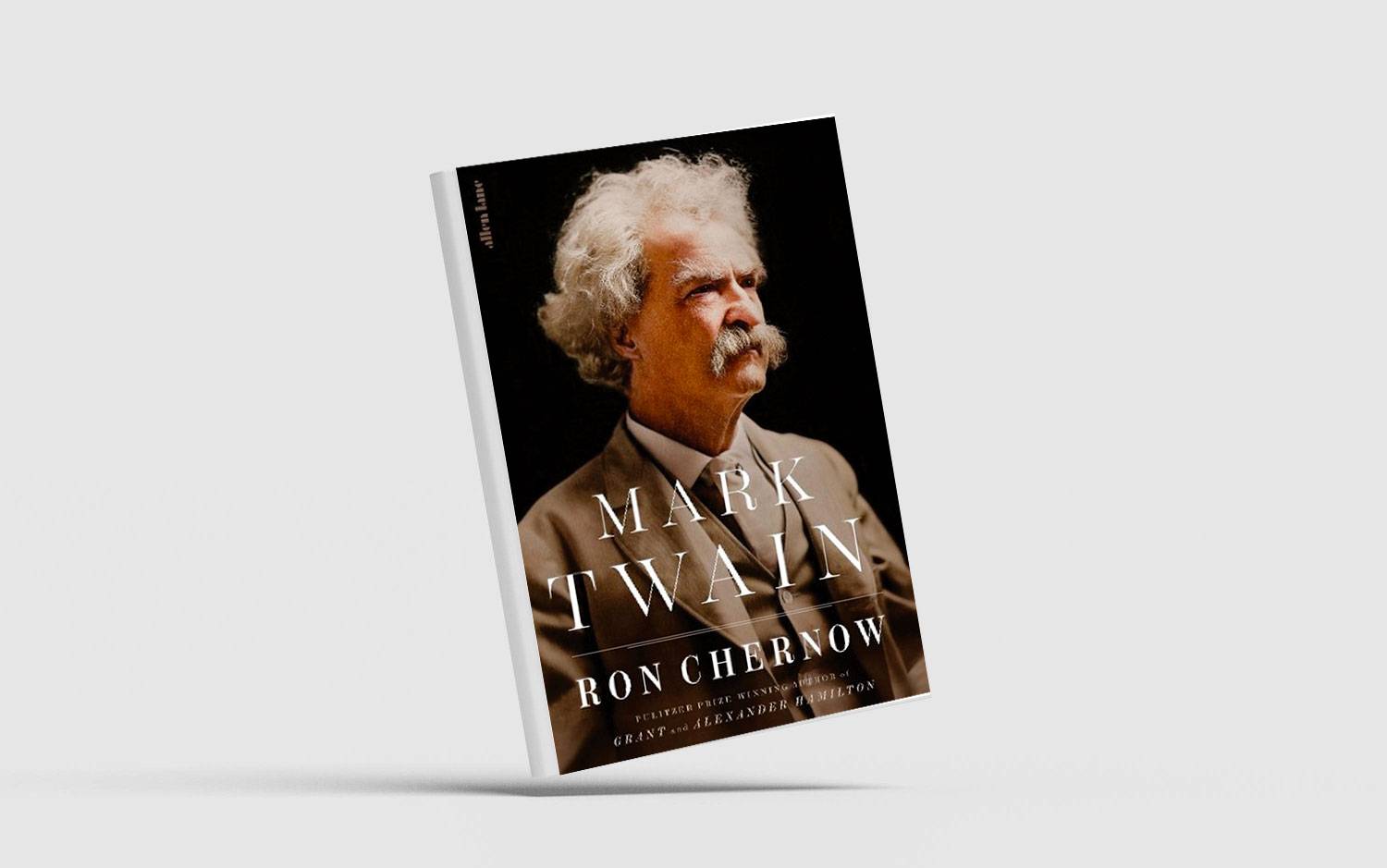عرفت تصورات الإنسان للجسد تغيرات عبر التاريخ. فبين من يراه سجنا للنفس يعوق انطلاقها لصيد الحقيقة، وبين من يراه شيئا ماديا لا يترك الروح تصل إلى أصلها الرباني. ليتحول هذا التصور في القرن السابع عشر، إلى نظرة للجسد آلية، جراء المتغير العلمي الذي أصبح يرى العالم ساعة ميكانيكية ضخمة، وما الجسد إلا تابع لها. الأمر الذي كانت له انعكاسات أدت إلى ظهور الجسد موضوعا للتجربة العلمية. بل موضوع تغيير وتحويل، سواء عن طريق التجميل أم التعديل الوراثي. وهو ما اختلط بالدوافع الربحية، إلى درجة أن الجسد أصبح سلعة، ليس فقط في المجال العلمي من زرع وبيع الأعضاء، بل حتى في مجالات الإشهار والموضة والغناء والرقص وغيرها، نظرا لما يتيحه الجسد من إمكانات الإغواء والإثارة. بكلمة واحدة، انتقلت البشرية من مرحلة إقناعهم بضرورة احتقار الجسد إلى مرحلة الاهتمام به.
* أفلاطون: الجسد المحتقر
* عندما نقرأ محاورة أفلاطون «فيدون»، المشهورة بخلود النفس، نكتشف كم أن الجسد ثقل على الإنسان، وعائق للنفس من أن تنطلق بحرية. فهو يحرمها صيد الحقيقة، ويمنعها بلوغ الكمال. إن هذه المحاورة التي كتبها أفلاطون على لسان أستاذه سقراط جاءت لتحكي لنا أخطر لحظة في تاريخ الفلسفة، المتمثلة في آخر حوارات سقراط مع مريديه.
المحاورة تبدأ عندما تم الحكم على سقراط بالموت، إذ لم تظهر عليه أي علامات تدل على الخوف. بل كان وجهه يشير إلى الرضا والسرور. وهو أمر أثار استغراب تلاميذه، فاندفعوا يسألونه عن السر وراء هذه الجرأة وعدم الخوف من الموت؟ فانطلق الحوار الذي يمكن أن نجمله في السؤال الآتي: ما العلاقة بين الجسد والنفس؟ هنا ينطلق سقراط من مسلمة أولى، وهي أن الموت بالأصل انفصال النفس عن الجسد. ليوافقه «سيمياس» في هذا المنطلق، وهو أحد مريديه الحاضرين لمشاهدة آخر لحظات أستاذه قبل مغادرة الحياة. ليتجه سقراط بعد ذلك، إلى توضيح بعض سمات الفيلسوف الحقيقي قائلا إنه هو ذلك الرجل الذي لا يجري وراء اللذات، كلذة الطعام أو لذة الشراب أو لذات الحب... فهو لا يجعل لها اعتبارا ويحتقرها على الدوام. فهو إذن لا يهتم بشؤون الجسد ويبتعد عنها قدر الإمكان، لينخرط كليا في النفس فهي بؤرة اهتمامه الكاملة. بعبارة أخرى، يؤكد سقراط في حواره مع أصدقائه - التلاميذ، أن ما يميز الفيلسوف الحق عن بقية البشر يتجلى في تخلصه إلى أقصى درجة من علائق الجسد. وما دام الفيلسوف يصبو نحو الحقيقة فهو مطالب بألا يترك الاختلاط بين الجسد والنفس قائما. فالجسد هو السوء الأكبر لأنه يضع أمامنا ألف عائق وعائق بسبب حاجاته إلى الطعام والرعاية، ناهيك عن أنه يتعرض للمرض ويجرنا إلى الحب والشهوة. بل هو من يزج بنا في الحروب والمعارك بسبب الرغبة وإرادة امتلاك الثروات، وهي كلها أمور جسدية. وهذا كله يمنع بلوغ الحقيقة في صفائها. فالجسد لا يوفر لنا التفرغ للبحث الفلسفي، فمعه دائما الإزعاج والاضطراب والتشويش. وكخلاصة عند سقراط، فإنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة في كل صفائها ونقائها إلا إذا تم التغلب على الجسد فهو سجن للنفس، وما دام الموت سيجعلنا نتحرر من الجسد كليا، فالموت إذن مطلب عند الفيلسوف، لأن النفس لم يعد لها من يكدر عليها صفوها، فستكون وجها لوجه مع الحقيقة.
إذن نخلص إلى أن الفيلسوف الحق، بحسب أفلاطون وسقراط، هو من يسعى إلى التغلب على جسده عله يتمكن من رؤية الحقيقة التي تغطيها رغبات وإلحاحات الجسد، وكأن الفيلسوف يمرن نفسه في حياته على العيش في وضع أقرب ما يكون إلى حالة الموت. وهذا ما يفسر لنا عدم انزعاج سقراط من الموت لأنها فرصته لكي يتخلص من جسده وتحرير نفسه من قبرها المزعج.
إن الطرح الأفلاطوني - السقراطي، يرى أن مهمة الجسد تختلف عن مهمة النفس. فالجسد منجذب نحو الملذات وغارق في الغريزة. بيد أن النفس تواقة للعلم والحكمة. وهذا تصور فيه ثنائية واضحة. كما أن فيه إعلان تفوق النفس ورفعتها على الجسد، وضرورة تحكم الأول في الثاني. فالحياة إذن موت للنفس، ولهذا يجب أن نعكس الآية بأن نتعلم كيف نموت.
إن هذه الأطروحة شبيهة ببعض التصورات الدينية التي ترى أن الإنسان مشكل من جوهرين متمايزين: روح وجسم، والعلاقة بينهما ظرفية ومؤقتة. فالنفس من طينة إلهية وهي متورطة في سجن الجسد، وعلى المرء الحقيقي أن يقهر جسده ويسعى للتملص منه.
إن هذا الهجوم على الجسد الذي تم نعته بسمات تحقيرية، كالوزر، والسجن، واللحد، والقبر، والسوء، وغير ذلك، هو من جعل الفيلسوف نيتشه يلقي بهجومه على الفلسفة الأفلاطونية، لكونها «افتقارا للحياة»، ليقلب الأمر رأسا على عقب بإعلانه أن الجسد هو العقل الكبير في مقابل العقل الصغير الذي هو الوعي.
* ديكارت: الجسد الآلة
* يقول ديكارت في كتابه «مقال في المنهج» إن «الجسم آلة صنعها الله بطريقة منظمة تتجاوز في تفوقها كل الآلات التي يمكن للإنسان أن يخترعها». ويرى ديكارت أن الإنسان مشكل من جوهرين مختلفين من حيث الطبيعة: جوهر مادي هو الجسد الذي يشبه العالم الخارجي، لكونه لا يفكر ولا يختار، فهو خاضع لقانونية وسببية صارمة وكأنه الساعة، في مقابل جوهر آخر نفسي يفكر ويختار. فمن أنا إذن حسب ديكارت؟ يقول إني لست محددا بالجسد، لأن الجسد شبيه بالكائنات الطبيعية القاصرة والعاطلة عن التفكير والاختيار. فهي مفعول بها على الدوام. فأنا إنسان لأن لدي جوهرا مميزا، هو الفكر والحرية، وهو ما لا يوجد في الطبيعة. وهذا ما وجد صداه بقوة عند أحد أعمدة المنهج العلمي، كلود برنار، الذي كان ديكارتي النزعة، وهو ما سنعمل على إلقاء نظرة عليه حيث وجه الجسد وجهة مختبرية.
* كلود برنار: الجسد آلة للتجارب
* عاش كلود برنار في القرن التاسع عشر، حيث استتب الأمر للعلوم الفيزيائية والكيميائية، أي علوم المادة الجامدة، التي كانت تعد آنذاك، علوما مكتملة. فهذه الفترة عرفت نقاشا حادا حول إمكانية مباشرة الجسم الحي بالطريقة نفسها التي نباشر بها المادة الجامدة. فكان كلود برنار من ضمن المتحمسين للأمر، حتى أنه قال: «علينا أن نقلد علماء الفيزيوكيميائيين في منهجهم. كما يجب أن نتعامل مع الجسد الحي باعتباره آلة»، بل يطالب الأطباء بإمكانية الاصطياد في الماء العكر، والتجريب حتى على الإنسان وليس الاكتفاء بالحيوانات فقط، إذا كان ذلك سيعود على الطب بمنفعة تذكر.
لقد حاول كلود برنار في كتابه ذائع الصيت، «مدخل لدراسة الطب التجريبي»، أن يبرز نقاط التشابه بين دراسة الأجسام الجامدة والأجسام الحية، موضحا أن تعقد الظواهر الحيوية هو ما جعل الفيزياء والكيمياء تكتملان أسرع من العلوم الأخرى. لكن رغم ذلك، فإن تلقائية الأجساد لا تتنافى وإمكانية التجريب عليها. فكلود برنار كان يريد أن يوضح في كتابه، أن علم الظواهر الحية لا يمكن أن يكون له أسس أخرى غير تلك التي للعلوم المتعلقة بظواهر الأجرام الجامدة. فليس هناك فرق في مبادئ علوم الحياة والعلوم الفيزيوكيميائية. فالحتمية تتجلى فيهما معا. فإذا كان الفيزيائي قادرا على التحكم في الظاهرة المدروسة، إما بإظهارها أو منعها، فهذا ممكن حتى في عالم الأحياء، حيث يمكن وضع الظاهرة في شروط معينة والتحكم فيها للنظر في الاستجابات التي تكون، غالبا، هي نفسها، متى كانت الشروط نفسها دائما.
إن قراءة كتاب كلود برنار، خصوصا في جزئه الثاني المتعلق بالتجريب على الكائنات الحية، يبرز تأثره بالنزعة الآلية التي ترى العالم آلة، بما فيها الجسم. فهو يقول: «الجسد الحي ليس إلا آلة عجيبة مزودة بأبهر الخصائص ومتحركة بتأثير آليات غاية في الدقة والتعقد». ويقول: «للوصول إلى حل مشكلات الجسد الحي ينبغي تفكيك الجسد شيئا فشيئا مثلما نفكك آلة نريد أن نتعرف على كل دواليبها وندرسها...». وهذا المنهج الآلي، القائم على التحليل يظهر بوضوح ديكارتية كلود برنار.
* ميرلوبونتي: وجهان لعملة واحدة
* ينتمي ميرلوبونتي إلى الفلسفة الفينومينولوجية التي ترفض الثنائيات. فقد أكد أن الجسد والنفس شيء واحد. فليس هناك ظاهر وباطن، فالعلاقة بينهما متلاحمة. فأنا لا أسكن جسدي كربان سفينة. فالربان قد يتفطن لخلل في سفينته، لكنه لن يحس بذلك كما يحس بالجوع أو العطش. فالأمر مختلف تماما. فبالجسد نعاشر العالم ونفهمه، ونجد دلالة له. إن الإنسان ليس فكرا مفصولا عن الجسد وليس جسدا مفصولا عن الفكر، بل نحن فكر متجسد وكيان في العالم، نحن نتواصل مع العالم عن طريق أجسادنا، كما أننا عندما نلتقي بالآخر نتعرف عليه بداية، انطلاقا من ملامح وتحركات جسده، فالجسد هو البوابة الأولى نحو عالم الغير، إذ يزودنا بانطباعات مهمة حوله، فالجسد لا يمكن أبدا فصله عن النفس، فالباطن والظاهر وجهان لعملة واحدة، فما نظهره هو إعلان عما نضمر. وهي الفكرة التي دافع عنها أيضا الفيلسوف الألماني ماكس شيلر (1874 - 1921) في كتابه «طبيعة وأشكال التعاطف»، فهو يرى أن الذات تدرك الغير بطريقة كلية، يندمج فيها النفسي بالجسدي، ليشكلا وحدة حية متكاملة لا تقبل التجزئة أو الانقسام إلى جسم ونفس. فنحن نتعرف في ابتسامة الغير غبطته، وفي دموعه حزنه، وفي احمرار وجهه خجله، وفي ضم كفيه تضرعه، وفي نظراته الحنونة غرامه، وفي صرير أسنانه غضبه، وفي قبضة يده المتوعدة رغبته في الانتقام، وفي كلماته معنى ما يريد قوله، فنحن لا نرى الجسم والملامح الشكلية بمعزل عن الباطن، بل نرى الصورة العامة والبناء الكلي. فعندما أكتشف أن الآخر يراني بطريقة أراها لا تطابقني، أدرك أنه مزق الرابط بين جسده وباطنه.
ولفهم مسألة لغة الجسد، نضرب المثال التالي: لنتصور أن هناك امرأة موجهة نحوها ثلاث نظرات من طرف ثلاثة رجال، النظرة الأولى جنسية والثانية عطوفة أبوية والثالثة فيها استجداء. فهل ستكتشف المرأة ذلك؟ بالطبع نعم، فهي ستفرق بين النظرات ومستوياتها. إذن العين ليست آلة صماء، إلا إذا كانت منفصلة عن الجسد كله، أما وهي في قلب الجسد، فستكون مثقلة ومحملة بباطن الذات، وهو ما يجعلنا نتحدث عن عين شريرة أو حائرة أو ماكرة أو قلقة... إذن يعد الجسد مجال تعبير الآخر والطريق الأول نحوه. وهذا عكس التوجه الديكارتي تماما.
في الختام، نقول إن الرؤى للجسد مختلفة، وهي الآن تزداد تعقيدا مع ظهور الجسد المعدل جينيا، خصوصا مع اكتشاف الجينوم، وظهور ما يسمى تحديد النسل، وعودة فكرة إكسير الحياة والشباب الدائم، وما صاحب كل ذلك من صرخات أخلاقية ستجعل الجسد مثار نقاش لن ينتهي.