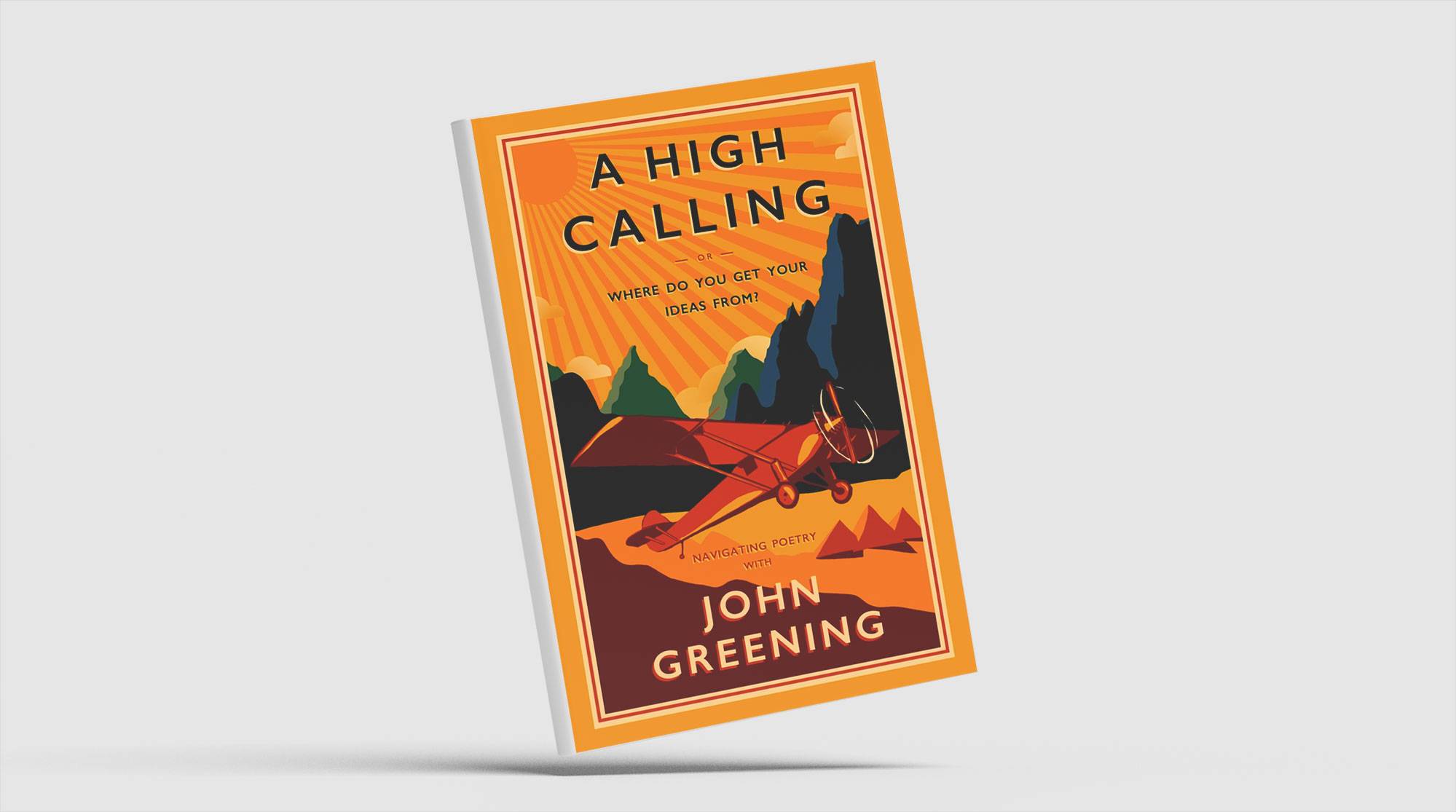فاز الروائي اللبناني حسن داود بجائزة «ميدالية نجيب محفوظ للأدب الروائي»، التي أعلنت مساء أمس الأحد، عن روايته التاسعة «لا طريق إلى الجنة»، كأول أديب لبناني يفوز بالجائزة التي تمنحها الجامعة الأميركية بالقاهرة. وسلمت الدكتورة ليزا أندرسون، رئيسة الجامعة الأميركية، داود الميدالية الفضية للجائزة وقيمتها المادية ألف دولار، في الذكرى الـ104 لميلاد نجيب محفوظ، وفي ظل غياب ابنتيه فاطمة وأم كلثوم.
تدور أحداث الرواية حول رجل دين شيعي يعيش بالجنوب اللبناني، يصارع مرض السرطان الذي ينهك جسده. ويظل البطل يتأمل حالة والده المُقعد وولديه الأبكمين، وزوجته المحبطة، تتكالب عليه هموم الحياة، ويجبره المرض على بتر أعضائه دون اختيار منه أيضا، وتنشأ بينه وبين أرمله أخيه علاقة حب لا يستطيع أن يخوضها لأنه مقيد بموقعه كرجل دين، ويصاب ابنه بمرض عضال، فيتمرد على الجبة والعمامة. تعالج الرواية العلاقات الإنسانية وقضايا الدين والوجودية والتحرر والبحث عن معنى جديد للجنة والخلود.
وعن حيثيات استحقاق الرواية للجائزة، ذكرت لجنة التحكيم أنها «رواية بديعة نفيسة تنفذ إلى معضلة الزمان والإنسان في مجتمع ديني»، ووصفوها بأنها رواية مختلفة «تتميز بسرد جوهر شخصية رجل دين، عبر سرد يتماهى كثيرا مع سرد إرنست همنغواي في جمل قصيرة محكمة، تبطن أكثر مما تكشف، وينسج الكاتب الذروة بهدوء شديد، ليخلع رجل الدين العمامة والجبة ويواجه العالم برغبته، وإدراكه أن ما يفعله لا يشكل طريقا إلى الجنة كرد على اضطهاد القدر له، فيرفض ما خضع له طوال حياته ويتمرد على معاناته مع مرض السرطان وهو على شفا الموت».
تكونت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام من الدكتورة تحية عبد الناصر أستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن بالجامعة الأميركية بالقاهرة، والدكتورة شيرين أبو النجا أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة؛ والدكتورة منى طلبة أستاذة الأدب العربي بجامعة عين شمس، وهمفري ديفيز المترجم المعروف للأدب العربي، والدكتور رشيد العناني الأستاذ الفخري للأدب العربي الحديث بجامعة إيكستر ببريطانيا.
وقال المترجم المخضرم همفري ديفيز عن الرواية: «إيحاءات العمل تشبه أسلوب مارسيل بروست في دقتها. كل فقرة تشبه طبقة رقيقة من الواقع، تقدم ببساطة شديدة تكشف عن المشاكل والأسئلة التي يثيرها كل حدث بكل تركيباته. الأسلوب الهادئ النقي يعطي هذا الكتاب صوتا متميزا». بينما ذهب رشيد العناني إلى وصف الرواية بأنها «طرح معاصر لقصة أيوب التوراتية». وقالت الدكتورة تحية عبد الناصر في كلمتها: «تتميز هذه الرواية بسردها الدقيق ويحفل النص بالتفاصيل وإيحاءات اللغة، وتشكل عالما كان الصمت فيه وسيلة للتواصل. تجسد الإشارات ما بين الراوي وولديه طرقا بديلة للخطاب في النص. وفي أثناء مرضه ينزوي الراوي للصمت».
وقال داود فور تسلمه الميدالية: «هذه الجائزة تُدنيني من نجيب محفوظ الإنسان، الذي صنعت رواياته إدراكنا لمعنى أن يتحول العيش إلى رواية». وردا على سؤال «الشرق الأوسط» له حول تأثره في هذه الرواية بأسلوب محفوظ الواقعي، قال: «نجيب محفوظ صوت نادر في رواية العالم خصوصا في أدبنا العربي، وتأثيره في وفي غيري من الأدباء أعمق بكثير من أثره في هذه الرواية، فهو أحد أعمدة الرواية العربية، صور المجتمع بتفاصيل هائلة وقوية بقوة الواقع نفسه، أمكنته وشخوصه لا تزال تعيش معنا. أصبحنا نأتي لمصر نسأل عن أمكنته رغم قراءاتي له منذ أكثر من 30 سنة، فجميع الروايات التي قرأتها لا أتذكر أحداثها ولا شخوصها، بينما محفوظ وأبطاله يعيشون بداخلي وأعتقد بداخل كل عربي». وأضاف: «كتبت هذه الرواية عن حياة رجل الدين ومحيطه الإنساني، ولم أقصد بها أي مجتمع أو أي إسقاط على أوضاع تاريخية أو مرحلية مرت بها لبنان أو غيرها. ألهمني والدي الكتابة عن حياة تلك الشخصية، أزمتها وهشاشتها، كونه عاش حياة لم يردها؛ كتبت الرواية له وعنه، لكن (السيد)، شخصية بطل الرواية، طورت نفسه وأصبح ما هو عليه، فهو مكتمل الفرادة كونه دفع دفعا ليكون إماما بينما كانت تعوزه القوة ليكون أبا».
وعن مسيرته الروائية، قال: «أرادني والدي أن أكون رجل دين، وأن أدرس بالنجف لأعود وأصبح إماما لثلاث قرى، كنوع من الوظائف المضمونة، إلا أن الصورة الذهنية عن رجل الدين لم تكن تستهويني، فقد كانت صورته لدي هي الصورة التي جسدتها السينما المصرية للمأذون، فلم أحب ذاك الطريق الذي أرادني والدي أن أسلكه رغم كونه غير متدين بدرجة عميقة». الرواية تحدث زمنيا في سنوات السبعينات، حيث كان الدين يشهد تراجعا، وهي تتحدث عن المأساة الفردية لهذا الشخص، وهو لا يحيل إلى سواه، كما لا تحيل الرواية على بلد بعينه حتى لبنان ذاته؛ وهذه المأساة هي سعي هذا الرجل إلى الخلاص مما لا يريده؛ وتحتفل الرواية بتفاصيل كثيرة في حياته، فهي تبحث في أعماق هذا الرجل».
استعان صاحب «لا طريق إلى الجنة» بتقنية السرد البطيء الخالي من الحوار والأمكنة، ونجح في تجسيد حياة ذلك الإمام المملة والرتيبة، بوصف دقيق للحياة اليومية كمشاهد سينمائية متصلة.
ولداود المولود في بيروت عام 1950، ثلاث مجموعات قصصية و10 روايات من بينها «بناية ماتيلدا»، و«غناء البطريق»، و«سنة الأوتوماتيك».
وكشف لأول مرة عن سر لم يعلنه من قبل بخصوص الرواية الفائزة قائلا: «كتبت هذه الرواية منذ 12 عاما، وحملتها معي كمخطوطة أثناء اضطراري للسفر لفرنسا، وهناك سرقت مني، ورغم كل محاولاتي لمكافأة من يجدها لم يعدها إلي أحد، وظللت طوال 10 سنوات أجاهد نفسي كي أعيد كتابتها، واستغرقت الرواية المطورة عامين، حيث قمت بتعديلها تماما، وأخيرا خرجت للنور. وحينما أعدت كتابة هذه الرواية لم أضع في ذهني النهاية ذاتها أو تطور الأحداث ذاته، بل بدأتها وتركتها تتجسد وتتشكل، فأنا أؤمن بأن الرواية عمل فكري قبل أن تكون عملا سرديا»
صدرت الرواية الفائزة عن دار «الساقي» ببيروت عام 2013، وخرجت في 320 صفحة من القطع المتوسط. وتمنح الجائزة لأفضل رواية معاصرة نشرت خلال عامين باللغة العربية، ولم تترجم للغة الإنجليزية، ويقوم قسم النشر بالجامعة الأميركية بالقاهرة بترجمة ونشر الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية في القاهرة ونيويورك ولندن.
وأعرب داود عن سعادته بفوز الرواية بالجائزة خاصة أنها تمنح في مصر، قائلا: «مصر الثقافة والأدب كانت هي محجتنا الفكرية والأدبية منذ أن كنا في مقتبل العمر. ما كنا نعرفه عن الثقافة كان يأتي من مصر، حتى الأدب الأجنبي كان يصلنا مترجما من مصر. كنا في السنوات الماضية نتثقف بثقافة مصر وفنها. وأعتبر هذه الرواية محظوظة رغم أنها لا تباع في مصر، إلا أنها الآن يمكنها أن تجد القارئ المصري والغربي أيضا». وأعرب عن حزنه لرحيل عدد كبير من الأدباء المصريين مؤخرا خلال العامين الماضيين والذين كانت تربطه بهم صداقة وطيدة.
وحول الرواية العربية، قال صاحب «نقل فؤادك»: «نشهد نهضة روائية كبيرة، أقصد في عدد الروايات التي تنتج كل عام وهي نحو 200 رواية، وهو أمر يصعب على أي شخص أن يطلع عليها كلها. قرأت لكل الكتاب المصريين تقريبا، من جيل الستينات والسبعينات؛ لأننا في الماضي كنا نعرف ماذا يصدر في مصر والعراق والمغرب، والآن ما يصدر في المغرب يظل في المغرب وما يصدر في مصر يبقى في مصر، وأحد أسباب رغبتي في الوجود بمصر من وقت لآخر هو الاطلاع على ما ينتج فيها، وأعتقد أن السبب هو أن المثقفين العرب يعيشون في جزر منعزلة، والدول العربية في حالة تشظٍ بارتفاع أسهم إقليميتها على وطنيتها»، مضيفا: «كان اللبنانيون يطبعون كتبا لمصريين وعراقيين، لكن دور النشر هذه توقفت بسبب الحروب والظروف الاقتصادية. وبتنا الآن في وضع صعب تتراجع فيه الترجمة والكتابة والقراءة. الأمة العربية لم تعد تقرأ، وأصبحت أمة كاتبة. نحن بحاجة إلى ثورات في كل المجالات، لكن قبل أي شيء علينا أن نتخلص من كمية الفساد والقمع والنزاعات الطائفية والمذهبية».
وحول قيمة الجوائز العربية بالنسبة لفن الرواية والترويج لها، قال: «مهمة بالطبع، لكنني أفضل أن يختار القارئ كاتبه، خصوصا أن ما يقترح على القارئ قد لا يكون صائبا. هناك مشاكل كبيرة تتعلق بما يُختار من الروايات العربية، خاصة الروايات التي تكتب وترتبط بحدث معين كالحرب على سوريا، هذه الأعمال لا تصبح ذات مستوى جيد».
تأسست جائزة نجيب محفوظ منذ 19 عاما دعما للأدب العربي المترجم وتكريما للأديب العالمي، الذي يعد الأديب العربي الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل للآداب، وأطلقتها دار نشر الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1996 باسم «ميدالية نجيب محفوظ للأدب الروائي»، كونها الناشر الرئيسي لأعمال نجيب محفوظ باللغة الإنجليزية لأكثر من خمسة وعشرين عاما والمالكة لحقوق نشر أكثر من 600 طبعة باللغات الأجنبية الأخرى لأعمال الأديب التي تُرجمت إلى 40 لغة في جميع أنحاء العالم منذ فوزه بجائزة نوبل عام 1988.
وكان «الأستاذ» نجيب محفوظ قد رحب بالجائزة التي تحمل اسمه قائلا: «الإعلان عن هذه الجائزة التي تكرم الأدب والأدباء هو حدث مهم يوم عيد ميلادي. وأتمنى أن تساعد هذه الجائزة في اكتشاف مواهب جديدة في الأدب العربي وتعريفهم للقراء في جميع أنحاء العالم».
فاز بالجائزة 20 أديبا عربيا؛ منهم: 11 أديبا مصريا، وفلسطينيان، وسوريان، وجزائري، ومغربي، وعراقي وسوداني، ولبناني. أما تصنيف الفائزين وفقا للجنس، فقد فاز بها: 8 سيدات و12 رجلا. وكان أول من فاز بها عام 1996 مناصفة الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد عن روايته «البلدة الأخرى»، والأديبة الراحلة لطيفة الزيات عن روايتها «الباب المفتوح»، بينما فاز بها العام الماضي الروائي السوداني حمور زيادة عن روايته «شوق الدرويش».
حسن داود: المثقفون العرب يعيشون في جزر منعزلة
روايته فازت بـ«ميدالية نجيب محفوظ الـ21 للأدب الروائي»

حسن داود يتسلم الجائزة

حسن داود: المثقفون العرب يعيشون في جزر منعزلة

حسن داود يتسلم الجائزة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة