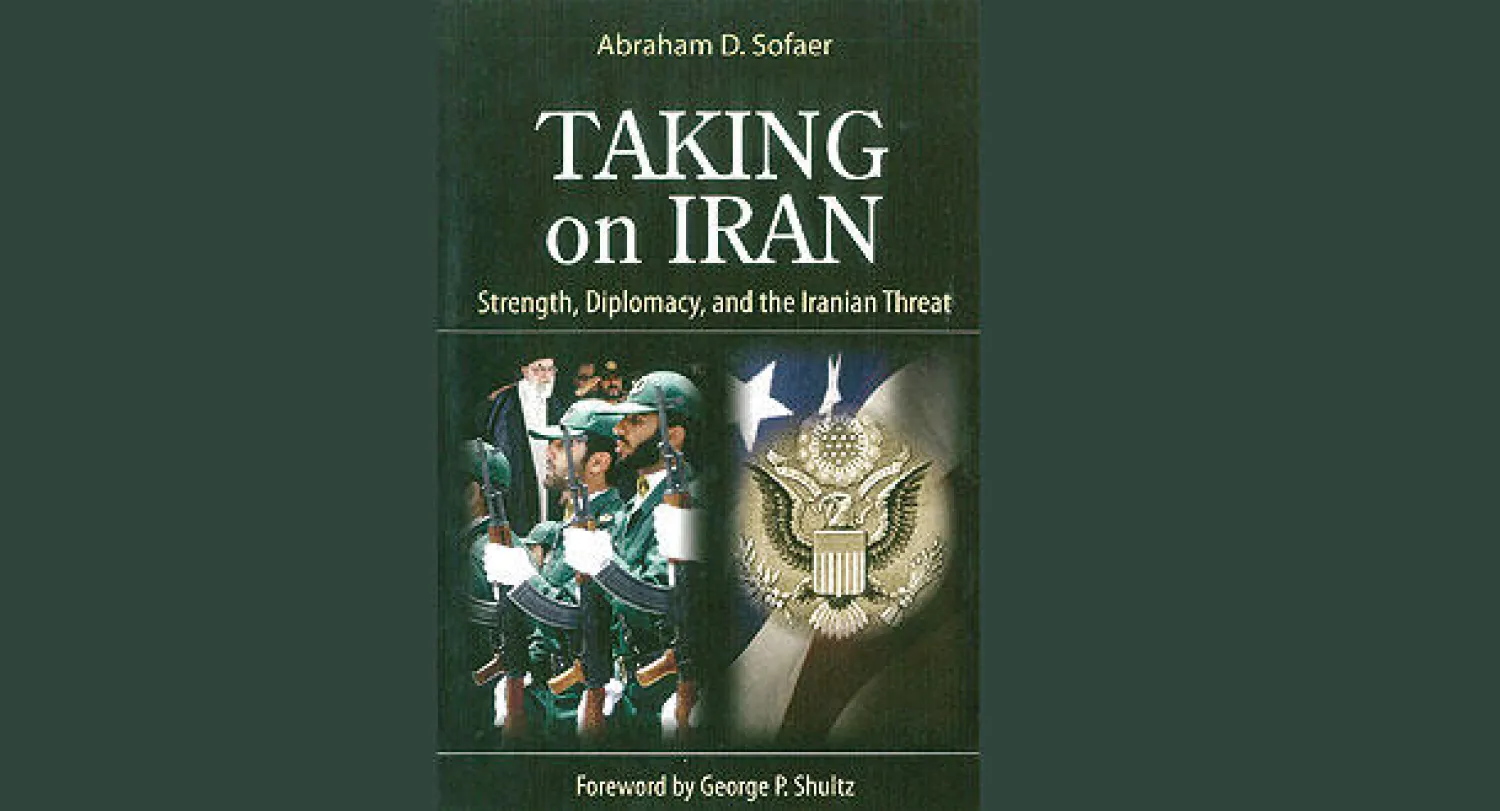بينما لا يزال مستقبل «الاتفاق» النووي بين إيران والقوى الست العظمى، الذي أحيط بقدر كبير من الدعاية - غير مضمون، يتواصل النقاش حول كيفية التعامل مع النظام الخميني في طهران. ويملك أبراهام سوفائير، مؤلف كتاب «التصدي لإيران.. القوة، والدبلوماسية والتهديد الإيراني»، مؤهلات جيدة لينضم إلى هذا النقاش. لقد كان على مدار خمس سنوات المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، ومن صلب مهامه العلاقات مع إيران، وهو منصب مكنه من مقابلة الكثير من المسؤولين وشبه المسؤولين الإيرانيين والوصول إلى تقارير سرية حول علاقات الولايات المتحدة مع إيران. ويكتسب كتابه الصلاحية بفضل مقدمة مطولة كتبها وزير الخارجية الأميركي الأسبق جورج بي. شولتز وتزكيات مختصرة من وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنغر وعباس ميلاني، وهو خبير أميركي من أصل إيراني، متخصص في شأن الجمهورية الإسلامية.
تقضي الحجة التي يروج لها سوفائير بأن الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت تضع سياساتها بشأن إيران على أساس التفكير بالتمني. فبعضها كان يطارد حلم «تغيير النظام» في طهران من دون أن يوفر فعليا الأدوات اللازمة لتحقيقه. ونتيجة لذلك، فقد تسببوا في مزيد من الاستعداء للملالي بينما سمحوا لهم بسحق معارضيهم في الداخل. في حين كان آخرون يعبثون بفكرة التكيف مع الملالي على أمل إقناعهم بتغيير جوانب سلوكهم. ومنيت هذه الخطة بالفشل لأن الملالي، بمجرد اطمئنانهم إلى أنهم ليسوا مهددين، لم يزدهم هذا إلا عدوانية.
ومتى كان الملالي يشعرون بتهديد حقيقي، فإنهم كانوا يرتدون «القناع الإصلاحي» ويقدمون صورة «الملا الضاحك»، مثل محمد خاتمي في القرن الماضي، وحسن روحاني اليوم.
يعترف سوفائير بأنه حتى ريغان «أضاع ثلاث سنوات» في المحادثات السرية مع الرئيس الإيراني آنذاك هاشمي رفسنجاني في طهران لمساعدة الجناح الذي يقوده الأخير على هزيمة الجناح المنافس بقيادة آية الله منتظري. وما إن تحقق لرفسنجاني هدفه، حتى أمر باستئناف العمليات العدائية ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك أسر مزيد من الرهائن الأميركيين في لبنان.
في عهد الرئيس باراك أوباما، انتهجت الولايات المتحدة سياسة التوافق مهما كان الثمن. ولتسويق تلك السياسة إلى الجمهور الأميركي المرتاب في الملالي، قلص أوباما الخيار بين غزو كامل لإيران ومنحها ما تريد، كما اختزل المعضلة الإيرانية بكاملها في المسألة النووية، فأغفل مسائل من قبيل دور إيران في تصدير الإرهاب، وانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان. ولأن الجمهور الأميركي ليس في مزاج يسمح بحرب برية جديدة في الشرق الأوسط، فقد تمكن أوباما من إطلاق العملية التي أنتجت «اتفاق» فيينا النووي.
ويدفع سوفائير بأن كل تلك السياسات كانت خاطئة، بل جاءت في بعض الحالات بمردود عكسي. وهو يوحي بأن على الولايات المتحدة التخلي عن فكرة تغيير النظام في طهران إلى جانب أي حلم بـ«الإصلاح الداخلي» في المشهد الخميني. وفي الوقت ذاته، يشير إلى أن الولايات المتحدة ترى في الجمهورية الإسلامية مشكلة أكثر تعقيدا بكثير، بخلاف المسألة النووية. وعلى خلفية هذه التأكيدات يقوم بمعالجة مسألة «التصدي لإيران». والسؤال هو: كيف؟
الحل الذي يقدمه سوفائير بسيط. على الولايات المتحدة أن تقوم بالتقييم ومن ثم تتعامل مع الجمهورية الإسلامية بناء على ما تفعله طهران في أي مرحلة زمنية. فإذا هددت طهران مصالح واشنطن في أي مكان، يكون على الولايات المتحدة أن ترد بمهاجمة المصالح الخمينية. وهو يزعم أن هذه الطريقة أصابت النجاح في كل مرة استعملت فيها.
على سبيل المثال، في مرحلة ما في العراق، وجد الأميركيون أن الكثير من جنودهم الذين ماتوا كانوا ضحايا ألغام أرضية قادمة من إيران. وعندها أرسل القائد الأميركي الجنرال ديفيد بترايوس رسالة إلى قاسم سليماني، الجنرال الإيراني المسؤول عن «تصدير الثورة»، مفادها: توقف وإلا فسنأتي ونصل إليك! توقفت الإمدادات المميتة في غضون أيام.
مثال آخر حدث في ثمانينات القرن المنصرم، عندما أمر الخميني قواته باستهداف ناقلات النفط الكويتية. أمر الرئيس رونالد ريغان البحرية الأميركية بإغراق بحرية الحرس الثوري الإيراني في معركة دامت يوما كاملا (18 أبريل - نيسان 1988). توقف الخميني فورا عن استهداف الناقلات، بل وافق على وقف الحرب في العراق.
في المقابل، يرى سوفائير أنه عندما قررت الولايات المتحدة أن تغضي الطرف، تجرأت إيران بالإقدام على مزيد من الأفعال الخاطئة. وهو يقول: «كانت لدى جهاز التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كل الأدلة المطلوبة لإثبات أن الهجوم على الخُبر الذي سقط فيه موظفون أميركيون قتلى، جرى تنفيذه بأوامر من طهران. ومع هذا فقد قرر الرئيس بيل كلينتون تهدئة الأمور ومن ثم زاد عدوانية إيران جرأة».
كما يقول سوفائير إن إيران حافظت على علاقة فعالة مع تنظيم القاعدة، وإن واشنطن رصدت خطابا من أيمن الظواهري يشكر فيه القيادة الخمينية. ويمضي إلى الزعم أن إيران وفرت بعض القواعد التي تحتفظ بها «القاعدة» في اليمن، ويفترض أن ذلك تم بمساعدة الحوثيين.
ويستشهد سوفائير بمحاولة أخرى لجناح رفسنجاني لـ«تحييد» الولايات المتحدة؛ ففي مايو (أيار) 2003، أرسلت طهران مقترحا ظاهريا كتبه صادق خرازي، وهو مبعوث إيراني سابق لدى الأمم المتحدة، يعرض على واشنطن «مساومة كبرى». ورغم أن الرئيس جورج دبليو بوش لم يكن مهتما بالتجربة، فقد أخذها في الحسبان وقلل الضغط على طهران. ويذهب المؤلف أيضا إلى القول بأن هناك «أساسا قانونيا صلبا» للقيام بأعمال عقابية، بما في ذلك الضربات العسكرية العقابية، ضد الجمهورية الإسلامية، بمرجعية حق الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
إن القيام بتحركات عقابية ردا على سوء السلوك من جانب طهران لا يستبعد المفاوضات الدبلوماسية، حسبما يؤكد سوفائير؛ فأهم ما يجب أن يفهمه قادة إيران هو أن هناك عواقب لكل عمل يقومون به. بل يشير المؤلف إلى أن بعض الأهداف المحددة لـ«الضربات» العقابية الأميركية، بما في ذلك جزر فارسي وأبو موسى ومراكز قيادة وسيطرة الحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا ولبنان.
من غير المرجح أن يقتنع الرئيس أوباما بسيناريو سوفائير. ومع هذا، فقد يستميل طرح سوفائير خليفة أوباما، على أقل تقدير.
يعاني كتاب سوفائير من تواضع التحرير، إذ تكرر الكثير من الفقرات الطويلة في صفحات مختلفة، كذلك فهناك الكثير من الأخطاء. فقد كان روبرت، وليس ويليام، غيتس أول وزير للدفاع في عهد أوباما. ولم يكن قلب الدين حكمتيار «زعيم طالبان» بل زعيم الحزب الإسلامي، الذي مولته الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أولا قبل أن تموله إيران. والسيدة التي اغتالها عملاء الخميني في واشنطن كانت السيدة نيرة، وليس ناريا، رافيزاده. ومن المعروف أيضا أن ريغان لم يبدأ الحوار بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، كما يعتقد المؤلف. فقد كان الطرفان حليفين أثناء الحرب العالمية الثانية، ولاحقا، باستثناء واحد، كانا يعقدان قمما مشتركة. (كان الاستثناء خلال تولي غريغوري مالينكوف، الذي خلف ستالين، رئاسة الوزراء، قبل أن يزيحه سيرغي خروشوف عن المنصب).
وسواء اتفق المرء أو اختلف مع ما يطرحه سوفائير، فرؤيته لـ«مواجهة إيران» هي رؤية صادقة.