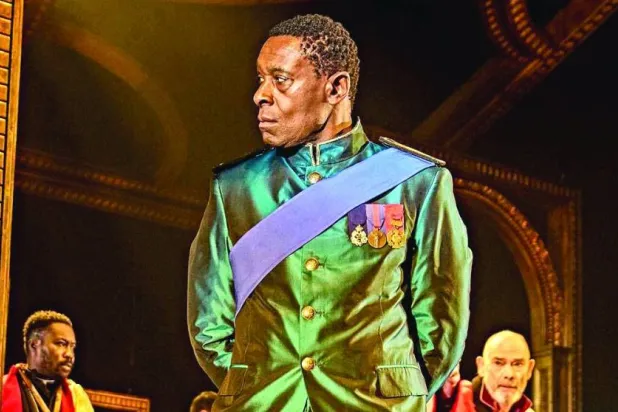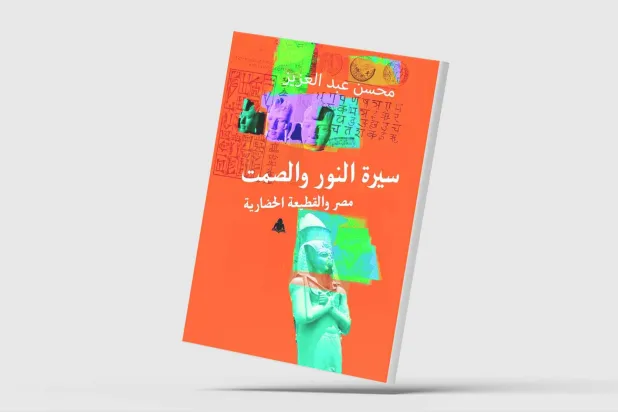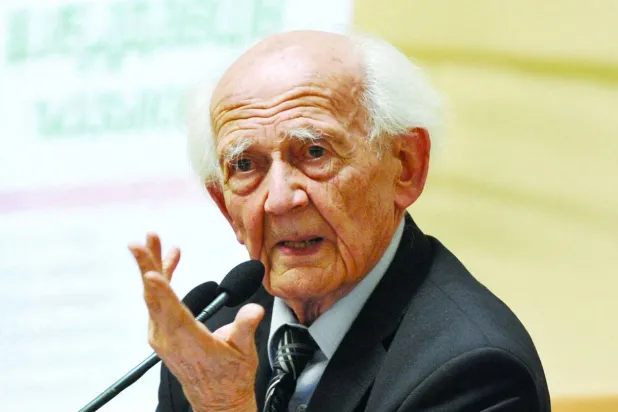يعود قاموس أكسفورد الإنجليزي إلى الأضواء مرّة كل عام على الأقل، ذلك عندما تعلن الهيئة القائمة على أعرق وأهم سجل معجمي للغة الإنجليزية وتوثيقها اختيارها لكلمة العام من بين المفردات الجديدة التي أبدعتها قرائح المتحدثين بتلك اللغة. وتعكس الاختيارات عادة جدلاً ثقافياً واجتماعياً واسعاً حول مسائل تعني الشأن العام، فشملت في السنوات الأخيرة «ما بعد الحقيقة» و«ثقافة الإلغاء» و«الأخبار المزيفة أو الكاذبة»، فيما امتنعت استثنائياً في عام الجائحة (2020) عن اختيار كلمة واحدة فحسب، نظراً لفيض الاصطلاحات التي أطلقتها الخبرة المستجدة للبشرية المعاصرة بالتعامل مع الطاعون الجديد «كوفيد 19»، فكان أن قدّمت مجموعة منها.
على أن العمل الذي ينجزه القاموس أوسع وأشمل بكثير من هذه المناسبة الإعلاميّة المسليّة، وهو يشمل تحديثاً فصلياً لتعابير اللغة الإنجليزية، يبدأ من إضافة كلمات جديدة تكرر استعمالها، وتنقيح أخرى من القاموس تعرضت معانيها لتحولات أو تقلبات ثقافيّة، كما نقل بعضها إلى المتحف اللغوي عبر وصفها بالقديمة التي عفا عليها الزمن أو النادرة الاستعمال.
وتعتمد بيوتات الصحافة والإعلام في العالم الغربي والجامعات ومراكز البحث، كما الأفراد بعمومهم، على قاموس أكسفورد كأكثر المرجعيات موثوقية بالنسبة للإملاء والمعاني وإنفاذ قواعد النحو والاستخدام السليم للغة الإنجليزية، ولا سيما أن القاموس لا يقتصر على النسق البريطاني، وإنما يتسع لكل الإنجليزيات المعروفة – إن جاز التعبير – من أستراليا إلى جامايكا، وما بينها من تجمعات سكانية يتحدث أصحابها طرفاً من لغة شكسبير.

جيمس موراي
ومنذ إطلاقه في القرن التاسع عشر، فإن قاموس أكسفورد وكأنّه قد كلّف نفسه بمهمة أوسع من رصد معاني الكلمات المستخدمة إلى ما يشبه سجلاً تاريخياً للنمو العضوي للغة الإنجليزيّة عبر المراحل، إذ إن الكلمة ما أن أدخلت إلى القاموس حتى لا تغادره أبداً، وإنما يتم تحديث وضع استعمالها، ما يعني أن «أكسفورد الإنجليزي» يتوسع بشكل دائم، حتى لتبدو مهمته مستحيلة بحق، ولا سيما أن اللغة الإنجليزية مرتبطة بهيمنة ثقافية أنجلوساكسونيّة على مجالات ثقافية وعلمية وتجاريّة كثيرة عابرة لحدود البلاد التي هي لغتها الأم. وهو بذلك يختلف عن القواميس الأخرى الدّارجة مثل كولينز وتشامبرز التي تحتفظ بالكلمات الأكثر تداولاً في نطاق مجلّد واحد، فهو يوضح أيضاً كيف تغير معنى كلمة معينة بمرور الوقت من خلال الاقتباسات التي يزيد عددها عن 3.5 مليون إلى الآن، والتي لا تؤخذ من الكتب والصحف والمجلات فحسب، بل في أوقاتنا الحالية من الإعلانات وكلمات الأغاني ونصوص الأفلام والتلفزيون حتى «تويتر».
يضم القاموس في صورته الحالية نحو 600 ألف كلمة، وطبعته الثانية التي نُشرت عام 1989 تملأ 20 مجلداً، وكانت هناك خطّة لنشر طبعة ثالثة في 2005 لكّن عمليّات التحرير لم تصل بعد إلى المنتصف. لكن قليلين في وقتنا الراهن يعتمدون على النسخة المطبوعة، وانتقل جزء كبير من التحرير والاستخدام إلى الإنترنت، وهو ما يفسّر جزئياً تلكؤ الناشر في الدفع بإصدار جديد مطبوع.
لكن ضخامة هذا المشروع واتساع تأثيره لا يجب أن تحجب عنا حقيقة أن عدد القائمين عليه لا يتجاوز 70 موظفاً، يعملون حين حضورهم في مكتب مفتوح متواضع في المبنى الذي يضم مقر مطبعة جامعة أكسفورد في أحد أحياء مدينة أكسفورد القديمة، وإن كان للقاموس يوماً غرفة فاخرة في إطار متحف الأشموليان العريق، التابع للجامعة. ويتولى هؤلاء الموظفون إدارة عمليات القاموس بشكل تعاوني لتقليل الأخطاء، ويمثل كل منهم مرجعيّة أوليّة للآخر قبل الاستعانة تالياً بجيش من غير المتفرغين، يشمل لغويين، وخبراء أصول الكلام، وعلماء البيبلوغرافيا، وأساتذة الآداب والعلوم، والخبراء المعنيين بالنطق، والمستشارين الخارجيين، لتعود الكلمة منهم إلى أيدي المحررين المتخصصين بالنشر في شكله النهائيّ.
ويمكن أن تستغرق هذه العمليّة بمجملها من بضع ساعات إلى بضعة أسابيع، بحسب طبيعة الكلمة واستخداماتها، لكنّه ليس مستغرباً أن تمرّ إحداها على 200 شخص قبل اعتمادها. كما أن القاموس لم يحقق ربحاً تجارياً في تاريخه، رغم أن الاشتراكات الحالية تغطى جزءاً هاماً من الميزانية السنوية التي تبلغ نحو 35 مليون جنيه أسترليني، إلا أن قيمته الأساسيّة تظلّ في السمعة الأدبيّة الراقية التي يمنحها للمطبعة، وللجامعة، وللمدينة، حتى للأمة البريطانيّة بمجملها، علماً بأن المشروع كان عُرض بداية على مطبعة جامعة كامبريدج المنافسة الدائمة لأكسفورد، لكنها رفضته في حينه، وإلا لكان الشرف لقاموس كامبريدج الإنجليزي!
تعود حكاية القاموس إلى العام 1857 حينما كانت بريطانيا في قلب العصر الفيكتوري الذي شهد ثورات معرفيّة وعلميّة وتقنيّة؛ السكك الحديدية، ومصانع الصلب، والأنثروبولوجيا، والتخدير، وأدب تشارلز ديكنز، ونظريات داروين. في تلك الأجواء الطموحة تداعت مجموعة من أعضاء جمعيّة فقه اللغة، هربرت كولريدج، وفريدريك فورنيفال، وريتشارد تشينفيكس، لتكوين ما سمي بلجنة الكلمات غير المسجلّة بهدف التقاط تلك التعابير التي ولدت ولم تحظ بشرف التسجّل في القواميس، وهذه كان صدرت منها تجارب مختلفة (أقدمها يعود إلى العام 1604). لكن المهمة بدت هائلة وشبه مستحيلة، فقررت اللجنة اللجوء إلى الأمّة برمتها، فأصدرت تعميماً يحتوي على تعليمات لتسجيل اقتباسات توضح استخدام كلمات إنجليزية جديدة على بطاقات بريديّة ترسل إلى اللجنة. وعلى الرّغم من أن العمليّة كانت تطوعيّة ولم يتلقَ المساهمون أي أجر على جهودهم، فإنّ اللّجنة غرقت حرفياً بالبطاقات البريديّة تلك، وشارك بعض الأفراد بعدة مئات منها بحماسة منقطعة النظير، ولا شكّ أن بعضهم كرّس أوقاتاً مهمة من حياته لتتبع حياة الكلمات ورصد استعمالها في الصحف والكتب والروايات، بل قصّوا أحياناً الاقتباسات من تلك المطبوعات ولصقوها على البطاقات لضمان دقّة التوثيق، مفسدين بذلك نسخ الكتب الأصليّة.
تعثّر العمل باللجنة بعد وفاة كولريدج، فتقرر نقل المشروع إلى مطبعة جامعة أكسفورد في العام 1879 وفق اتفاق شمل أيضاً تعيين جيمس موراي عالم اللغويات الشهير رئيساً للتحرير، الذي شكل فريقاً استغرقه العمل لفرز البطاقات البريديّة المتراكمة مسبقاً لدى اللجنة سنتين كاملتين، وكذلك نشر القاموس في 7000 صفحة خلال 10 سنوات، بميزانيّة لا تتجاوز 9 آلاف جنيه إسترليني. لكن بعد مرور 5 سنوات بدا واضحاً أن إنجاز المشروع بشكل نهائي سيأخذ وقتاً أكثر مما خطط له، ما حدا بالناشر إلى تبني فكرة النشر المجزأ. وهكذا صدر الجزء الأوّل في 1884 لكن الطبعة كاملة لم تكتمل (في 10 أجزاء) قبل عام 1928، أي بعد 70 عاماً من تشكيل لجنة الكلمات غير المسجلة. وقد احتفلت بريطانيا الرسميّة بذلك الإنجاز على لسان رئيس وزرائها آنذاك، ستانلي بالدوين، الذي قال في مأدبة عشاء بتلك المناسبة إن «تاريخنا، رواياتنا، قصائدنا، مسرحياتنا، كلها جمعت في هذا الكتاب الواحد العظيم. ومع ذلك فإن كثيراً من المدخلات في الطبعة الأولى كانت قد أصبحت قديمة، ولم يظهر كثير من الكلمات التي استجدت أثناء النشر، ما استدعى إصدار مجلدات تكميليّة متتابعة، قبل أن يقرر الناشر إصدار طبعة ثانية كاملة منقحة عام 1985. وهو النّص الذي يعتمد عليه اليوم في إعداد الطبعة الثالثة المقبلة.
نسرد هذه الحكاية عن قاموس لغة أمّة قررت أن تحافظ عليها حيّة ومتجددة، بينما يملأ قلبنا التشاؤم من عجز أمتنا العربيّة الممتدة عبر 22 دولة و400 مليون نسمة واستثماراتنا الملياريّة المتناثرة في بنوك الغرب عن تأسيس قاموس عربي موحد على نسق قاموس أكسفورد، يحفظ لغتنا العربيّة، ويمنحها القدرة على النموّ والتطوّر والانتشار بعد مرور قرون عدّة على صدور القاموس الرائد لابن منظور «لسان العرب» في القرن الثالث عشر، الذي لا يزال ونحن في القرن الحادي والعشرين أشمل معاجم اللغة العربية وأكبرها حتى الآن. وباستثناء أننا نمتلك القرآن الكريم الذي ضبطت نصوصه منذ ما يقرب من 1500 عام، فإن العربيّة المعاصرة تفتقر بشكل فاضح إلى مرجعيّة لغويّة حتى لتبدو رغم محاولات قطرية علقت في أبراج عاجيّة خارج الحياة وخارج الواقع وكأنها يتيمة بين لغات الأمم الحية، التي لكل منها وإن تضاءل عدد المتحدثين بها مؤسسات وطنيّة تدير قواميس شاملة تعنى بتجديد كلماتها وضبط استعمالها ورصد تحولات معانيها.
إن نهضة عربيّة لن تكون ممكنة دون قاموس لغوي شامل ومحدّث، سواء تولته عاصمة واحدة أو منظمة عربيّة جامعة عابرة للسياسة والأحلاف اللحظيّة. ومن خبرة قاموس أكسفورد الإنجليزي الماثلة أمامنا، فإن ما نحتاجه لجعل ذلك واقعاً ليس مالاً كثيراً ولا تجهيزات هائلة ولا جيشاً من الموظفين، بل كثير من الشغف لاستعادة ثقافتنا - معبراً عنها بلغتنا - من موتها السريري غير المعلن.