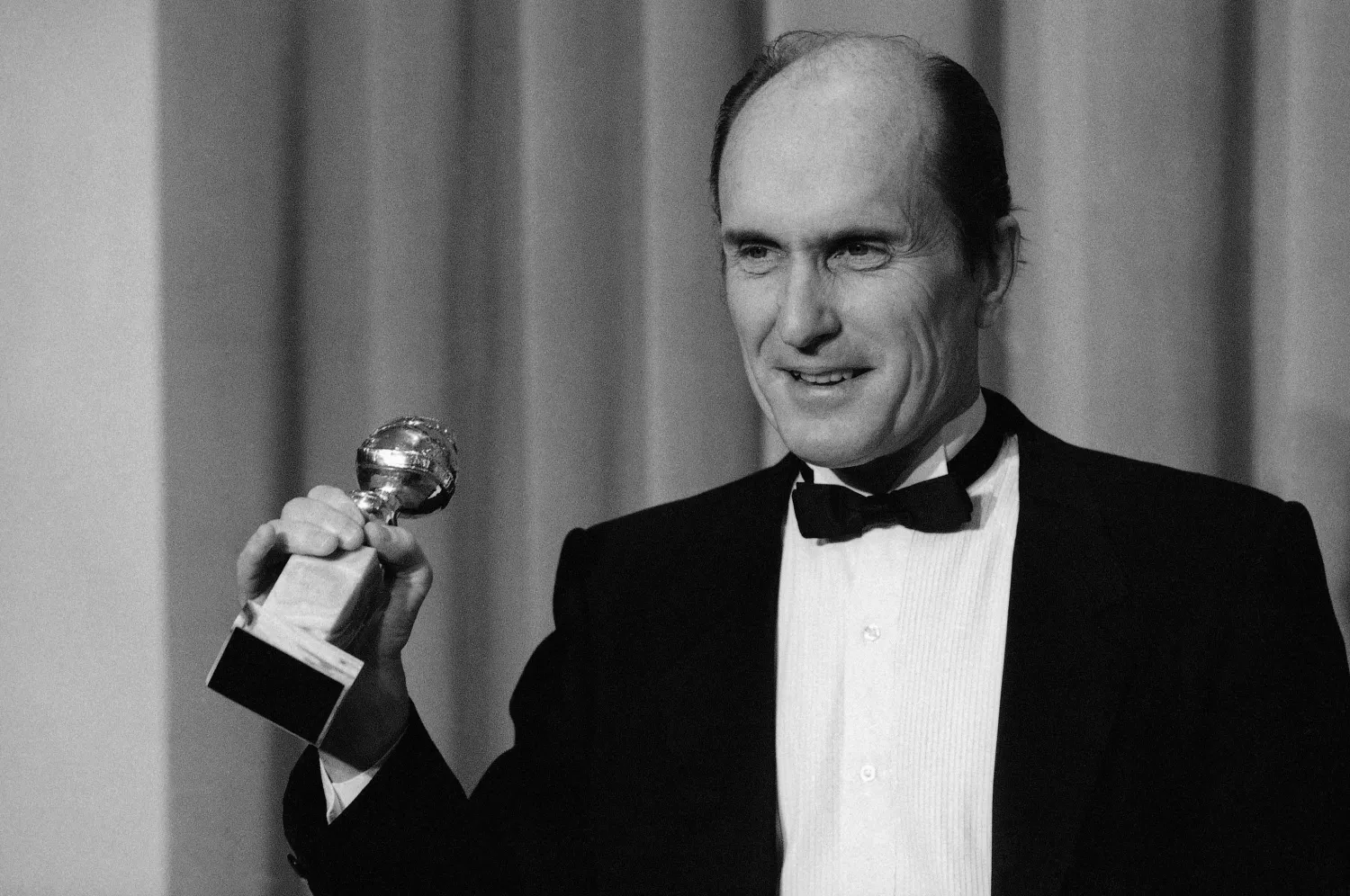2 طلعت حرب
> إخراج: مجدي أحمد علي
> مصر (2021)
> دراما اجتماعية | عرض خاص
(جيد)
يميل المخرج مجدي أحمد علي في كافة أفلامه إلى بناء كلاسيكي المقام يمنحه ثبوت الإيقاع وطرح المضامين بسرد لن يتسابق مع الزمن أو يقفز بين ألوان من المعالجات الجديدة. هذا البناء الكلاسيكي يمنح أعماله تميّزاً عن سواه (أو معظم سواه) من الأعمال السينمائية كما يوفر للمشاهد نمطاً من سرد الحكاية بتتابع رصين وثابت.
«2 طلعت حرب» لا يختلف في هذا الإطار لكنه يختلف عن أعماله السابقة في قليل من اتجاهاته. هو عبارة عن أربع حكايات متتابعة في إطار فيلم واحد وعلى خلفية زمنية طويلة. الغاية سرد الحكايات المتصلة بعضها ببعض بشخصياتها وبمكانها (عمارة رقم 2 شارع طلعت حرب) لتحكي ما هو خاص، في المقدّمة، وما هو عام في الخلفية.
تقع الحكاية الأولى في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ونلتقي فيها بابن البوّاب شعبان كولد صغير. وهي تبدأ بمشاهد وثائقية لخطب الرئيس ولعناوين الصحف ولبعض المشاهد العامة قبل أن تأخذ أحداث الحكاية دورتها. إنه جزء مصوّر بالأبيض والأسود وفيه نتعرف على الولد شعبان، ابن بوّاب البناية، الذي يساعد الطبّاخ لتحضير صحون العشاء لمجموعة من الضيوف في منزل تقطنه امرأة واقعة في حب طبيب نفسي. تبدو المجموعة في سلوكها وما تتبادله من حوارات كما لو كانت آتية من فيلم «المذنبون» أو «الكرنك» من حيث موقع هذه الشخصيات البعيد عن نبض الأحداث حولها.
صاحبة المنزل لطيفة وسعيدة لولا أنها ترتاب في تصرّفات من تحب. تراه يغادر الحفل عند منتصف الليل معتقدة أنه على علاقة بامرأة أخرى. لكن ما نراه نحن، ويغيب عنها، هو معالجته لرجل يحتل مكانة مهمّة تجعل عناصر المخابرات ترتاب في انتمائه. عندما يتم جلب الطبيب بالقوّة لتوقيع شهادة وفاة مزوّرة يأبى ذلك وتنتهي الحكاية لتنقتل إلى الفترة الساداتية.
هذه تبدأ كما بداية الحكاية الأولى: وثائقيات ومشاهد للرئيس محمد أنور السادات والخطوة التي قام بها عندما زار الكنيست الإسرائيلي ووقع معاهدة السلام. يستخدم المخرج هنا الألوان ليسرد حكاية شاب لبناني اسمه نديم يصل إلى منزل صديقه المصري الذي يملك دكان أقمشة. يرحب به الصديق ويسكنه في منزله. لكن الشاب المصري والشاب اللبناني يختلفان. الأول منفتح على العلاقات الجنسية مع أي فتاة يلتقي بها ولو أن قلبه يفوح حباً ببائعة لديها «كيوسك» في مقابل دكانه. حين يتعرّف اللبناني عليها يقعان في الحب، مما يغيظ صديقه المصري.
اللبناني الآن يريد العودة إلى لبنان التي تعاني من الحرب الأهلية في مطلع الثمانينات. إذ يفعل ذلك تنتهي الحكاية برسالة تصل بعض أشهر إلى الصديق من والد نديم يعلمه فيها بمقتل ابنه في تلك الأحداث.
هاتان الحكايتان هما الأقدر على ترجمة مكوّنات الفترة السياسية والاجتماعية مقارنة بالحكايتين الثالثة، التي تدور في سنة 2004 (فترة الرئيس حسني مبارك)، والرابعة التي تقع في فترة الرئيس الحالي (تبدأ في سنة 2012).
على هذا النحو، الفيلم هو بانوراما لتاريخ ولشخصية شعبان الذي ينطلق ولداً ويصبح شاباً ثم رجلاً وينتهي عجوزاً. ما لا يعمل بنفس الكفاءة أو حسب ما هو منشود حقيقة أن الفيلم لا يستطيع أن يكون من وجهة نظر الشخصية المحورية، وبذلك يفقد قدراً من ترابطه الدرامي المفترض.
مشكلة ثانية لا تقل أهمية، هي أن الحكايات المختارة ليست متساوية الأهمية، ولا تبعث على اهتمام متساوٍ يسودها جميعاً. الحكاية الأولى تمر سريعاً. الثانية هي الأكثر نبضاً واقعياً والأفضل في الدلالات المستوحاة. الثالثة تهبط في ركن منخفض من الأهمية، والرابعة تختم الحكايات بتقديم صاحب العمارة للمرّة الأولى (سمير صبري) الذي يجمع في منزله المشرف على المظاهرات فرق التصوير التلفزيونية ويتعرّف على فتاة شابّة تعتقد أن من تحب هو بين المتظاهرين لكن الحقيقة التي لا يستطيع كشفها لها أنه قُتل في المواجهات.
لكن الفيلم، وسط تفاوت مستويات الدراما، يحافظ على أسلوب عمل متقن في التفاصيل الشخصية وطموح لكي يعكس الفترات المتعاقبة من حياة مصر الحديثة عبر مراحلها ورؤساء جمهورياتها من الستينات وإلى مطلع حكم الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
أمر آخر أهم هو نجاح المخرج في إيصال نهاية كل حكاية إلى مفاد يعكس أحلاماً مجهضة. هي عاطفية في الحكايات الأولى والثانية والرابعة لكنها تعبّر جميعاً عن طموحات لبناء اجتماعي لا يجد المخرج أنه وقع على النحو المأمول. نهاية الحكاية الرابعة هي وحدها التي تحمل الأمل في قدرة مصر على تجاوز إحباطات المراحل السابقة.
Titane
> إخراج: جوليا دوكورناو
> فرنسا (2021)
> رعب | عروض: «كان» وتجارية
(وسط)
نتعرّف على أليكسيا في مطلع هذا الفيلم وهي تجلس في المقعد الخلفي من سيارة يقودها والدها. تصدر أصواتاً تزعجه. يطلب منها خفض الصوت لكنها تأبى وحين تنصاع بعد قليل تبدأ برفس المقعد الذي أمامها، يصرخ فيها والدها منشغلاً عن القيادة وسريعاً ما تستدير السيارة حول نفسها وتصطدم بجدار. المشهد التالي لها في المستشفى وقد تم زرع قطعة معدنية في رأسها الصغير الذي تعرض للعطب.
بالحكم على الفيلم عبر أحداثه اللاحقة يطرح الفيلم ذلك السؤال الذي لم تكترث المخرجة جوليا دوكورناو للإجابة عليه: هل نقرأ في طيات العمل نقداً موجهاً ضد العلم بمعنى أن ما يحدث لأليكسيا بعدما بلغت سنوات الأنوثة الكاملة هو بسبب تلك القطعة المزروعة في الدماغ؟ لا يمكن الوثوق بذلك لكن لا يمكن أيضاً التأكيد حتى مع وجود تشوّه فوق الأذن اليمنى يذكرنا دوماً بمشهد زرع القطعة في الرأس.
ما هو مؤكد أن الأحداث التي تسردها المخرجة جوليا دوكورنيو لا تحوي السبب الصحيح لتصرفات بطلتها بعدما بلغت أنوثة جاذبة تستخدمها لقتل ضحاياها من رجال ونساء. إنها قاتلة متسلسلة بلا رادع ولا واعز ولا سبب فعلي كذلك. الفيلم لا يحتوي على دوافع من أي نوع. لا دوافع اجتماعية ولا دوافع نفسية ولا عائلية. يقدّم الحالة ويعمل على تزويدها بحكاية تنتقل من مشهد عنيف إلى آخر.
تعمل أليكسيا (أغاثا روسيل) في نادٍ ليلي راقصة وتخرج منه لترتكب جريمتها الأولى، ويستمر منحاها على هذا النحو إلى أن تضطر لإخفاء هويتها فتدخل حماماً وتلف نفسها بقماشات لاصقة لإخفاء مكامن أنوثتها. لكنها حبلى في الوقت ذاته ولا نعلم (ولا هي تعلم) مِن مَن.
هنا تلفت اهتمام رجل متوسط العمر اسمه فنسان (فنسنت ليندون) يفتقد ابنه ويعتقد - لحين - أن أليكسيا هو إياه، أو يستطيع أن يحل مكانه. هذا لوحده غريب ويستمر على هذا النحو حتى من بعد أن عرف فنسان حقيقتها. هو الآن حريص على وهمه وسيساعدها على إخفاء هويتها. هذا السبب غير المقنع في تفاصيله ليس أغرب من كيف صاغت المخرجة علاقة أليكسيا بالسيارات. فحوى تلك العلاقة هو أنها تجد في السيارة عشقاً لا يُقاوم. السيارة هي الشيء الوحيد الذي تحب ولا تؤذي. الإيحاء أن الكائن الذين في بطنها هو نتيجة علاقة بينها وبين سيارة كلاسيكية كانت أوت إليها.
يذكّر فيلم دوكورنيو بأفلام لاري كووَن وديفيد كروننبيرغ. كووَن داوم أفلام الرعب البيولوجية (تلك التي تعتمد على خصائص جسدية متوحشة) وكروننبيرغ عمد إليها إلى حين قبل عزوفه عنها. لكن دوكورنيو ليست في مجال التقليد، بل تبتكر حالة ضوضاء وفوضى بصرية وأسلوبية تعمد من خلالها إلى تطويع المؤثرات البصرية المباشرة لخدمة مشاهد دموية فادحة.
تدفع المخرجة الفيلم ليكون متميّزاً بحكايته، خصوصاً عندما تربط مصير بطلتها بمصير رجل الإطفاء فنسان الذي يريد أن يتوهم بأن الفتاة هي ابنه أدريان ويقدّمه لرجال الإطفاء على هذا النحو. هناك ما يشي بأن فنسان مثلي (وهناك من رجال الإطفاء من يهمس لزميل له بذلك) لكن هذا المشوار من الأحداث شائك وغير مريح ليس بسبب الموقف الحاصل بالضرورة، بل أساساً في أن لا شيء ناضج يأتي من تلك العلاقة ولا هي منسابة أو موحى بها بطريقة فنية صحيحة.
حين نتحدّث عن الفن فإن الفيلم في نهاية مطافه عبارة عن فيلم رعب ينتمي إلى النوع (The Genres) أكثر من انتمائه إلى أي شيء آخر. وكلما حاولت المخرجة تمييزه فشلت بعد مشهد لاحق أو سواه في المحافظة على هذا التميّز، وفي النهاية تستولي شروط «الجنر» على شروط التميّز لتخلق فيلماً ناشزاً بالقصد وبالنتيجة.
هذا ما يجعله فيلماً بلا خريطة وصول إلى جمهور ما. في الواقع من المبهم ما جال في بال دوكورنيو وهي تكتب الفيلم وتحققه. يبدو الفيلم عالقاً بين الرعب الناتج عن التعذيب والألم والدموية (لا تخفي أليكسيا ساديّتها قبل قتل واحدة من ضحاياها) وبين الرغبة في تسجيل موقف تبقى صفحته داكنة بحيث لا يمكن قراءة كلماتها كونها داكنة أيضاً.