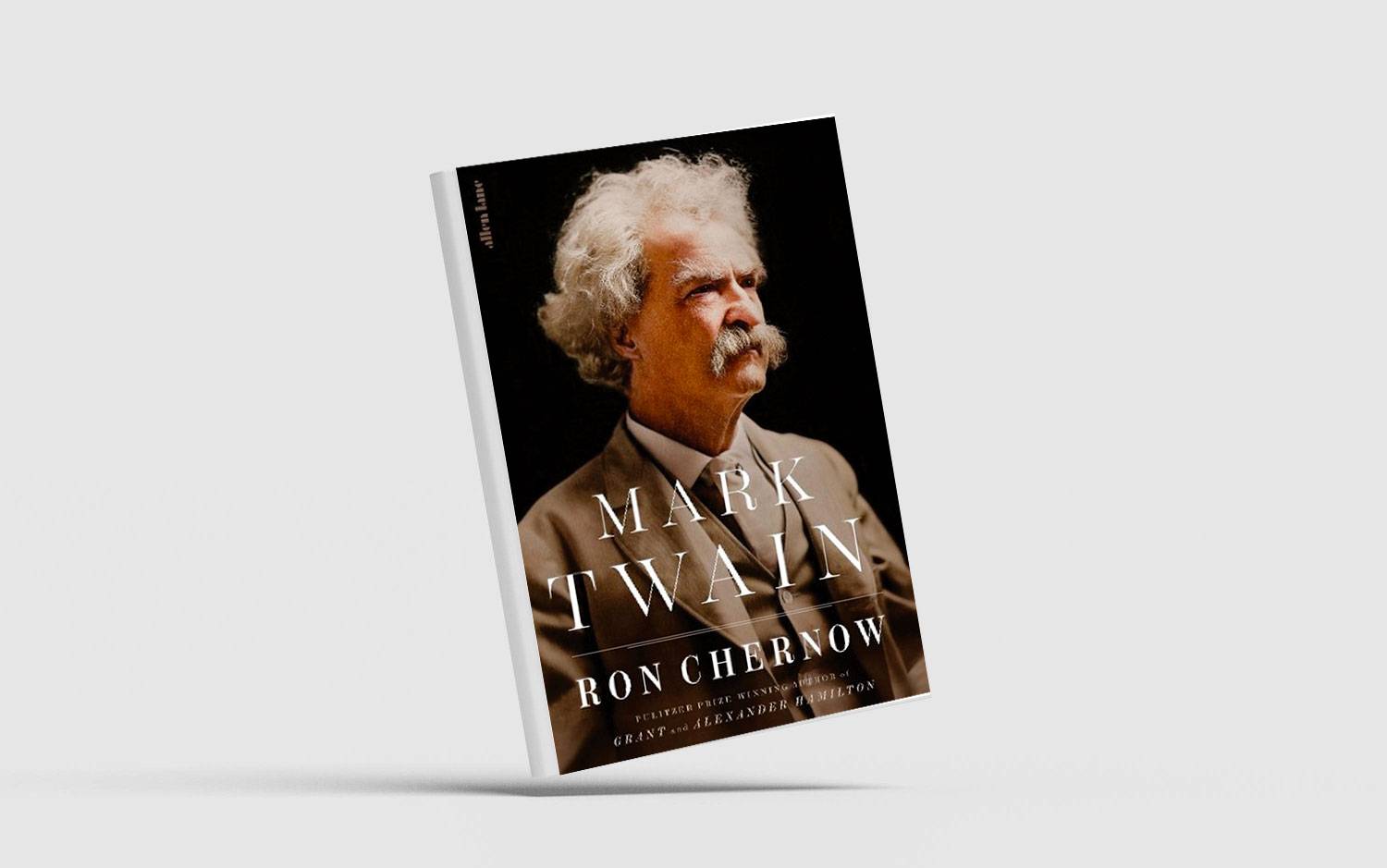لا يبدو الكاتب المصري محمد البرمي مشغولاً بتنويع أجواء مجموعته القصصية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، التي تحمل عنواناً لافتاً «للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق»، فمعظم نصوص الكتاب تحمل ملامح متشابهة لبطل واحد يدور حول نفسه على مدار 122 صفحة من القطع الصغير. تختلف بعض التفاصيل هنا أو هناك، لكننا نظل في النهاية إزاء شخصية مركزية يمكن رصد سماتها الأساسية عبر شاب في نهاية الثلاثين أو بدايات الأربعين، حساس، مثقف، يعاني من الإخفاق وعدم تحقيق ذاته مهنياً وعاطفياً ومادياً، ويقضى يومه وهو يحارب أشباح الوحدة والفراغ، فلا زوجة تؤنس وحدته أو حبيبة تطل عليه مثل نسمة في يوم قائظ.
مثل هذا الشاب من السهل للغاية أن يختلط في ذهنه الواقع بالخيال، والحقيقة بالوهم، كما يحدث في قصة «دون كيشوت على مقهى الحسين». في الحي التاريخي السياحي، يتعرف على شخصية غامضة تبدو خارجة للتوّ من كتب الأساطير؛ عجوز يحمل تمثالاً عبارة عن فارس يمتطي صهوة حمار وهو يشهر سيفه في مواجهة عدو خفي. يجسد التمثال شخصية الكاتب «دون كيشوت» الشهيرة التي ابتدعها الكاتب الإسباني ثيربانتس، وبات يُضرب بها المثل في العبثية واللاجدوى، بعد أن أخذت على عاتقها محاربة طواحين الهواء! تشده شخصية العجوز، فيسعى للتقرب منه، ودعوته إلى فنجان من القهوة. في البداية، يبدو العجوز متوجساً، لكنه في النهاية يقبل دعوته، وتنشأ الثقة بينهما، ثم يبدأ العجوز الغامض في بثّ رسائل أكثر غموضاً للصديق الشاب. يقول العجوز إنه لا ينتمي لشيء، ولا يمكن أن يكون جزءاً من نظام، حتى لو كان الترس الأهم كي يدور الكون من حوله، وكل محاولاته لأن يصبح جزءاً من شيء ذهبت هباءً منثوراً أو صارت كزبد البحر، لم تنفعه أو تضره. هو رجل له تصورات أخرى عن الوجود لا تشبه تلك الحكايات المعتادة، حين تضيق به الأرض يمنح نفسه للسماء، وحين يضج منها يمنح نفسه للبحر ليصبح وليمة لأعشابه، أو يمنح نفسه للأرض فيصبح طعاماً لديدانها. لا يخاف الموت، لكنه يطمع في البقاء أكبر قدر ممكن على قيد الحياة.
تتعدد اللقاءات بين الطرفين حتى يبثه العجوز رسالته الأخيرة: «لا مسافة بين الشيء واللاشيء، كلاهما يشبه النوم على مساحة أرفع من عمودك الفقري، إلى اليمين قليلاً ستسقط، وإلى اليسار قليلاً ستسقط، أما البقاء كما أنت فيضمن لك السلامة». تزيد الرسائل المحملة بالألم من ارتباك البطل، لكنه يوقن تماماً أن عليه تغيير خط سيره نهائياً ليهرب من مصير دون كيشوت!
يبدو البطل في معظم القصص شديد الارتباط بمنطقة «وسط البلد» بالقاهرة، فهو يحبها «بنسماتها وضجيجها وعلاقاتها المتشابكة وشجار الأصدقاء والضوضاء القادمة من السيارات والباعة الجائلين»، على حد وصفه في قصة «روف جهنم»، لكنه حين يجر خطواته بتثاقل نحو مقر العمل في قصة «رجل تافه وامرأة تائهة» لا يجد جديداً؛ كل شيء عادي؛ الضحكات البلاستيكية التي يوزعها كل يوم على زملائه، الجاكت الأسود الثقيل الذي يرتديه كلما بدا اليوم ممطراً، الغضب المكتوم بداخله بسبب أدائه لوظيفة لا يحبها. ويضاعف من حزنه في ذلك الغروب الشتوي الملبد بالغيوم أن حبيبته تزوجت، وكان عرسها بالأمس. في غمرة الإحباط، يترك نفسه تنداح كما تشاء، وفي المترو يتعرف على فتاة ثلاثينية.
يتبادلان أرقام الهواتف، لكنه سرعان ما ينسى الأمر، ويفاجأ باتصال منها في المساء، تخبره فيه أنها تود أن يلتقيا. يلبي طلبها، وفي الطريق إلى أحد المطاعم، توجز له قصتها، فهي أرملة توفي زوجها تاركاً لها طفلين تعيلهما بلا مورد سوى مبلغ شهري تحصل عليه بانتظام من عمتها التي تقيم بالقاهرة. تبحث عن الحب، وتأمل أن يكون هو الفارس الموعود، لكنه في نهاية السهرة يشعر بتأنيب الضمير، فهو لا يريد إعطاءها مزيداً من الآمال الكاذبة، فيتحجج لها بأعذار واهية، ويتركها فريسة الحزن والإحباط.
هذا الإحساس العارم بالأسى كثيراً ما يكتسب حساً وجودياً مفعماً بالاغتراب في كثير من قصص المجموعة البالغ عددها 24 قصة. ففي القصة التي تحمل عنوان الكتاب نفسه ثمة مقهى فارغ إلا من 3 شخوص؛ الراوي، ورجل، وامرأة، تلامس الوحدة أطراف أصابعهما. لا أحد يضحك، لا صوت يخرج. يراقب البطل الرجل والمرأة؛ حيث تتباعد المسافات بينهما، حين تعود إليهما الحياة، يأخذ كل منهما وضع القرفصاء، ثم يدفن ذراعيه كسلحفاة محتضناً وحدته وخوفه وقلقه. كمن يتعلق بقشة أخيرة، ينادي البطل عامل المقهى، لكن صوته لا يخرج هو الآخر، ينكمش في داخله، يخرج منه شيء كالبكاء. وتظهر في هذا التوقيت فتاة جميلة حقاً، تقلب أوراقه، لكنها لا تراه أو تلمسه. من بعيد، يظهر رجل مبتهج يناديها بقوة؛ هيا يا عزيزتي، فيخرجان معاً متشابكي الأيدي، ليبقى البطل وحيداً منكمشاً داخل قضبان المقهى يحاصره الأوغاد وقطاع الطرق!
وتحت عنوان «أيام الكورنتينا» التي تضم عدداً من النصوص القصيرة جداً، يقدم المؤلف ما يشبه اعترافاً للقارئ، قائلاً: «لأكن صادقاً، هذه الأقاصيص كتبتها على فترات متباعدة عن مشاعري وأفراحي وأحزاني، وبعضها كان سيصبح مشروعاً بالفعل، أم البعض الآخر فكان محض مشاعر فقط؛ محبة وخذلان ويأس وخوف من الموت والغربة والوحدة وشبح (كورونا). لماذا جمعتها؟ كنت أخشى أن أموت في فترة الرعب التي اجتاحت العالم بسبب الجائحة، وكنت أريد أن أترك إرثاً من بعض مشاعري دون خجل أو مواربة. وحين منحني الله العمر، وأكملت تلك المجموعة القصصية، آثرت ألا أحذف تلك الأقاصيص، وأبقى عليها كذكرى من لحم ودم برائحة الموت».
بالطبع، كان يمكن لمحمد البرمي أن يتجاهل مثل هذا «الاعتراف» أو «التقديم»، لكنه آثر الصدق مع قارئه، وهو ما يحسب له. جاءت بعض هذه النصوص القصيرة موفقة في حبكتها وعالمها، كما في قصة «علاج للحنين». أما بعضها الآخر، فجاء أقرب إلى الخواطر والتأملات ذات التعبير المباشر والنبرة التقريرية، كما في قصة «انسحاب». لكن يبقى للمجموعة أنها رسمت مرثية شجية للإنسان المحبط في عالم محاط بالأوبئة والكوارث.
12:57 دقيقه
الفراغ والوحدة و«كورونا» في مجموعة قصصية
https://aawsat.com/home/article/3319531/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D8%A9



الفراغ والوحدة و«كورونا» في مجموعة قصصية
محمد البرمي يكتب مرثية لـ«المحبين والأوغاد وقطاع الطرق»

- القاهرة: رشا أحمد
- القاهرة: رشا أحمد

الفراغ والوحدة و«كورونا» في مجموعة قصصية

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة