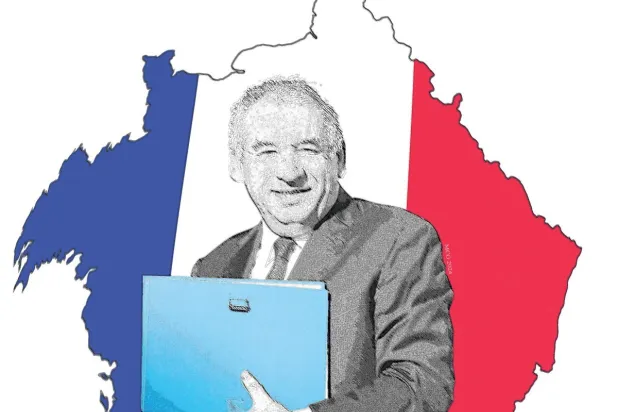مع وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي في ربيع عام 2017، حاول الرئيس الشاب المنتخب، غرس صورة جديدة في أذهان مواطنيه بالإيحاء أن «زمناً جديداً» بدأ مع تسلمه مسؤوليات الحكم... وهو يحل محل «الزمن القديم».
كان ماكرون يعني بذلك أن البنى السياسية التقليدية التي هيمنت على المشهد السياسي في فرنسا، أقله منذ تأسيس «الجمهورية الخامسة» على يدي الرئيس الجنرال شارل ديغول بنهاية خمسينات القرن الماضي، ولّت إلى غير رجعة. وأن انتخابه بعيداً عن المجموعتين التقليديتين الرئيسيتين، وهما: من جهة، اليمين الكلاسيكي الممثل راهناً بحزب «الجمهوريون»، واليسار الاشتراكي من جهة أخرى، أفضل دليل على ذلك. ومنذ اليوم الأول، سعى ماكرون للجمع بين شخصيات يمينية وأخرى يسارية في حكوماته المتعاقبة. وهذا واضح أيضاً في الحكومة الراهنة التي أوكل رئاستها إلى جان كاستيكس، اليميني الانتماء، الذي شغل سابقاً منصب مساعد أمين عام قصر الإليزيه زمن الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي. ويمسك اليمين اليوم بما لا يقل عن ثماني وزارات، أهمها وزارات الاقتصاد والمال والداخلية. الأولى، أعطيت لبرونو لومير، والأخرى لجيرالد دارمانان. وفي المقابل، فإن اليسار الاشتراكي يشغل عدداً مماثلاً من الحقائب، وثمة وجهان يساريان بارزان في الحكومة الراهنة، هما وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزيرة الدفاع فلورانس بارلي. لكن الصبغة العامة، أن هذه الوزارة كما سابقاتها تميل يميناً. وإلى جانب اليمين واليسار هناك شخصيات لم تكن ناشطة في الحقل السياسي، مثل وزير العدل أريك دوبون ــ موريتي، وهو محامٍ لامع. وأخرى جاءت من صفوف المجتمع المدني «المحايد». إلا أن الأهم، أن كل الوزراء انقطعوا عن انتماءاتهم وهوياتهم السابقة وأصبحوا «ماكرونيين» وإن لم ينتموا بالضرورة، عقب دخولهم جنة الوزارة، إلى حزب «الجمهورية إلى الأمام» أي الحزب الرئاسي.
يرى كثيرون في فرنسا وخارجها أن الفلسفة «الماكرونية» تعني أن «الزمن الجديد» تخطى اليمين واليسار، وتجسّد في العمل مع شخصيات متنوعة الآفاق «تصهرها» البوتقة الرئاسية ولخدمة البرنامج الرئاسي الذي أوصل إيمانويل ماكرون إلى سدة الحكم. لكنها أيضاً تستهدف تهميش الأحزاب التقليدية وإيجاد فرز جديد للمشهد السياسي الفرنسي شرحه ماكرون، وقوامه فرز الأحزاب إلى مجموعتين: من جهة، «التقدميون»، أي ماكرون ومن يريد العمل إلى جانبه... مقابل الشطر الآخر الذي سمّاه «القوميون» المتطرفون وتجسيده «التجمع الوطني» الذي ترأسه مارين لوبن، منافسة ماكرون في انتخابات عام 2017 والساعية للحلول محله في العام 2022.
كانت هذه الصورة هي الرائجة والمقبولة عموماً حتى 20 يونيو (حزيران) الماضي، موعد الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية الفرنسية. إلا أن الأمور انقلبت راساً على عقب. لقد كانت استطلاعات الرأي المتلاحقة ترجّح أن تكون رئاسيات العام المقبل استعادة لنسخة عام 2017، بحيث يتأهل للجولة الرئاسية الثانية ماكرون ولوبن في حين يخرج من السباق، مرشحو اليمين واليسار الاشتراكي و«الخضر» واليسار المتشدد ممثلاً برئيس حزب «فرنسا المتمردة» جان لوك ميلونشون.
- ضحية مقاطعة الانتخابات
حتى اليوم، ما زال متابعو الشأن السياسي الداخلي في فرنسا يجمعون على اعتبار أن المنافس «الأمثل» لماكرون هي لوبن، رغم أن الأخيرة تسبقه أحياناً في استطلاعات الرأي... وأحياناً العكس. وكان المرجح جداً، حتى الاستحقاق الأخير، أنهما سيتواجهان مجدداً، وأن ماكرون سيتغلب، للمرة الثانية، على لوبن انطلاقاً من الاعتقاد السائد أن الناخبين الفرنسيين ليسوا مستعدّين بعد لتقبّل تسليم قيادة فرنسا لشخصية تأتي من اليمين المتطرف... رغم الجهود التي بذلتها لوبن في السنوات الماضية لتقدم نفسها على أنها «معتدلة». والدليل على ذلك أن دارمانان، وزير الداخلية - وهو يميني متشدد ومدافع شرس عن العلمانية ومحاربة «الانفصالية الإسلاموية» -، تهكّم على لوبن خلال مناظرة تلفزيونية شهيرة أجريت الشهر الماضي حين عاب عليها أنها تخلّت عن آرائها وآيديولوجيتها السابقة. وخلال الأيام الأخيرة، انسحبت مجموعة من كوادر «التجمع الوطني» (حزب لوبن)؛ لأنها ما عادت تعتبر أن الحزب اليميني المتطرف يمثلها أو يحمل طموحاتها ويدافع عن قناعاتها. كذلك، فإن المنظّر السياسي والصحافي أريك زيمور، الذي كان من أشد أنصار لوبن والمدافعين عن آرائها في السنوات الأخيرة، يخطط الآن لمنافستها على الفوز بأصوات اليمين المتشدد، وهذا الأمر من شأنه إضعافها، لكنه لا يخدم مصالح ماكرون؛ إذ إن تراجع لوبن يمكن أن يسهّل مهمة وصول مرشح يميني كلاسيكي إلى الدورة الثانية، وهو ما لا يتمناه الرئيس الحالي.
كانت هذه القراءة صالحة حتى الانتخابات الأخيرة بجولتيها التي هزّت، إلى حد بعيد، الصورة السابقة. ذلك أن النتائج التي أسفرت عنها بيّنت أن هناك ثلاثة خاسرين، هم على التوالي: الديمقراطية الفرنسية بسبب النسبة العالية من التغيب عن التصويت، والرئيس ماكرون، ولوبن بسبب النتائج الكارثية التي حصدها حزباهما «الجمهورية إلى الأمام» و«التجمع الوطني»... وإن كانت الظاهرة الأبرز قد تمثّلت بعودة «الزمن القديم» إلى الحياة.
الضحية الأولى بالطبع هي الديمقراطية الفرنسية. فنسبة المقاطعة جاوزت في الدورة الأولى الـ67 في المائة. ولم تجد النداءات التي أطلقها قادة الأحزاب والمسؤولون السياسيون الفرنسيون لتحفيز الـ48 مليون ناخب للمشاركة في الجولة الثانية. وجُلّ ما حصل عليه هؤلاء جاء مخيباً للآمال؛ إذ إن نسبة أقل من واحد في المائة إضافية أصغت لنداءات الاستغاثة وارتادت مراكز الاقتراع، بحيث بقي الامتناع عن التصويت أكثر من 65 في المائة؛ الأمر الذي لم تعرفه أبداً الانتخابات المماثلة في السابق. وكما بعد الجولة الأولى، تبارى السياسيون والمحللون في تفسير أسباب الحب المفقود بين الناخب وصندوق الاقتراع.
منهم من رأى فيه أزمة الديمقراطية وتشويها لمعناها، وهذا واضح ولا يحتاج لشروح؛ إذ من غير الطبيعي أن تحصل انتخابات من غير ناخبين. وذهبت فئة أخرى لاعتبار أن ما حصل ليس أقل من أزمة نظام، في حين سعى المتفائلون لتبرير التغيب بالإشارة إلى تبعات جائحة «كوفيد - 19» وتحوّراتها وتدابير التباعد الاجتماعي ورغبة المواطنين الاستفادة من نهاية أسبوع بعد تدابير الحجر التي أنهكتهم طيلة أشهر طويلة. وبعضهم أرجع هذه الظاهرة إلى ملل المواطنين وتشكيكهم في البرامج المطروحة واعتبار أن حياتهم اليومية لن تتغير مهما كانت هوية اللوائح الفائزة.
وأما التفسير الأخير، فعنوانه أن نسبة كبيرة من المواطنين لا تعي أهمية الانتخابات الإقليمية ولا تفقه صلاحيات مجالس المناطق وانعكاساتها على الحياة اليومية للمواطن، وبالتالي فإن اهتمامها ينصب بالدرجة الأولى على ثلاثة استحقاقات رئيسية: الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية. والخلاصة الطاغية، أن نسبة المشاركة المتدنية تمنع من استخلاص النتائج المتسرعة مما أفرزته الدورتان الأولى والثانية.
- ضعف الحزب الرئاسي
لا شك أنه يتعين أخذ هذه التحفظات بعين الاعتبار. لكن ثمة علامات بارزة لا يمكن القفز فوقها لما تحمله من دلالات ستكون لها تبعاتها في الاستحقاقات المقبلة. وخلال الأيام المنقضية منذ الدورة الثانية، أي منذ 27 يونيو، جرى التركيز على الضعف البنيوي لحزب «الجمهورية إلى الأمام» الرئاسي الذي لم ينجح في تخطي نسبة الـ7 في المائة من الناخبين. وهذه النسبة تُعد الأسوأ لحزب يمارس السلطة ويتمتع بأكثرية نيابية مريحة منذ عام 2017، ولا يمكن القول إن ماكرون لم يبد اهتماماً بهذا الاستحقاق، لا، بل إن كل المؤشرات كانت تدل على أنه انغمس فيها «حتى العظم» وعمد إلى تعبئة وزرائه لإحراز نجاحات تحسب له ولحزبه، ويكون لها مردودها الانتخابي لدى الاستحقاق الرئاسي. وهكذا، أرسل ماكرون 15 وزيراً من حكومته للمشاركة في هذه الانتخابات، آملاً أن يحقق أحد الهدفين التاليين أو كليهما معاً: إما الفوز بإدارة أحد الأقاليم الـ13 التي تتشكّل منها فرنسا القارية و(أو) أن تحتل لوائحه - على الأقل - موقعاً يجعله مؤثراً في ضمان الفوز للفريق الذي يتناغم معه. وفي هذه الحال، يمكن أن يأمل بأن يرد له الجميل في الانتخابات الرئاسية. والحال، أن لوائح «فرنسا إلى الأمام» لم تنجح في الفوز بأي إقليم من الأقاليم، لا، بل إن العديد من مرشحيها إما أخرج بعد الجولة الأول لأنه لم يحصل على نسبة 10 في المائة الضرورية للاستمرار في المنافسة أو احتل، في الجولة الثانية، المراتب الأخيرة.
قيل الكثير في تفسير النكسة الرئاسية الانتخابية. ويقول التفسير الأول، إن حزب ماكرون حديث العهد مقارنة بأحزاب اليمين واليسار، وبالتالي فإن انغراسه المحلي والشعبي ما زال ضعيفاً. ويقول التفسير الثاني، إنه من الخطأ استخلاص نتائج متسرّعة من انتخابات محلية ــ إقليمية وتعميمها على انتخابات «وطنية» مثل انتخابات رئاسة الجمهورية، واعتبار أن نتائج الأحد الماضي ستنسف حظوظ الرئيس الفرنسي في البقاء لولاية ثانية في قصر الإليزيه. ويلجأ أصحاب هذا القول إلى الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي التي نشرت يوم الجولة الثانية بيّنت أن ماكرون مستمر في تصدّر لائحة المرشحين الرئاسيين مع لوبن بحيث حصل كل منهما على 24 في المائة من الأصوات. كذلك، تفيد استطلاعات الراي الأخرى، أن شعبية ماكرون إلى ارتفاع والسبب الرئيس في ذلك إدارته لجائحة «كوفيد - 19» ورهاناته الصائبة التي مكّنت البلاد من أن تعود إلى الحياة الطبيعية الكاملة بدءاً من الخميس الماضي بفضل تراجع الإصابات والحالات المستعصية.
ومن جانبه، شدد ماكرون، أكثر من مرة، في الأيام السبعة الماضية، على التمييز بين ما هو محلي وما هو عام، لا، بل أكد أنه لن يحدث تغييرات جذرية في تشكيلة حكومته التي سترافقه حتى الانتخابات الرئاسية، وسيبقي كاستيكس على رأسها. ويتركّز الجدل داخل الحزب الرئاسي على الحاجة إلى تغيير أمين عام الحزب النائب ستانيسلاس غيريني، الذي يعاني من حضور شاحب إعلامياً وسياسياً ومن إخفاقه في تحويل «الجمهورية إلى الأمام» إلى حزب شعبي يتمتع بجمهور قوي وقادر على توفير الدعم للمشروع الرئاسي.
ثمة تقبّل عام لهذه الصورة المرسومة. بيد أن الأهم موجود في مكان آخر. فمع ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة، طفا إلى السطح «الزمن القديم» الذي أراد ماكرون وأده، وعادت الأحزاب التقليدية القديمة إلى الواجهة. إذ اكتسح اليمين الكلاسيكي واليسار الاشتراكي المتحالف مع «الخضر» أحياناً والمنفصل عنهم أحياناً أخرى، المشهد السياسي.
اليمين حافظ على الأقاليم السبعة التي يديرها، بينما أبقى اليسار الاشتراكي هيمنته على الأقاليم الخمسة التي يسيطر عليها منذ عام 2015، بل وكسب إقليماً إضافياً من المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار. وهكذا تبيّن الخريطة السياسية وجود لونين فقط: الأزرق والأحمر (أو الوردي). الأول لليمين والآخر لليسار. وعليه، عادت الحياة تدبّ في شرايين اليمين واليسار على السواء، وبرز «الخضر» كقوة يجب أخذها بعين الاعتبار... وعاد الأمل إلى هذه الأحزاب التي لم تعد ترى أن ثنائية ماكرون - لوبن قدر محتوم. ومن هنا قلق الطرفين معاً.