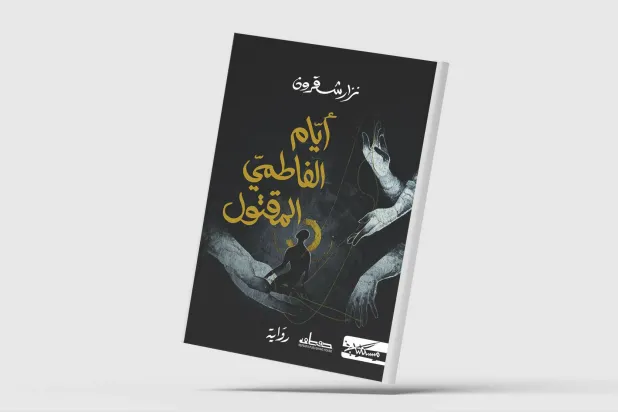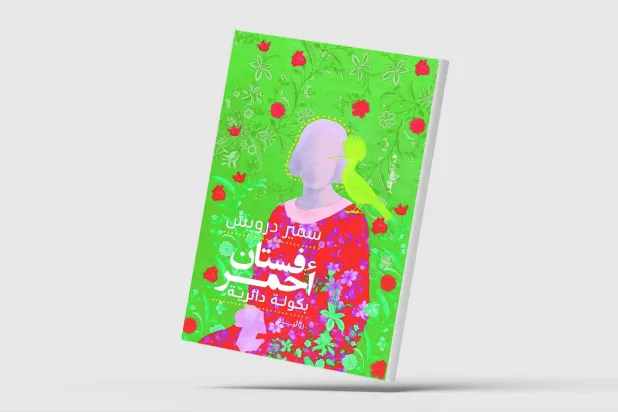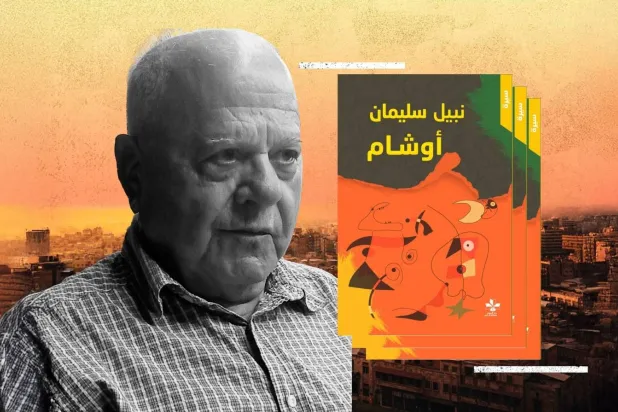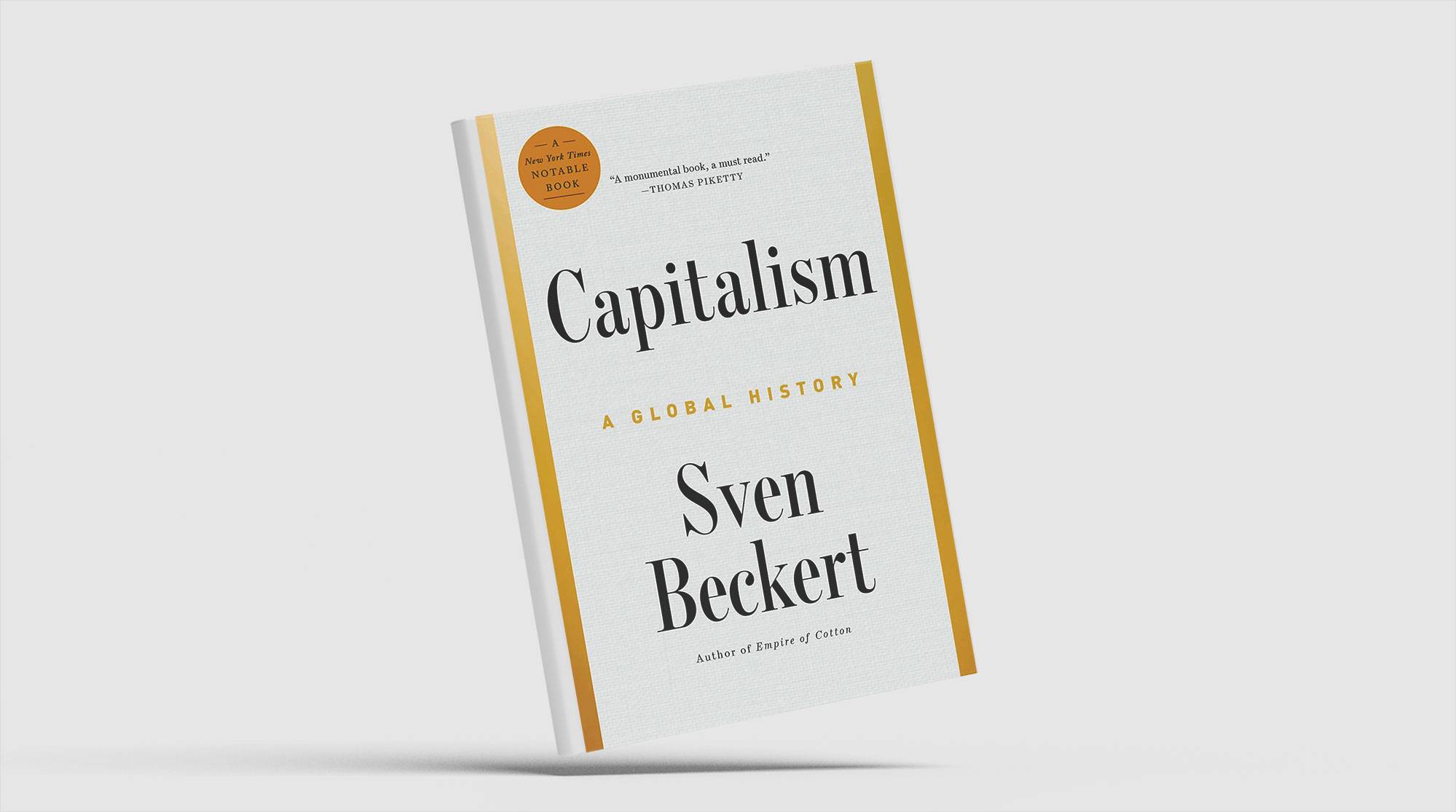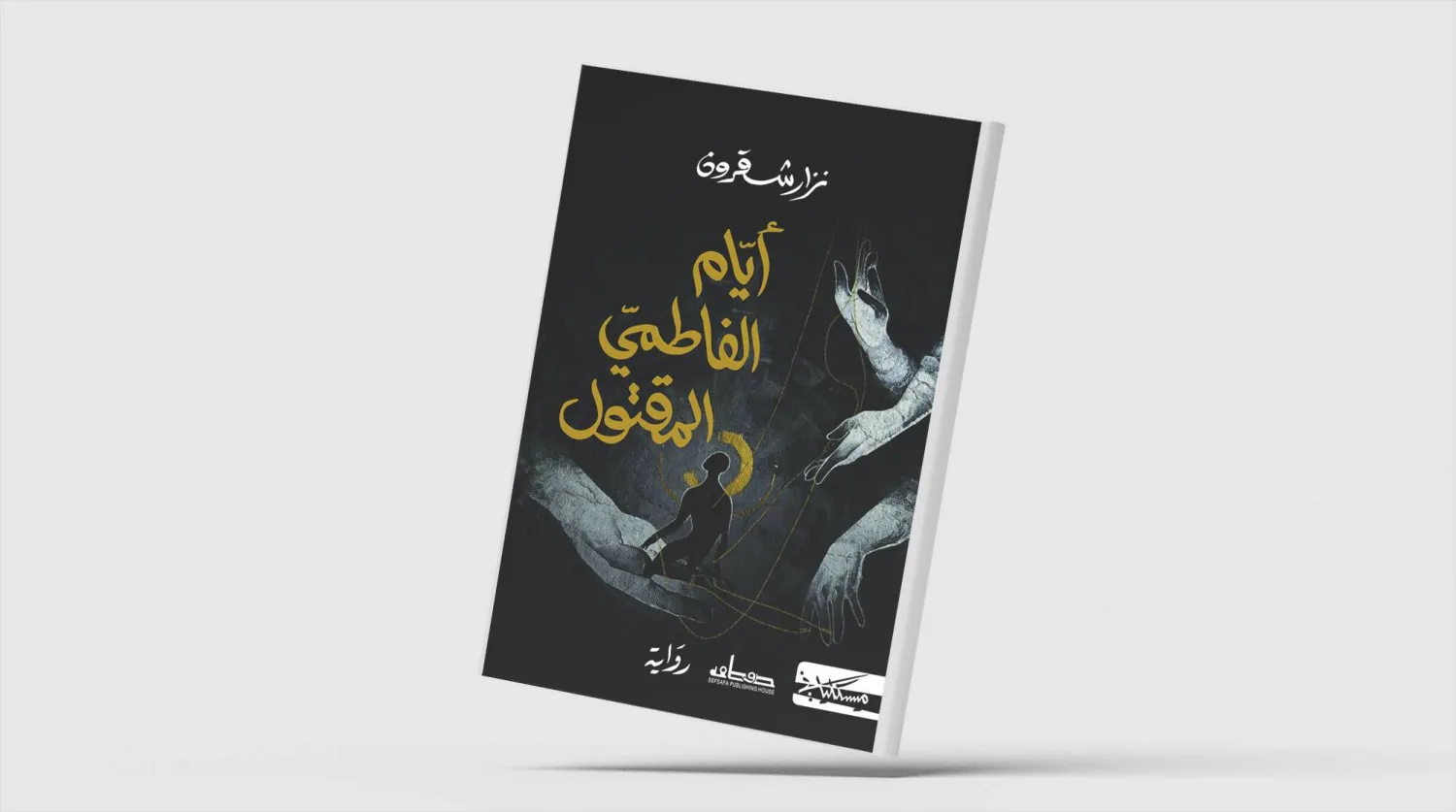تركت مدينة الرياض التي كانت تعرف قديماً بـ«حجر اليمامة»، إرثاً تاريخياً حضارياً موغلاً في القدم، وشهدت المدينة على مر تاريخها أحداثاً وتغيرات، وحملت مسميات أخرى، لكنها بقيت في المكان ذاته تحكي تاريخاً من آلاف السنين مليئاً بالأحداث لواحدة من أقدم المستوطنات البشرية في الجزيرة العربية، تعاقبت على أرضها حضارات وفي أزقتها وأحيائها المتعددة وعلى ضفاف واديها الشهير «حنيفة» خرج المشاهير الذين كان لهم اسم في سجل التاريخ، كما سجلت المدينة مفارقات عجيبة من خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة قبل الإسلام وما بعده، إلى اتخاذها عاصمة للدولة السعودية الثالثة.
عن هذه المدينة التاريخية، قدّم كرسي التراث الحضاري في السعودية، للمكتبة العربية ولقارئ التاريخ إصداراً عن الرياض دعمه ورعاه رجل الأعمال السعودي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، يعد أحدث ما يمكن أن يُكتب عن الرياض بشكل شامل ومختصر منذ نشأتها إلى اليوم على مر العصور، وجمع مادته كل من الدكتور عبد الناصر الزهراني، والدكتور محمد أبو الفتوح غنيم، والدكتور محمد إسماعيل أبو العطا.
واعتبر المهندس المعجل، أن «الكتاب بقدر ما يفتح لدى القارئ آفاقاً من الدهشة والفضول بخصوص هذه المدينة وتاريخها، فهو استنهاض لهمم الباحثين بإكمال ما جاء فيه من خلال النقد والتدقيق والمراجعة والتمحيص».
بداية، يشير الإصدار إلى مكان الرياض الضارب بجذوره في أعماق التاريخ وإلى حداثة اسمها، حيث لم يكن اسم الرياض مستخدماً قبل القرن السابع عشر الميلادي، مبرزاً أن الرياض كانت موطناً لكثير من أعلام التاريخ، فعلى أرضها عاشت أشهر امرأة عُرف عنها حدة البصر وهي «زرقاء اليمامة»، كما أن في أحد أحيائها الحالية وهو حي منفوحة، التي كانت قرية مجاورة للرياض عاش وصال وجال ومات ودفن أحد شعراء العربية الكبار أصحاب المعلقات الأعشى (ميمون بن قيس)، كما كانت الرياض في صدر الإسلام موطناً لبعض صحابة رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم. ولفت الإصدار في هذا الصدد إلى أن بعضاً من أحياء الرياض الحالية (كأرض الفوارة في حي الفاخرية الحالي) كانت أرضاً منحها الرسول لبعض الصحابة. ويكشف الكتاب عن مفارقات التاريخ في هذه المدينة من خلال مشاركة أهل الرياض في حروب الردة مع مسيلمة بن حبيب الحنفي، وضده، كما أن المدينة، عاصمة المملكة اليوم، كانت من أكثر المدن مقاومة للدولة السعودية الناشئة في طورها الأول، واستعصت على عاصمتها الدرعية ولم تخضع لها إلا بعد حروب دامت ما يقارب ثلاثة عقود، نتيجة قوة أهلها وتحصينها، وبعد نهاية أيام الدولة السعودية الأولى ودمار الدرعية، التي لم تعد تصلح مقراً للحكم.
وقع اختيار مؤسس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبد الله على الرياض لتكون مقراً لحكمه وعاصمة لدولته، كما كانت الرياض البداية الفعلية في عهد الدولة السعودية الثانية، وكان سقوطها في أيدي آل رشيد إيذاناً بنهاية تلك الدولة، لتأخذ الرياض مكانتها كمقر للحكم السعودي في الفترة الثالثة بعد استعادة الملك عبد العزيز لها في رحلة طويلة لتوحيد الدولة الجديدة وإعلان قيامها عام 1932 لتبدأ رحلة النمو والتطور خلال عهد سبع ملوك في إرجاء البلاد.
رصد الإصدار في سبعة فصول تاريخ المدينة، ففي الفصل الأول أبرز محاور عن: أصل مدينة الرياض التي قامت على أنقاض مدينة حَجْر، مركز إقليم اليمامة وساكنيها قديماً ونزول بني حنيفة فيها، وواقع الرياض في صدر الإسلام وحروب الردة وفتح اليمامة، ثم اليمامة في عهد الخلفاء الراشدين، واختفاء مسمى حَجْر وظهور اسم الرياض، ووضعها في الدولة السعودية الأولى والثانية، ثم غزو محمد بن رشيد لها، إلى استعادة الملك عبد العزيز للرياض وقيام الدولة السعودية الثالثة وجعلها عاصمة لها.
وتناول الفصل الثاني من الإصدار أسوار وبوابات الرياض وأبراجها التي كانت حاضرة في بناء المدينة، وعاملاً مهماً في تخطيط المدن في العصور القديمة كعناصر أمنية لحمايتها وتتبع الإصدار الأسوار التي كانت محاطة بالرياض وبنيت على مر العصور: العصر الجاهلي والأموي عندما كانت الرياض تعرف باسم حَجْر، ثم أيام مدن مقرن ومعكال، ثم في فترة حكم دهام بن دواس، ثم في عهد الملك عبد العزيز بعد استرداده لها، ونظراً لاختفاء السور تماماً في الوقت الحالي بسبب إزالته قبل أكثر من سبعين عاماً؛ تماشياً مع متطلبات توسع المدينة وامتدادها.
واعتمد المؤلفون في تناول وصف أسوار المدينة على ما كتبه المؤرخون والرحالة القدماء، كما ذكر الإصدار الأبراج المحيطة بالرياض التي بلغت 21 برجاً، توزعت في أنحاء السور كافة، ومن أشهرها: برج الذلّان والواقع جنوب شارع السبالة حالياً، وبرج العصافير الذي لا يعرف موقعه بالتحديد، لكن تم التأكد بأن أهل معكال قد شيدوه، وبرج منفوحة، كما رصد الإصدار بوابات الرياض التي حددها بلجريف في وصفه ورسمه خريطة الرياض وبواباتها في عهد الإمام فيصل بن تركي بـ12 بوابة، وأشهرها بوابة الثميري، والبوابة الرئيسية في السور الجنوبي للمدينة وهي «دروازة دخنة» التي تعد أكبر بوابات السور وعرفت باسم الدروازة الكبيرة وبوابة نقبة مصدة ودروازة المريقب في الشميسي ودروازة البديعة التي عرفت باسم المذبح؛ نظراً لأن الجزارين كانوا يذبحون ذبائحهم خارج الرياض في هذه الناحية.
وتناول الفصل الثالث أحياء وشوارع الرياض ومسمياتها، في حين عدد الفصل الرابع مساجد الرياض القديمة، كما خصص الفصل الخامس للحديث عن قصور الرياض وأنماط المباني فيها، كما تحدث الفصل السادس عن متاحف الرياض الرسمية والخاصة، وخصص الفصل السابع كيفية الحفاظ على المعالم التراثية في مدينة الرياض.
10:2 دقيقه
«حجر اليمامة»... مدينة الإرث التاريخي والحضاري والمفارقات العجيبة
https://aawsat.com/home/article/2893406/%C2%AB%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9%C2%BB-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%A9



«حجر اليمامة»... مدينة الإرث التاريخي والحضاري والمفارقات العجيبة
الرياض التي تغيّر اسمها بعد القرن السابع عشر الميلادي

- الرياض: بدر الخريف
- الرياض: بدر الخريف

«حجر اليمامة»... مدينة الإرث التاريخي والحضاري والمفارقات العجيبة

مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة