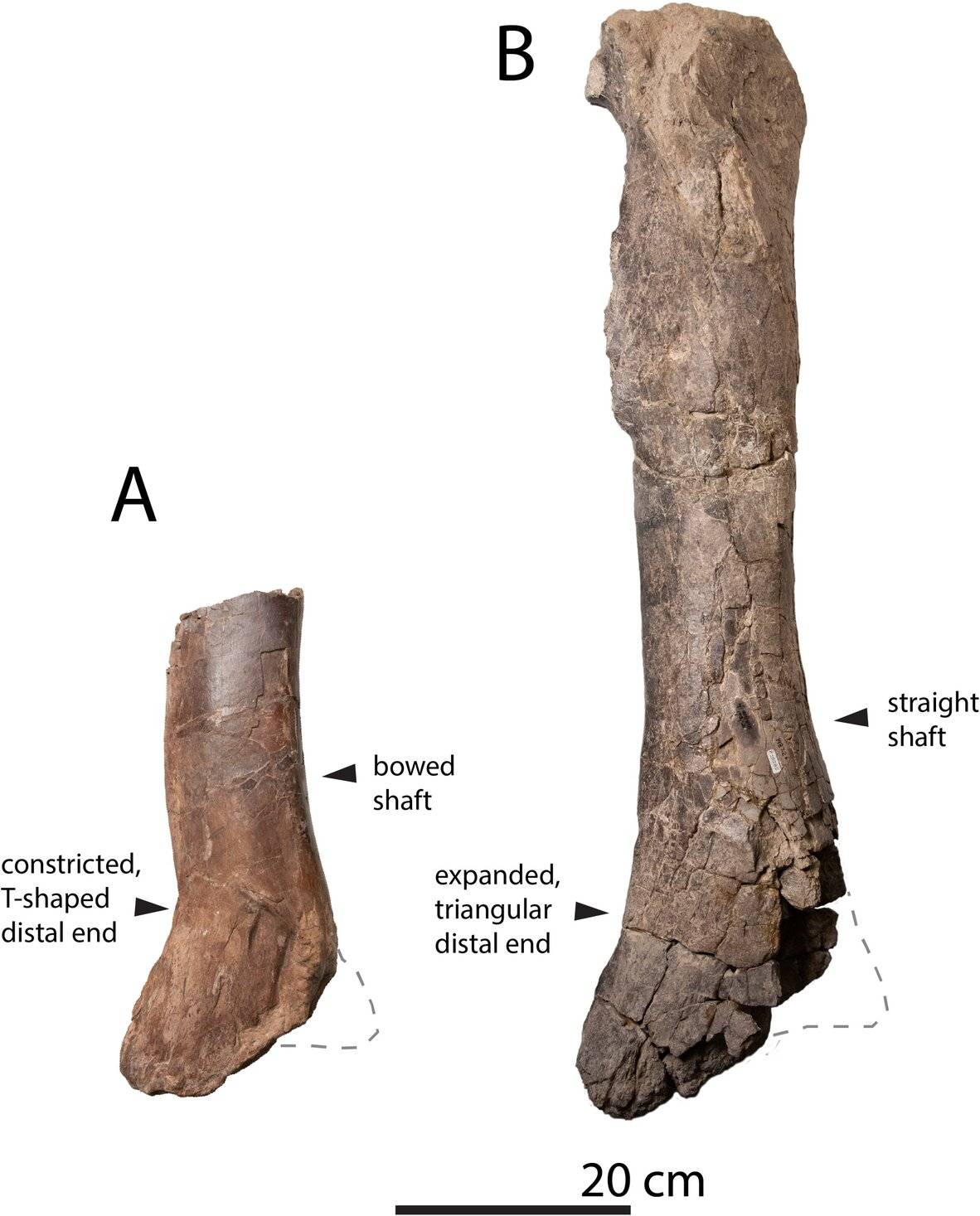لم تكن الحياة على الأرض مأهولة دائماً بالرخاء أو معبّدة بالورود. إذ يكفي أن نعود إلى كتب التاريخ لكي تتكشف لنا مستويات متباينة من الكوارث المفجعة التي عصفت بالكوكب، والتي تتراوح في هولها بين الانقراض شبه الكامل للكائنات الحية، كما في حالة الطوفان، وبين عدد لا يحصى من الزلازل والبراكين والأوبئة التي دمرت كثيراً من المدن والدساكر وأزهقت أرواح ملايين من البشر. وما عجزت الطبيعة عن تحقيقه، تكفّل به سدنة الأرض والممسكون بناصيتها، ممن لم يتوقفوا عن شنّ الحروب وتلويث البيئة وارتكاب الفظاعات وزهْق الأرواح، تحت شعارات «خلبية» مختلفة، يلبس فيها الجشع لبوس العقيدة، وتتلطى العنصرية خلف اللافتات الوطنية والقومية، وتتراشق فيها الأطراف المتقاتلة بكل أنواع الميثولوجيا والغيبيات والشعارات الطائفية والمذهبية الزائفة.
ومع أن «كوفيد 19» لم يكن ضيفاً جديداً وفريداً من نوعه على هذه الكرة، التي اعتادت أن تواجه كل 100 عام تقريباً جائحة مماثلة تتبدل أشكالها ومسمياتها بتبدل العصور والظروف المناخية، فإن البشر الميالين إلى النسيان أو التناسي، يتعاملون مع أحداث التاريخ وكأنها مجرد أساطير متصلة بعصور ما قبل الحداثة، ولن يكون لها بالتالي سبيل إلى التجدد والانبعاث. صحيح أنه لم يمر أكثر من قرن واحد على وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي قضى على عشرات الملايين من سكان الكوكب الأرضي آنذاك، لكن الحدث على فداحته قد نُسي تماماً، أو هو انتقل إلى عهدة الروايات وحكايا الجدات والأخبار القديمة المتناقلة، خاصة أن أحداً من الأجيال المتأخرة لم تتح له بشكل مباشر معاينة ما حدث.
والحقيقة أن الأمر قد احتاج إلى أسابيع وشهور عدة لكي نستطيع، نحن السادرين في حمأة العيش وفوضاه، أن نتحقق من هول الصدمة، ومن حجم هذا الزلزال المباغت الذي ضرب الحياة في أوجها. ففي ظل الارتفاع المطرد لمنسوب التنابذ القومي والعنصري بين البشر، واستشراء الأنانيات الفردية والتنافس اللاأخلاقي على السلطة والمال، وجّه «كوفيد 19» ضربته القاصمة إلى سكان الأرض دون استثناء، ودون تمييز بين الطبقات والأعمار والمجموعات الإثنية المختلفة. هكذا بدت الحضارة برمتها نهباً للشكوك والمخاوف المشروعة وانعدام اليقين. ولعل المفارقة الأكثر إلفاتاً في هذا السياق أن أولئك الذين ضاقت بطموحاتهم مساحة الأرض، وراحوا يبحثون عن مواطئ لأقدامهم ولأحلامهم في الفضاء الواسع والكواكب المترامية، قد اضطروا بفعل كائن هش وغير مرئي، إلى الانكفاء صاغرين نحو بيوتهم وأماكن سكناهم، لائذين بجدرانها من وطأة الخارج الكابوسي. على أن ما تقدَّم ليس دعوة إلى التشكيك بالعقل البشري بوصفه الأداة الأكثر مصداقية للمعرفة، أو بقيمة العلم، بما هو العنوان الأبرز للحضارة المعاصرة، بقدر ما هو دعوة إلى التبصر في مآلات الحضارة الحديثة، التي باتت رديفة للتوحش الرأسمالي والتهالك على الربح والاستحواذ، بمعزل عن أي قيمة إنسانية أو اعتبار أخلاقي. وهو ما كان قد استشرفه قبل قرنين من الزمن الكاتب الألماني غوته، من خلال شخصية فاوست الذي باع روحه للشيطان مقابل الحصول على مفاتيح العلم والمعرفة العقلية. إضافة إلى ما أبداه آرنولد شبنغلر من حدس مبكر بمستقبل الحضارة المادية في كتابه الشهير «تدهور الحضارة الغربية».
وإذا كان الكوكب الأرضي يواجه، بسبب وباء كورونا المستفحل، ظروفاً بالغة القسوة حوّلته إلى سجن واسع، وأدت إلى إصابة الاقتصادات العالمية بالشلل، وإلى تفاقم البطالة وتقنين التواصل المباشر بين الأفراد والجماعات، فإن الأمور في العالم العربي لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتخذ مسارات أكثر صلة بالمأساة، وأكثر مدعاة للقنوط واليأس من أي بقعة أخرى من بقاع العالم. ذلك أن كورونا لم يكن سوى تتويج مأساوي لسلسلة من الإخفاقات المرافقة لخفوت وهج الثورات، وتفرّق شمل المنادين بها من الحالمين بغد أفضل، وأيام أقل قتامة. ولعل انكسار الأحلام أصعب بكثير من انكسار الواقع، بل إن الانكسار الثاني، رغم ما يرتّبه على المنادين بالتغيير من مخاوف مختلفة، هو الشرط الضروري لتأسيس السلطة البديلة التي توفر لمواطنيها العدل والحرية والرخاء، في حين أن الانكسار الأول يعني فقدان الأمل بالتغيير، والاستسلام الكامل للإحباط والقنوط. وهو ما يؤكد بشكل أو بآخر مقولة أينشتاين إن تشابه الأسباب والمعطيات لا بد أن يؤدي بالضرورة إلى تماثل المآلات والنتائج. هكذا بدت جائحة كورونا بمثابة تتويج طبيعي للتراجيديا العربية المتواصلة ؛ حيث لم يبق من مشروعات الوحدة سوى مزيد من الانقسام والتذرر، ومن الأطياف الوردية للحرية سوى الأنياب الكابوسية للاستبداد، ومن مشروعات التنوير سوى عتمة التكفير «الداعشي» بنُسخه المختلفة.
وإذا كان التوصيف الأقرب لما يمر به العالم اليوم، والعالم العربي على وجه الخصوص، متمثلاً في عبارة «الدرجة صفر للحياة»، المعدلة قليلاً عن مقولة رولان بارت «درجة الصفر للكتابة»، فإن للحقيقة وجهاً آخر سيكون تجاهله نوعاً من الافتئات وقصر النظر، أو التعامي المقصود. وأعني به الوجه المتعلق بزوال الأصباغ والزخارف المحيطة بالوجوه والنفوس، لكي تتمكن الحياة الإنسانية من الإفصاح عن نواتها المغيبة خلف قناع المظاهر الخداعة. ولعل أثمن ما قدمته الجائحة الفتاكة للجنس البشري هو أنها خلصت الإنسان من أوهام البارانويا والتضخم النرجسي والمجد الزائف، وأعادت تذكيره مرة جديدة بأنه في نهاية الأمر كائن أعزل ووحيد، وأن كنزه الحقيقي في هذا العالم هو عقله المستنير، وقلبه المترع بالحب، وقدرته غير المحدودة على العطاء. وقد تكون عبارة «اعرف نفسك» التي أطلقها سقراط قبل أكثر من 25 قرناً، هي الممر الإلزامي للخروج من نفق اللامعنى والعبث المأساوي، الذي نعيش داخل ردهاته المظلمة في زمننا الراهن.
ليس بالأمر المستغرب إذاً أن تتقدم الكتابة مرة أخرى لتحتل دورها الريادي في إنقاذ البشر وإعادتهم إلى بر الأمان. وإذا كنا جميعاً ننتظر بفارغ الصبر اللقاحات الأكثر نجاعة للشفاء من الكورونا، والتي تتنافس أمم الأرض على إنتاجها، فإن الإبداع الأدبي والفني في هذه المرحلة هو وحده الذي يستطيع أن يعالج كسور الروح المريضة ويوفر لها سبل الشفاء. ولن يكون الحديث عن انفجار إبداعي محتمل، في ظل الحجْر الصحي والعزلة الطويلة المفروضة على البشر، ضرباً من التنبؤ أو العِرافة أو التنجيم. إذ لم يحدث منذ زمن طويل أن أتيحت لسكان الأرض فرصة الاختلاء بذواتهم، والنزول إلى الأعماق الأخيرة للأسئلة الوجودية، كما هو حاصل اليوم. ومع أن الانفجار المحتمل لم يأخذ مداه الزمني بعد في عالمنا العربي، لأنه يحتاج إلى وقت أطول للتخمر والنضج، فإنه على المستوى الروائي قد بدأ بالتبلور؛ حيث دُفعت عشرات الروايات والأعمال السردية إلى سوق النشر في الأشهر الأخيرة. والملاحظ أن معظم هذه الأعمال يدور حول المتغيرات السياسية والاجتماعية في الدول التي عانت من استشراء العنف والحروب الأهلية، وحول المواجهات الضارية مع الاستبدادين السلطوي والتكفيري، وحول انحلال الحياة السياسية واستشراء الفساد. وهو أمر إن دل على شيء، فإنما يدل على شعور الكتّاب العرب بالمرارة والخذلان، بعد أن سقط معظم الرهانات المعقودة على الثورات العربية في نسخها المختلفة. ومع أننا لا نعثر بين الأعمال الجديدة على ما يتصل بوباء الكورونا، باستثناء بعض الأعمال القليلة التي تتسم بالخفة والتسرع، فإن الأوان لم يفت بعد على أن نحصل على نماذج عالية وعميقة مما يمكن تسميته بأدب الأوبئة، أو الأدب المكتوب في ظلها، والذي سبق أن تجلت نماذجه العليا في إبداعات شديدة التميز على الصعيد العالمي، مثل «الطاعون» لألبير كامو، و«الحب في زمن الكوليرا» لماركيز، و«العمى» لساراماغو.
على أن سؤالين اثنين يمكن أن يتبادرا اللحظة إلى الأذهان، أولهما ليس جديداً تماماً، بل يتكرر طرحه مع كل حرب تقع أو كارثة تحدث، ويتعلق بجدوى الكتابة وقدرتها على تغيير الواقع. أما الثاني فيتعلق بالعثور على رابط ما بين أحوال الحياة وأحوال الكتابة. ومع التسليم بأن مثل هذين السؤالين الصعبين يحتاجان إلى إجابات معمقة ومستفيضة لا سبيل إليها، فإن ما يمكن قوله في الجانب الأول هو ضرورة الفصل بين ما هو من مهمات الكتابة، وما هو من مهمات السياسة وإدارة شؤون الدول والمجتمعات. فالعمل الإبداعي لا يملك أن يغير نظاماً أو يطعم جائعاً أو يكسو عرياناً أو يبني منزلاً تهدم، ولكنه يملك أن يزود الروح اليائسة والمتصدعة بكل أسباب الأمل والمناعة والاحتفاء بالجمال غير المتاح. وإذا كان له أن يغير الواقع ويثور على القبح والخنوع، فهو لا يفعل ذلك على طريقة الانقلابات العسكرية والسياسية السطحية، بل هو يمتلك زمنه الخاص الذي يحفر بصبر وأناة طويلين في تربة الواقع، وصولاً إلى تغيير الذائقة المتخثرة والمفاهيم البالية، وإلى فك أسر العقل وتحريره من قيوده المرهقة.
أما الجانب المتعلق بتلازم «الصفرين»، الحياتي والإبداعي، فهو ينطوي بدوره على قدر مماثل من الغموض والالتباس. وإذا كان صاحب «لذة النص» يميز بوضوح بين قاموس كلاسيكي للكتابة، هو قاموس الاستعمال والتعبير، وقاموس حداثي، هو قاموس الابتكار الذي يُكتب «على حافة الزوال» ويقارب «الأدب المستحيل»، فهو يتوقف ملياً بالمقابل عند عجز الثورة الفرنسية عن خلق هذا النموذج الكتابي الجذري، في حين أن الحراك الاجتماعي العنيف في أربعينات القرن التاسع عشر، استطاع أن يطلق على يد بودلير وقلة من مجايليه شرارة التفجير الحداثي «القصووي». وهو ما يؤكد مرة أخرى على أن إيقاع التغيير في الأدب والفن، لا يتساوق بالضرورة مع مثيله في السياسة والواقع، رغم الدور الفاعل الذي يلعبه كل منهما في حرف الآخر عن مساره العادي. ومع أن لا شيء يؤكد أن ما شهده عالمنا الراهن حتى اللحظة، هو الفصل الأكثر سوءاً من فصول العزلة والانكفاء على الذات والمواجهة الضارية مع الموت، فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن ما يعتمل داخل البشر من هواجس ومكابدات وأسئلة وجودية مختلفة، لا بد أن يوفر للأدب والفن كل ما يحتاجانه من أسباب التجدد والغليان، والتفجر التعبيري والرؤيوي.
الدرجة صفر للحياة والآفاق المنتظرة للكتابة والفن
الإبداع الأدبي والفني وحده الذي يستطيع أن يعالج كسور الروح المريضة


الدرجة صفر للحياة والآفاق المنتظرة للكتابة والفن

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة