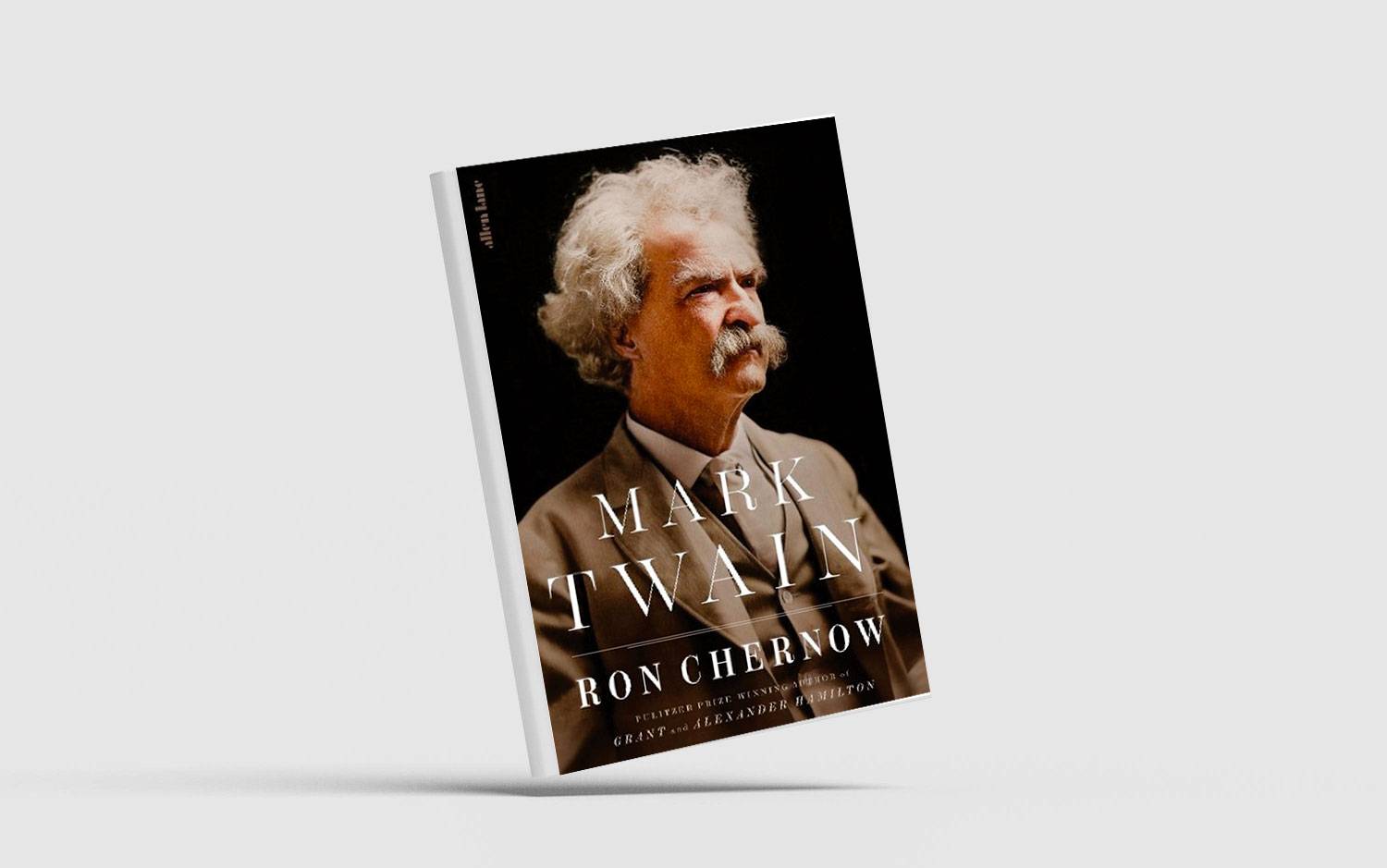تطور فن السيرة الذاتية كثيراً، وتنوعت أساليب كتابة وتدوين تجارب الذات، وقد تداخل هذا الشكل الفني مع الأجناس الأدبية الأخرى. ولعل ذلك التفاعل أكثر وضوحاً في تمظهرات السيرة داخل السرد الروائي، وهذا ما يفسرُ إسقاط ما يأتي في السياق الروائي على المؤلف. وعندما يكشفُ المبدعون جانباً من كواليس مؤلفاتهم الروائية تتضحُ صحة القراءة الإسقاطية ولو نسبياً؛ بمعنى أنَّ النص الروائي لا يتمُ طبخه بعيداً عن تجارب حياتية عاشها المؤلف، أياً يكن مستوى حضور الذات في العمل الروائي، فإنَّ المؤكد هو تسرب الخبرات الشخصية إلى متون الأعمال الأدبية. والحال هذه، فإنَّ مجال المراوغة يزداد نتيجة وجود مساحات وتقنيات مشتركة بين الرواية والسيرة الذاتية، ولا يمانع بعض المبدعين في الحديث عن أوجه توظيف الخبرات في المشروع الروائي. وهذا ما تراه لدى كل من الروائي المغربي بنسالم حميش والروائية الفلسطينية سحر خليفة، فالأخيرة أوردت في إطار سيرتها المعنونة بـ«روايتي لروايتي - سيرة ذاتية أدبية» مقاطعَ من أعمالها الروائية دعماً لما تسردهُ حول معاناة شعبها، وبذلك تكون للرواية وظيفة توثيقية، إذ قد يتعمقُ النص في مسارب معتمة كاشفاً الموجهات غير المرئية في الالتفاف حول بعض القيم السائدة، ناهيك من مشاكسة الرواية لخطوط حمراء، ما يفتحُ باب الجحيم على النص وصاحبه. وبدوره، يتناولُ بنسالم حمِّيش في سيرته الموسومة «الذات بين الوجود والإيجاد» حيثيات كتابة عمله الروائي الأول «مجنون الحكم»، وكانت نواته قد ولدت شعرياً، إذ نظمَ بنسالم قصيدة عن حياة أغرب خليفة شهده تاريخ العرب، والمقصود أبو علي بن المنصور، لكنه أدرك أنَّ حياة الحاكم بأمر الله يضيقُ بها النص الشعري، لذا يستعيد الكاتبُ سيرة هذه الشخصية في إطار الرواية، فيما لاحظت صاحبة «الصبار» منذ البداية أنَّ وقائع حياتها وتجارب شعبها المعقدة المُتشابكة لا تغطيها سوى الرواية، وكانت قراءاتها في الأدب الوجودي وروايات دوستويفسكي وتولستوي قد زادتها وعياً بخصائص هذا الفن.
الوعي الإبداعي
تعترف سحر خليفة بأنها كانت تخجل من الحديث عن معاناتها الشخصية وهمومها الذاتية الخاصة في الإطار الروائي، ولم تجد في ذلك ما تستحقُ اهتماماً وتأملاً، رغم ما ذاقته من المرارة في حياتها الأسرية ورحلتها إلى ليبيا، حيثُ يمعنُ الزوجُ في التنكيل بها، وهذا الواقع المختنق في الغربة يكونُ عاملاً رئيساً وراء قرار الانفصال، والبحث عن مصير مختلف. أما الرواية لدى مؤلف «جرحى الحياة» فهي، إضافة إلى كونها منصة لرصد العلاقات الإنسانية والمجتمعية، إطار يتحققُ من خلاله تشكيل الوعي بالبعد الجمالي للحياة. وبرأي بنسالم، لا يتمُ الانتقال من البداوة إلى الحضارة الفاعلة إذا غاب هذا البعد. أكثر من ذلك، يرى الكاتبُ أن تاريخ كتابة الرواية انطبع عبر فتراته المختلفة بالبنية السوسيوثقافية والآيدولوجية السائدة. وفي هذا السياق، يشيرُ بنسالم حميش إلى ضرورة التشبع بثقافة الرواية، من خلال الاهتمام بمؤلفات المبدعين الكبار. إذن، فإنَّ تأسيس المشروع الروائي يتطلبُ وعياً بتاريخ هذه الصنعة، وتواصلها مع مختلف الفنون الإبداعية. ومن هذا المنطلق، يعبرُ بنسالم عن رأيه حول وفرة الإصدارات الروائية المستقاة مادتها من سيرة مؤلفها، وشحة المعرفة بالسيرورة الثقافية والقيمية. فبنظره، من يكتفي بين الروائيين بتحويل سيرته الخاصة أو حتى المتخيلة، يقصي نفسه من سجل الأدب الروائي. ويستشهد هنا برأي إيكو صاحب «اسم الوردة» الذي يقولُ إن 90 في المائة من العمل الروائي ينجز بعرق الذات. ومما يتقاطع فيه الاشتغال الإبداعي لدى سحر خليفة وبنسالم حميش استفادة الاثنين من الخبرة الأكاديمية في كتابة العمل الروائي، إذ إن ما تراكم لدى الأخير حول حياة ابن خلدون، خلال انكبابه على أطروحة الدكتوراه في العهد الوسيط المتأخر في بلدان المغرب، كان بمثابة حجر زاوية لروايته «العلامة». كما أنَّ الانطباعات والأجواء التي تكتشفها سحر خليفة في أميركا، ومراقبتها لشكل حياة المواطنين العرب في المهجر، كل ذلك يصبح مادة لروايتها المعنونة بـ«الميراث»، وهي تكتبها كجزء من أطروحة الدكتوراه، ومن ثمَّ تقومُ بصياغتها لاحقاً في القالب الأدبي، وما قصة دنيا التي تبدأ بها الرواية إلا حصيلة معايشتها لواقعة تتبلور من خلالها بعض أفكارها النسوية.
تفكيك
ليس الغرض من كتابة السيرة سرد ظروف النشأة أو الحديث عن الروافد المعرفية أو الإفصاح عن معلومات كانت طي الكتمان فحسب، بل إلى جانب ذلك يكونُ النقدُ ركناً أساسياً لدى من يشرع بنشر سيرته الذاتية، إذ يهمُ المتكلم مراجعة المواقف أو تفكيك الأسس التي ينهضُ عليها النظام السياسي والاجتماعي، كما يبدو ذلك بوضوح في سيرة سحر خليفة، حيثُ تضعنا أمام واقع يرسف بقيود العقلية الذكورية، حيث تصطدمُ الكاتبة بمهيمناتها في بيئتها الأسرية والمجتمعية. فكانت بداية المعاناة مع نزوج الوالد حتى لا يوصم بأنَّه مقطوع، إذ لم تنجب زوجته الأولى غير البنات، وبالتالي لقبت بأم البنات، وهذا اللقب كما تقول سحر خليفة كان شتيمة في ذلك الزمن. وعليه، فإنَّ نشأة الكاتبة في واقع متخم حتى العظام بقيم ذكورية أثارت لديها أسئلة بشأن هوية الذات، ودورها في مجتمع تسوده نظرة دونية للمرأة، ومن هنا تهربُ سحر خليفة إلى الكتابة والألوان.
والأهم هو تشريح سحر خليفة للفئة المثقفة ومواقفها المُتناقضة، وانفصال المثقفين عن هموم المواطن العادي. وحسب ما يردُ في مفاصل الكتاب، فإنَّ المثقف لا يوظفُ عدته الفكرية لتسويغ تقلباته السياسية فحسب، إنما يستفيد من معجمه الشعاراتي لتلبية رغباته الغرائزية. وملمحُ آخر من هذا الكتاب هو المقارنة بين العقليتين العربية والغربية استناداً إلى معاينة الوسط الثقافي. وفي هذا السياق، تعودُ مؤلفة «عباد الشمس» إلى ما ذكره مواطنها هشام شرابي في «الجمر والرماد» للإبانة عن مظاهر البؤس الفكري والثقافي. ومن جانبه، يتخذُ بنسالم حميش مسلكاً انتقادياً في سيرته، إذ يناقشُ سلوكيات الدعاة الفرانكوفونيين، وازدواجية سياسة البلدان الغربية التي تتصرف بإيحاء التركة الاستعمارية. وهذا لا يعني التنكر للمبادئ والقيم الإنسانية التي تمخضت من مسيرة أقطاب الثقافة الغربية، أمثال ماركس وكانط وسارتر وأندريه مالرو وميشيل دي مونتاين، بل يشكلُ إرث هؤلاء المفكرين والفلاسفة عنصراً بارزاً في تكوين شخصية بنسالم الثقافية. ومن الملاحظ فيما يسردهُ الكاتبُ في سيرته الاهتمام بالبعد الفكري والمصادر التي أسست لانطلاقته الثقافية والفكرية. وما يتضمنهُ الكتاب من الإحالات والاقتباسات يوحي أيضاً بثقافة بنسالم حميش التراثية. وما يشد الانتباه أكثر في هذا الإطار سجالات بن سالم مع مجموعة من المثقفين العرب، ومخالفته لمنهجهم الفكري، علماً بأنه كان معجباً ببعض من يجادلهم، وهذا ما يؤكدُ أهمية عملية التحرر من نماذج مكرسة، وهو يحتاج إلى عقلية جدلية نافذة.
* كاتب كردي عراقي