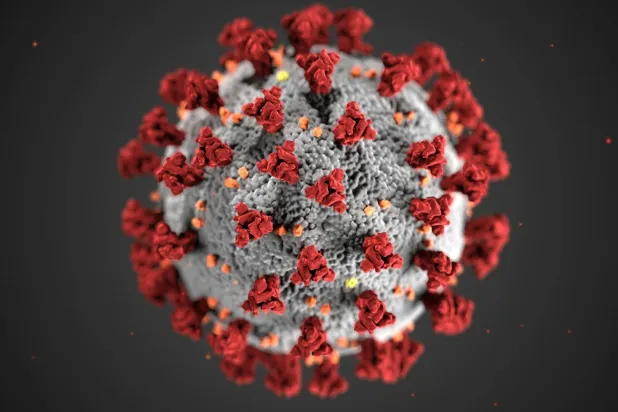أبلغني الأطباء، في 17 مارس (آذار)، بأنني مصاب بفيروس «كورونا».
أضاف الخبر السيئ هواجس كثيرة على القلق الذي بدأ ينتابني منذ صبيحة الجمعة 13 مارس (آذار). استيقظتُ يومذاك في بيتي بمدينة نيويورك على حمى وصداع، وبعض الأوجاع. مثل كل الناس المتوجسين من أخطار العدوى والإصابة بــ«كورونا»، قمتُ أولاً إلى ميزان الحرارة الذي نستخدمه (زوجتي وأنا) بصورة دائمة في بيتنا، للتأكُّد من سلامة ابنتنا وابننا. ظهر القياس فوق المائة بقليل على مقياس فهرنهايت (نحو 38 درجة مئوية). كان هذا المؤشر الأول إلى أمر غير طبيعي، علماً بأنني عانيتُ منذ البداية من سعال جافّ، ولكنه لم يكن بالغ السوء. تحسَّن وضعي قليلاً بعدما تناولتُ حبتَيْ دواء لخفض الحرارة والألم. تغلبتُ على بعض ما انتابني من القلق، ثم حاولتُ أن أزاول حياتي اليومية كالمعتاد... طبعاً من المنزل على سبيل الاحتياط.
أعاد الدواء حرارتي طبيعية بضع ساعات. بيد أن التعب والإرهاق رافقاني رغم أنني لم أقم بأي جهد كبير. لازمتُ الفراش في غالب الوقت. عاودتني الحمى مساء. عالجتها بالدواء مجدداً. لم يكن الأمر سيئاً. غير أن الشّكوك ساورتني أكثر. كانت الأنباء عن الوباء والجائحة والعدوى بلغت كل الأرجاء، قريبة وبعيدة، وعبرت كل الحدود.
كنتُ أحسب طويلاً (كما كثيرين وكثيرات) أن العيش في نيويورك يوفر رعاية صحية لا تُضاهى. تنعم المدينة بعدد وافر من المستشفيات والأطباء والممرضات والممرضين. هنا مقصد الساعين إلى الصحة الفضلى والعافية الكبرى. رغم المخاوف والهواجس التي انتابتني، لم أشأ أن أكون عبئاً على النظام الصحي في نيويورك. بدأتُ أسمع أن هذا النظام متعَب ومنهَك، مع أنه من الأغلى عالمياً. هل جاء هذا الفيروس ليزيل الفوارق بين العالم الأول والعالم الثالث؟ ماذا عدا مما بدا؟
تكررت العوارض ذاتها لديّ السبت 14 مارس (آذار)، فسألت طبيباً صديقاً عما ينبغي القيام به. لم يتردد في نصحي بإجراء فحص «كورونا». سألتُ طبيباً آخر، فجاء جوابه أن الفحص ضروري. عندها حاولت الوصول إلى طبيبي العام في مستشفى «وايل كورنيل»، فلم أفلح. طلبت معاينة إلكترونية عن بُعد. ولم أتلقَّ إجابة فورية. بتُّ في حيرة وفي مزيد من القلق. تساءلتُ في قرارتي: كيف يمكن أن يصاب شخص ما بعوارض مرضية رئيسية، ويجد أن ثمة ما يعوق الذهاب إلى طبيب، حتى في نيويورك؟
عانيت عوارض إضافية، مثل التصلبات والتشنجات العضلية في أنحاء مختلفة من جسدي، بما في ذلك الرقبة والجوانب والبطن والأرجل واليدين. اتصلت هاتفياً بعيادة قريبة «ووك إن كلينيك»، وهي خدمة صحية على طريقة الوجبات السريعة. قيل لي إنه يمكنني الدخول والحصول على معاينة من طبيب متخصص. وأضافوا أن نسبة الفحوص المتوافرة قليلة للغاية. بيد أن الطبيب المتخصص سيقرر... هكذا كان. وضعتُ كمامة على وجهي، وأكفّاً بلاستيكية في يدي، وذهبت. قابلتُ الطبيب الأول الذي كان يرتدي كمامة واقية أيضاً. وجه لي كثيراً من الأسئلة، ثم أجرى مجموعة من الفحوص الحيوية الأولية. الحرارة 101 على مقياس فهرنهايت (أكثر من 38 مئوية). دقات القلب سريعة بعض الشيء (99 في الدقيقة). ضغط الدم طبيعي.
ثم جاءني طبيب متخصص آخر بدا لي وكأنه رائد فضاء. اطّلع على نتائج الفحوصات الأولية، ثم سألني عن عملي، وما إذا كنتُ قابلتُ أي شخص يمكن أن يكون مصاباً بالفيروس. الأمم المتحدة؟ سأل. هذا مقصد لعاملين ولزوار من كل أصقاع الأرض. للأسف، انطبقت عليّ شبهات عديدة. قال لي إنه سيجري فحصاً لمعرفة ما إذا كنتُ مصاباً بالإنفلونزا. بعد انتظار لنحو 15 قيقة، جاءت النتيجة سلبية. قال لي على الفور: تنطبق عليك كل المواصفات لإجراء فحص «كورونا». ذهب وعاد بعدة الفحص: قشة طبية طويلة في رأسها غلاف قطني. أدخلها إلى عمق الأنف وأدارها مرات عدة للحصول على عينة. سحبها، ثم وضعها على الفور في أنبوب يحتوي على سائل خاص. أغلقها وأبلغني أن النتيجة ستظهر بعد خمسة إلى سبعة أيام. طلب مني أن أضع نفسي في الحجر الذاتي إلى حين ظهور نتيجة الفحص، وأن أتوجه إلى العيادة أو الطوارئ في المستشفى إذا شعرتُ بعوارض إضافية أو مضاعفات، أخطرها أي شعور بضيق التنفس. طلبوا أيضاً أن تخرج زوجتي وابنتي وابني من المنزل الذي نعيش فيه، ريثما تظهر نتيجة الفحص. وأضافوا أنه إذا كان هذا غير ممكن، فعلى الأقل أن أضع نفسي في حجر تام، وألا أتقاسم دورة المياه مع بقية أفراد العائلة.
عدتُ إلى البيت حاملاً المزيد من الآلام والهموم والمخاوف. حبستُ نفسي في غرفة. وضعت بجانبي بعض الماء والدواء المخفف للألم والحمى وميزان الحرارة، وبعض الكتب. حاولت أن أقرأ، ثم استسلمت إلى النوم. مرّت الصباحات والنهارات والمساءات والليالي، وأنا في عزلتي أحصي الآلام المتنقلة في جسدي.
اتّصل بي الأطباء، الثلاثاء، في 17 مارس (آذار)، لإبلاغي أن نتيجة الفحص جاءت إيجابية. لم أُفاجأ كثيراً لأن الشعور بالإصابة كان فعل فعله بي. حرصت على إبلاغ جميع من كنتُ على صلة مباشرة معهم خلال الأيام السابقة، وبينهم زملاء من الصحافيين والإعلاميين والمسؤولين في الأمم المتحدة والعديد من السفراء والدبلوماسيين في نيويورك. كان أملي في ألا أكون نقلتُ العدوى إلى أي شخص، وفي أن يدرك أي شخص يصاب كيفية انتقال العدوى في حال حصولها.
تلاشت الحمى شيئاً فشيئاً. غير أن الأوجاع في صدري صارت تقلقني أكثر. ثم أتى الألم الحاد في العينين ليحرمني ثلاثة أيام متتالية حتى سلوى القراءة ومتعتها. تلاشى هذا الألم أيضاً، ليأتي الفصل الأخير (كما آمل) من العوارض؛ فقدتُ بشكل كلي حاستي الشم والطعم، اللتين قال الأطباء إنهما من مظاهر الإصابة بـ«كورونا».
تلقيتُ كثيراً من الاتصالات من أناس حريصين على صحتي، ومن آخرين قلقين على صحتهم، وأولئك الخائفين من انتقال العدوى إليهم مني مباشرة أو بواسطة شخص ثالث. أهم الأسئلة هي تلك التي تتعلق بالعوارض وتدرُّجها وخطورتها، فضلاً عن كيفية انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، وما إذا كان هناك سبيل للشفاء الناجز والتام.
نعم، هذا الذي حصل بعد 14 يوماً من العزلة. زالت الآلام والحمى والعوارض غير الطبيعية. عادت الحيوية إلى جسدي. عدتُ كما كنتُ ولكن بتواضع أكبر، تواضع أمام هول ما حصل لي وما أصابني. الجسد الذي نحمله ويحملنا ليس منيعاً على كل الأمراض والأوبئة.
أحسب أننا نعيش في عالم جديد تسافر فيه الأوبئة عبر كل الحدود والمسافات، يُضطرّنا إلى عزل أنفسنا وعلى حجر أنفسنا في أضيق الأمكنة، بغية حماية أنفسنا وحماية الآخرين. وجدت نفسي مرغماً على وضع جديد: نرى العالم يدخل في فضاءات افتراضية جديدة.
وباء «كورونا» ليس بداية عزلة من 14 يوماً فحسب، بل أكثر. لعلها غيرّت وجه هذا العالم.
قصة إصابة بـ{كورونا}... 14 يوماً من العزلة وأكثر

مدينة نيويورك

قصة إصابة بـ{كورونا}... 14 يوماً من العزلة وأكثر

مدينة نيويورك
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة