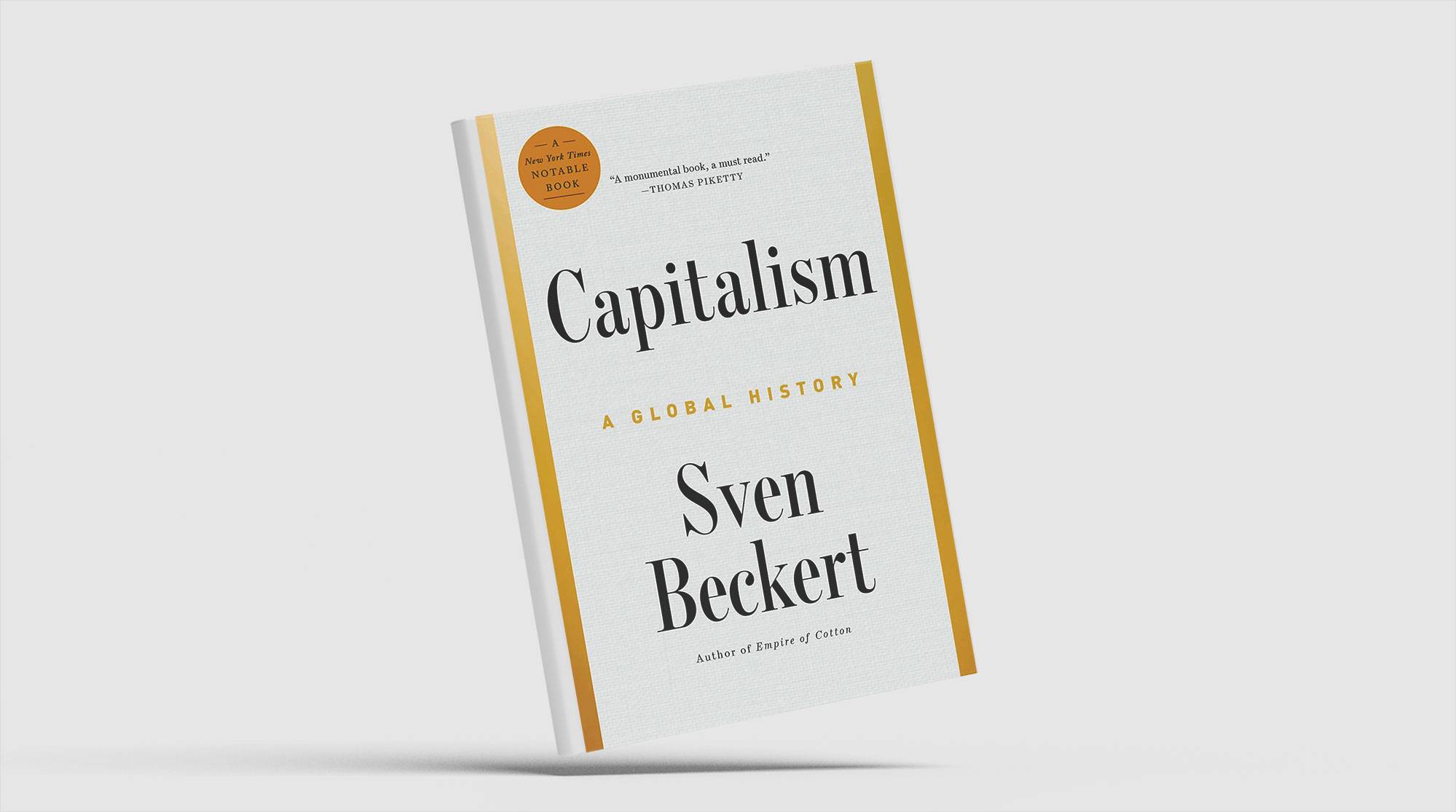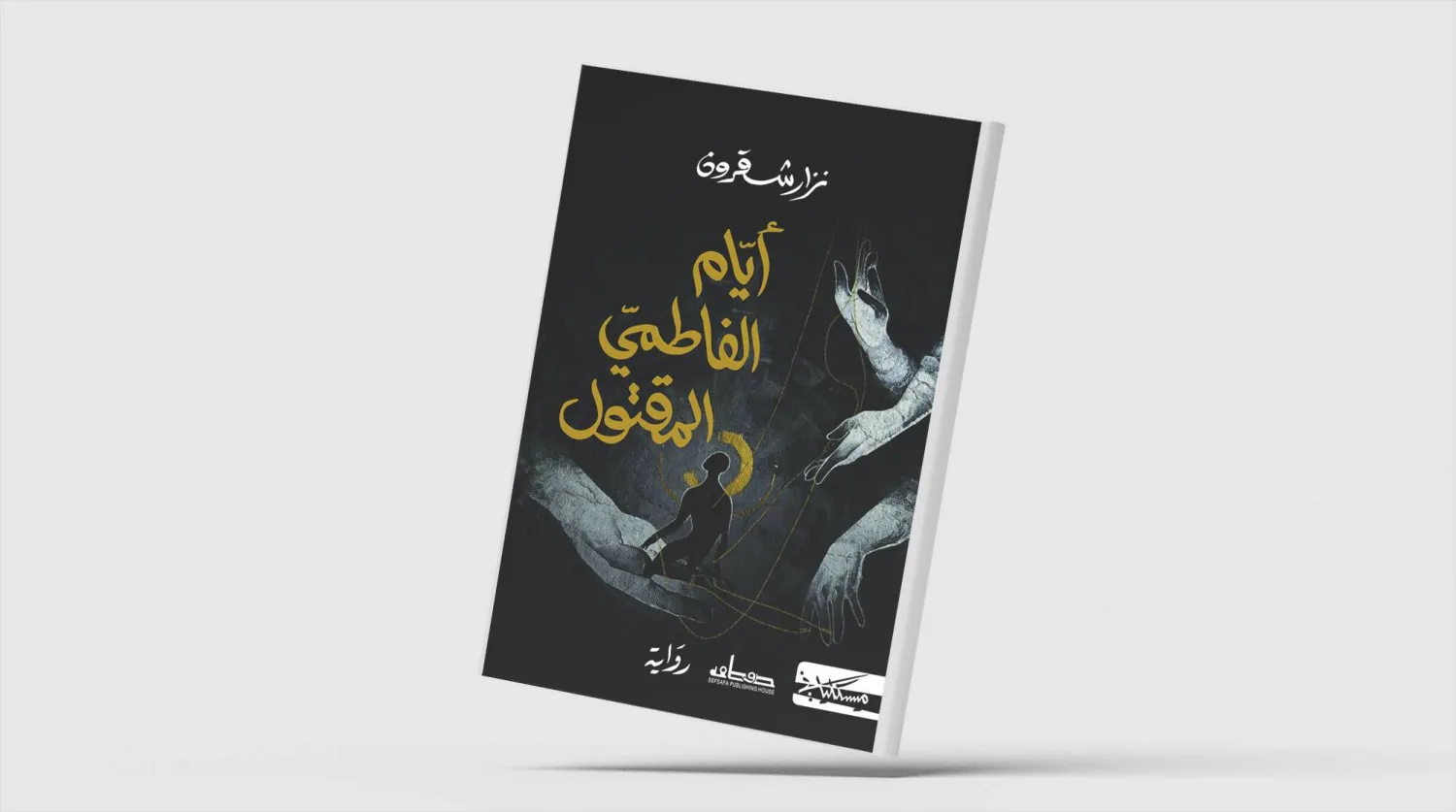لم تعد ظاهرة التشدد الإسلامي مقصورة على منطقة جغرافية بعينها، لكنها امتدت إلى مناطق كثيرة في عالمنا، حتى أصبحت توصف بأنها لا وطن لها، شأنها في ذلك شأن الإرهاب بوجهه القبيح... عن هذه الظاهرة تطالعنا دار النشر الفرنسية العريقة «غاليمار» بكتاب يحمل اسم «الجهاد الفرنسي: الضواحي، سوريا، باريس، السجون»، لمؤلفه هيجو ميشيرون المتخصص ببواطن الأمور في الضواحي الفرنسية، خاصة ذات الصبغة العربية، كما ظهر خلال السنوات الأخيرة بصفته عالماً ومتخصصاً في هذا الملف وكذلك عالم السجون، إضافة إلى كونه متخصصاً في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، ويُدرّس علومها السياسية في جامعات فرنسا، مثل جامعة ليون على سبيل المثال، كما يعد زميل كرسي متميزاً بجامعة باريس في سياسات الشرق الأوسط.
وتبرز أهمية هذا الكتاب الذي يقع في 416 صفحة من القطع المتوسط، أنه يأتي بعد خمسة أعوام من سلسلة العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا منذ يناير (كانون الثاني) 2015 بين مجزرة «شارلى إبدو» ومذبحة «البنتاكلون» ليقدم لنا وصفاً دقيقاً من الداخل الفرنسي لهذه الظاهرة، مؤكداً على تنامي ما يسميه ـ «الجهاد الفرنسي» الذي نشأ وترعرع في المدن والضواحي الشعبية الفرنسية التي تمثل أرضاً خصبة للجهاد، مروراً بتنظيم «داعش» في سوريا، وصولاً إلى السجون الفرنسية التي يتم وضع العناصر الخطرة بها.
لذلك؛ يتمتع الكتاب بأهمية خاصة، فهو ثمرة نتاج جهد خمسة أعوام من العمل البحثي الميداني والنظري للمؤلف؛ إذ اعتمد على أكثر من مائة حوار بثلاث لغات مختلفة (العربية، والفرنسية، والإنجليزية) خلال الفترة من 2014 إلى 2019 مع عناصر متطرفة، ليس فقط في فرنسا وبلجيكا، لكن أيضاً في سوريا، ولبنان، وتركيا، وكردستان العراق، هذا بالإضافة إلى 24 حواراً مع عناصر خطرة قابعة خلف أسوار السجون الفرنسية ليصل من خلالها إلى تحليل دقيق لطبيعة وماهية «الجهاد الفرنسي»، مؤكداً على أن السجون الفرنسية تمثل نقطة تفاعل مع الضواحي الفرنسية لإنتاج هذه الظاهرة.
كما يشير المؤلف إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمثل انعكاساً طبيعياً لأوروبا، واتضح ذلك جلياً من خلال إقامة ميشيرون، في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2014 إلى يناير 2017، في المنطقة ليسجل حوارات مع متمردين ولاجئين سوريين هربوا من الرقة تحت نيران «داعش»، وكذلك عناصر متطرفة لبنانية أعضاء بالنصرة، هذا بالإضافة إالى حوارات تمت بمساعدة مترجم كردي مع اللاجئين الإيزيديين والمقاتلين الأكراد. لكن تم الانتهاء من العمل الأساسي من خلال عمل ميداني مباشر داخل السجون الفرنسية بداية من 2015 من خلال أربع مؤسسات تابعة للسجون الفرنسية معنية بتأهيل العناصر الأصولية.
يسوق لنا المؤلف بعض الأرقام الكاشفة والمفزعة التي تؤكد مدى خطورة «الجهاد الفرنسي» على الأمن والسلم في قلب المجتمع الفرنسي، ففي الفترة من 2012 إلى 2018، تورط ما لا يقل عن 2000 فرنسي في التنظيمات الإسلامية المتطرفة في سوريا؛ الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد نزلاء السجون الفرنسية، خاصة فيما يتعلق باستقبال العناصر الإرهابية الخطرة التي تورطت في عمليات إرهابية في مناطق كثيرة بين أفغانستان والبوسنة في السابق، وشارك معظم هذه العناصر في تنظيم «داعش» في مدينة الرقة في 2014 التي تم إسقاطها بعد ذلك بثلاث سنوات. ومن بين هذه العناصر أطفال ونساء ما زالوا موجودين حتى الآن في معسكرات احتجاز في شمال شرقي سوريا. وخلال هذه الفترة، تم إحباط أكثر من 59 عملية إرهابية، إلا أنه تم تنفيذ أكثر من 20 عملية في فرنسا، وتتماثل هذه الإحصائيات في بلجيكا، وألمانيا، وبريطانيا، وإسبانيا، وهي عمليات أودت في مجملها بحياة أكثر من 250 فرداً وإصابة آلاف آخرين بجروح. في هذا السياق، يكشف المؤلف عن معلومة في منتهى الخطورة والأهمية، مؤكداً على أن معظم العمليات الإرهابية التي شهدتها الأراضي الفرنسية قد نُفذت بأيادي عناصر فرنسية تربوا على الأراضي الفرنسية وتعلموا في مدارسها.
ويرى هيجو ميشيرون، أن «الجهاد الفرنسي» فرض نفسه بقوة كحقيقة دامغة بالنسبة لكل دول الاتحاد الأوروبي مع وجود تنوع في مصادر ونشأة العناصر المتطرفة الذين انضموا إلى «داعش»، فهناك معلومات تشير إلى أنه في الفترة من 2012 إلى 2918، فإن 80 في المائة من العناصر الأوروبية المتطرفة التي انتمت إلى «داعش» تعود أصولها إلى أربع دول أوروبية فقط (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا) يمثل الفرنسيون منهم 40 في المائة بواقع يتراوح بين 2000 و5000 فرد و800 لبريطانيا و800 لألمانيا، بينما يقدر نصيب بلجيكا بـ600 لتمثل أكبر دولة أوروبية فيها عناصر جهادية مقارنة بعدد سكانها.
وفيما يتعلق بالدول الأوروبية التي شهدت عمليات إرهابية، يوضح الكتاب أن فرنسا تتصدر القائمة، فتقريباً خرج من معظم البلديات الفرنسية عناصر متطرفة، وترتب على ذلك تنظيم شبكات عنقودية في بعض المدن الأوروبية، في حين لا يعرف البعض الآخر أي نشاط إرهابي، أي أن هذا النشاط يتركز في مدن محددة دون أخرى، وليس أدل على ذلك من الحالة البلجيكية التي تؤكد أن 75 في المائة من إجمالي عدد العناصر البلجيكية المتطرفة البالغ 600 فرد ينتمون إلى خمس بلديات فقط، وتأتى على رأسهم بلدية مولنبيك ذات الأغلبية العربية التي شهدت تنظيم وترتيب العمليات الإرهابية التي استهدفت فرنسا في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتلك التي استهدفت بروكسل في 22 مارس (آذار) 2016.
ويعتقد المؤلف أن العوامل الاقتصادية المتردية لا تمثل دافعاً لوجود أرض خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة، وليس أدل على ذلك من انتشار هذه الظاهرة في بعض المدن البلجيكية بالإقليم الفلمنكي ذات الأوضاع الاقتصادية الجيدة، مثل مدينة فيلفورد، ومدينة انتويرب، والوضع نفسه تشهده فرنسا، فمدينة ليمل ذات الـ25 ألف نسمة فقط، ولها طبقة اجتماعية جيدة، إلا أنها حازت في 2014 لقب «عاصمة الجهاد الفرنسي»، حيث توجه منها 25 عنصراً متطرفاً إلى سوريا، وفي الوقت نفسه، فإن المدن الأكثر ازدحاماً عشرات المرات في شمال مارسيليا لم تشهد توجه متطرف واحد إلى سوريا في الفترة من 2012 إلى 2018؛ الأمر الذي يؤكد عدم جدوى استخدام المعيار الاجتماعي أو الاقتصادي في تفسير وتنامي تلك الظاهرة، حسب ميشيرون.
ويخلص المؤلف من حواراته الـ24 بشقيها المنفرد والجماعي داخل السجون الفرنسية إلى أن هناك طرفاً ثالثاً يربط بين فرنسا وتنظيم «داعش» الإرهابي، ويكمن هذا الرابط في «السجون الفرنسية» التي تمثل أرضاً خصبة لتبادل الأفكار والتوجهات بين العناصر المتطرفة.
«الجهاد الإسلامي»... من السجون والضواحي الفرنسية إلى سوريا والعراق
اعتمد المؤلف على أكثر من مائة حوار بثلاث لغات مختلفة من 2014 إلى 2019

حي مولنبيك في بروكسل - بلجيكا

«الجهاد الإسلامي»... من السجون والضواحي الفرنسية إلى سوريا والعراق

حي مولنبيك في بروكسل - بلجيكا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة