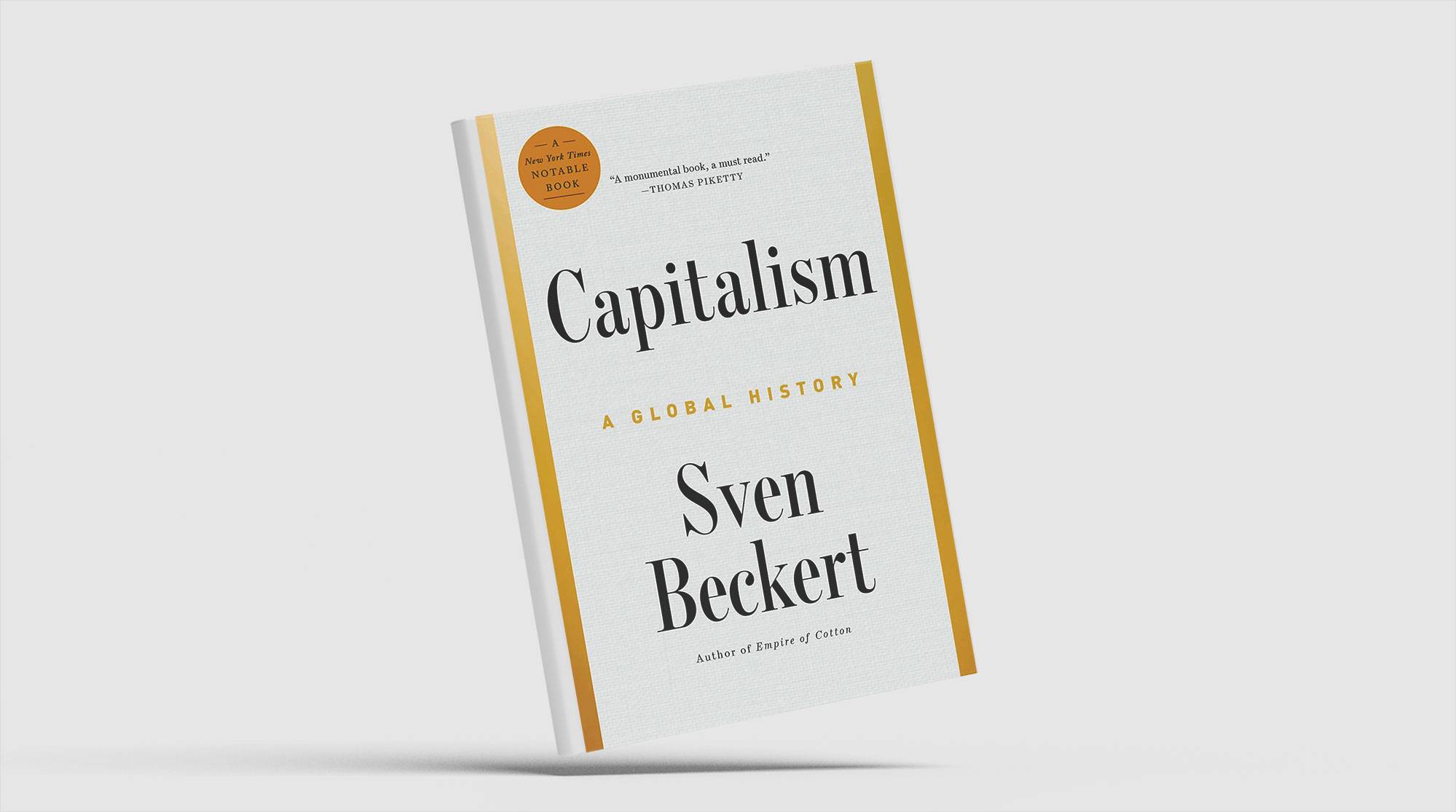أصبح التقدم العلمي المذهل المحيط بنا في كافة مناحي الحياة يمثل ضرورة وجود للتعايش مع هذا العالم؛ خصوصاً أن هذا التطور الهائل يفرض علينا نظرية مؤداها: هل يمكن للتقدم العلمي أن يحل محل العنصر البشري في جميع أمور حياتنا؟ وهل يمكن للعنصر البشري أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التطور العلمي الذي اقتحم جميع الميادين، بما في ذلك ميادين كنا نظن أنها مقصورة على العنصر البشري فقط، مثل الصحة؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، يأخذنا كتاب «سحرة المستقبل: هل يمكن للذكاء الصناعي أن يعالجنا؟» الصادر مؤخراً عن دار النشر الفرنسية «مارابو» في 256 صفحة من القطع المتوسط؛ حيث يطرح مؤلفه الدكتور لواك إتيان، وهو طبيب طوارئ، من خلاله، عدداً من الأسئلة، مثل: هل يمكن للإنسان الآلي أن يشخص حالتنا الصحية؟ وهل يمكن له كذلك تحديد الأدوية المناسبة لكل حالة على حدة؟ وهل يمكن له أيضاً إجراء عمليات جراحية لنا؟
الإجابة تبدو بسيطة للغاية، مفادها أنه من الآن فصاعداً، وخلال العشرة أعوام القادمة، سيكون بمقدور الذكاء الصناعي تنفيذ كل المهام سالفة الذكر؛ بل سيتجاوز الأمر مداه بتنفيذها بطريقة أمهر وأفضل من الطبيب البشري ذاته، وهو ما ننتظره حقاً، الأمر الذي قد يغير من طبيعة ودور العنصر البشري في المجال الطبي.
ثم يتساءل المؤلف: لكن، هل يمكن لنا أن نخشى ونخاف من هذا التغير في الدور؟ أو بمعنى آخر: هل يمكن لنا أن نقلق من دور الذكاء الصناعي الذي سيقلب موازين الحياة البشرية؟
إن هذه الخطوة - كما يستدرك - تمثل حلقة الوصل بين الخيال والاحتمال الواقعي لما سيكون عليه الطب في المستقبل، ولذلك يجب أن نستعد لهذا التغير دون خوف أو تردد أو قلق «أمامنا خمسة أعوام لنجعل من الآلة حليفاً وليس عدواً في المستقبل».
يتمتع هذا الكتاب بخصوصية فريدة واستثنائية؛ ليس فقط لأنه يتطرق لموضوع جديد من نوعه، وإنما لأن مؤلفه له باع في هذا المجال، فهو من مؤسسي «الذكاء الصناعي الطبي»، وانشغل به منذ عام 1987، وله تجارب رائدة في هذا المجال. وهو يحرص منذ مطلع عام 2000 على نقل هذه الخبرات التراكمية لنا عبر الإنترنت، بمعاونة فريق عمله، ليحدث بذلك تطوراً ملموساً في نظام الذكاء الصناعي الطبي المعروف بـ«MEDVIR» الذي يساعد في اتخاذ القرار الأمثل للمرضى، ومن ثم يسهل مهمة عمل الطبيب؛ لكنه، من جانب آخر، يقول لنا إننا سنكون عند مفترق طرق، وعلينا أن نفكر كثيراً بأي طريق تتجه بنا مقاليد الأمور، وعلينا أن نتحلى باليقظة بشأن العواقب والتداعيات غير الإنسانية.
ثم يطرح المؤلف رؤية تحليلية لما سيكون عليه هذا المجال بحلول عام 2030. وهو يرى أن «الذكاء الصناعي الطبي» ممكن أن يكون حليفاً جديداً للطبيب، لما أثبته من نجاحات رائعة وملموسة في عديد من أفرع الطب، مثل القلب والعيون والجلدية وأمراض الأورام السرطانية، إذ يستطيع أن يحدد مراكز ومناطق انتشار البؤر السرطانية، بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يشخص تطور الأمراض، ويحدد العلاج المناسب لكل حالة على حدة، ليفتح بذلك الطريق أمام طب أفضل من ناحية الأداء، وأكثر مردوداً.
وهنا يشدد الدكتور لواك إتيان على أن الإنسان الآلي لن يحل مطلقاً محل الأطباء البشريين، وذلك نظراً لضعف مستوى ذكاء الآلات. فعلى الرغم من قدرتها على تحليل الصور الطبية بدقة، والتعامل بسرعة فائقة مع ملايين البيانات، فإنها ليس لديها إدراك لذاتها، ولا لما تفعله، فهي تطبق معلومات وتحدد طرقاً وإجراءات مكتسبة بشكل مجرد.
إذن، يثير الذكاء الصناعي مخاوف مشروعة، ولن يكون بديلاً للعنصر البشري الطبي في عديد من المهام؛ بل سيوفر للطبيب الجهد، والجودة في الأداء، والوقت أيضاً، مما يسمح له بتعزيز علاقته الإنسانية مع مرضاه، والإنصات أكثر لتساؤلاتهم، الأمر الذي يمثل فرصة جيدة للعودة لطب أكثر إنسانية.
وحول مجالات استخدام وتطبيق الذكاء الصناعي الطبي، يشير الكتاب إلى أن هناك عديد من المجالات الطبية التي أثبت الذكاء الصناعي الطبي قدرة جيدة فيها، ومن أهم هذه المجالات سرطان الجلد، إذ يمكن للذكاء الصناعي الطبي تحديد منطقة سرطان الجلد دون خطأ، كما أنه من الآن فصاعداً يمكن الاعتماد على نظام طبي مزود بالذكاء الصناعي، لتحديد ما إذا كان الورم حميداً أم لا.
وفي مجال الأشعة، تبرز أهمية الذكاء الصناعي من خلال استخدام مئات ملايين الصور الرقمية، وكم هائل من المعلومات المعقدة التي بمقدور الذكاء الصناعي الطبي التعرف عليها وتحليلها، عن طريق آلة تسمى «آلة التعلم» التي تسمح بعد ذلك بتحليل الصور وتشخيص المرض، ليكمل بذلك دور الطبيب البشري.
وفي مجال العلاج بالخلايا الجذعية، حقق العلاج بهذه التقنية تقدماً بالغاً خلال السنوات العشر الماضية، لا سيما في مجال السرطان؛ لكن لا تزال هناك عقبة كبيرة في هذا الصدد؛ حيث يستجيب بعض المرضى للعلاج عن طريقها دون البعض الآخر. ولكن بفضل الذكاء الصناعي الطبي في مجال «الجلدية»، تمكن الباحثون في معهد «جيستاف روسي» بفرنسا من التنبؤ بالاستجابة للعلاج من عدمه، مع مراعاة البيئة المناعية لطبيعة الورم.
وفي مجال المساعدة في اختيار العلاج الأمثل المناسب للمريض، يوضح الكتاب أن جهاز «الإنسان الآلي» يقوم بذلك عن طريق ما عليه من كم هائل من المعلومات، مع معرفة دقيقة للتاريخ المرضي للشخص وللعائلة، وعوامل الخطر، وكذلك نتائج الفحوصات الإشعاعية والبيولوجية وبيانات المريض السلوكية، وأيضاً ما يتناوله من أدوية في الوقت الراهن، مع تحديد ما لها من آثار جانبية محتملة، مما يساعد على تحديد العلاج الأفضل والأمثل للحالة المرضية.
10:2 دقيقه
هل يجب أن نقلق من الذكاء الصناعي وقلبه موازين الحياة البشرية؟
https://aawsat.com/home/article/2140436/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F



هل يجب أن نقلق من الذكاء الصناعي وقلبه موازين الحياة البشرية؟

- القاهرة: أحمد صلاح
- القاهرة: أحمد صلاح

هل يجب أن نقلق من الذكاء الصناعي وقلبه موازين الحياة البشرية؟

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة