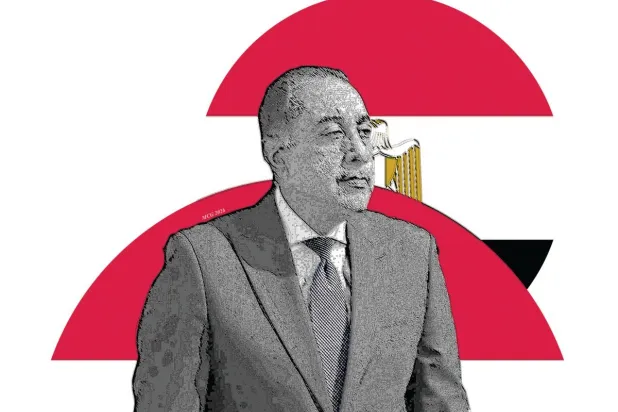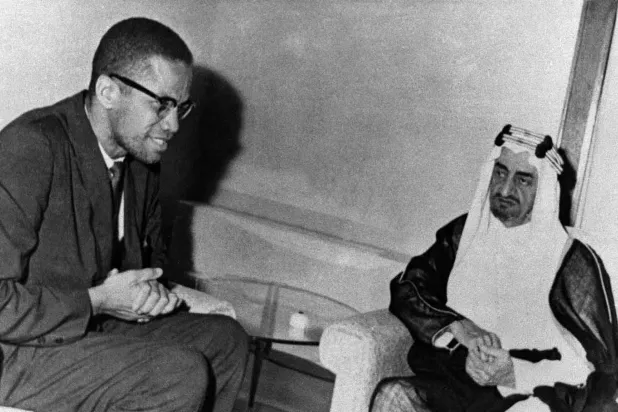يلخص شعار «نريد وطناً» الذي رفعه المتظاهرون العراقيون مطلع حراكهم، الذي انطلق مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كل ما يتعلق برغبتهم في تغيير صورة بلادهم التي لحق بها كل ما هو «مشين» برأيهم على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما لحق بها من أدران الفساد وسوء الإدارة والعمالة المعلنة لغالبية قواها السياسية لقوى الخارج.
وعلى رغم وجود أكبر سفارة في بغداد للدولة التي احتلت بلادهم عام 2003، وهي هنا الولايات المتحدة الأميركية، فإن حدة النقمة الشعبية عليها، لا تعادل بما لا يقارن مع تلك النقمة المتصاعدة ضد إيران لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر، أن واشنطن وخلافاً لطهران، لم تجد من بين صفوف العراقيين من يسارع إلى التصريح علناً بأنه سيقف معها في أي اعتداء تتعرض له، بينما تحظى طهران بعشرات الفصائل المسلحة الموالية لها التي تعلن ليل نهار أنها ستقف معها في حال تعرضها إلى أي اعتداء. وهذا يفسر محلياً على أنه ولاء معلن وغير شرعي لدولة خارجية على حساب البلاد ومصالحها.
ثمة أسباب عديدة وراء تصاعد مشاعر الكراهية واللا ارتياح من الدور الإيراني في العراق. وهي مشاعر اتخذت أشكالاً شتى، سليمة أحياناً وتتمثل بالانتقادات الشديد التي يوجّهها ناشطون ومثقفون وسياسيون لسياسات طهران في العراق، وعنفية تمثلت في حرق قنصلياتها التي لها منها إضافة إلى السفارة في بغداد 5 قنصليات في عموم البلاد، خلافاً لبقية دول العالم، وهذا مؤشر آخر على حجم النفوذ الإيراني في العراق.
كربلاء والنجف
مشاعر العداء ضد طهران تفجّرت، وبطريقة غير مسبوقة ربما، ظهرت في مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) التي ما زالت متواصلة. ففي الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقدم محتجون في محافظة كربلاء التي تعد ثاني (هناك مَن يعدها الأول) أهم مركز ديني لدى الطائفة الشيعية في العالم لارتباطها بالحسين بن علي الشهيد، وأقدموا على إحراق القنصلية الإيرانية فيه. وفي يوم 27 من الشهر نفسه - نوفمبر (تشرين الثاني) - هاجم المتظاهرون القنصلية الأخرى في مدينة النجف، وأضرموا النار فيها، ثم عادوا مرتين متتاليتين وأحرقوا إجزاء من القنصلية ذاتها. بل إن بعض الناشطين شبّهوا حينها «تندّراً» قنصلية إيران في النجف بـ«أركيلة» تبغ يتسلى المحتجون في دخانها وحرقها بين حين وآخر. في عمليتي الحرق بكربلاء والنجف، دارت مواجهات عنيفة مع قوات الأمن خلّفت عشرات الجرحى بين المتظاهرين. ويقول مقربون من صناعة القرار الإيراني إن «القنصليتين في النجف وكربلاء مثلث أحد أكبر الصدمات غير المتوقعة لصناع القرار في طهران، وقد جاءت بعد سنوات من النفوذ وشبكة واسعة من العلاقات والمصالح في أهم مدينتين شيعيتين».
قد تبدو عمليات حرق القنصليتين ذروة ما وصل إليه الغضب الشعبي في النجف وكربلاء خاصة والعراق عموماً ضد الهيمنة الإيرانية التي باتت لا تطاق بنظر غالبية السكان منذ سنوات، لكن ذلك لا يقلل من أهمية عوامل أخرى مماثلة قام بها المتظاهرون في بغداد وبقية المحافظات. حيث عمدوا إلى حرق الكثير من صور المرشد الإيراني علي الخامنئي وقائد فيلق «القدس» التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، وردد المتظاهرون في غالبية الساحات أهازيج وشعارات منددة بإيران. كذلك قام متظاهرون في النجف مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتغيير اسم «شارع الإمام الخميني» وسط المدينة إلى «شارع شهداء ثورة تشرين». وشملت التصرفات الاحتجاجية المناهضة لإيران إطلاق حملة واسعة لمقاطعة بضائعها في العراق وأطلق الناشطون منذ أسابيع هاشتاغ «خلوها تخيس» بمعنى «دعوها تتعفّن».
البعد القومي
المحامي والناشط محمود الخزرجي في كربلاء يرى، أن أسباب الكره الشعبي للإيرانيين في كربلاء والنجف كثيرة «بعضها متغلل ذات طابع قومي عربي - إيراني يعود لعقود طويلة، وبعضها يعود للسنوات القليلة الماضية». وعن أسباب السنوات الماضية، يقول الخزرجي لـ«الشرق الأوسط» شارحاً: «ثمة وعي متنامٍ لدى الأجيال الجديدة من الشباب التي باتت تدرك حجم الخطر الذي تمثله إيران على مصالحهم ومصالح البلاد بشكل عام، وباتوا يدركون حجم التغلغل الإيراني في جميع مفاصل الدولة والمجتمع، وحجم النظرة الاستعلائية التي يمارسها الإيرانيون في كربلاء والنجف».
ويضيف الخزرجي: «هناك أيضاً، شعور متنامٍ لدى الشباب في كربلاء والنجف أن الحكومات المحلية في المحافظتين واقعة تحت سيطرة ونفوذ الإيرانيين، إلى جانب الكره التقليدي الذي يكنّه سكان المدن الدينية لبعض رجال الدين، ثم جاءت الهيمنة الإيرانية على طيف واسع من المعممين لتزيد نقمة الشباب وغضبهم».
ويشير الخزرجي إلى سبب آخر يرى أنه وراء أسباب النقمة ضد الإيرانيين وحرق قنصلياتهم وهو أن «كربلاء تتألف من خليط سكاني تتحدر أعداد كبيرة منه من الطبقات الفقيرة في محافظات الجنوب العربية، وهؤلاء تحديداً، ينظرون غالباً بازدراء وعدم احترام لمن يطلقون عليهم توصيف (العجم)». ويضيف: «لا ننسى الدور الذي مارسته القنوات الإعلامية المموّلة إيرانياً في تضخيم دورها على حساب التضحيات التي قدمها العراقيون في الحرب ضد «داعش»، ومثّل استهانة بأرواح شباب العراق. هذا التضخيم المتعمد للدور المزعوم أدى إلى خلق مشاعر كراهية واسعة ضد إيران».
على أن عملية حرق أخرى مماثلة قام بها المتظاهرون وطالت القنصلية الإيرانية البصرة مطلع شهر سبتمبر (أيلول) 2018، مثلت ربما الشرارة الأولى لعمليات الحرق اللاحقة، التي تشير بوضوح لا يقبل التأويل إلى حجم الغضب الشعبي العفوي في المحافظات العراقية ذات الأغلبية الشيعية ضد نفوذ إيران وهيمنتها على العراق منذ سنوات، وهذا على رغم ما تردده إيران وأتباعها من أنها عمليات مخطط لها من قبل جهات وأجندة خارجية.
المحور الإيراني الواضح
ومع ذلك، لا يمكن بأي حال النظر إلى عمليات الحرق وجميع الأفعال المناهضة لإيران التي وقعت خلال الاحتجاجات العراقية التي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بوصفها لحظة آنية مبتورة عن سياقها الممتد منذ سنوات الذي ترجح اتجاهات غير قليلة تفاعله وبروزه للعلن منذ عام 2011. الذي شهد انسحاب القوات الأميركية من العراق، ودخوله لاحقاً على المستوى السياسي الرسمي ضمن المحور الإيراني. ومعروفٌ، أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كان قد أعلن دعمه لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد تماهياً مع الموقف الإيراني الرافض للانتفاضة الشعبية السورية التي تفجّرت في فبراير (شباط) 2011. ولذا نرى أنه بعد نحو 5 سنوات من ذلك التاريخ، ظهرت للعلن لأول أهزوجة «إيران بره بره... بغداد تبقى حرة» المعادية لحكم الولي الفقيه ونفوذه في العراق في هتافات المتظاهرين الذي اقتحموا مبنى البرلمان في 30 أبريل (نيسان) عام 2016.
مناهضة نفوذ إيران وغيرها في العراق، لا يقتصر على المواطنين العاديين وجماعات الحراك، إنما يتعداه إلى المرجعية الدينية في النجف وإن لم تشر إليه بشكل صريح مطلقاً، لكنها شدّدت في كثير من خطبها على سيادة العراق ورفض التدخلات الخارجية، وحول موقف مرجعية النجف وعلاقتها بنظام ولاية الفقيه في إيران يقول الباحث علاء حميد إدريس إن: «مرجعية النجف لا تتبنّى مبدأ ولاية الفقيه، رغم التشابه بين المرجعيتين، فهما يختلفان في التعامل مع السياسة والسلطة. إذ لم تكن السياسة حاضرة في ذوق مرجعية النجف طوال مراحل حضورها الاجتماعي والديني، ولا يأتي تدخّلها إلا بعد حصول أزمة أو يطلب منها التدخل».
ويضيف إدريس: «تنبع مرجعية النجف المتمثلة بالمرجع الديني للسيد علي السيستاني مع أن دورها يعتمد على النصح والإرشاد فيما يتعلق بالعراق بشكل مميّز دون بقية الدول التي يوجد فيها مسلمون شيعة، على العكس من المرجعية الدينية في إيران التي يعبّر عنها المرشد الإيراني علي الخامنئي؛ والتي تعمل على إيجاد نفوذ وحضور في أغلب مناطق الإقليم ومنها العراق، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، والبحرين، واليمن». ويرى أن «مساحات النفوذ تكشف أن كلتا المرجعيتين مختلفتان بشكل ملموس في الأسلوب والعمل؛ فمرجعية النجف تعتمد مبدأ مسافة التوجيه؛ والمقصود بها الابتعاد عن الدخول في تفاصيل قضايا الشأن العام، أما مرجعية إيران فإنها تعمل ضمن مبدأ الحضور في تفاصيل تلك القضايا انطلاقاً من مبدأ ولاية الفقيه على عموم المسلمين».
ما فعله «داعش»
الكاتب الصحافي والمحلل السياسي سرمد الطائي، يرى أن «لحظة اجتياح تنظيم داعش للعراق كانت صدمة أنتجت وعي الجيل الجديد الذي لاحظناه يستهدف رموز إيران في البصرة وجنوب العراق خريف 2018. وفي هذا إدراك أن العراق يصبح تدريجياً كبش فداء في مواجهة دولية تقوم بها إيران، ولذلك ظهر رأي عام عراقي يرفض أن تنتقل أزمة مضيق هرمز إلى بغداد».
ويقول الطائي، الذي عاش شطراً من حياته في إيران إبان معارضته لحكم الرئيس الراحل صدم حسين لـ«الشرق الأوسط» إن حرب «داعش» الطويلة أدت إلى تشجيع جيل الشباب الكاره للحرب، على إدراك أن التغيير والإصلاح ليس رغبة عابرة كمالية، بل تحوّل حاسم هو مسألة حياة أو موت، لمنع القرارات الحمقاء في السياسة والأمن والاقتصاد.
وينظر الطائي إلى جيل الاحتجاج الجديد بوصفه «جيلاً مختلفاً عن سابقه ولا يمثل أهواءً سياسية بل ينتج عن تحول اجتماعي عميق يجب أن يؤدي إلى تحول سياسي، وهكذا فإن المجتمع الذي شهد توافق 2003 لم يعد مقرراً وحاسماً في عراق 2018 وما بعده من مظاهرات البصرة ولاحقاً مظاهرات تشرين.
وهذه العوامل مجتمعة، بحسب الطائي «أنتجت ثقة وطنية كبرى على أنقاض الفشل السياسي، لم تعد تتقبل أن يصبح العراق كما يردد قادة حرس الثورة الإيرانيين، مجرد مساحة نفوذ لطهران، فكانت مهاجمة المقرات التي ترمز لنظام إيران إعلاناً بسيادة عراقية جديدة يفرضها التحول الاجتماعي لا الطبقة السياسية الخائفة أو أو الحذرة من سطوة الجنرال قاسم سليماني».
محفّزات كثيرة
ومن جانبه، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري، أن ثمة محفزات كثيرة لحالة العداء ضد إيران في الشارع العراقي، منها «دعمها لمعادلة السلطة التي أنتجت حكومة عادل عبد المهدي التي شكل أغلب أطرافها قوى وفصائل وثيقة الصلة بإيران، وبعد أن صورت هذه الحكومة باعتبارها المنقذة للبلاد، وجد العراقيون أنها حكومة تمثل أجندات خارجية وتسعى إلى ترجمة الرؤى الإيرانية على حساب الداخل العراقي». ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: إن «جولات عبد المهدي الخارجية بدت وكأنها محاولات لوقف تصاعد الخلافات بين واشنطن وطهران، مما دفع كثيرين للتساؤل عن جدوى ذلك، وهناك حريق داخلي في البلاد».
ويعتقد الشمري أن العامل الاقتصادي كان من بين أهم محفزات العداء الشعبي ضد إيران، حيث إن «تعامل إيران الاقتصادي واستحواذه على السوق العراقية وبالتالي إسهام ذلك في إيقاف النمو الاقتصادي العراقي على الصعيدين الحكومي والخاص أدى إلى ما يشبه عملية استلاب تام لاقتصاد البلاد دفع الناس وحرضهم على النقمة». وتضاف عوامل أخرى كان لها الدور الحاسم في إثارة الرأي العام العراقي ودفع المتظاهرين إلى حرق القنصليات الإيرانية، ضمنها «طبيعة التصريحات الاستفزازية التي أطلقها قادة إيرانيون ومست بشكل وثيق السيادة العراقية، خاصة تلك التي تتحدث عن تابعية العراق لإيران وارتباطه بمحور ما يسمى بالمقاومة، إلى جانب التصريحات التي أطلقت ضد المتظاهرين ووصفتهم بالمشاغبين المدفوعين من قوى خارجية». ولا ننسى طبعاً، والكلام للشمري «طبيعة الشخصية العراقية التي لا تقبل بالخضوع للأجنبي مهما كان أصله وانتماؤه».
وعن توقّعاته المستقبلية للعلاقة بين العراق وإيران عقب مرحلة حرق القنصليات والمظاهرات المنددة بنفوذها في العراق، يقول: «مهمة الحكومة المقبلة صعبة ومعقدة، وعليها أن تعمل بجد لوضع العلاقة بين البلدين على أسس من المصالح المشتركة وليس على أساس التابعية، وتوقعاتي أن تكون ضمن أولويات الحكومات المقبلة القيام بعملية شاملة لإعادة تقييم العلاقة بين البلدين وما عدا ذلك فإن الغضب الشعبي ضد إيران سيتزايد بمرور الأيام».
بدوره، يرى الباحث في علم الاجتماع السياسي عبد الرزاق علي، أن «السلوكيات العنيفة للأشخاص أو للجماعات وللسياسات في التحليل السوسيولوجي هي ذلك الشعور بالكره والرعب واللاتسامح. وعادة ما تكون هذه السلوكيات بالاندفاع والتصرف الخارج عن السيطرة». ويقول علي لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث في مدن البصرة وبغداد والنجف خلال الاحتجاجات الماضية والحالية وما نجم عنها من إقدام المحتجين على اقتحام وحرق القنصليات في النجف والبصرة ومحاولتهم الوصول وحرق السفارة الإيرانية في بغداد ما هي إلا تعبير عن الشعور بالكراهية واللاتسامح مع السياسة الإيرانية المتعلقة بالعراق». يشير الباحث علي هنا إلى المحاولات المتكررة للمتظاهرين في بغداد للوصول إلى السفارة الإيرانية في جانب الكرخ عبر جسر السنك والخلاني المؤديين إليها، مما أدى إلى وقوع خسائر كثيرة بين صفوف المتظاهرين نتيجة للاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية المرابطة على الجسرين.
تدخلات إيران بعد 2003
ويضيف علي أن «حقبة ما بعد 2003 شهدت تدخلات إيرانية محمومة للتدخل وصناعة جزء من المشهد السياسي العراقي وبحسب مؤشرات كثيرة دعمت السياسة الإيرانية وسعت جاهدة إلى تأسيس قوى سياسية وميليشياوية متعددة خدمة لمشروع وسياسات محددة تمثل مصالحها الاستراتيجية بغض النظر عن تقاطعها مع المصالح الوطنية العراقية». ويشير إلى أن «جيل الاحتجاج الحالي في الوسط والجنوب العراقي يمثل التعبير الجلي والواضح للشعور المتنامي لدى أغلب الشرائح الاجتماعية والتي ترفض سياسات إيران وتدخلاتها وصناعتها ودعمها لفصائل مسلحة وغير مسلحة تعمل بالضد من تطلعات المجتمع العراقي الذي ترزح غالبية أفراده في واقع غارق في الفساد والفشل والمعاناة من سياسات نهبوية تريد للعراق أن يبقى حديقة خلفية لإيران، وحاجتها لأن يكون العراق خط الصد الأول بمواجهة صراعها مع القوى الغربية».
ويتفق الباحث عبد الرزاق علي على أن «تصريحات القادة الإيرانيين ووسائل الإعلام الإيرانية المتعلقة بالعراق شكلت حالة من الاستفزاز والشعور العميق بسلب الإرادة الوطنية وربما حتى الإحساس بالمهانة والحيف والظلم في قرارة الشخصية العراقية، وتحديداً لدى جيل الشباب المحتج غير المتحدر بعقد آيديولوجية أو طائفية».
دور إيران في العراق... قبل الثورة السورية وبعدها
> يصعب النظر إلى عمليات الحرق التي طالت القنصليتين الإيرانيتين في كربلاء والنجف، بوصفهما أفعالاً تمثل لحظة ثورية أقدم عليها شباب غاضبون لا يدركون أهمية ما فعلوا، وتالياً النظر إليها كلحظة منقطعة الصلة بما قبلها من مشاعر عداء وغضب ضد إيران ونفوذها.
ذلك أنه منذ نحو عقد ونصف، ظل التساؤل حول إيران ودورها في العراق وما إذا كان مفيداً أو ضاراً يعاود الظهور بأشكال شتى وفي كل مناسبة تقريباً. وإذ نظرت قطاعات شيعية غير قليلة إلى الدور الإيراني قبل عام 2011 (العام الذي سحبت فيه الولايات المتحدة قواتها من العراق وانطلاق الثورة السورية) بنوع من القبول والتعاطف باعتباره داعماً للعهد الجديد الذي انطلق بعد 2003. فإن تلك القناعات باتت تتراجع شيئاً فشيئاً بعد ذلك التاريخ الذي انكشف فيه «الغطاء» عن الدور المهيمن لإيران، عبر سلسلة تصرفات قام بها حلفاؤها من الساسة وقادة الفصائل المسلحة، بصبر وسرية عاليين بتكريسه في العراق.
على مستوى الشارع نشط أتباع إيران بعد ذلك التاريخ في الترويج العلني للولي الفقيه عبر نشر صوره في الساحات والأزقة الشعبية في صورة لم يسبق لها مثيل، وبدأت الفصائل المسلحة تتحدث علناً عن «محور المقاومة» التي تنتمي إليه وتديره إيران.
وعلى المستوى السياسي، نشط رئيس الوزراء حينذاك نوري المالكي، بدعم إيراني واضح، في مطاردة خصومه من الساسة السنة البارزين أمثال نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي.
وبعد بضعة أسابيع على انطلاق الثورة السورية في فبراير (شباط) 2011، أرسل المالكي وفداً رسمياً رفيعاً ضم أعضاء بارزين من حزب «الدعوة» لدعم حكم الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي فهم على نطاق واسع محلياً على أنها كانت الخطوة الأولى لزج العراق فعلياً في المحور الإيراني وما تلا ذلك تداعيات وصعود «داعش» واحتلاله نحو ثلث الأراضي العراقية. ومن ثم، ما ترتب عليه من صعود واضح لجنرالات إيران مثل، قاسم سليماني وغيره في الحضور الدائم داخل الأراضي العراقية بذريعة مساعدة البلاد في حربها ضد التنظيم الإرهابي.
من هنا يمكن اعتبار عام 2011، نقطة انطلاق إيران الواسعة في العراق بعد سنوات من العمل السري من جهة، ومن جهة أخرى لحظة تصاعد التساؤلات المحلية المعترضة على ذلك الدور وطبيعته التي مهدت لاحقاً لجميع الأفعال الشعبية المناهضة لإيران.