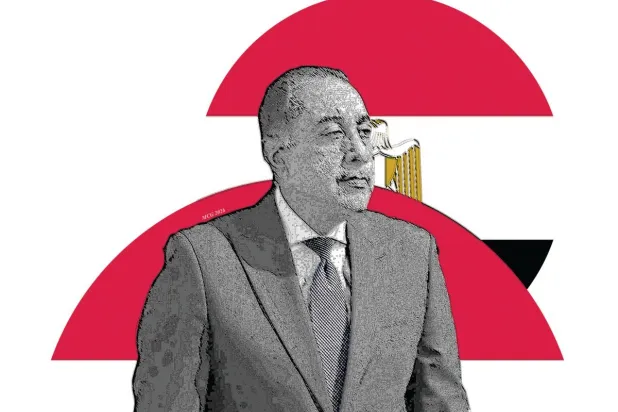لم تكن الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد عام 2003 تتوقع هذا النمط من المظاهرات التي سرعان ما تحولت إلى احتجاجات واسعة النطاق.
الأيام الأولى منها، حين اندلعت في الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حصدت أرواح مئات القتلى وآلاف الجرحى في سابقة لم تحصل من قبل. وبينما قدمت الحكومة والبرلمان حزما إصلاحية هي الأكبر من نوعها منذ 16 سنة، فإنها لم تؤثر سواء في زخم الاحتجاجات وتنوعها أو في تنوع سقوف مطالبها التي وصلت إلى حد الدعوة إلى تغيير النظام. والمتظاهرون، بعد وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، أعلنوا عن تأجيل مظاهراتهم إلى يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي الذي يصادف مرور سنة كاملة على تولي رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي مهام منصبه.
تنفست الطبقة السياسية في العراق الصعداء خلال فترة أسبوعين في وقت بقي زخم الإعداد للمظاهرات المليونية المقبلة بدءا من يوم الـ25 من الشهر الحالي قائماً على قدم وساق، على الرغم من استمرار تقديم التنازلات من قبل الحكومة، بما فيها فتح المزيد من فرص التوظيف أو الخدمات، وتوزيع قطع الأراضي، وإعادة النظر في الرواتب والامتيازات لكبار المسؤولين ولشرائح أخرى في المجتمع.
وفضلاً عن دعوات المرجعية الدينية للتهدئة، فإن تنسيقيات المظاهرات بقيت مستمرة في التحشيد ورفع سقف المطالب دون أن تلتفت إلى ما يصدر عن البرلمان والحكومة العراقية. وفي أثناء ذلك صدر التقرير الخاص بلجنة التحقيق بالأحداث التي رافقت المظاهرات، والتي طلب المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيلها «لكي تبين حقيقة ما حصل، ومن هي الجهات والأطراف التي قصرت في عملها... المتمثل حصراً في حماية المتظاهرين ممن أطلق عليهم المندسّين والقنّاصين».
تحقيق مخيب للآمال
وفي حين كان العراقيون ينتظرون نتائج التقرير لكي تكشف الحقيقة، أو جزءاً منها في الأقل، لتضع النقاط على الحروف، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير في سحب البساط من تحت أقدام الجهات التي بدأت تركب موجة المظاهرات، فإن نتائج التقرير نفسه جاءت مخيبة للآمال.
ذلك أن التقرير لم يكشف حقيقة ما حصل بشكل مهني كما كان مأمولاً. وبدلاً من أن يوضح هوية الأطراف التي تتحمل مسؤولية إطلاق الرصاص الحي، أو كيفية دخول مندسّين إلى قلب المظاهرات في ظل وجود أجهزة أمن ومخابرات واستخبارات، فإنه حمّل المسؤولية لعدد من القادة العسكريين من قادة العمليات أو قادة الشرطة في المحافظات التي وقعت فيها المظاهرات، وهي في غالبيتها، العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
مفارقة دستورية
طبقا لتجربة المظاهرات في العراق منذ عام 2011 بالتزامن مع الربيع العربي آنذاك، فإن كل توقعات الطبقة السياسية الحاكمة في العراق ما كانت تتعدى ما هو مطلبي عام، يمكن حله بطرق وأساليب مختلفة ما دامت تقع تحت سقف الدستور الذي يضمن حرية التظاهر. والواقع أن الفصل الخاص بالحريات بالدستور العراقي يُعد من أفضل فصول الدستور الذي تقع مهمة إلغائه في مقدمة مطالب المتظاهرين الآن.
وفي حين حرص كتاب الدستور العراقي، الذي سبق التصويت عليه بنسبة زادت على الـ80 في المائة من أبناء الشعب العراقي - وبخاصة في الوسطين الشيعي والكردي عام 2005 - على جعل المواد الخاصة بالحقوق والحريات، وكذلك النظام الفيدرالي من بين أهم مواده التي اعتني تماماً بصياغتها، فلقد بدت المواد الأخرى ذات الطبيعة السياسية الخلافية مملوءة بالألغام التي لا أحد يتوقع متى تنفجر.
وفي حين بدأت الخلافات مبكرة حول المادة 124 الخاصة بالتعديلات الدستورية التي حددت وقتذاك سقفاً زمنياً لا يتعدى الشهور الأربعة لتعديل المواد الخلافية فيه، فإن الخلافات استمرت حتى هذا اليوم دون أن يتمكن الأفرقاء السياسيون من حسم تعديل المواد الدستورية العالقة.
المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين المركز وإقليم كردستان، وفي مقدمتها محافظة كركوك، ظلت مادة خلافية حتى اليوم، مع أن الدستور حدد لها سقفاً زمنياً لا يتجاوز عام 2007. يضاف إلى ذلك وجود أكثر من 50 مادة دستورية بقيت جامدة حتى الآن، بسبب فشل الكتل والأحزاب والقوى السياسية في تنظيمها بقانون طبقاً لما ينص عليه الدستور. انطلاقاً من ذلك، فإن المطلب الأول للمظاهرات بات الآن هو تغيير الدستور، بعدما كانت المطالب في البداية لا تتجاوز الخدمات مثل فرص العمل والسكن والضمان الصحي والاجتماعي.
حسابات مؤجلة
ربما كانت أكثر المفارقات اللافتة في المظاهرات العراقية اليوم المطالبة بتغيير الدستور بالدرجة الأولى، وتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، وكتابة قانون انتخابي جديد، هي أنها انطلقت من أوساط الشباب حصراً... وفي المناطق والأحياء ذات الغالبية الشيعية من بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية.
وبينما يفسّر عبد الله الخربيط، النائب في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار - ذات الغالبية السنية - في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، امتناع العرب السنة عن المشاركة في المظاهرات بأنها تهدف إلى «تجنب توجيه اتهامات جاهزة للسنة بأن خلفها حزب البعث والإرهاب و(داعش)، فإن خروج المتظاهرين من قاع الأحياء الشيعية الفقيرة، بما فيها العشوائيات، يؤكد أن النظام الذين راهنوا عليه والذي تقوده غالبية شيعية حاكمة لم ينجح في تحقيق ما كانوا يأملون بتحقيقه».
ويرى الخربيط أن «المطالب العامة للمظاهرات صحيحة، وهي مطالب مشروعة وكان ينبغي أن تتحقق خلال السنوات الـ16 الماضية... لكن فشل نظام المحاصصة الذي تشارك فيه الجميع (الشيعة والسنة والكرد) هو الذي فجرّ الغضب الجماهيري». وبيّن النائب أن «طبيعة رد الفعل القاسية من قبل القوات الأمنية، أو بعضها على الأقل، على المتظاهرين ما كان مبرراً. وبالتالي فإن دخول السنة في المظاهرات كان من الممكن أن يخلق مشكلة على صعيد كيفية التعامل معهم... خصوصاً أن لهم تجارب سلبية سابقة، عندما أدت إلى حصول مشاكل كبيرة وهو ما مهّد فيما بعد لدخول (داعش) واحتلالها المحافظات الغربية».
غضب المناطق الشيعية
أما لماذا تفجّر الغضب الشعبي في أوساط الشيعة، وتحديداً، مناطق الوسط والجنوب، فإن لذلك أسبابا و«سيناريوهات» مختلفة؛ منها أن الجيل الجديد من أبناء هذه المناطق، وإن كان لا يختلف عن سواه من أبناء المكوّنات الأخرى (السنة والكرد)، بات ينظر إلى أن الطبقة التي تصدّرت السلطة، وهي شيعية في المقام الأول، لم تحقق له ما كان ينتظره من وطن يتمتع بكل ما تتمتع به الأوطان من عيش كريم وفرص عمل متساوية وعدالة اجتماعية وحكم رشيد. وهذا، مع العلم، أن العراق بلد غني بموارده وثرواته.
من ثم، بدت الحسابات التي انطلق منها هذا الجيل مؤجلة، وتعود إلى 16 سنة مضت. وطبقاً لطبيعة الحكم الذي يتركز بيد الشيعة - الذين لهم رئاسة الوزراء التي تتضمن كل الصلاحيات - كان ينبغي أن يكون حال العراق في وضع أفضل بكثير مما هو عليه اليوم، ولا سيما، أن معظم الشيعة الفقراء يقطنون في منازل بائسة في عشوائيات ومدن صفيح. ومن ثم، فإن فقراءهم يشعرون بالمفارقة من أن تكون السلطة بيدهم... وأن يتركّز الغنى والثروات في يد قلة قليلة ممن كانوا يعيشون خارج العراق وجاؤوا إليه مع الاحتلال الأميركي عام 2003.
الحلول والسقوف والأولويات
هذه أول مظاهرات في العراق تدخل شهرها الثاني، في وقت يزداد زخمها الجماهيري لتشمل مؤخراً طلبة الجامعات والمدارس الإعدادية. وبينما بدأت المظاهرات شيعية مناطقية (أحياء بغداد ذات الغالبية الشيعية) ومحافظات الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية، فإنها تحولت إلى وطنية عامة تقريباً بعدما انضمت إليها أحياء ذات غالبية سنّية من العاصمة بغداد. وفي الوقت الذي لم تخرج مظاهرات في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنّية خشية أن يجري اختطافها، كما حصل في مظاهرات عام 2013 التي مهدت لعودة تنظيم «داعش»، سجّلت مساهمات من بعض تلك المحافظات بإرسال مواد غذائية وطبية إلى المتظاهرين في ساحة التحرير.
مع كل ما تقدّم، فإن هذه المظاهرات، بدلت تعاطي السلطات العراقية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مع مطالب المتظاهرين. وباتت تراها كجزء من الحلول الضرورية الممهدة للحل النهائي لمشكلة النظام السياسي في البلاد. وهذا، رغم عدم وجود أهداف موحدة للمظاهرات فضلاً عن عدم بروز قيادات لها... ما يجعل سقوفها مرتفعة مرة ومتناقضة مرة أخرى.
وفي هذا السياق، في إطار الحلول المقترحة من قبل السلطات الثلاث في العراق وصلتها بالسقوف المتضاربة للمظاهرات... تتجسد المشكلة بالأولويات. إذ في حين تكاد تتفق الطبقة السياسية بكل قواها على أن أهداف المظاهرات سلمية ومشروعة، فإنهم يرون أن البداية هي تقديم الحلول ذات الطابع الخدمي (فرص عمل وسكن وضمان صحي واجتماعي)... وصولاً إلى إصلاح بنية النظام الأساسية بدءاً من تعديل الدستور، وإقرار قانون انتخابات جديد، وإمكانية تحويل العراق من نظام برلماني إلى رئاسي.
غير أن المتظاهرين يرفضون إصلاحات الحكومة، مهما بدت جادة، لأنهم يريدون البدء بإصلاح النظام أولاً. وعليه، فهم يصرون مرة على إقالة الحكومة، أو إلغاء النظام كله مرة أخرى... من دون وجود خريطة طريق يمكن أن تتحقق من خلالها مثل هذه الآلية.
تصويت البرلمان... والفساد
البرلمان العراقي من جهته، صوّت على حزمة من القرارات والإجراءات عدّت الأقوى منذ عام 2003، الذي يشكل بداية النظام السياسي الجديد في العراق.
من بين أهم القرارات التي اتخذها البرلمان: إلغاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية في الأقضية والنواحي، وهو ما يُعد أقوى ضربة للحكم المحلي في البلاد.
كذلك قرر البرلمان تشكيل لجنة لتعديل الدستور العراقي. وصوّت على إلزام الحكومة عدم الجمع بين راتبين، ومن بينها رواتب رفحاء التي أثارت على مدى سنوات جدلاً في الأوساط العراقية بسبب جمع المشمولين بها راتبا لكل فرد في العائلة. كما صوّت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والمناصب الكبرى في البلاد.
القضاء من جهته، اتخذ إجراءات استثنائية بشأن مكافحة الفساد في البلاد. وقال المجلس في بيان له إنه «على ضوء ما يجري من أحداث وبعد المداولة الإلكترونية، والاجتماع الطارئ بين رئيس مجلس القضاء الأعلى مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فقد توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك».
وأضاف: «كما يعلن المجلس أن المادة الثانية الفقرة 2 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ تنص على أن يعد من الأفعال الإرهابية (العمل بالعنف والتهديد على هدم أو إتلاف أو أضرار عن عمد مبان أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة)، كذلك يعد بموجب الفقرة 5 من المادة الثانية المذكورة عملاً إرهابياً مَن يعتدي بالأسلحة النارية على دوائر للجيش أو للشرطة أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القطعات العسكرية الوطنية، وأن هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب».
وفي هذا الصدد، أكد سعيد ياسين موسى، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، الذي يترأسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى على صعيد بدء إجراءات فعالة لمحاربة الفساد، سوف تؤدي إلى حسم نحو أكثر من 12 ألف ملف فساد كانت محمية في السابق بسبب التأخير في الإجراءات الإدارية التي كانت تمثل سياجا منيعا لحماية الفاسدين».
وأضاف موسى أن «تأخير حسم تلك الملفات لم يكن بسبب القضاء، بل بسبب التحقيقات الإدارية التي كان يحق لرئيس الدائرة - الذي هو برتبة وزير أو وكيل - تأخيرها لأسباب مختلفة، وبالتالي لا تصل إلى القضاء للبت فيها، وهو ما تم تجاوزه الآن». وبيّن أن «من بين الـ12 ألف ملف فساد كان قد حسم نحو 8000 آلاف منها، بينما بقيت قضايا مهمة تعد بالآلاف. ولذلك بدأت الآن مثل هذه الإجراءات الحاسمة لتضع الأمور في نصابها الصحيح، حيث صدرت مذكرات قبض بحق كثيرين ممن كانوا محمين لهذا السبب أو ذاك».
ليس هذا فقط، فإن إجراءات القضاء شملت إجراءات رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد، وهي مسألة كانت من الصعوبة بمكان خلال الفترات الماضية. ولقد قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي البدء بنفسه، حين طلب من البرلمان رفع الحصانة عنه وعن نائبيه، في محاولة منه لتشجيع السلطة التشريعية على المضي في إجراءاتها الهادفة إلى بدء مرحلة جديدة من العمل الرقابي في البلاد.