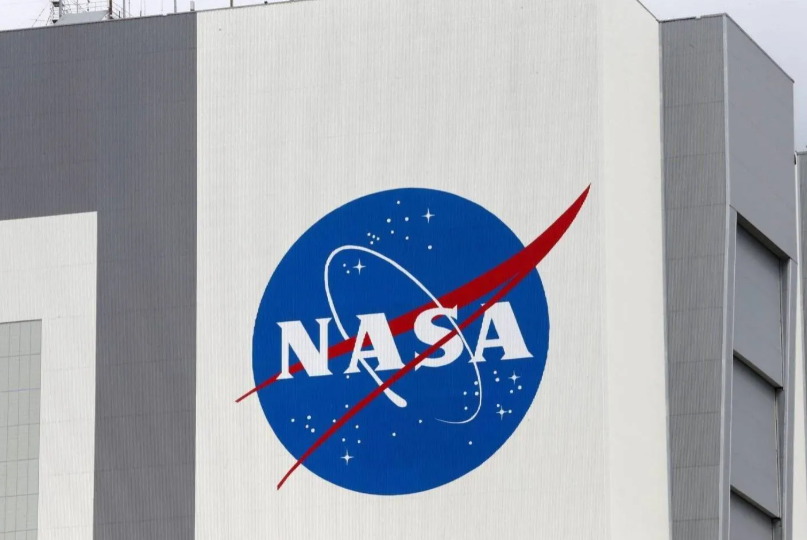لو كانت السياحة ديناً، فمدينته المقدسة البندقية. هي المكان الذي يزور محبي السفر في أحلامهم ويناديهم، مثلما تفعل المدن المقدسة في أحلام المؤمنين.
وبمجرد أن يتحقق الحلم، لا بد من شهقة عند مصافحة المدينة، تشبه في عمقها شهقة دبة الروح في الجسد الفخار.
مغادرة غبشة أو عتمة محطة القطار إلى النور في ساحة سان ماركو بمثابة خروج مفاجئ إلى النهار؛ تتعرض الروح لصدمة مواجهة الجمال الكامل اللانهائي الذي لم يتأهل الزائر للقائه. لن تخفف من دهشته آلاف الصور التي لا بد أنه طالعها للمدينة، وعشرات الأفلام التي تجري في رحابها، فالوجود في المدينة العائمة واستنشاق هوائها شيء آخر.
لا يثير الكمال إلا أفكار الموت والعزلة الأبدية. البنايات الباذخة بقبابها المذهبة المزججة تبدو المثال الأعلى لمدينة، لكنها محاصرة بالماء. ورغم أننا نعرف أن هذه البنايات عاشت قروناً تحت هذه الظروف، لا يمكننا إلا أن نفكر في أثر الماء على جدرانها، وأن نفكر بفنائها أكثر مما نفكر بفناء أي مدينة أخرى.
ولا ينحصر مجاز الموت الذي يسكن الماء في الخوف على مصير المدينة، بل يمتد إلى مصير الزائر نفسه. وهو ليس خوفاً صِرفاً، وإلا كان رد الفعل صرخة فزع صريحة، وليس شهقة عجماء.
الماء أكثر العناصر نشاطاً وإرباكاً في اللاوعي، ليس كالنار التي تذهب في اتجاه الموت والتطهير العنيف، وليست له الأمومة المستقرة للتراب محتضن البذرة، وليست له خفة وأثيرية الهواء. هو مُطهر، وهو كذلك مصدر التلوث الأسوأ عندما يأسن، هو صانع الحياة والنماء بقدر ما هو صانع للموت، وعلى الأقل هو طريق الموت، وهو في هدوئه مفعم بالأنوثة والأمومة، لكنه يصبح ذكراً عندما يهتاج ويبتلع.
والماء في البندقية ليس ضيفاً لطيفاً ينتشر ويتحرك بحساب كضيف، كما الماء في أمستردام مثلاً، لكنه الأساس والأصل، وما تلك البناءات الكبيرة القديمة وسط الماء إلا أعجوبة صنعها جبروت الإنسان وعناده في لحظة انقضت.
يبدأ التمهيد للهوية المائية للمدينة قبل الوصول، حيث تختفي اليابسة بأشجارها التي تجري في الاتجاه المعاكس، ويجد المسافر نفسه في رفقة اللجة الرصاصية من الماء، ثم يبدأ القطار في تهدئة سرعته ليدخل حذراً إلى المحطة.
هروباً من الماء الذي تركوه خلفهم للتو، وربما فضولاً لرؤية المدينة، يتدافع حجاج البندقية لحظة مغادرتهم المحطة بابتهاج وصخب جنود عائدين من الحرب، لكنهم يجدون أنفسهم في مواجهة الماء مرة أخرى، بينما تتشبث أقدامهم بمواضعها وسط الزحام على شريط من اليابسة صغير مثل مرساة، وسيتأكدون بعد جولتهم الأولى في المدينة أن هذا الشريط الضيق المدهش هو أكبر ساحاتها.
عندما تكون بينهم في تلك اللحظة، ستشعر بأمان يعززه الحمام المطمئن بين الأقدام. وعندما ترفع عينيك عن الأرض، ترى في نظرة واحدة كنيسة القديس مرقس، بتأثيرات البذخ البيزنطي في قبابها، وخيول واجهتها المذهبة، ومقهى فلورين الشهير.
البناء الإلهي غارق في وحدته المتعالية، والدنيوي صاخب ببشر يأكلون ويشربون ويتكلمون بأيديهم وبأفواههم وعيونهم، يبدون للقادم الجديد كأنهم الكفار الذين أنكروا الله والخطر. كيف يلهون هكذا والماء لم يزل كثيفاً إلى الحد الذي يجعل خبر انحسار الطوفان غير مؤكد؟!
أول رغبة للزائر، بعد مصافحة المدينة المائية مباشرة، هي الذهاب إلى أرض؛ إلى نزل إقامته للتخلص من عبء الحقيبة، والتخلص من أثر السفر، أو بمعنى خفي: القيام بطقوس التنسيب التي تجعله منتمياً إلى المكان الجديد.
وسائل الانتقال المتاحة محدودة عائمة، مما يعزز الشك بانقضاء خطر الطوفان، الأمر الذي يخلق شكاً آخر، ولو ضئيلاً، في أن يكون النُزُل الذي حجزته حقيقياً موجوداً. وللمفاجأة السارة، ستهتدي إليه بمعاونة ملاحي المدينة، وتنعم بالمأوى. لكن، هل استمتع أحد بنوم ممتد في غرفة بالبندقية؟
عن نفسي، لم أفعل. الزمن الذي أقضيه في الغرفة بالبندقية هو الأقصر على الإطلاق. زرتها أكثر من مرة، وكان لديّ دائماً إحساس بأن شيئاً ما مثيراً أو مخيفاً، لذيذاً أو مؤلماً، يجري بالخارج، ولا بد أن أخرج لألقاه ولا أدعه يقتحمني في عزلة الغرفة.
يلهيك بذخ العمارة عن الانشداد للماء بعض الوقت. ستتكفل القناطر بحل مشكلة التنقل من ضفة إلى أخرى فوق القنوات الضيقة، وتقوم الجنادل والصنادل بحملك عبر القنوات الأوسع. ومع الوقت، تعترف بالهزيمة، وتبدأ استسلامك للعائق المائي مُخفِّضاً من حركتك، مكتفياً بالانتقالات الضرورية، حيث أدركت بشكل واضح محدودية حريتك.
عمارة البندقية ليست باذخة فحسب، بل مهرطقة.
في المدن الأخرى، يتواضع البناء البشري، ويترك للبناء المنذور للرب تفوقه من حيث الحجم واختلاف العناصر والموتيفات المعمارية من القباب والأبراج وتيجان الأعمدة وزخارف الواجهة وحجم الفضاء الذي يتمتع به البناء، كحرم يُمهِّد الزائر لإدراك عظمته، لكن تجار البندقية الأثرياء كانوا يبنون لأنفسهم بيوتاً لها من الضخامة والفخامة ما للبيوت التي يبنونها للرب.
التنافس المعماري غير المحسوم بين البشري والسماوي من جهة، والتنافس بين اليابسة والماء المحسوم لصالح السيولة المهدِدة من جهة أخرى، يجعل المدينة جميلة إلى حد مؤلم، مثيرة للتشوش إلى الحد الذي رآها عليه آشنباخ بطل توماس مان.
المطلق الذي أثار نوازع الموت لدى توماس مان في نوفيلا «الموت في البندقية» أدركته لطيفة الزيات كذلك وتوحدت معه.
تقول في مذكراتها «أوراق شخصية»: «توصلت إلى المطلق في مرحلتين مختلفتين من عمري، وفي مكانين مختلفين عن بعضهما اختلاف النهار والليل، الجمال والقبح. توصلت إلى التوحد في ميدان (سان مارك) بالبندقية لحظة غروب، وفي ظلمة بئر بيتنا القديم، وأنا أتوحد مع الموت».
لنا أن نلاحظ حضور الماء في الحالتين اللتين شعرت معهما لطيفة الزيات بتهديد المطلق، ومن المدهش أن تتوصل كذلك إلى إدراك يشبه إدراك آشنباخ، بطل توماس مان: «أدرك الآن أني سعيت العمر لما هو مطلق، وأن المطلق قرين الموت».
لكي تقاوم حزن البندقية، عليك أن تتسلح بنظرة سطحية، تضرم النار في وقتك بالتقاط الصور وشراء التذكارات وزيارة مشاغل الحرف اليدوية، أما التعمق فخطر، سواء انتبهت إلى هرطقة العمارة، أو تعمقت في الإشارات المتضاربة للماء، فالبحر أحد وجوه اللامتناهي في الكون، وكل ما لا نحيط بحدوده جميل مخيف. مع ذلك، فماء البندقية ليس بحراً تماماً، هو مستنقع آسن عكر، لا يرقى إلى صورة الخالد المطلق، ولا موج فيه يستدعي رمز القوة.
ربما عاين سكان المدينة وزوارها القدامى شيئاً من ذكورة الماء، عندما كانت أموج البحر الأدرياتيكي تغمر المدينة العائمة، لكن المصدات التي أقيمت تباعاً لتقليل أثر المد نزعت عن الماء ذكورته، مثلما تعرض النيل للإخصاء ببناء السد العالي.
صار ماء المدينة الهامد أنثى طوال العام، لكنها أنثى عاقر، فاختلاط الطين بالماء المالح يبقى عاجزاً عن صناعة حياة. يظل مجرد ممر للمماحكات المالية والجنسية في جنادل سوداء مبطنة بقطيفة طوبية كتيمة تُذكَّر بمراكب الموت. لا يحتاج زائر البندقية إلى قراءة توماس مان لكي يقع على الموت في المظهر الكئيب للجندول. لكن غاستون باشلار يضع يدنا على السر الغافي في لا وعي كل منا: «إذا أردنا حقاً أن نُعيد إلى المستوى البدائي القيم اللاشعورية المُتراكمة كلها حول جنازات مُعينة، من خلال صورة الرحيل على الماء، فسوف ندرك على نحو أفضل دلالة نهر الجحيم وجملة أساطير المأتم.
يمكن لعادات معقلنة قبلاً أن تُحسن عهدة الأموات إلى القبر أو إلى المحرقة، بينما اللاشعور الذي يسمه الماء، سوف يحلم، فيما وراء القبر، وفيما وراء المحرقة، برحيل في البحر» (باشلار، الماء والأحلام، ترجمة: د. علي نجيب إبراهيم).
أساطير الغرب المتعلقة بالماء والإبحار ليست بعيدة عن المخيال الشرقي، مركب كارون في الميثولوجيا اليونانية الذي يحمل أرواح المتوفين حديثاً، عبر نهري ستيكس وأشيرون، ليس بعيداً عن مركب الشمس التي تحمل جثة الفرعون في النيل إلى حيث يقابل روحه في البر الغربي، ويتحد معها مجدداً وإلى الأبد. ولا يمكن لصورة الملاح الذي يبدو شبحاً يمضي على الماء بضوء خفيف في ليل البندقية إلا أن تستدعي رهبة رحلات العالم السفلي.
كثافة الموت هي التي تستنهض قوى الحياة في الزائر ربما إلى حد الهذيان الحسي. آشنباخ أنفق وقته في مطاردة صبي غافل، وفي كثير من الأفلام الأميركية تذهب المرأة متوسطة العمر إلى فينسيا حالمة بمغامرة مع رجل إيطالي حار ساذج. وتجد ضالتها في بائع هدايا، ولا تفرح المسكينة بحبيب المصادفة السعيدة حتى يتشقق قناع العاشق، ويظهر من تحته وجه التاجر، وإذا بها تخرج من دكانه محملة بالإحباط، وبما لا نفع له من الأشياء غالية الثمن.
زائرة واحدة أعرفها زارت فينيسا دون أن تتألم، وذلك ببساطة لأنها لم ترها، ولم تعانِ جمالها المؤلم، ولم تتعلق بسحر رجالها المبالغ فيه. تلك الزائرة هي كوني بطلة «عشيق الليدي شاترلي» (رواية د. هـ. لورانس).
وصلت السيدة شاترلي إلى المدينة العائمة منشغلة عنها بحمل في بطنها من عامل بسيط يساعد زوجها القعيد في الصيد، ولم يكن مصاب الحرب الأرستقراطي العاجز يمانع في أن تلد له زوجته وريثاً من عشيق أرستقراطي، فذهبت إلى البندقية لتقنعه عندما يبدو تكور بطنها أن الحمل ثمرة مغامرة مع رجل يستحق قابلته في البندقية.
نجاة كوني لانشغالها بما تركته وراءها لا يهدد قاعدة النهايات الحزينة التي تمنحها البندقية لزوارها وزائراتها، خصوصاً الزائرات.
وإذا ضربنا صفحاً عن فاجعة موت آشنباخ، الرجل الذي اجتمعت عليه سوداوية توماس مان وسادية فيسكونتي في الفيلم الذي حمل عنوان النوفيلا «الموت في البندقية»، فمن بين كثير الأفلام التي صورت في البندقية من النادر أن نرى امرأة تحصل على نهاية سعيدة.
- كاتب مصري