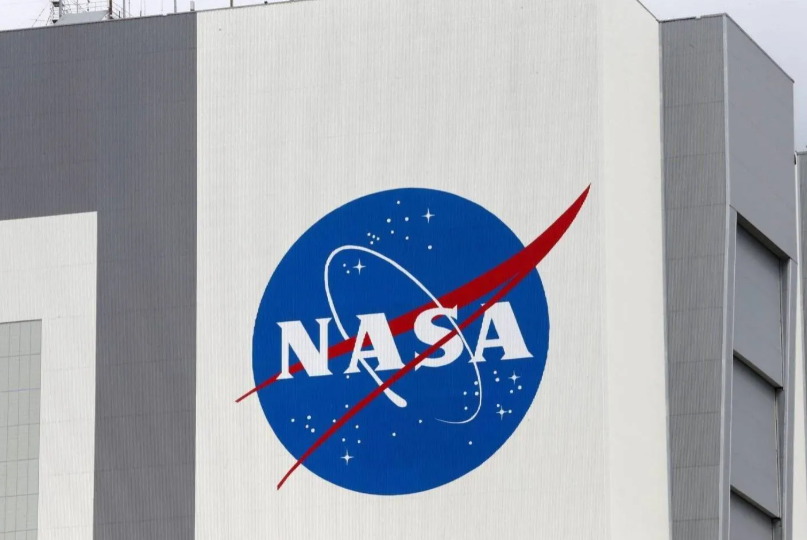تلعب نهى محمود في روايتها «سيرة توفيق الشهير بتوتو»، الصادرة حديثاً عن «دار بتانة»، على وتر الحارة المصرية، تقلِّب في ماضيها وعلاقات بشرها الفقراء البسطاء، وما آلت إليه أحلامهم، في واقع اضطربت فيه المعايير والقيم، حتى أصبحت الحارة كياناً عشوائياً يجب بتره وإزالته من الوجود، تحت شعارات تطوير وتجميل وجه المدينة الشائخ، الذي طفت فيه بثور الزمن، وغبار الفساد والإهمال.
ما تشير إليه الكاتبة في البداية بجملة تتناثر كلازمة نصية في نسيج الرواية، قائلة: «في الحارة التي كانت جديدة وزاهية في زمن آخر، ثم نال العجز والتراب من روحها وبيوتها، تلك البيوت القديمة غير المتناسقة، والشرفات المفتوحة على وسعها، والبشر وحكاياتهم».
نحن إذن إزاء مرثية للحارة، تجتهد الرواية في رصد ملامحها وتفاصيل حياتها، مستخدمة تقنية يتضافر فيها إيقاع «الاسكتش» الفني، لتوسيع أفق الرؤية بصرياً وزمنياً، خصوصاً في حيز مكاني ضيق ومنكفئ على ذاته، كما تلجأ إلى إيقاع التقرير الصحافي لتوثيق أحوال البشر في هذا الفضاء، وما يدور بينهم من صراعات ومشاحنات وحروب صغيرة.
تتسم لغة الرواية بواقعية قحة، حيث حكي الحارة في «عَبلِه» العشوائي، وبداهة تقاليده وأعرافه الشعبية المألوفة والمعتادة بين ناسها، فيخفون تحت قشرة هذه البداهة الرجراجة صورهم الحقيقية، ويتلاعبون فوق سطحها بكل ما يمكنهم من حيل الكذب على أنفسهم، وعلى واقعهم أيضاً. لكنهم مع ذلك يرون في بساطتها الجارية عزاءهم من القلق والخوف، وفرصة للتلذذ بفتات المباهج الصغيرة في الحياة، ودلالة على الوجود في المكان... «فهنا، كل شيء محتمل وقابل للحدوث».
ومن ثم، لسنا أمام رواية سيرة ذاتية للشخوص، محكومة بضمائر حكي معينة، وإنما سيرة ذاتية للمكان داخل الشخوص، مفتوحة بروح البداهة على فضاء شتى الضمائر، يبرز فيها اليومي في أنساق سردية متباينة، كلغة عادية متداولة في حوارات الشخوص، مشرّبة بمسحة من العامية الدارجة، وحس لا يخلو من الفكاهة والسخرية والمفارقة في بعض المواقف الخاصة، بيد أن التمثيل الأمثل لهذه اللغة حين تتحول إلى طقس، وفضاء للونس والأمل، وهو ما يتجلى على نحو لافت في حكاية «جماعة الكراسي» الذين اتخذوا من مدخل الحارة مكاناً لجلوسهم ومسامراتهم، تصفهم الرواية (في ص 32) على هذا النحو: «كانت الجلسة تجمع أربعة أو خمسة من الرجال الذين خرجوا على المعاش من وظائفهم، ومن دون اتفاق حملوا كراسي خشبية وجلسوا في تلك الرقعة، يراقبون الرائح والغادي، يلقون التحية على الجميع، يسألون الشباب عن حال أهلهم، ويبتسمون للشابات، ولسان حالهم يقول: نحن هنا للحماية».
حين يعترض «فاروق» السمج، أحد سكان العمارة، ويتهمهم بانتهاك خصوصية الآخرين، والاعتداء على ملكية الحكومة، حيث يجلسون على الرصيف... يلجأون إلى استئجار محل مغلق، يتقاسمون ثمن إيجاره فيما بينهم، ويقومون بطلائه بأنفسهم وتنظيفه، وينقلون جلستهم أمامه، بل يصرون على عمل افتتاح كبير له، وهو محل فارغ لا يبيع شيئاً، وليس به سوى كراسيهم وبعض الكراكيب التي جلبوها من بيوتهم، لتمتزج رمزية الونس بروح الحارة، وحكمتها أيضاً، كفضاء إنساني للأخوة والمحبة.
تتنوع أنماط الحكي بين فصول الرواية الثمانية، وصفحاتها التي تناهز المائة، بتنوع أنماط الشخوص وهوياتهم، وما انتهت إليه مسيرة بطلها «توتو»، الشاب المريض نفسياً، ولعنة «كوكو»، فأره المتخيل الذي يسميه ويكلمه ويبث له أوجاعه وأحزانه، بعد أن تسبب الظن في وجوده داخل المصيدة في مقتل والديه. هذا الخطأ الكارثي الذي وقع فيه توتو، بعد أن استيقظ مبكراً ذات يوم، ولم يجد ثمار الطماطم الكافية لصنع طبق فطوره المفضل له ولوالديه «جبن بالطماطم»، فأخذ ثمار الطماطم المسمومة المتناثرة على الأرض حول المصيدة، ظناً منه أنها سقطت من الكيس عندما أحضرها والده. لقد أراد توتو أن يريح والدته المتعبة، ويعد الفطور بنفسه، لكنه أراحها هي ووالده إلى الأبد.
تؤجل الكاتبة «الساردة» إماطة اللثام عن حقيقة هذه الكارثة إلى الفصل الأخير في الرواية، مكتفية بعبارات هامشية من قبيل التأسي والشفقة والترحم على ما نجم عنها، ما يجعل حضور توتو يبدو متطفلاً في معظم تلك الفصول السابقة، وليس خالصاً لذاته، وإنما يتوقف على حضور أطراف أخرى، مثل «أم طارق» جارته الأرملة «الخمسينية» التي يتلصص على جسدها من شرفته المقابلة لحجرتها، بينما تطفو على السطح شخوص كثيرة تتخم الرواية، وتصيب القارئ بالتشتت والإحساس بالمتاهة أحياناً، بلا مبرر فني اللهم الوجود في الصورة، أو المشهد، خصوصاً أننا إزاء علاقات نمطية، يسودها منطق التشابه والتكرار، يفرزها المكان بتلقائية شديدة، تنعكس على شخصيته، وتؤثر في صراعات ناسه مع ذواتهم وواقعهم الاجتماعي.
نعم، قد تكون هذه الشخوص الهامشية بفقرها وجوعها وإحباطها ومخاوفها فاعلة في واقعها المادي المعيش، لكنها دون ذلك في النص، الوجود الموازي لهذا الواقع الذي تصنعه الرواية. وعلى سبيل المثال، شخصية «سيدة» الشحاذة السمينة التي اتخذت من التسول والنوم في الخرابة وسيلة للعيش، وأصبحت حارسة لها تزود عنها ضد اللصوص والبلطجية... هذه المرأة المخبولة القوية تتمتع بسطوة ما تحت قناع التسول، فالجميع يتعاطف معها بدافع إنساني، لا يخلو من خشية ما... طبيب الصيدلية يعطيها الحبوب المخدرة طواعية وبلا مقابل، و«هَوهَو» صاحب عربة سندوتشات الكبدة والسمين «حين تقف عنده، ودون أن تتكلم يملأ لها رغيفاً»... حتى أننا يمكن أن نجد صلة ما، ولو في الخلفية، بين خبلها وبين «توتو» الذي لا يخلو من الخبل أيضاً... يتوقف قلب «سيدة» عن النبض في ليلة شتوية باردة، بعد أن أعطاها محسن، الشاب النحيل تاجر المخدر الأبيض، بعض الأقراص، فيأخذها إلى بيته. وبحسب الرواية (ص22. 23) «سيجدها الناس في الصباح نائمة فوق فرشة أم عاشور (بائعة الخضراوات)، متدثرة بالغطاء الخيش، زرقاء ومغمضة العينين، وميتة».
وكلك شخصية الشيخ حسن، الذي طرد السكان من عقار قديم يملكه، وبني عليه عمارة من عشرة أدوار، وزاوية صغيرة للصلاة بالدور الأرضي، حتى يبارك الله في بيته وتجارته، لكنه مع ذلك لم يستطع أن يستر أخته العانس بالزواج، بعد أن خصص لها شقة بالدور الأخير، فتقع في براثن شاب يشترط أن تكتب الشقة باسمه، ثم يتزوجها لليلة واحدة ويطلقها.
يفرض الوجود الموازي حساسية ما في التعامل مع منطقة الظل وكائناتها، فدائما ما تذبل وتنطفئ هذه الكائنات، بل يتم التخلص منها، تحت وهم أنها أصبحت عبئاً على الوجود الأصلي. لكن الأمر ليس كذلك خصوصاً في الإبداع، فهناك شخوص في الظل وجودهم لو تمت تنميته والتعامل معه بعمق وحساسية سينتقلون تلقائياً إلى فضاء الوجود الأصلي، وربما يصبحون أبطالاً. لذلك كان يمكن - برأيي - أن تظل «سيدة» حية، كعين أخرى في المشهد، ترصده وتراقبه من تحت قناع التسول، كراوٍ ضمني، يعضد من حركة السارد الرئيسي، وكان يمكن أن يمتد وجود الشيخ حسن، ولا ينحسر فقط في الفصل الثاني، خصوصاً أنه يمثل رمزية هدامة سالبة لتراث الحارة.
تتعاطف الكاتبة الساردة مع بطلها في واقعة السم الكارثية إلى حد التواطؤ، وتموه عليه، فلا تطرح مجرد علامة استفهام حولها، أو حتى تساؤل عابر، تاركة هذه الفجوة الإنسانية تراوح أمام عين القارئ بين حتمية القدر وحتمية الخطأ، وكأنهما ركنا جريمة ارتكبتها الصدفة، بينما موت شخوص آخرين بطرائق شديدة العبث في الرواية يصبح أمراً عادياً وحمولة زائدة عليها.
إذن... لماذا لم يأكل توتو بطل الرواية من طبق الجبن وهو المفضل لديه؟ لماذا لم يذقه ووضعه لوالديه على الطاولة، ثم انسحب مطمئناً إلى حجرته؟ توتو النهم إلى الأكل بشراهة بشعة، الذي أنفق كل ميراثه من والديه في إشباع هذا النهم، وقطع شوطاً في التعليم حتى المرحلة الثانوية، وأصبح مثاراً للتهكم والسخرية، فهو لا يعمل، ويكره الخروج من البيت، وكان ذروة هذه السخرية إصرار أمه على تزويجه ربما ينعدل حاله، وينتهي مارثون البحث عن زوجة له بفضيحة أخلاقية، بعد أن طلب توتو من أهل العروس والضيوف إخلاء الحجرة ليتحدث مع عروسه على نحو خاص، ثم تصرخ العروس، ويفاجأ الجميع به خالعاً بنطاله. وفي المقهى، ينهال عليه «صديق»، ابن خالة أمه المُكلف بمهمة تزويجه، محطماً زجاج النرجيلة على رأسه، ما استدعي نقله إلى المشفى... لقد طفح به الكيل من ألاعيبه البلهاء، وكاد يفقد في ظلها حياته الزوجية الهادئة.
نحن إذن أمام بطل مجرم، يمتلك إرادة واعية بما يفعل، تكشف عنها مواقفه وذائقته فيما يأكل ويشرب، ويمتلك وعياً بجسده وتؤرقه رغباته الحسية، لكن للحرية حدوداً في التعاطف، لذلك صعب أن أتقبل هذه الفجوة في لعبة روائية مغموسة بكليتها في الواقع، لكنها لم تستطع أن تمارس شكلاً من أشكال القطيعة معه، فظلت حبيسة مصيدة وهمية، صنعتها ذاكرة مضطربة في الداخل والخارج معاً.
سيرة ذاتية للمكان داخل الشخوص
نهى محمود تتواطأ مع بطلها في «سيرة توفيق الشهير بتوتو»


سيرة ذاتية للمكان داخل الشخوص

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة