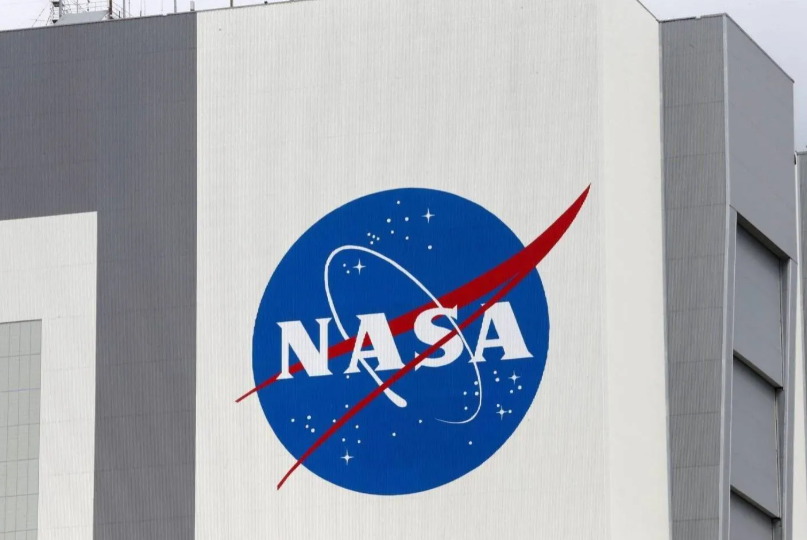أنت أيضاً قد يراودك السؤال الملح وأنت تعاين ما آل إليه حال الشعر والشعراء في زمن العرب هذا، زمن التكفير والحروب والفقر، عندما ترى أنه لم يعد في هذا الكون الشعري العربي المأزوم، واحد من الشعراء يستطيع أن يملأ القاعة أو حتى نصفها أو ربعها بالحضور المتعطش لسماع الشعر. يشتاق الشاعر أن يمر بين الموت والموت، بين فتوى وفتوى، أن يخرج من عزلته التأملية وطقوسه الكتابية إلى الناس، فيقرأ شعره على الملأ، كما كان يفعل محمود درويش مثلاً أمام جماهير لا تسعها مدرجات ملعب رياضي، ومثله نزار قباني وهو يلهب قلوب العذارى يَسلُلْن من تحت مخداتهن قصائده النائمة بين أغلفة من الورد والذكريات، ويلتحقن في أجمل زينتهن مسرعات شغوفات لرؤيته ولقراءته بالصوت والصورة.
أين الشعراء أينهم، أين هي تلك الفصيلة من العصافير المهددة بالانقراض... من سيخرج اللفظ من دلالته الحقيقية نحو المجاز على رأي ابن رشد؟
ما بال الشعر وقد هجر العرب؟
هل تم الخلع بينهما؟
وماذا سيفعل العرب بالمعلقات السبع أو العشر، لا يهم العدد... وماذا سيفعلون بقوانين الخليل بن أحمد الفراهيدي وببحوره التي تجاوز عددها عدد بحور الأرض، وسُلّم «السولفاج» المقدس الذي ورّثنا إياه ودق أطرافه بالحديد، ليتبعه الشعراء العرب إلى نهاية الأرض ونفاد الخليقة والخزينة، ومن دونه ودون شروطه فلا شعر ولا شعراء. ولا يفلح المتأخرون فيما لم يفلح فيه القدماء.
ما العمل إذن؟ هل العرب يفقدون ديوانهم كما فقدوا حروبهم جميعها؟ يا للخسارة. لم ينتعش قلب الشعر ولم يدق على الرغم من الأموال الغزيرة المصبوبة في برامج مرئية ومسموعة لإعادة إحياء الروح فيه، من يحييه وهو رميم اللغة؟
هل هو الشعر الذي مات في العرب، أم أن العرب هم الذين ماتوا في قلب الشعر. فلم يعد ينبض بهم، ولا لهم، ولا على إيقاعات بحورهم، ولا على حداء إبلهم؟
ثم لماذا يفتن الشعر وتجذب أصوات «سيرينات» هوميروس العجيبة مئات العشاق في العالم نحو أماسي قراءات الشعراء بأميركا اللاتينية مثلاً، فيدفع القادم إلى «الحفل الشعري» ثمن تذكرة الحصول على مقعده بين ألفي سامع وأكثر، يدفعون سعر تذاكر حضورهم للتمتع ببهجة الشعر. ولماذا تكتظ ساحة المبنى الأثري الكبير وسط مايوركا، وتنتقل الأسر مساء بكبارها وصغارها، نسائها ورجالها، ليستمعوا إلى إلقاء الشعراء قصائدهم وبلغات عدة. ولماذا تتبرك مدينة لوركا بإسبانيا بالشاعر فريديريكو غارثيا لوركا الذي تحمل اسمه أمام العالمين وتتباهى به، لك السلام يا بلاد سرفانتيس وابن زيدون.
هو السؤال يحفر فينا أخدوده فيترك جرحه الثقافي ندوباً واضحة: هل في أمة الشعر هذه، الممتدة من الماء إلى الماء، بعربها وكردها وبربرها، مدينة واحدة تحمل اسم شاعر، وهم كثر من امرئ القيس إلى أدونيس مروراً بالجواهري والأخطل الصغير والبردوني ونازك الملائكة ومالك حداد وكاتب ياسين.
وها هم عشاق الشعر ببرلين أنفسهم، لا يخطئون مواعيدهم نكاية في دموية هتلر وتطبيقاً لمقولة فيلسوفهم، فيلسوفنا جميعاً، هيدغر الذي قال إن الشعر يساعد على الانفتاح على الوجود. ويشبه الألمانَ السويسريون، فعلى الرغم من قلة ساعات الشمس وضوء النهار إلا أنهم يحبون الشعر. ففي مدينة بيرن ينجذبون نحو قارئي الشعر ومبدعيه بقدر شغفهم بضيفهم الاستثنائي، نزيل سويسرا، الفيزيائي ألبير أينشتاين، حيث يجلس كمانه شاهداً عليه، وبأبهة سامقة في المتحف المركزي.
ما الأمر إذن... لماذا يهجر الشعر من كانوا يعتبرونه ديوانهم قبل الآخرين. وهل الشعر أيضاً يختار أهله بحرية في زمن الديمقراطية والحرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. هل لأنه يهوى التجريب ولا يتجاوب مع السكون، ويتمرد على الجمود الذي يكتنف نظام الأشياء. ألأنه ينفر من المستهلك، وينتعش لكل ما هو جديد كالحياة؟
كثيرة هي الأسئلة وكثيرة هي احتمالات الأجوبة. والحال هو الحال.
تذهب لتلبي دعوة شاعر صديق... الحق يقال إن الحملة الدعائية للأمسية لا عطب فيها... فقد أعلنوا عنها في خط الأخبار السريع أسفل الشاشة على بعض القنوات التلفزيونية، وفيما تبقى من الجرائد الورقية التي أصبحت تقرأ بخجل. ثم إن الشعراء المبرمجين للقراءة، أصدقاءنا من عشيرة اللغة، لم يقصروا أبداً في الإعلان عن موعد أمسيتهم بين أصدقائهم، عبر هواتفهم وعلى حيطان حساباتهم الإلكترونية في «فيسبوك» و«تويتر» وغيرها.
الحق يقال... لم يقصروا في الإعلان عن الأمسية الشعرية لمدة سبعة أيام قبل تاريخ موعدها، وبسبع طرق مختلفة، بحيث إن كل يوم يتفنن كل واحد منهم في نشر الخبر بطريقة يراها أكثر نجاعة مرفقة بصورة منتقاة بحذر.
وتأتي الساعة الحاسمة، وتدخل القاعة تلبية لدعوة الصديق الشاعر، فتجد نفسك أمام مشهد لم يعد غريباً. على المنصة سبعة شعراء يصطفون بكل أدب وبثقة منقطعة النظير، يقرأون الواحد تلو الآخر طوال القصائد وقصارها، بصوت عالي النبرات، وحركات غاية في المبالغة المسرحية، لتبليغ بلاغة المعنى، ويموسقون أواخر الكلمات وأواسطها. كل ذلك في قاعة خالية اللّهم إلا من سبعة شعراء آخرين هم الجمهور، جالسين في الصف الأول من القاعة قبالتهم، يقبض كل منهم على حزمة أوراق، ينتظرون على أحر من الجمر دورهم التاريخي للصعود إلى المنصة، حينما يكمل السبعة الغلاظ هؤلاء دورهم في القراءة، سيصعد الشعراء السبعة بعد أن تنزل الجماهير السبعة الذين كانوا الشعراء السبعة، وكل من الشعراء السبعة، والجماهير السبعة، يتوعد الآخر أن يعلمه من أين تؤكل كتف الإبداع. حينها يرن في جمجمتك صدى ما قاله ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: كان الشعر يُنشد على الموتى.
- كاتبة جزائرية