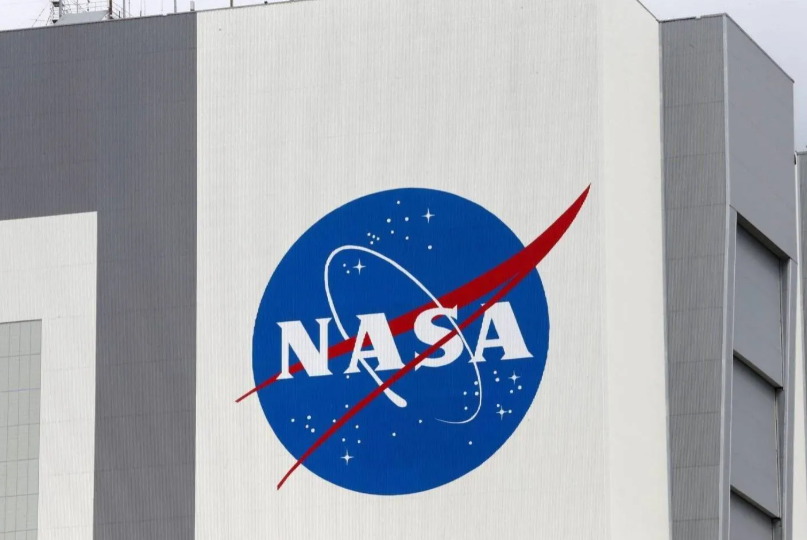لا يعرف العرب في مختلف دولهم أشياء كثيرة عن الصين ونهضتها الحديثة. وباستثناء أفراد قلائل يتواصلون مع نظرائهم في ذلك البلد لأغراض تجارية ولوجيستية محضة فإن تصوراتنا عن أكثر دول العالم سكاناً لا تتعدى «كليشيهات» بالية تراكمت في عقلنا الجمعي بحكم الانخراط العربي شبه الكلي في الثقافة الغربية التي صاغت مفاهيمها عن العالم أجواءُ الحرب الباردة. الصين بالنسبة لنا لا تتجاوز حروب الأفيون القديمة، والشيوعية وهونغ كونغ وتايوان والسور العظيم وجيش التيراكوتا وميدان تيانانمين، وربما سيلاً من البضائع المقلدة الرخيصة والرديئة الجودة أو التجسس الصناعي، بينما لا تزال اللغة الصينية وصفاً دارجاً في غير بلدٍ عربي لكل أمر معقد مستغلق يستحيل فهمه رغم أن الحديث الشريف حض قبل أكثر من 1400 عام مضت على طلب العلم حتى لو كان في الصين.
تلك الحالة من الانغلاق الاختياري تجاه الشرق، وحصر التبادل المعرفي بالغرب، لا سيما بجناحه الأنغلوفوني، ربما كان لها ما يبررها في أوقات مضت عندما كانت بعض الدول العربية لا تزال تخطو خطواتها الأولى في مرحلة بناء الدولة بعد الاستقلال، وفي ظل الهيمنة التامة للإمبراطورية البريطانية ووريثتها الأميركية. لكن الأمور اختلفت ونحن الآن على أبواب الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، ولا بد أن مقاربة مختلفة للعلاقات العربية بالصين أصبحت مستحقة أكثر من أي وقت مضى، فقد تولّت أجيال جديدة شابة مقاليد السلطة في العالم العربي خرجت من عباءة العلاقات الأبوية الطابع بالدول الكبرى، وأصبحت بشكل متزايد أقدر على تعاملات أكثر ندية في علاقاتها الدولية كما اتخاذها القرارات الاستراتيجية. وفي ذات الوقت، فإن صين اليوم على وشك إزاحة دولة العالم الأعظم، الولايات المتحدة، عن عرش الاقتصاد الأكبر عالمياً خلال سنوات قليلة، وهي الآن المستثمر الأكبر في تطوير البنية التحتية والموانئ والاتصالات عبر الكوكب، وقد نجحت في رفع مئات الملايين من مواطنيها خارج خط الفقر ليقربوا مكانة الطبقة الوسطى المنتجة والمستهلكة، التي عادةً ما تدير ماكينة الاقتصادات العالمية.
يحدث هذا في الوقت الذي يشهد فيه الغرب تباطؤاً اقتصادياً، وردة فكرية نحو الفاشيات الخطرة، فيغرق الاتحاد الأوروبي في شباك من أزمات المديونية والبطالة وسياسات التقشف والخلافات بين أعضائه، وتنعزل بريطانيا على نفسها بعد «بريكست»، وتصبح عرضة للتهميش الاقتصادي والثقافي (أقله مقارنة بماضيها الإمبراطوري) وتتجه نحو تفكك شامل لمكونات الهوية البريطانية لحساب القوميات المحلية في الأقاليم الخاضعة لحكم لندن. وتبدو الولايات المتحدة في وارد منافسة جادة على مناطق نفوذها التقليدي، سواء فيما يتعلق بالتعاملات بالدولار أو ولاءات الدول، وذلك بعد استرداد روسيا لعافيتها تدريجياً منذ مرحلة سقوط الاتحاد السوفياتي السابق، ونهضة الصين وأمم آسيا الأخرى، وتكرار محاولات دول أصغر لبناء استقلال جزئي تجاه الهيمنة الأميركية، بل وحتى بناء نطاقات نفوذ إقليمية من الهند إلى تركيا، ومن إيران إلى فنزويلا.
الجيل الجديد من القيادات العربية يفتقر في ظل هذه التحولات الكونية الهائلة على مسرح السياسة العالمية إلى قاعدة معرفية محلية من خبراء وتقنيين ومؤرخين ودبلوماسيين يكون بمقدورها ليس فقط التحدث مع الصين اللغة والثقافة والحضارة والأمة والدولة والشعب، بل وأيضاً امتلاك الكفاءة لعبور العقل الجمعي الصيني والتفكير بطريقته.
يتطلب بناء مثل تلك القاعدة المعرفية في العالم العربي بداية الاستغناء عن النظارات الغربية التي لطالما حصرت فهمنا للصين بمساحة صراع الحرب الباردة العديمة البصيرة واستبدال بها نظرة عريضة ذات عمق تاريخي. مثل تلك النظرة ستضع التحولات الآيديولوجية لصين القرن العشرين والدولة العملاقة التي نتجت عنها في حجمها الحقيقي كمجرد تطور مرحلي ضمن إطار سياق زمني ممتد نحو ماضٍ من ثلاثة آلاف سنة، ولا يخرج عن البنية الجينية لثقافة هذا الجزء من العالم الذي بقي طوال قرون طويلة محور الحضارة البشرية، على الأقل لحين بزوغ الرأسمالية المعاصرة في القرن الثامن عشر التي نقلت مركز الجاذبية – بمعناها الحضاري والثقافي – مؤقتاً نحو الغرب.
هذا العمق التاريخي الذي تستند إليه جمهورية الصين الشعبية بعقودها السبعة (تأسست 1949) يجعل كثيراً من المفاهيم الأساسية عن شكل منظومة الحكم والسلطة وبنية القوة والولاءات فيها مستمدة بشكل أو آخر من تعاليم فلاسفتها ومفكريها القدماء من العهد الكلاسيكي أكثر منها نتاج التجارب الماركسية الأورومركزية، تماماً كما كثير من الأفكار الناظمة للسلوكيات المشتركة بين المواطنين الصينيين العاديين في وقتنا الراهن كأخلاقيات العمل، وأهمية العائلة، وتوقير السلطة والآباء وكبار السن التي تكاد تكون مُستلَّة بحرفيتها من نصوص الحكيم الصيني العظيم كونفوشيوس (551 – 479 قبل الميلاد). ولا شك أن هوس الصينيين بالتعليم والمعرفة كصيغة أكيدة لصعود الفرد ورِفعة مجتمعه معاً إنما هو انعكاس لتجربة قومية طوال 25 قرناً عندما كان يتعين على مَن يأمل الالتحاق بالعمل العام في خدمة الإمبراطور أو الترقي لمناصب سلك الخدمة المدنية العليا أن يتجاوز سلسلة من امتحانات القبول والكفاءة عدة مرات وفي موضوعات مختلفة ثقافية وتقنية.
وللحقيقة، فإن المتابع لمُجريات الحياة في الجمهورية الشعبية المعاصرة وطبيعة النقاشات التي تجري فيها يلحظ بسهولة أن المثقفين على تنوع توجهاتهم الآيديولوجية يسترجعون ويستشهدون بنصوص وأفكار حكماء أمتهم القدماء، تماماً كما يستذكر الغربيون شكسبير وميكافيللي وهيغل ومونتيسكو، ولا شك أن أعرافاً سائدة مثل صيغة المجتمع المتناسق التي تفترض تقديم حفظ اللحمة الاجتماعية ووحدة المجتمع على مصالح الأفراد، أو الاعتقاد بمبدأ وحدة القيادة - قائد أعلى واحد للمجتمع - المُستوحى من النظام التقليدي للأسرة الصينية، أو حتى مبدأ أنه من الأنجع إدارة وسَوْس الجشع البشري للمادة بدل محاولة قمعه بالكلية، وغيرها، مستقاة من أفكار صينية قديمة الجذور بقيت قيد التداول، وتحولت مع مرور الأيام إلى طبيعة ثانية للعقل الصيني، بغض النظر عن كل الرطانات الحزبية والثورية والألوان الحمراء والشعارات الشيوعية.
لا يعني بناء قاعدة معرفية تتولى توفير المشورة لدول العالم العربي بشأن العلاقات مع العملاق الصيني تحولاً جذرياً في التموضعات السياسية إقليمية كانت أو عالمية، ولا حتى المغامرة بفقدان صداقات عميقة وتحالفات بنيوية قائمة مع الغرب، بقدر ما هي لحاق بما تستدرك دول الغرب نفسها القيام به. الأميركيون اليوم ينفقون أموالاً طائلة على مراكز أبحاث وبعثات وأكاديميات معنية بدراسة الصين بكل ما فيها، ولديهم أكبر عدد من الخبراء العالميين بشؤون ذلك البلد بعد بكين نفسها. أما تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، التي عليها أن تواجه الانعكاسات السلبية الحاسمة المترتبة على مشروعها لتنفيذ مسألة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد طارت مسرعة إلى بكين في زيارة دولة محاولة بناء شراكة تجارية عميقة معها، تعوضها عما ستخسره المملكة المتحدة من التجارة مع شركائها الأوروبيين. وليس سراً أن ثمة تغييرات جذرية تتم وفق برنامج قومي شامل في بنية مناهج المدارس البريطانية لمنح فرص لعدد كافٍ من الطلاب البريطانيين لتعلم اللغة الصينية مبكراً ومن ثم تأهيلهم للتخصص الجامعي في مجالات تسمح ببناء جسور تواصل ثقافي وتكنولوجي وتجاري وحتى اجتماعي مع أمة كونفوشيوس، وبينما تتسرب أدوات القوة الناعمة من أيدي القوى الغربية رويداً رويداً لسوء التقدير وتقديم مصالح القلة، يبني الصينيون قواعد جديدة للتأثير العالمي سواء من خلال بناء منصات كونية للإعلام، أو من خلال الاستثمارات الخارجية في معظم دول العالم من آسيا إلى أفريقيا ومن أوروبا إلى الأميركيتين.
إنه موسم الاتجاه إلى الشرق. ولا نملك في العالم العربي هذي المرة أن نكون آخر الواصلين.
ألم يحن موسم الاتجاه إلى الشرق؟
من أجل بناء القاعدة المعرفية في العالم العربي

كونفشيوس

ألم يحن موسم الاتجاه إلى الشرق؟

كونفشيوس
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة