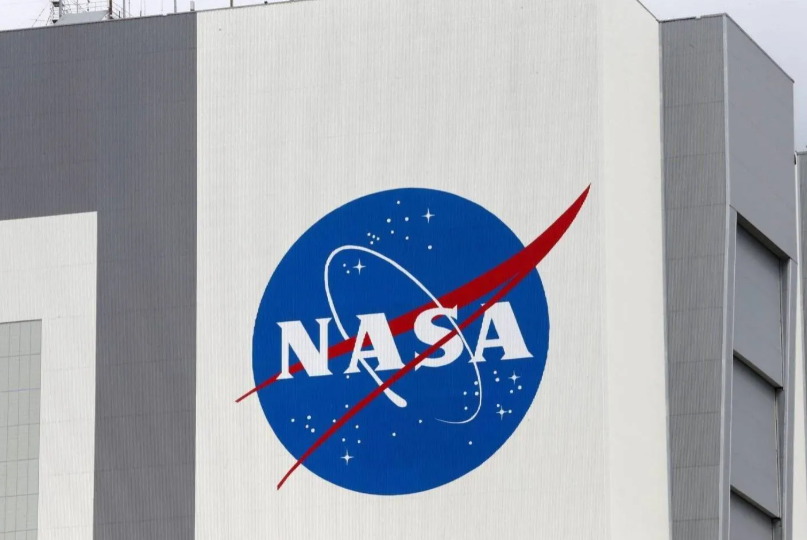كان أرنست همنغواي ينصحنا بأن لا نكتب إذا كنا نستطيع أن لا نكتب. هذه الاستطاعة تعني أن الكتابة عندنا ليست سبب وجودنا وجوهره. قد تكون ملحقا جميلا بهذا الوجود، شيئا إضافيا أردناه عن وعي أو نصف وعي، أو ديكورا خارجياً يزين ذواتنا. لكنه ليس هناك في النخاع، ليس هو ما يشكل دمنا وأعصابنا، وخلايا أدمغتنا. إنها ليست نحن.
أول من طبق ذلك هو همنغواي نفسه. حاول أن لا يكتب نسخة أخرى من «وداعا للسلاح» أو «الشمس لا تزال تشرق» أو «العجوز والبحر»... حاول ذلك صادقاً. أصبحت الكتابة عصية عليه. ولكن همنغواي ليس شيئا آخر سوى الكتابة. ظل ذلك العجز يحفر في أعماقه عميقاً. لم تسعفه جائزة نوبل، ولا شهرته الأسطورية، ولا حياته الصاخبة، ولا نساؤه. لا شيء يعوض عن الكتابة. كان يعرف أنه ليس همنغواي من دون الكلمات. والكلمات لا تعني عند همنغواي وزملائه من «بناة العالم» الكبار، من هوميروس إلى آخر مبدع، سوى شيء واحد: عملية خلق كبرى. أن تخلق أو تموت. وبعد صراع ممض مع الكتابة، جاءت تلك الطلقة التي أفرغها في رأسه الفخم لتنهي ذلك العذاب الأليم: العجز عن الخلق.
وهل فعل ذلك العابر الهائل الخطوات، آرثر رامبو، شيئا آخر؟ امتلأ بالكلمات وهو في التاسعة عشرة، حتى غص بها، وانتحر على طريقته الخاصة: هرب من الكلمات، إلى اليمن ليتاجر بالمواشي أو السلاح.
ومن أبقى الألماني العظيم هولدرلن نزيل مستشفى الأمراض العصبية ثلاثين سنة كاملة غير عذاب الكلمات؟ وحل الفرنسي العظيم الآخر، جيرار دو نيرفال، ضيفا على المستشفى نفسه في باريس. حتى هناك، كانت الكلمات لا تفارق شفتيه وهو يرقد على سرير «الجنون»، فكتب أجمل قصائده «نزهات وذكريات» و«أوريليا» و«الحلم والحياة». وبعد لياليه البيضاء، السوداء، كما كتب مرة، توجه إلى شجرة وسط العاصمة الفرنسية ليتوحد معها إلى الأبد. وهو بعد في الرابعة والأربعين.
هنا يصبح السؤال «لماذا نكتب» سؤالاً زائداً، لا معنى له. سؤال منطقي عن أكثر العمليات الإنسانية غموضاً... ظاهرة لا منطق لها. لا أحد يعرف كيف أتت، ولا أين تمضي. ولماذا تصيب هذا وليس ذاك. لا سبب هناك ليكون هناك جواب.
يذكر الروائي ريتشارد روسو، الحائز على جائزة بولتزر، في كتابه «سارق القدر»، الصادر حديثاً عن «ألان وآنوين» أنه عرض ما يكتبه على روبرت داون، أستاذه آنذاك في الكتابة الإبداعية في الجامعة فقال له الأخير: «معظم الكتاب يكتبون ألف صفحة من النثر الرديء ثم يمزقونها. في حالتك أنت تحتاج إلى ألفي صفحة»!
ويقول لنا روسو إن الكتابة صعبة كالحياة نفسها. لكن روسو مع اليأس، وما يسميه أحد النقاد «انتقاص الذات»، بدأ درسه الروائي الجدي مع نفسه بالمثابرة اليومية، وحيداً في عزلته ووحشته، باحثاً عن «الحقيقة التي يمكن أن تبني حياة». لكنه يذكر أيضاً أولئك الكتاب الذين كانوا يتمتعون بموهبة أكبر منه، كما يعترف. لكنهم انطفأوا.
التاريخ مليء بالكتاب المنطفئين، حتى قبل أن يتوهجوا. ربما غصوا أيضاً بالكلمات. وزحفت اللاجدوى لتعطل العقل والحس، وتملأهما بالظلام، كما هتف سارتر مرة في أوج يأسه: ماذا يستطيع الأدب فعله؟ وأنقذته الفلسفة.
9:11 دقيقه
لماذا نكتب؟ سؤال لا معنى له
https://aawsat.com/home/article/1689306/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%9F-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%87



لماذا نكتب؟ سؤال لا معنى له


لماذا نكتب؟ سؤال لا معنى له

مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة