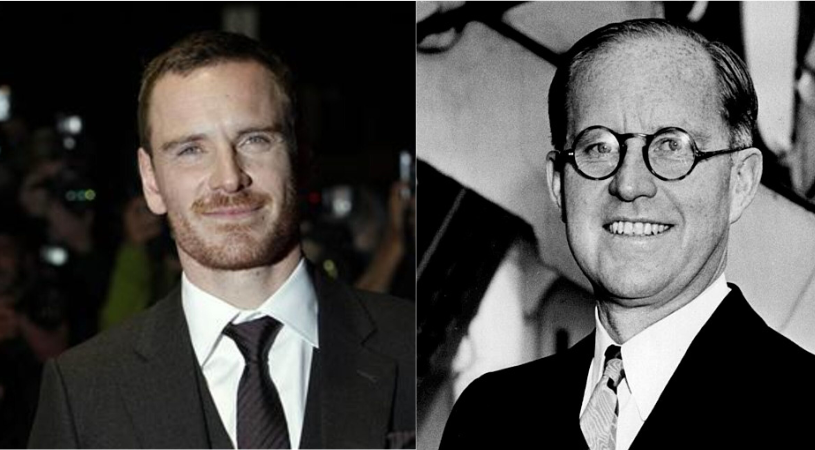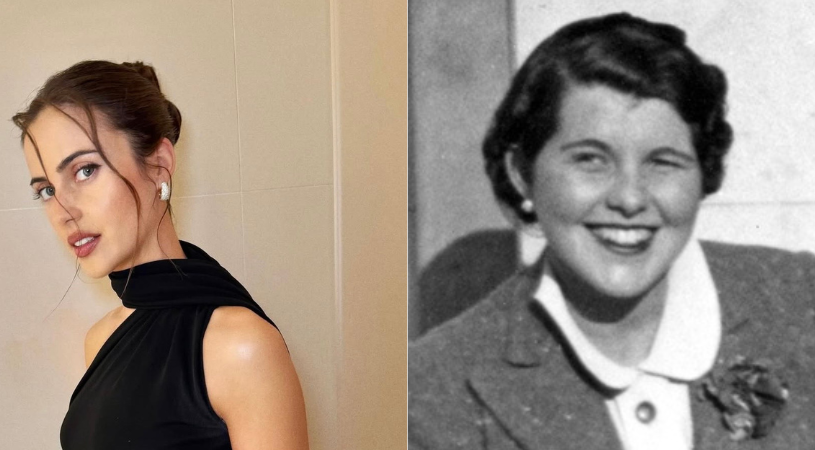ليست الكتابة في عمقها سوى رسائل من نوع ما يبعث بها الكتّاب إلى جهات متعددة العناوين، دون أن يتلقوا بالضرورة إجابات عنها. وهذه الجهات قد تكون أنفسهم بالذات، وقد تكون بشراً أو أماكن وأزمنة مفقودة. قد تكون مسدّدة باتجاه المرئي الذي يهمنا أن نبوح له بمكنوناتنا ونتبادل معه الشجون والهواجس ووجيب القلب، أو باتجاه المجهول واللامرئي المستتر وراء غموضه الملغز، كما هو شأن الحياة والحب والموت ومعنى الوجود وأسئلته المرهقة. على أن ثمة فوارق غير قليلة بين الرسائل العامة التي تقارب شتى مناحي الحياة ووجوهها والمعَدّة أصلاً للنشر، وبين الرسائل الشخصية التي يكتبها العاشقون على نحو خاص من دون أن يضعوا في حسبانهم إمكانية تعميمها ودفعها إلى النشر في يوم من الأيام. فحيث يحرص الكاتب في النوع الأول، ومن ضمنه المذكرات والاعترافات وأدب السيرة، على إخفاء قدْر قليل أو كثير من سلوكياته وعيوبه وعوالمه الداخلية، يتخلى في النوع الثاني عن تحفظاته وأقنعته، ويقدم للطرف الآخر كشف حساب تفصيلي عن كل مكابداته وهواجسه ومشاعره المتأججة. وإذا كانت وسائل التواصل الشخصي بين البشر، بدءاً من الحمام الزاجل وعلَب البريد وسعاته ووصولاً إلى الرسائل الإلكترونية، قد حفلت بملايين الرسائل الركيكة أو البليغة، فإن بعض الرسائل العاطفية التي تبادلها عبر الزمن مبدعون ومبدعات متميزون، ترقى من حيث أساليبها التعبيرية العالية وعمقها الدلالي إلى مستويات الأدب الرفيع الذي يتجاوز طابعه العلاقات الثنائية المغلقة على نيرانها ليلامس الأغوار الأخيرة للنفس الإنسانية والهواجس المشتركة بين البشر. لا بل إن الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز يذهب إلى أبعد من ذلك، فيعتبر أن «كل كتابة هي رسالة حب من نوع ما، وأن على المرء ألا يموت إلا بواسطة هذا الحب، وبواسطته يكتب أو يكفّ عن الكتابة».
تبدو الرسائل الأدبية من بعض وجوهها نوعاً من التعازيم التي تهدف إلى الانصهار بالآخر، أو ردم الهوة التي تفصلنا عنه، أو لاستعادته من عهدة الفقدان. كذلك كان حال تيد هيوز الذي أهدى لزوجته الشاعرة سيلفيا بلاث ديوانه الشعري «رسائل عيد الميلاد»، بعد انتحارها المأساوي بسنوات، أو حال جمال الغيطاني الذي حاول في «رسالة في الصبابة والوجد» أن يربط بين حضارة سمرقند الغائرة في قلب التاريخ، وبين الجمال الأنثوي الذي ثُلم قلبه بين قبابها. ومع ذلك فإن الرسائل العاطفية المباشرة تكتسب نكهة خاصة لأنها أقرب إلى البوح الداخلي وهتْك الأحشاء منها إلى الرصانة والحذر وحسابات الرقابة الاجتماعية والأخلاقية. وهي إذ تُنشر على الملأ بعد ذلك، توفر للقارئ النهِم متعة الفضول والتلصص على الحيوات الغامضة لكبار المبدعين وما يكتنفها من تناقضات وشوائب وتصدعات داخلية عميقة. ولهذا تلقف القراء بشغف بالغ الرسائل المتبادلة بين جبران خليل جبران ومي زيادة، أو تلك التي تبادلها هنري ميلر وإنييس نن، أو سيمون دي بوفوار وجان بول سارتر. إن كاف المخاطبَ التي يعتمدها العشاق في رسائلهم تتجاوز الاسم الشخصي للمرسل إليه لتتحول إلى أداة للتقريب بين كل من لفحتهم رياح العشق، أو من ينتظرون بلا طائل حبيباً أرهقهم صدوده أو غيابه الطويل...
قد لا تكون الرسائل الشخصية والعاطفية التي يعمد كتّاب الغرب وساسته وفنانوه إلى نشرها على الملأ مدعاة للدهشة أو الاستهجان، لأن هؤلاء ليسوا محكومين بالتابوهات الاجتماعية والأخلاقية التي تجعل من كل اعتراف حميم أو بوح متجرئ نوعاً من الفضيحة الشخصية المجلجلة. وحيث يتحول أدب السيرة الغربي إلى شهادة صادقة عن الحياة الفعلية التي عاشها الكاتب، فإن معظم النماذج التي قدمها أدب السيرة العربي يعتمد على تمويه الحقائق والتستر على العيوب، وتقدم الحياة كما يرغب الكاتب في عيشها، لا كما حدثت بالفعل. وقد تكون غادة السمان من هذه الزاوية هي إحدى الرائدات الأكثر جرأة على انتهاك المحظورات، والأكثر إسهاماً في دحض المفاهيم الذكورية السائدة في بلاد العرب. ولعله من باب الإنصاف بالطبع أن نذكر نساء مماثلات، من أمثال ليلى بعلبكي في روايتها «أنا أحيا»، وأمل جراح في «الرواية الملعونة»، وصولاً إلى حنان الشيخ ونوال السعداوي وفاطمة المرنيسي وغيرهن. لكن ما يميز غادة السمان، فضلاً عن الأهمية البالغة للسبق الزمني، هو ثراؤها الإبداعي الصادر عن شغف بالحياة قلّ نظيره، وعن شرر داخلي لا يتردد في توزيع نفسه بين الرواية والقصة والمقالة والشعر. وحتى في حواراتها الصحافية التي صدر آخرها في كتاب جامع تحت عنوان «تعرية كاتبة تحت المجهر»، نعثر على الكثير من اللقى والإصابات اللماحة التي لا تكف صاحبة «السباحة في بحيرة الشيطان» عن تسديدها إلى عقول القراء وقلوبهم في آن. فهي من تقول في إجابتها عن سؤال يتعلق بلغة الرواية وواقعها الحالي: «الرداء لا يصنع الراهب، والإناء الكريستالي لا يحتوي بالضرورة أجمل الأزهار». وهي من تصف فيروز بأنها «حنجرة الما وراء». وهي من تعبّر عن صعوبة مهمة التغيير المنوطة بها في عالم عربي بائس بالقول: «إنني لست سوى صَدَفة تحاول أن تُفرغ بحر الأحزان من مياهه».
لم يكن بالأمر المستهجن تبعاً لذلك أن تبادر غادة السمان، وبجرأة نادرة، إلى أن تنشر على الملأ الرسائل العاطفية المؤثرة التي سبق لغسان كنفاني أن بعث بها إليها في منتصف ستينيات القرن الفائت. وإذ تؤكد الكاتبة على عدم امتلاكها لأي من الرسائل التي بعثت بها إلى غسان، وتناشد من يحتفظون بها أن يفرجوا عنها، تبدو مقدمتا الكتاب كافيتين تماماً لإشعارنا بأن ذلك الحب لم يكن أبداً من طرف واحد، وأن علاقة بذلك الألق والبهاء لا يجب أن تكون مدعاة للخجل، أو أن تلفها غياهب النسيان: «نعم كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني، يقرع باب ذاكرتي ويدخل بأصابعه المصفرة بالنيكوتين وإبرة (أنسولينه) وصخبه المرح، يجرني من يدي لنتسكع معاً تحت المطر، ونجلس في المقاهي مع الأصدقاء، ونتبادل الموت والحياة والفرح بلا أقنعة... والرسائل أيضاً». ولم يكن بالأمر المفاجئ في الوقت عينه أن تواجه صاحبة «لا بحر في بيروت» كل هذا القدر من الغبار والضجيج في عالم عربي تقوم معظم أدبياته على التقية الاجتماعية والأخلاقية، وعلى جعل الكتابة شأناً ذكورياً بامتياز، وأداة لإعادة إنتاج السائد في السياسة والدين والأخلاق ونظام القيم. وليس صحيحاً بأي حال الزعم بأن تقديم كنفاني في صورة العاشق المتيم يسيء إلى صورة الرجل المقاوم الذي يمثله، بل الصحيح أنه يقدم الوجه الإنساني المترع بالرقة لذلك المناضل الصلب الذي يرى في الأنوثة المحتجبة والوطن المغيب وجهين لحلم واحد، ويرى في المرأة، أنثى ومبدعة، رمزاً للجمال الأيقوني الذي يشع من وراء قبح العالم وفظاظته. ثم ألم يكن الافتتان بالمرأة المعشوقة هو الوجه الآخر للفروسية عند العرب، منذ خطر لعنترة أن يتوئم بين لمعان السيوف وبريق الشفاه، وحتى القولة الشهيرة «نحن قوم تذيبنا الأعين النجل\ على أننا نذيب الحديدا»، التي ينسبها البعض لأبي فراس الحمداني وينسبها آخرون لسواه. ولن يضير كنفاني في شيء قوله لغادة: «قيل في الهورس شو إنني سأتعب ذات يوم من لعق حذائك البعيد»، ففي لغة العشق ليس ثمة من مجال للشعور بالمهانة، وإلا كيف نقرأ قول بابلو نيرودا لحبيبته: «أريد أصابع قدميك العشرة لكي آكل واحداً كل يوم»! ثم إن في الرسائل من جهة ثانية لغة مشدودة العصب ومترعة بالصور والمجازات: «كيف لم أتمسك بك يا هوائي وخبزي ونهاري الضحوك؟ أيتها المرأة التي مثلكِ لا يُرى، أيها الشعر الذي ولد تحت جفني مثل جناحي عصفور ولد في رحم الريح، أيتها العينان اللتان تمطران خبز القلب وملح السهول الجديبة. يا طليقة، كيف انخلعتِ هكذا عني؟ دونك لستُ إلا قطرة مطر ضائعة في سيل».
تبدو رسائل أنسي الحاج من ناحية ثانية، التي نشرتها السمان بعد رحيله، مفاجئة تماماً لقراء الشاعر الذي كان شديد التكتم على علاقاته وحياته الشخصية. فقد كان أنسي من الخارج غيره من الداخل. كما لو أنه كان يحشو جنونه وفوضاه داخل لغته المباغتة في تشكّلها وتمردها على السائد، فيما كانت ملامحه وسلوكه ينضحان بالرقة والخشوع الخفر. ولعل نعته بالقديس الملعون كان الترجمة المختزلة لمثل هذه المفارقة. على أن ما يلفتنا قبل كل شيء ليس فقط تنويه السمان بأنها لم تكتب لأنسي أي رسالة، بل اكتفاؤها في الآن ذاته بتقديم «حيادي» وشديد الإيجاز تشير فيه إلى مقاهي بيروت القديمة التي كان يلتقي فيها الكتاب والمثقفون، ولم يعد لها اليوم من أثر. أما الإشارة إلى عجزها عن تمزيق الرسائل لما تحمله من قيمة أدبية عالية، فتبدو بمثابة إقرار ضمني بأن علاقتها بأنسي لم تتجاوز حدود إعجابها بتجربته الإبداعية الرائدة. وما يلفت الانتباه أيضاً هو توضيحها للقراء أن أنسي لم يكن متزوجاً لدى كتابة رسائله إليها، فيما لم نجد في تقديمها لرسائل كنفاني مثل هذا التوضيح، كما لو أن الحب عندها لا سواه هو ما يعطي للعلاقات مسوغها ومشروعيتها الأخلاقية. واللافت هنا أن رسائل الحاج السبع كُتبت جميعها في الشهر الأخير من عام 1963 ثم انقطعت بعد ذلك، بما يشير إلى احتمالين اثنين، أولهما انتصار الكاتب لكرامته حين لم يلق من المرأة المعشوقة أي استجابة، وثانيهما أن يكون ما أقدم عليه مجرد مغامرة عاطفية جامحة سرعان ما خمدت نيرانها حين لم تجد سبيلاً إلى التحقق. «إنني بحاجة إليك» يقول أنسي لغادة في غير مناسبة. ولأنه ليس متأكداً من العكس فهو يبذل كل طاقته لكي يثبت لها صدق مشاعره نحوها ووطأة مكابداته. وحيث لا تأتي من الطرف المعشوق إشارات كافية للاطمئنان، تنفلت اللغة من عقالها لتتحول إلى حمى هذيانية ونداءات بلا عناوين: «اذهب أنت. اخرجوا من هنا بسرعة. خذوا الكراسي معكم. كُلوني في الخارج. لا أريد أن أرى أحداً. أحرقوا الكتب جيداً وفلّتوا الذئاب. اتركوا المفاتيح أمامي». وفي خطاب العشق الهذياني هذا ثمة دائماً حالات متناقضة تختلط فيها مشاعر الخجل والانسحاق والندم وتأنيب الذات وصولاً إلى هواجس الجنون والموت. وإذا كان هلدرلن قد رأى الحب بوصفه نوعاً من المرض المخجل، فإن أنسي يعتبر نفسه «مريضاً بسرطان الزمن والخيبة»، في استشراف حدسي مبكر للمرض الذي قتله بعد أكثر من خمسة عقود.
لقد وعدتنا غادة السمان أخيراً بكشف المزيد من المستور، وبنشر المزيد من الرسائل المودعة في مكان من قلبها شديد الظمأ إلى الحب، وفي مكان من عقلها بالغ الاستنارة. وإذا كان هذا الوعد موضع ترحيب واسع من قبَل الأوساط الثقافية العربية، كما يتراءى لي، فإن من حقنا جميعاً أن نطالب الكاتبة التي جعلت من البومة شعارها الأثير أن تُخرج رسائلها العاطفية من ظلمة الأدراج، ليس فقط لكي تقف مع الذين عشقوها على أرض الاعتراف المتبادل والجرأة المتكافئة. بل لكي تميط لقرائها اللثام عن أكثر وجوهها الأدبية التصاقاً بالقلب والتوتر التعبيري والمغامرة الإنسانية.
غادة السمان تنتهك «السرية» العاطفية
من التالي على قائمة الرسائل بعد غسان كنفاني وأنسي الحاج؟

غادة السمان

غادة السمان تنتهك «السرية» العاطفية

غادة السمان
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة