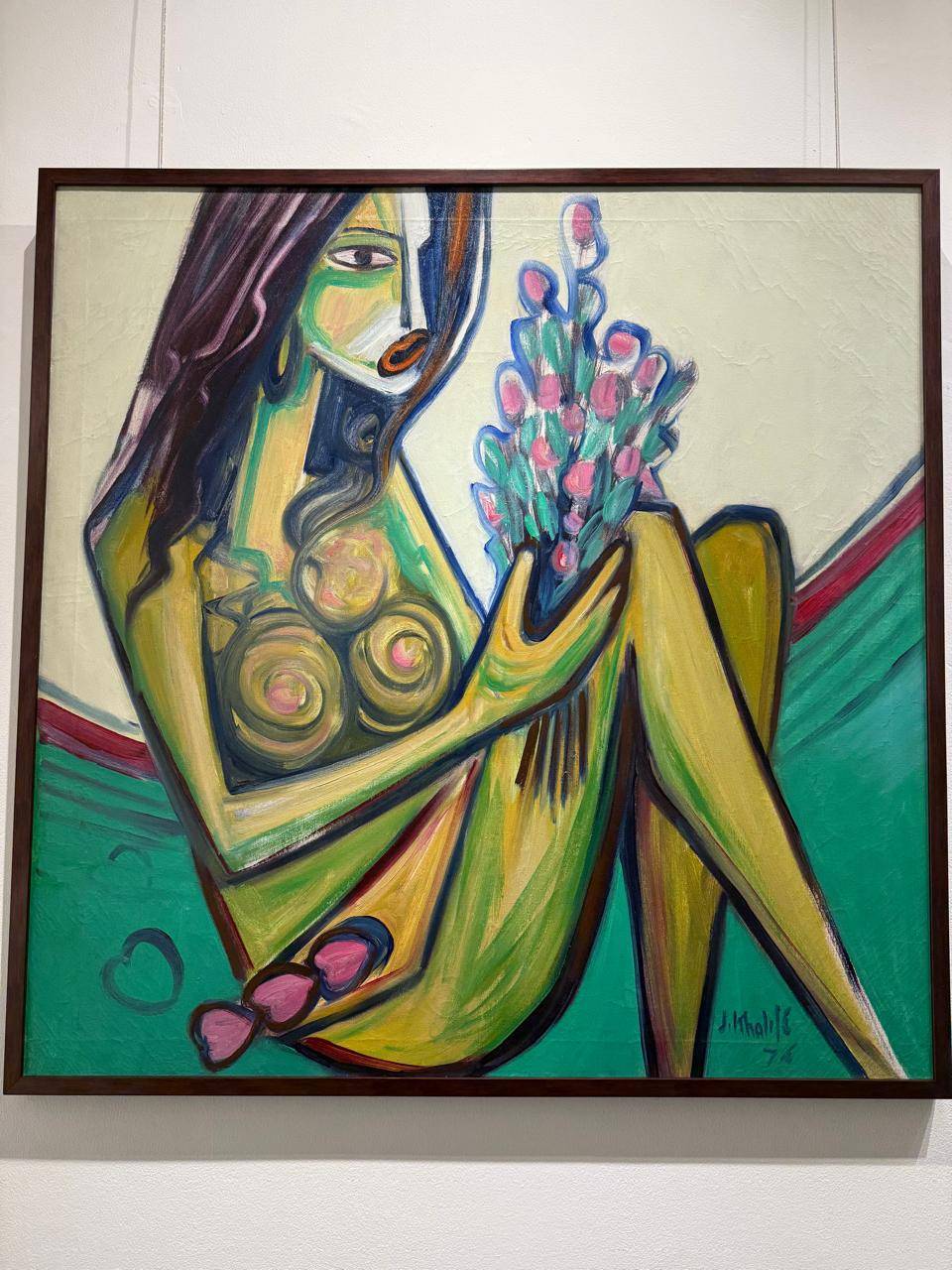غالباً ما ينتابني شعور عند الدخول إلى مكتبة عامة بأن كل المؤلفين الذين استقرت كتبهم منذ عقود على رفوفها قد غادروا الحياة، وأنهم الآن يتوسلون بي من وراء حاجز الغيب كي أستل مؤلَّفاً ما من أعمالهم، ولعل تصفحه فقط سيكون كافياً لمنحهم خيطاً واهياً من الشعور بالخلود، حتى للحظة واحدة.
وقد لا أستبعد أن هذا الشعور راود طالب الدراسات العليا الذي دخل إلى مكتبة أكاديمية العلوم في موسكو بحثاً عن مصادر لأطروحته، وعادة تكون أغلب الكتب فيها محجوبة عن القراء خارج أسوار الجامعة لأنها غالباً ما تتعارض (من وجهة نظر القيادة السياسية) مع الفكر «الماركسي - اللينيني».
خلال تجواله العشوائي بين الرفوف وقعت عيناه على كتاب بعنوان مثير: «مسائل الشعرية لدى دوستويفسكي» (الذي ترجمه إلى العربية الدكتور جميل نصيف التكريتي تحت عنوان «شعرية دوستويفسكي»، وراجعته الدكتورة حياة شرارة، وصدر عن دار توبقال، عام 1986)، وحين قرأ اسم مؤلفه: ميخائيل باختين، خامره شعور عميق بأن هذا المؤلِّف المجهول تماماً قد غادر الحياة منذ عقود كثيرة.
تحت الإثارة الفكرية والنفسية التي تركها هذا الكتاب في نفسه، قام ذلك الطالب بإشراك عدد من الأكاديميين الشباب في اكتشافه. هآنذا أراهم مصعوقين أمام الكنز الذي أخرجه زميلهم من القمقم، كأنه يشبه بذلك الجني الذي خرج من القارورة بعد قضائه دهراً طويلاً داخلها عقاباً له على عدم إطاعة النبي سليمان.
لا بد أن هذا الاكتشاف جاء بفضل الانفراج الذي عرفه الاتحاد السوفياتي بعد عام 1956، حيث خفَّت كفّ النظام الثقيلة ضد الثقافة غير المدجَّنة.
بعد بحث طويل عن ذلك المؤلف المجهول ودراساته، اكتشفت تلك المجموعة الصغيرة من الباحثين الشباب في معهد الآداب العالمية التابع لأكاديمية العلوم، أن المؤلف الذي يحمل اسم باختين، الذي رحل في 7 مارس (آذار) - عام 1975- ما زال على قيد الحياة.
كذلك، فإن كتاب «شعرية دوستويفسكي» فتح أعينهم على مقالات ودراسات مبعثرة في أرشيفات مغلقة هنا وهناك، وقادهم إلى أن أطروحة باختين التي رفضت اللجنة المناقِشة لها منحه درجة دكتوراه في أواخر الأربعينات، موجودة هي الأخرى وراء أبواب مقفلة أمام الجمهور، وتحمل عنوان: «رابليه وعالمه».
لا أستبعد أن يكون قدوم ثلاثة شباب من موسكو إلى بيته الواقع في بلدة نائية، معزولة، عام 1963، قد أثار قدراً من الخوف في نفسه. فهو منذ وقوفه أمام المحكمة الثورية عام 1929 بتهمة نشر الأفكار الهدامة بين الشباب، وصدور حكم ضده بالنفي لعشر سنوات إلى سيبيريا، يعيش تحت هاجس عودة رجال المخابرات ثانية إليه. كان السبب وراء ذلك الحكم هو انضمامه إلى حلقة من المثقفين تعمل على تحقيق التوفيق بين الدين والأفكار الحديثة، وكان ذلك كافياً في أواخر عقد العشرينات من القرن الماضي أن يعاقَب الفرد على هذه «الجريمة» بالنفي أو السجن أو الموت أو العمل القسري الجماعي.
حتى ذلك الوقت لم يكن صدر لباختين أي كتاب أو دراسة في مجلة متخصصة، عدا كتاب «شعرية دوستويفسكي». ولعل الاحتفاء الكبير الذي أظهره مثقف بلشفي كبير في ذلك الوقت بالكتاب كان وراء تجنبه النفي إلى سيبيريا. إنه أناتولي لوناتشارسكي، الذي عيَّنه لينين بعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) كوميسارا (وزيراً) للتربية والثقافة؛ تعبيراً عن تقديره لإنجازاته الأدبية الكثيرة.
ترك كتاب باختين في نفس المسؤول الكبير انطباعاً إيجابياً كبيراً، ترجمه بنشر مقالة نقدية تمتدح عالياً مؤلّفه، ولعل تلك المقالة وتدخل لوناتشارسكي وراء إنقاذه من النفي إلى سيبيريا.
بعد استئناف الحكم عليه، ومع التقرير الطبي الذي قدمه، بإصابته بمرض مزمن في العظام، وأن إقامته في سيبيريا ستقتله، بدلت المحكمة حكمها ضده، من حيث المكان الذي سينفى إليه. إنها بلدة كوستاني الصغيرة في كازخستان، حيث عمل محاسباً صغيراً. وخلال السنوات الست التي قضاها هناك، كتب باختين في أوقات فراغه دراسات مهمة (لم تُنشر) من بينها «خطاب الرواية».
عام 1937، انتقل باختين إلى بلدة كيمري التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن موسكو. وهناك ألّف كتاباً عن الرواية الألمانية في القرن الثامن عشر. وقد قُبِلت من «دار نشر الكتّاب السوفيات»، لكن الحظ لم يحالفه؛ إذ إن المبنى الذي كانت المخطوطة الوحيدة محفوظة فيه قصفها الألمان عند غزوهم الاتحاد السوفياتي عام 1941.
اشتد مرض العظام عليه آنذاك، لكن صحته تحسنت بعد قطع ساقه عام 1938، وخلال سنوات الحرب أقام في موسكو، وواصل إنتاجه الفكري، لكن الحصار الذي عانته المدينة دفعه إلى استهلاك جزء كبير من أوراق مخطوطة أخرى له لسجائره.
بعد رفض منحه درجة الدكتوراه على أطروحته «رابليه وعالمه» في أواخر الأربعينات، اكتفى «مكتب التفويض الحكومي» بمنحه لقباً أكاديمياً أقل شأناً.
انتقل باختين خلال الخمسينات من القرن الماضي إلى بلدة سارنسارك في موردوفيا، حيث عمل مدرساً في المعهد التربوي الموردوفي. ومع تدهور وضعه الصحي تقاعد عن العمل عام 1961، وكان من المفترض أن تختفي تلك الكنوز الفكرية التي تركها هنا وهناك، مخطوطات في أماكن مختلفة، لولا كتاب «شعرية دوستويفسكي».
في الوقت نفسه، عرفت أعمال دوستويفسكي خلال القرن العشرين إهمالاً مطرداً، واعتبره الكثير من النقاد مفتقداً لأسلوب أدبي متميز، وآخرون نظروا إلى أعماله من زاوية سيكولوجية ضيقة، باعتبار أبطاله مصابين بالعصاب، فضلاً عن إقصائه من قبل الحركات اليسارية الصاعدة بسبب أفكاره «الرجعية».
ويمكن تلمس هذا الإهمال في العالم الأنجلو - ساكسوني، فروائي مثل د. إتش. لورانس نبذ كل أعماله واكتفى بالصفحات القليلة التي كتبها بطل «الإخوة كارموزوف»، إيفان، تحت عنوان «المفتش العام». أما الناقد الأميركي البارز هارولد بلوم، فقد تجاهله تماماً في دراسته المهمةWestern Canon «(الكتابات الغربية الكبرى).
جاء كتاب باختين «شعرية دوستويفسكي» في حقل النقد الأدبي شبيها بما حققه العالم الفلكي كوبرنيكوس الذي كشف في القرن السادس عشر أن الأرض هي التي تدور حول الشمس لا العكس.
هنا تقدم لنا هذه الدراسة القيّمة جملة مفاهيم جديدة تساعدنا على إعادة قراءة واكتشاف دوستويفسكي من جديد؛ فمفاهيم مثل «الكرنفالية»، و«تعدد الأصوات» (البوليفوني)، و«العتبة» و«الباروديا» (المحاكاة الساخرة)، و«الحوارية» جعلت من الروائي الروسي الكبير منتمياً إلى كل ما سبقه من أشكال أدبية وممارسات اجتماعية كبرى بمدلولاتها الكثيرة. كذلك جعلت أعماله مصدر اهتمام كبير في العالم، سواء بين القراء العاديين أو بما يخص الدراسات الأكاديمية.
ففي كشف باختين للكيفية التي استخدم دوستويفسكي الكرنفالية، على سبيل المثال، تمكن القارئ أن يتلمس كيف أن تلك الطقوس التي يضيع فيها الحياء والتراتبية تتحقق خلال الكرنفالات، وكيف أن دوستويفسكي استخدمها في رواياته، وكيف تتقلب مواقع شخصياته خلال لقاءاتهم فيصبح الأقل أهمية مهما والأكثر أهمية ضئيلاً.
كذلك الحال مع «المحاكاة الساخرة»، حيث خلق فيدور دوستويفسكي أكثر من شخص يقلد بشكل ما شخصية رئيسية. ولعل مبدأ «تعدد الأصوات» هو الأكثر أهمية في أعماله. فنحن لا نتابع رأي الكاتب في أبطاله، بل رأي كل شخصية بغيرها، وهذا ما سمح بخلق الطباق الموسيقي counterpoint في أعماله.
قد يمكن القول إن دراسات باختين النقدية في الرواية فتحت الباب واسعاً للرواية كي تزدهر في القرن الواحد والعشرين، بعيداً عن ذلك التقنين الذي فرضته روايتا بروست وجيمس جويس: «البحث عن الزمن الضائع» و«عوليس»، اللتان حددتا المساحة الروائية بالتجربة الذاتية للكاتب فقط.
كل ذلك كان بفضل تلك الحلقة الصغيرة التي التفَّت حول «المعلم» باختين في آخر سنوات حياته، وتعاونت معه ليعيد قراءة ما كتبه وينقح أو يضيف ما يشاء، وعند وفاته عام 1975، كانت صورة الإرث الفكري الذي تركه باختين وراءه واضحة: إنه لم يكن منظّراً أدبياً فقط، بل إن اختصاصه الحقيقي (حسب قوله) هو الفلسفة، وبالذات ضمن ما عُرف في بداية القرن العشرين بـ«الكانطية الجديدة».
نحن إذن أمام معلَم فكري كبير كادت الهزات التي عاشها القرن العشرون أن تفقد أثره إلى الأبد. وكان العمل الدؤوب الذي قام به مفكرون وأكاديميون مثل الفيلسوفة جوليا كريستيفا وغيرها في الكثير من بقاع العالم وراء استرجاع هذه اللقى المنتشرة هنا وهناك. لنكتشف في مؤلفاته الفيلسوف وعالم الدلالات والفيلولوجي والأنثروبولوجي وفيلسوف اللغة والأخلاق والتفكيكي.
مع ذلك، يظل ذلك الكتاب الذي فتح الآفاق أمام باختين هو نفسه الذي أنقذه من موت سيبيريا، وهو نفسه الذي أنقذ دوستويفسكي من موت النسيان: «مسائل الشعرية لدى دوستويفسكي» أو في طبعته العربية: «شعرية دوستويفسكي».
لا بد من الإشارة إلى أن الترجمة التي قام بها الدكتور جميل نصيف التكريتي بمراجعة الدكتورة الراحلة حياة شرارة هي الأخرى معلماً متميزاً في المكتبة العربية. فكتابات باختين معقدة بتراكيبها ومصطلحاتها وطرائق بحثها، حتى بالنسبة إلى المترجمين في الغرب.
باختين... فتح الباب واسعاً أمام الرواية كي تزدهر في القرن الـ21
44 عاماً على رحيل مبتكر مفاهيم «الكرنفالية» و«تعدد الأصوات»

منذ مثوله أمام المحكمة الثورية عام 1929 بتهمة نشر الأفكار الهدامة بين الشباب وصدور حكم ضده بالنفي لعشر سنوات إلى سيبيريا ظل باختين حتى مماته يعيش تحت هاجس عودة رجال المخابرات ثانية إليه

باختين... فتح الباب واسعاً أمام الرواية كي تزدهر في القرن الـ21

منذ مثوله أمام المحكمة الثورية عام 1929 بتهمة نشر الأفكار الهدامة بين الشباب وصدور حكم ضده بالنفي لعشر سنوات إلى سيبيريا ظل باختين حتى مماته يعيش تحت هاجس عودة رجال المخابرات ثانية إليه
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة