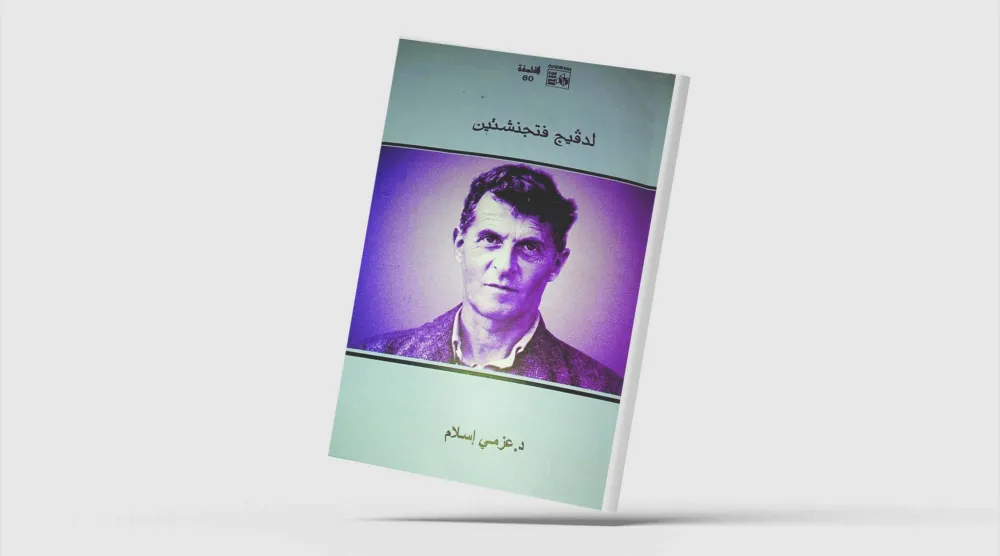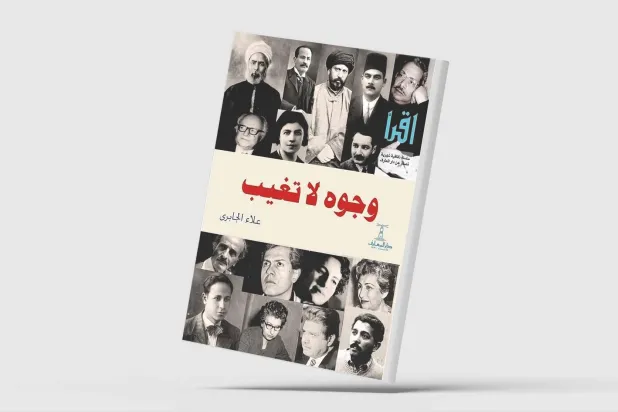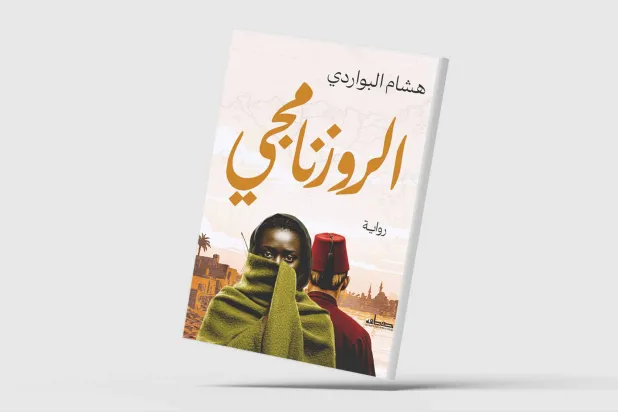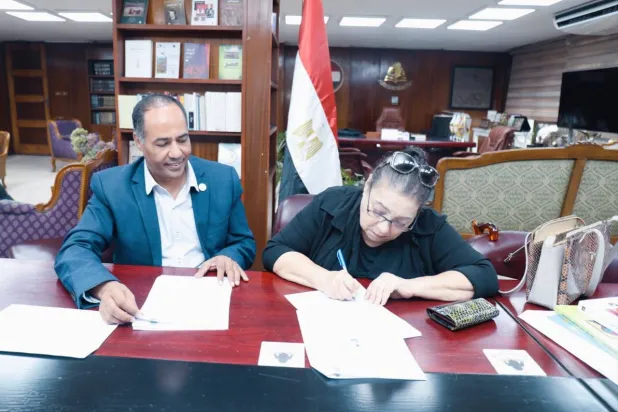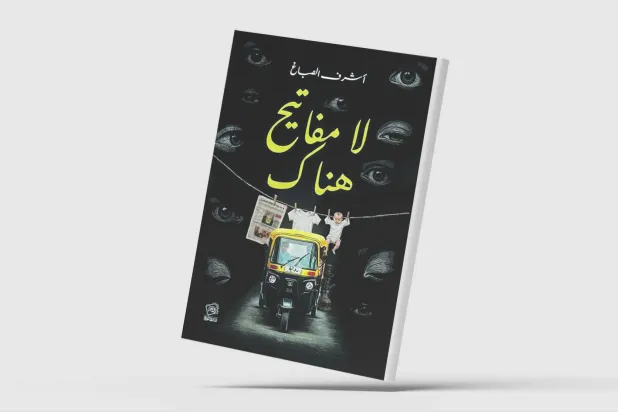يستعرض الكاتب محمود سعيد ألعابه السردية في مجموعته القصصية الجديدة «الساحر» مثل ساحر. يمد يده في أعماق قبعته «السيلندر» السوداء ليخرج زهرة حمراء سرعان ما تستحيل قذيفة هاون تنفجر وسط بيوت الموصل القديمة. وبدلاً من أرانب، يخرج محمود من قبعته «خنانيص» صغيرة تسرح وتمرح على جسد جندي عراقي جريح في أهوار العمارة إبان الحرب العراقية - الإيرانية.
لا تفرغ جعبة الساحر (قبعته) من مفاجآت أخرى، لكنه يمد يده إلى جيب سترته السوداء كي يستفز المشاهد بما هو أكثر وأغرب. يصطاد من جيبه «جراباً» قبرت في جوفه، في أعماق دجلة، يد مغنية حسناء قتلها مجهول في عصر الخليفة المعتضد. وهذا حسّ بوليسي مرهف عرفناه لدى محمود في رواية «وادي الغزلان»، لكنه يسرد لنا هنا حكاية مثل حكايات «ألف ليلة وليلة»، وفي عصر من الحضارة ودولة قانون صرنا نتحسر عليه الآن.
في قصة «مستعمرة العظاءات» يحوّل محمود سعيد الجنود في قاعدة تشبه قاعدة غوانتنامو، بلمسة من عصاه السحرية، كما في قصة «سندريلا»، إلى عظاءات... عظاءات... عظاءات، بل مستعمرة من العضاءات التي ترفع رؤوسها، وتشاهد تعذيب متهم بالإرهاب بطريقة الكهرباء.
وينقلب السحر على الساحر في قصة «الشويعر معتوق»، الذي مسخه ساحر القبيلة كلباً، حينما يخرج الكاتب من كمه عظمة يلوح بها للشاعر المزعوم. ونعرف أن «معتوك» أو «مفتوك» ليس أكثر من دَعِي ثقافة يحتفظ بشاعريته «الكلبية» بعد حرب الخليج الثانية. ربما أنه نموذج لشعراء موائد الحكام في زمن ديكتاتوري بغيض.
تقع مجموعة «الساحر» القصصية، من منشورات «دار ضفاف» ببغداد، في أكثر من 140 صفحة، وتتوزع في ثماني قصص. والقصص هي: «خطوة و... الموت»، و«الساحر»، و«مستعمرة العظاءات»، و«الجندي والخنازير»، و«أشلاء في دجلة»، و«القبعة»، و«إن كنت تعرف القسم التي تقصده فاضغط...»، و«المنسدح».
وكان محمود سعيد قد زار مدينته الأولى الموصل بعد أشهر من تحريرها من عصابات «داعش» الدموية، وأثبت، رغم تقدمه في السن، شجاعة أدبية نادرة. جال في شوارع الموصل، أو أطلالها، وشاهد بأم عينيه كيف أجهز التحرير على رمق ما تبقى من حياة تركها المحتل «داعش». وينقل لنا من المدينة قصة زوجين شابين وتوأميهما (عمر سنة) وهم محاصرون بين قناصي «داعش» ومدفعية «الحشد».
الطفلان لا يقويان على الحركة لشدة الجوع والعطش، ولا تجد الأم من بديل غير أن ترطب كسرة خبز يابسة، انتزعتها من فم كلب، ببولها كي تطعمها للطفلين. يجهز القناص على الأم عند محاولة الهرب، وتقتل شظايا القصف أحد الطفلين. يدفن الأب الجريح زوجته وطفله على عجل، ويحمل طفله الثاني لا يلوي على شيء إلى بر الأمان. وحينما يكون خارج منطقة الموت يقولون له إن الابن قضى نحبه. وتكتمل المأساة، حين يكتشف الأب المصدوم، أنه دفن الابن الحي بالخطأ، وأنقذ الطفل الميت.
ويتجسد «سحر القبعة» في محمود حقيقة في قصته الطريفة «القبعة». وما يحصل هو أن قبعة جميلة قلّبها في مخزن ما، تتسلل بشكل ما إلى داخل سلة مشتريات الشخص في القصة. وأعتقد أن القصة تتعلق بهاوي جمع القبعات محمود نفسه، لأنه يمتلك في شقته الصغيرة في شيكاغو «أرشيفاً» من القبعات التي يغطي بها ما تيسر من صلع زحف على رأسه. ولا يكتشف هاوي القبعات «القبعة المتسللة» إلّا بعد خروجه من المحل، وتأبى أخلاقيته تقبل الأمر ويسعى إلى إعادة القبعة.
في النهاية تساعده صديقة أميركية في إعادة القبعة إلى المحزن. ويقرر المخزن مكافأة المرأة على أمانتها بشراء ما قيمته 100 دولار مجاناً. ونعرف أن المرأة تشتري قطعة ملابس داخلية بمبلغ صغير لا يرتقي إلى مائة دولار.
هكذا، تتباين القصص في «الساحر» بين تراجيديا الحروب والمفارقة والطرافة. وينتقل الكاتب من «الحدباء» إلى جزيرة مجنون، ومن جزيرة أم الخنازير إلى شيكاغو، حيث يعيش الكاتب منذ عقود.
يصف الكاتب في «مستعمرة العظاءات» مشهد تعذيب بشعاً وكأنه حضره أو تعرض له بنفسه. ويجمع محمود سعيد في القصة بين ضحيتين من ضحايا التعذيب الأميركي في السجون المخصصة للإرهابيين: المترجمة العراقية التي تتعرض للاغتصاب بعد أن يُدس لها المخدر في العصير من قبل الجنود وبائع السجاد المغربي أحمد الذي كان يبيع السجاد في المكان والوقت غير المناسبين على الحدود الأفغانية الباكستانية.
وتكتشف المعلمة أن من وعدها بمرتب كبير نظير الترجمة ينتظر منها ما هو أكثر من المشاركة في التحقيق، أي المشاركة في تعذيب المتهم وانتزاع الكلام منه أيضاً. لا ترد بقايا الإنسان المعذب بغير سؤال واحد على سؤال المترجمة: «آللا العراقية شحال من دري معاك؟» (أيتها العراقية كم طفلاً عندك).
يجري تعذيب أحمد بصعقات كهربائية على عضوه التناسلي، وبالضرب على العضو المتورم المزرق من الصدمات، وهو يشهق ويعيد الرد نفسه على السؤال نفسه. ويموت المتهم تحت التعذيب، ويكتبون في السجل أنه انتحر، ويطالبون المترجمة بالحضور لاستجواب متهم آخر في الأيام المقبلة.
وتعرف المترجمة أنها لم تعد أكثر من عظاءة يمكن أن يسحقها الجنرال بجزمته متى ما أراد، لا سيما بعد أن التقطوا لها الصور وهي عارية بين أيدي الجنود. كما ترك التعذيب ندبة لا تمحى في قلبها وعقلها مثل عضات العظايات، بحسب وصف الجنرال.
هل يخاف المسعور من السعار؟ هذا ما تقوله قصة «المنسدح»، وهي قصة شهد العراقيون المئات منها في عهد الديكتاتور الكبير وحفنة الديكتاتوريين الصغار التي حكمت بغداد.
هي قصة طبيب ينتزع من فراشه مساء من قبل رجال أمن القصر الرئاسي، ويقاد معصوب العينين إلى حيث لا يدري. وإذ يحاول الطبيب معرفة «الجريمة» التي ارتكبها ودفعت رجال «الريِس» لاختطافه بهذه الصورة، لا يتذكر سوى صديقه الطبيب الذي فشل في معالجة أحد رجال الديكتاتور المسمى «راكان محقان مزبان». كانت المنية قد أنشبت أظفارها في مزبان، وما عادت أي تميمة أو دواء تنفعه بعد أن صرعه السعار. عض كلبه وحصانه وكل المقربين منه قبل أن يعرض على الطبيب.
يقاد الطبيب إلى الديوان الرئاسي، ويفتش تفتيشاً دقيقاً، ثم يدخله الحرس على رجل «منسدح» يتفرج على مشاهد مصارعة حرة في التلفزيون. كان الرجل مريضاً، متوتراً، وقلقاً، وجّه إلى الطبيب سؤالين فقط:
هل تنتقل عدوى الأنفلونزا بالهواء؟
الطبيب: تعتمد على البعد.
المنسدح: كما في وضعنا... نفس البعد.
الطبيب: نسبة عشرة في المائة.
المنسح: والكَلَب.
الطبيب: ما به؟
المنسدح: أ...، يعدي، بالهواء؟
الطبيب: لا.
المنسدح: بالمصافحة؟
الطبيب: لا.
المنسدح: أأنت متأكد؟
الطبيب: نعم.
انتهت ليلة «الهالوين» بهذا الحوار القصير، ويقاد الطبيب بعدئذ إلى البيت. ولكم أن تتصورا من هو هذا المنسدح!
تناول محمود سعيد مختلف الموضوعات في أدب قصصه ورواياته، طوال أكثر من نصف قرن، لكنه لم يغير في أسلوبه الذي وصفته «New Yorker» بأنه: «بسيط. وواضح. ومباشر. كتب عن الحروب والتعذيب والسجون والغانيات ومدن عراقية كثيرة، وحياة العراقيين في المغرب وشيكاغو، وفي الجريمة أيضاً، لكنه بقي أميناً لسرديته الأنيقة». وأقول: حسناً فعل! رغم معرفتي أن نقاد ما بعد الحداثة تهمهم كثيراً التعبيرات الحداثوية الرنانة مثل «سردنة الواقع» و«عصرنة الأسلوب» و«صقلنة الثيمات»... إلخ.
14:11 دقيقه
قصص تتباين بين المفارقة والطرافة والحرب من الموصل إلى شيكاغو
https://aawsat.com/home/article/1380231/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88



قصص تتباين بين المفارقة والطرافة والحرب من الموصل إلى شيكاغو
مجموعة «الساحر وقصص أخرى » لمحمود سعيد

- برلين: ماجد الخطيب
- برلين: ماجد الخطيب

قصص تتباين بين المفارقة والطرافة والحرب من الموصل إلى شيكاغو

مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة