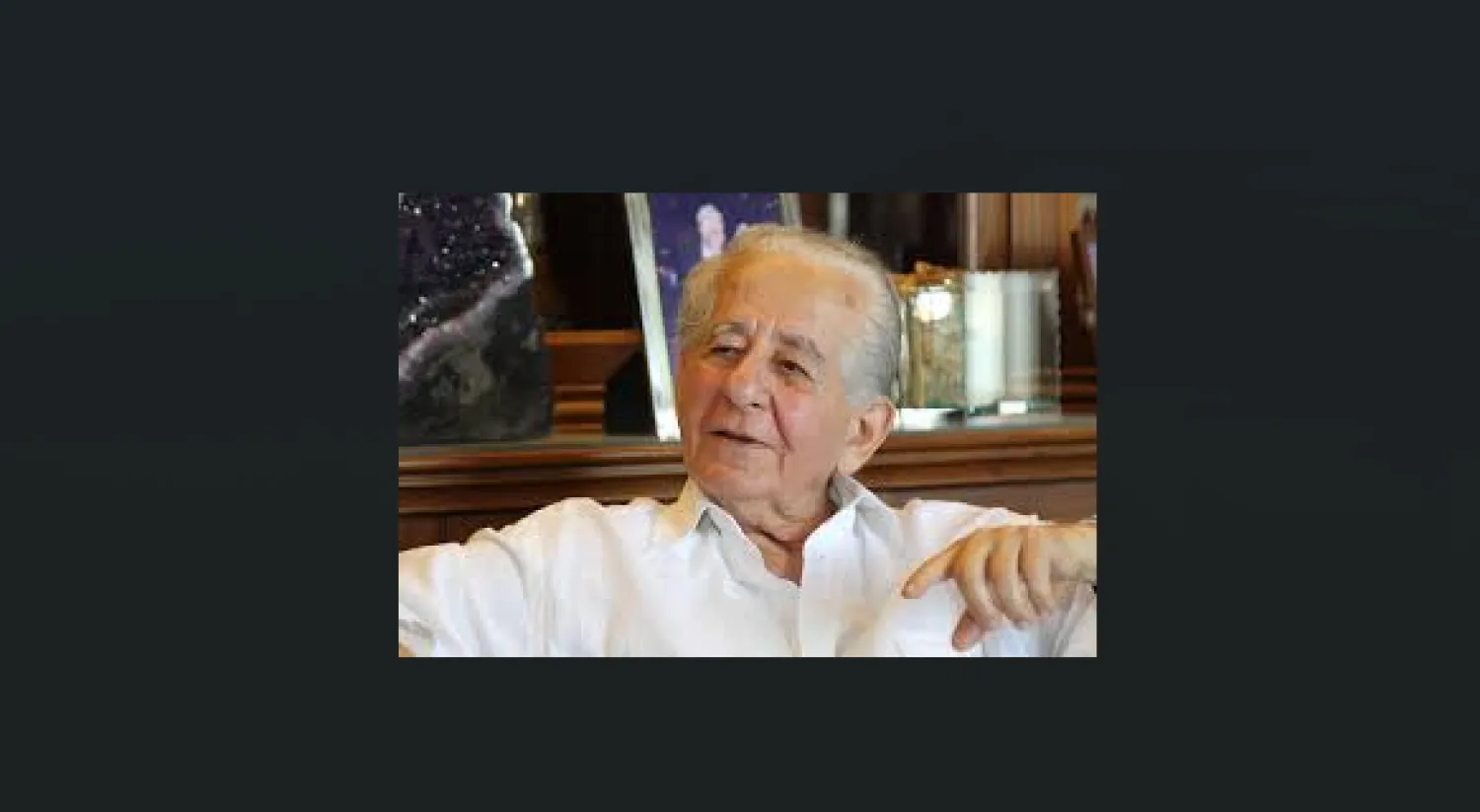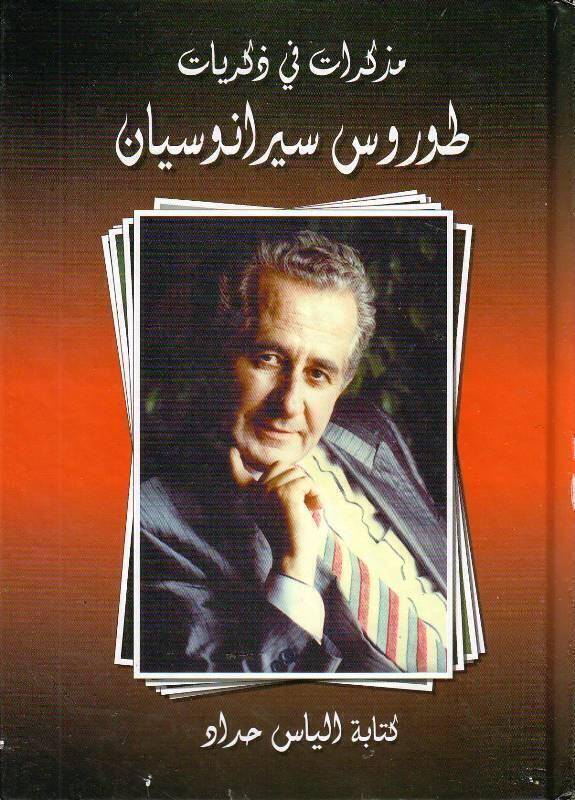لم يسبق للعبة من الألعاب أن وحّدت حولها سكان الأرض وشعوبها المتناحرة، وشدّت إليها أنظار ملايين المتفرجين والمشاهدين، كما هي الحال مع كرة القدم. وإذا كان سحر هذه الكرة يتوزع على مدار أيام السنة وشهورها، فهو في حقبة المونديال، التي تتجدد مرة كل سنوات أربع، يبلغ ذروته القصوى ويُشيع على امتداد المعمورة نوعاً من الهستيريا الجماعية التي لا تهدأ حمّى انفعالاتها قبل أن ينجلي الغبار عن الرابح الأخير، الذي يرفع الكأس الذهبية بيده بعد أن استحقها قبل ذلك بأقدام فريقه الفائز. فخلال شهر كامل من الزمن يتخفف سكان هذا الكوكب العجوز من أوزار حروبهم وكوارثهم الطبيعية وأزماتهم الاقتصادية والسياسية، ويسمرون أنظارهم باتجاه الشاشات الفضية الصغيرة في منازلهم العائلية، أو باتجاه الشاشات العملاقة التي توفر لرواد المطاعم والمقاهي حماساً أقوى وتفاعلاً مليئاً بالإثارة وتماساً مع المؤيدين أو الخصوم، لا ينتهي دائماً بشكل ودي.
على أن تحول كرة القدم إلى اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم لا يمكن أن يكون وليد الصدفة المجردة، بل هو نتيجة تضافر معقد بين عناصر مختلفة تتيح لكل واحد منا أن يرى إليها من منظوره الخاص، وأن يقرأ فيها ما يتلاءم مع مزاجه وإدراكه وفهمه للأمور. ففوق ذلك المستطيل الأنيق من الخضرة المتموجة ينفتح التأويل على مصراعيه، وتتناغم الموهبة مع المهارة، والرشاقة مع القوة، ويتقاطع الفردي مع الجمعي في سلسلة مترابطة من الاختزال الموحي. وفي «لعبة الأمم» الرمزية تلك، ثمة معايير وقواعد وتراتبيات مغايرة تماماً لما هو قائم على أرض السياسة والاقتصاد، حيث يمكن لدول كبرى من وزن الولايات المتحدة والصين وروسيا أن تنكفئ إلى الخلف، فيما تتقدم إلى موقع الصدارة دول أقل شأناً كالبرازيل والأرجنتين والسويد وكوريا الجنوبية، أو دول صغيرة وفقيرة كالسنغال وآيسلندا وأورغواي وغيرها. فهذه الكرة الصغيرة التي تشبه الأرض تتيح للشعوب المستضعفة أن تتجاوز ما تعانيه من شعور بالدونية وعقد النقص إزاء الإمبراطوريات الممسكة بمقاليد العالم. وتبدو السيطرة على المستطيل الأخضر بمثابة تعويض من نوع ما عن حالات التهميش والعزلة وغياب الأدوار.
إن الذين يتحدثون عن تحول كرة القدم إلى نوع من الديانة الجديدة، بالمعنى المجازي للكلمة، لا يبتعدون كثيراً عن الحقيقة. ليس فقط لأنها لعبة عابرة للقارات، ولأن عشاقها ومتابعيها يفوقون في أعدادهم معتنقي أي ديانة بعينها، ويتوزعون على كافة الأعمار والطبقات والولاءات الدينية والمذهبية والآيديولوجية فحسب، بل لأنها باتت محلاً لالتقاء الكثير من الطقوس والإشارات والمفارقات الدلالية والانفعالية. ففي الإطار الأوسع يبدو كل فريق ممثلاً لوطنه ولروح شعبه القومية، حيث الجسد الفردي في هذه اللعبة ليس منبتاً أبداً عن الجسد الطوطمي الذي يضخ دماءه المتجددة في عروق السلالة وشرايين أبنائها. والقدم التي تركل الكرة تبدو وكأنها تفعل ذلك نيابة عن الأمة برمتها. هكذا تصبح أجساد المتفرجين على المدرجات امتداداً لأجساد من يمثلونهم في الأسفل. وحيث لا لزوم للكلام الواضح والجمل المفهومة، واللغة حكر على الأقدام والرؤوس يعبر المنقسمون في الأعلى عن مشاعرهم بالهمهمات والقبضات المرفوعة والصيحات البدائية. ولأن اللعبة هي نوع من الحرب الرمزية بين فريقين متواجهين فإن كل ما يسعد أحدهما يحزن الآخر. وعند الطرف المقابل لكل ضحكة أو تهليل أو نشوة انتصار، ثمة دمعة تُذرف وزفرة تعلو وحزن يهيمن. ولعل البعد القومي للعبة هو ما يدفع اللاعبين المنضوين في فرق أجنبية للعودة أثناء المونديال إلى كنف منتخباتهم الوطنية التي تتجاوز انقساماتها المحلية المختلفة، وتتوحد جميعها تحت علم البلاد المرفرف في المكان، كما تؤدي التحية بخشوع ظاهر لنشيدها الوطني الذي يسبق بقليل انطلاق صافرة البدء. على أن البعد السحري الطوطمي لعلاقة الأمة مع أبنائها اللاعبين قد يأخذ في بعض الأحيان أبعاداً دموية عنفية فيؤدي إلى قتل اللاعب الذي «خذل شعبه»، كما حدث للكولومبي إسكوبار الذي اغتالته عصابات المافيا بداعي تسببه بهزيمة بلاده في مونديال العام 1986. وقد يبلغ الاحتقان العصبي القائم بين مشجعي الفرق المتنافسة حدود التصفية الدموية، كما حدث في أحد مقاهي بيروت قبل أيام حين عمد مشجع لبناني لألمانيا إلى قتل مواطنه المشجع للبرازيل، إثر خروج الفريق الألماني مهزوماً من المونديال الأخير. تجمع كرة القدم من جهة أخرى بين الكفاءات الفردية المتألقة مهارة وحضوراً، وبين البعد الجماعي الذي يقوم على توزيع الأدوار بين اللاعبين والتناغم الخلاق فيما بينهم بغية تحقيق الظفر. كأنها تؤالف بشكل أو بآخر بين ذروة الفردانية الرأسمالية، وبين ذروة الاندماج في الجماعة الذي تنادي به الاشتراكية. وفي ظل هذا التناغم الخلاق بين العبقرية الشخصية والتربة الرياضية الملائمة يمكن أن يتحول بعض اللاعبين إلى أساطير أو أيقونات حقيقية، كما هو حال بيليه ومارادونا ورونالدو وزيدان وميسي ونيمار وغيرهم.
تتيح كرة القدم لجسد اللاعب، من جهة أخرى، أن يغير تراتبيته المألوفة. فاليد «المبصرة»، التي تملك عبر أصابعها الخمس قدرات كثيرة من بينها الكتابة والاحتضان والعزف والإمساك بالأشياء والاحتفاظ بها لا تصبح على أرض الملعب عاطلة عن العمل فحسب، بل إن تدخلها في اللعبة يستتبع أوخم العواقب، وقد يقلب احتمالات الانتصار إلى هزائم نكراء. في حين أن القدم «العمياء» التي تمثل الجنوب المهمش للجسد الإنساني تسترد ألقها المغيب لتناور وتمكر وتسدد باتجاه المرمى، وتمنح صاحبها أكثر ما يصبو إليه من النجومية وذيوع الصيت. أما الرأس من جهته فلا يكتسب أهميته من خلال تلافيف الدماغ أو من خلال الذكاء وإنتاج الأفكار فحسب، بل من خلال فيزيولوجيته العظمية الظاهرة التي تمكّنه من إصابة المرمى بأكثر الكرات خطورة واستعصاء على الرد. ولعل هذا الدور الطريف للرأس يذّكّر من بعض وجوهه بالموقف الطريف الآخر في رواية «زئبق» للفرنسية إيميلي نوثومب، التي رغم عزوفها عن القراءة، لم تفلح في الهروب من سجنها إلا بعد أن حولت الكتب الموجودة في حوزتها إلى منصة عالية وفّرت لها سبيل الهرب إلى الخارج والنجاة من الأسر.
ثمة وجوه كثيرة أخرى تمنح هذه اللعبة فرادتها الخاصة وجاذبيتها الاستثنائية. فالملعب منظوراً إليه من بعيد هو أشبه بلوحة متناغمة الألوان يعاد تشكيلها باستمرار. هنا يتحد الرسم بالرقص عبر موسيقى الأجساد المخاتلة التي تبعث على الطرب والنشوة البصريين. وفوق أرض الملعب تمتزج الضرورة بالمصادفة والمنفعة بالمتعة والرؤية بالعمى، كما يعبر اللاعب الفرنسي الشهير ميشيل بلاتيني في حوار له مع مواطنته الكاتبة مرغريت دوراس. ليس ثمة في اللعب من تقدم أو تقهقر دائمين بل كرّ وفرّ متعاقبان، وثمة لقاءات على الأرض وارتطامات ومناورات في الفضاء. والقوة هنا لا تحضر في سياقها الوحشي المجرد، بل هي قوة تسندها المهارة ويرفدها الذكاء وتبعدها الليونة عن الفظاظة المجردة. وقد يكون التعاطف الواسع الذي يبديه جمهور اللعبة مع الفريق البرازيلي ناجماً عن مؤالفة هذا الأخير بين الجسد الأبولوني القائم على الرشاقة والتناسق العضلي والجمالي، وبين الروح الديونيزية المتوثبة والمفعمة بالحيوية والشغف. وفي الحالين ثمة دلالات إيروتيكية للعبة التي يحضر من خلالها الجسد الذكوري بكامل فحولته الفتية. فاللاعبون بسيقانهم الممتلئة وخصورهم الضامرة وعروقهم النافرة وعضلاتهم المشدودة وعدْوهم السريع ونظراتهم الصقرية الحادة، يبدون مزيجاً غريباً من الخيول والنمور والغزلان.
وإذا كان العرب، أخيراً، يسبغون على شعرائهم الممسكين بناصية اللغة والغوص التخييلي صفة الفحولة، فإن لاعبي كرة القدم يجسدون هذه الصفة في بعدها المرئي والملموس. ففوق المسطح الأخضر تتكفل الأجساد الفتية بكتابة نص كروي تشكيلي بالغ الذكورية، فيما الحقيقة الفنية لا تكتمل إلا مع تأنيث المرمى وتسجيل الهدف في قلب شباكه المتمنعة.
الكرة الساحرة بين ذكورة الجسد وأنوثة المرمى
جوانب كثيرة تمنح اللعبة فرادتها الخاصة وجاذبيتها الاستثنائية

التعاطف الواسع مع الفريق البرازيلي (الصورة) ناجم عن المؤالفة بين التناسق العضلي والجمالي والروح المفعمة بالحيوية والشغف

الكرة الساحرة بين ذكورة الجسد وأنوثة المرمى

التعاطف الواسع مع الفريق البرازيلي (الصورة) ناجم عن المؤالفة بين التناسق العضلي والجمالي والروح المفعمة بالحيوية والشغف
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة