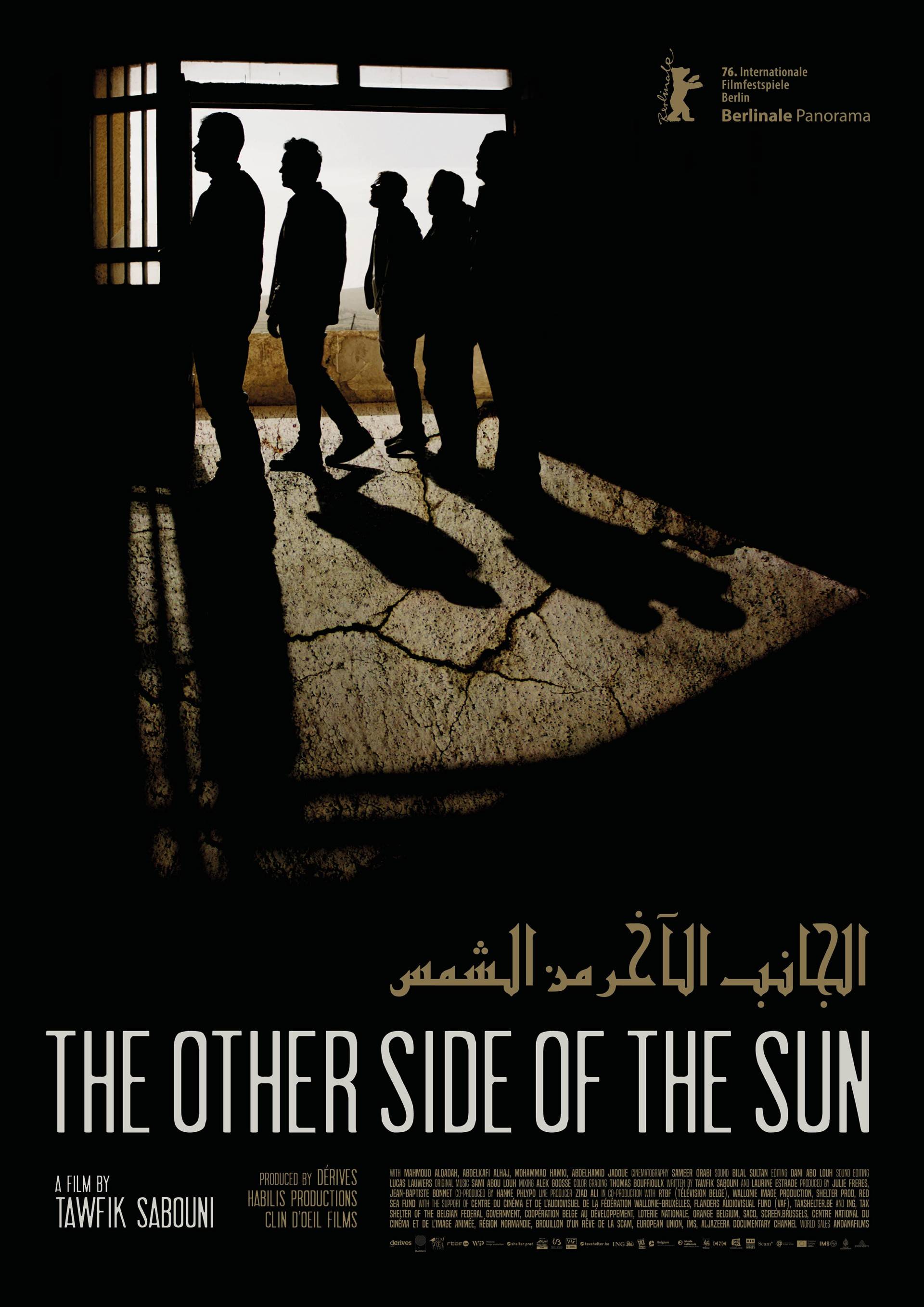اختار الناقد الأدبي الدكتور يسري عبد الله، في كتابه «جماليات الرواية العربية.. أبنية السرد ورؤية الواقع»، 30 روائياً من مصر والعالم العربي ليسائل من خلالهم الفضاء المعرفي والدلالي الذي تنطوي عليه جماليات الرواية العربية، ورؤية هؤلاء الكتاب لواقعهم الاجتماعي والثقافي، في إطار رؤيتهم للعالم والعناصر والأشياء.
الكتاب الذي صدر حديثاً عن دار «بدائل» بالقاهرة، في 240 صفحة من القطع المتوسط، يمثل الحلقة الثالثة من مشروع نقدي طموح يسعى عبد الله إلى تأصيله بخبرة جمالية لافتة، بعد كتابيه المتميزين: «الرواية المصرية.. سؤال الحرية ومساءلة الاستبداد» و«جيل السبعينات في الرواية المصرية.. إشكاليات الواقع وجماليات السرد».
تجدل عناوين الكتب الثلاثة، بتقاطعاتها مع بعضها بعضاً، فكرة أساسية تمثل حجر الرؤية لهذا المشروع النقدي الطموح، وهي أن النقد ابن الواقع والخيال معاً، وأن كلا العنصرين يشكل ماهية النص الروائي، بكل عوالمه وأبعاده المنفتحة على فضاءات الذات والواقع، وأزمنته الغابرة واللاحقة.
على هذه الأساس، وبمعاول نقدية متنوعة، تتوغل دراسات الكتاب في النصوص المختارة، تفكك وتحلل شفراتها ومحمولاتها، بحثاً عن الجمال المخفي المغاير، الذي لا يخضع لمعايير ومقاييس أدبية مستهلكة ومنتجة سلفاً، وإنما يؤسس لسرديات جديدة تسعى وراء الحقيقة باعتبارها التجلي الأمثل للذات، وللواقع والخيال معاً. يكشف عبد الله، من خلال هذه التوغل، أن اللعبة الروائية تبلغ ذروتها الفكرية والجمالية حين تصبح امتداداً لمعارفنا الشخصية، وجزءاً من حياتنا، نسد به الفراغ والفجوات في التاريخ والحياة. ومع ذلك، يظل النص أوسع من تاريخه، ومن واقعه، بقوة الخيال، وجدله الحي مع الذاكرة والحلم، والانفتاح على المستقبل بطاقة المغامرة والتجريب.
نقطة مهمة أيضاً في هذه الكتاب النوعي، وهي حرص الناقد على اتساع فضاء مشروعة النقدي، وأن يكتسب خصوصيته الفنية والجمالية من خلال التجاور بين أجيال من الكتاب، تتباين أعمارهم ومشاربهم الفنية، لكنهم ينضوون جميعاً تحت مظلة البحث عن كتابة سردية جديدة، تحرر النص من الذهنية الثقافية الضيقة والحبس داخل مقولات جامدة.
يشمل هذه التجاور الروائيين: «محمد البساطي، ويحيى مختار، وإبراهيم عبد المجيد، وجار النبي الحلو، وفتحي إمبابي، وسلوى بكر، ومحمود الورداني، ورضا البهات، وأحمد الفيتوري (ليبيا)، وأحمد المخلوفي (المغرب)، وعبده وازن (لبنان)، ومكاوي سعيد وخالد أقلعي (المغرب)، وعزة رشاد، وسيد الوكيل، ومحمد الشاذلي، وعبد الستار حتيتة، وعامر سنبل، وحمدي الجزار، وأشرف الصباغ، وعلي عطا، وفتحي سليمان، ومحمد داود، وصبحي شحاتة، ويوسف وهيب، وهاني القط، وسمر نور، ومايا الحاج (لبنان)، وعلي سيد علي، وأحمد مجدي همام».
ويؤكد عبد الله أن عمله النقدي «ينطلق من (الآن / وهنا) ليرصد لنا (جدارية السرد العربي في لحظة فارقة)»، لافتاً إلى أن نصوص هؤلاء الكتاب تعبر عن تمثيلات واعية ومنتخبة لواقع الرواية العربية الآن، مشدداً في معرض تقديمه له على أن «ثمة دوراً مسؤولاً وتاريخياً يجب على النقد أن يمارسه الآن، بوصفه عطاءً من عطاءات الواقع الرحبة، وأنه لا نص ينمو في الفراغ، وإنما هو ابن لسياقاته السياسية والثقافية، وبما يؤكد أن ثمة انحيازاً للفني بالأساس».
في الشغل النقدي على إبداعات الروائيين، نستشف قواسم فنية متشابهة، وعوالم مشتركة إلى حد كبير بين معظم النصوص، ومنها ثنائية القهر والحرية التي تشكل المفتاح النقدي لروايتي الروائي المصري الراحل محمد البساطي «غرفة للإيجار» و«سريرهما أخضر». ترصد الدراسة مستويات القهر، وتحلل أبعادة في العملين، وكيف يصبح ضاغطاً على الشخوص، قامعاً لأحلامها ورغباتها البسيطة، وبعنف يصل إلى الحرمان الجسدي في عالم مسكون بالقسوة والعتامة.
يتردد جدل هذه الثنائية بتراوحات مختلفة في نصوص أخرى، فتتحول إلى قناع للتخفي تتم من خلاله مساءلة التطرف والقمع، وتحالف قوى الرجعية مع الاستعمار، في روايتي «خريف العصافير» و«رايات الموتى»، للكاتب المغربي خالد أقلعي. كما نجد صدى لها في رواية «البحث عن دينا»، للكاتب محمود الورداني، التي تجسد سيرة فتاة مناضلة، تصبح رمزاً لوقائع مرت بها الثورة المصرية. وتتحول هذه الثنائية في رواية «أن تحبك جيهان»، لمكاوي سعيد، إلى أنشودة لشخوص محبطين، يقفون على حافة اليأس والنشوة والثورة، ليختلط الصراع العاطفي بالسياسي، وسط رهان خاسر على سلطة الكتابة.
ويحتل اللعب على جماليات المكان مساحة وافرة من الدراسات، ويكشف الناقد عن سمات خاصة للمكان في علاقته بالنص الروائي، وتأثيره على العناصر السردية فيه، وكيف يتنوع الأفق الجمالي لهذه السمات بتنوع بيئة المكان نفسه وثقافته وطبيعة ناسه وخبرتهم في الحياة. فيطالعنا المكان النوبي في أعمال الكاتب يحيي مختار، حيث تصبح النوبة مكاناً روائياً له، وهو ما يبرز في أغلب هذه الأعمال، خصوصاً روايتيه: «تودد» و«مرافئ الروح»، حيث تصبح النوبة منبع انطلاق الحكايات.
هناك أيضاً المكان الريفي، ودلالة اللعب معه وتعريته فنياً في رواية «شجرة اللبخ»، للكاتبة عزة رشاد. وفي رواية الكاتب الليبي أحمد الفيتوري «ألف داحس وليلة غبراء»، تكشف الرواية تناقضات المكان، في إطار تحولات الواقع الليبي في زمن الاحتلال الإيطالي، ثم بعد الثورة تحت نظام القذافي. وفي «عشرة طاولة»، للكاتب محمد الشاذلي، حيث يبرز جدل الجمالي والسياسي في حيز مكاني يتسم بالتنوع، ما بين أحياء في القاهرة والأقاليم، خلال عام من حكم الإخوان المسلمين.
ويرصد الكتاب جماليات أخرى للمكان في براح الصحراء، وكيف يتحول إلى نفس ملحمي وفضاء مغاير وجديد، وذلك في رواية «شمس الحصّادين»، للكاتب عبد الستار حتيتة، حيث تتكشف جدلية المكان عبر بعدين يشكل كلاهما الآخر: بطل مأزوم ومكان مأزوم أيضاً، يعلق به غبار الحرب العالمية الثانية، وتحت وطأة ميراث عتيد من الأعراف والتقاليد البدوية.
ويقلِّب عبد الله في مشروعه النقدي منحنى آخر للمكان، حين يصبح فضاءً خانقاً قريناً للوحشة والفقد والعزلة والاغتراب، وهو ما يطالعنا في رواية «مدرات الغربة والكتابة»، للكاتب المغربي أحمد المخلوفي، حيث يبدو جدل الداخل والخارج متواشجاً مع الأنساق الاجتماعية والسياسية والثقافية، وفي صراع مع ذات فردية تواجه العالم بطاقة الحلم والخيال، بينما يتحول فضاء «مصحة الكوثر للأمراض النفسية» حاجزاً أمام رؤية البطل لذاته وللعالم، في رواية «حافة الكوثر»، للكاتب علي عطا.
ويطوِّف الكتاب في هذه الجدارية السردية على ظواهر فنية أخرى أصبحت تشكل أبنية السرد، فيفض الاشتباك ما بين التاريخي والجمالي في روايتي «عتبات الجنة» و«شوق المستهام»، للكاتب فتحي إمبابي، مشيراً إلى وعي الكاتب بهذه المشكلة، وتقديمه حلولاً سردية لها من خلال تمرير المقولات الكبرى في نسيجه الروائي، وتذويبها بسلاسة في نسيج السرد، لتصبح جزءاً حياً منه.
ويشتبك الدرامي والجمالي على خلفية جدل الأضداد المتقابلة في رواية «البيت الأزرق»، للكاتب اللبناني عبده وازن، مشكلة ارتحالاً قلقاً في فضاء روائي معبأ بالوحشة والعزلة والفقد.
ومن نافذة «فانتازيا الثورة / عبث الواقع»، يضع الكاتب إبراهيم عبد المجيد خطوطه السردية المتميزة في هذه الجدارية، عبر روايته «قطط العام الفائت»، التي تكاد تشكل سيرة ذاتية لثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ويتم ذلك عبر آلية الإحالة والدلالة الأسطورية التي تتأسس خارج الواقع. ويشير المؤلف إلى أن عبد المجيد «يختار لحظته الروائية ببراعة، متخذاً من القطط برمزيتها المقدسة في الحضارة الفرعونية، ووصفها بأنها بسبع أرواح، معادلاً موضوعياً للشباب الثائر الذي يتحول إلى قطط، بعد أن يعيد الحاكم عقارب الساعة سنة إلى الرواء، ويخوض دراما الثورة مع الآلة الجهنمية للقمع».
قريباً من أجواء اللعب بالفانتازيا، تطالعنا رواية «بوركيني»، للكاتبة اللبنانية مايا الحاج، حيث محاولة التصالح بين المتناقضات في الذات والواقع، ولو باللعب اللغوي واللجوء إلى هذه الكلمة التي اشتقتها مسلمة أسترالية للدلالة على كلمتي «برقع» و«بكيني» كغلالتين لجسد يمثل البطل الضد، يمارس الحرية باتساق شديد مع الذات، وسط واقع محافظ يتعايش تحت سقف من الظلال المتنافرة.
على هذه المنوال، يبرز التجريب أيضاً كأساس للكتابة في رواية «اللعب»، للكاتب صبحي شحاتة، من منطلق نسبية الأشياء ولا يقينيتها، والنزوع الفردي لتحويل فعل الكتابة إلى فضاء للمتعة والتسلية. ومن مسقط سردي آخر، يبرز الهم بمعنى الوطن كمرادف وصدى للإخفاق العاطفي وانكسار أحلام الذات على صخرة الواقع، واختلاط الوهم بالحقيقة، في رواية «شرطي للفرح»، للكاتب أشرف الصباغ، بينما يبحث الكاتب حمدي الجزار عن بؤرة تمجيد للمرأة، بوصفها مبتدأ العالم ومنتهاه، في روايته «الحريم»، كاشفاً أقنعة التصور الذكوري للعالم، وما ينطوي عليه من نزوع فردي عقيم للاستحواذ والمصادرة والتبرير لتحولات المجتمع والتاريخ.
وبعد.. لقد اتسعت رؤية الدكتور يسري عبد الله بحصافة ووعي نقديين في هذا الكتاب المتميز، لتضع هذه الكوكبة من الكتاب في جدارية السرد العربي، لكن أرجو أن تتسع برحابة أوسع في أعماله المقبلة، فثمة كتاب روائيون في مصر والعالم العربي جديرون بأن يكونوا أعضاء فاعلين في هذه الجدارية.
جدارية سردية بتوقيع 30 روائياً
يسري عبد الله في «جماليات الرواية العربية»

يسري عبد الله

جدارية سردية بتوقيع 30 روائياً

يسري عبد الله
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة