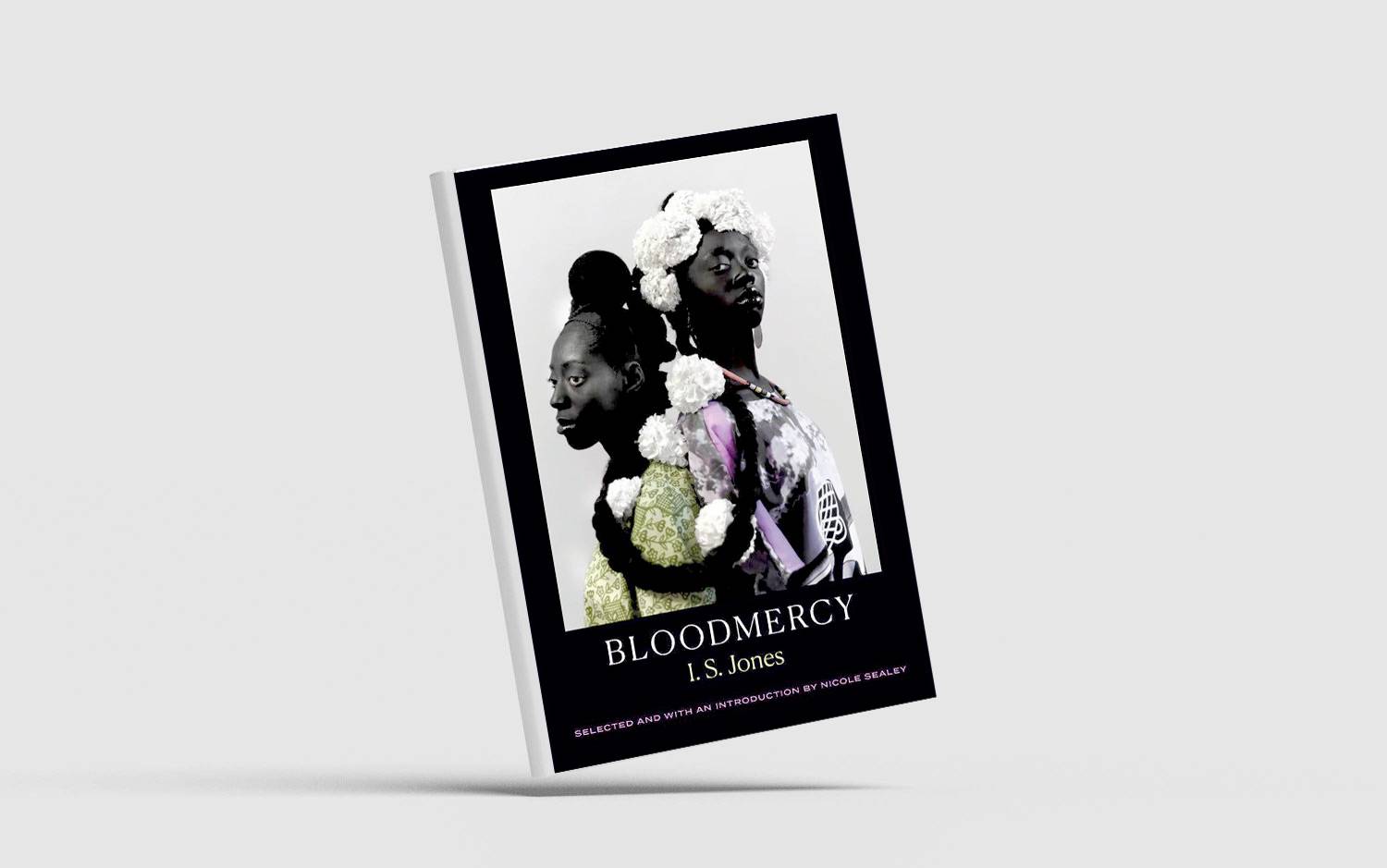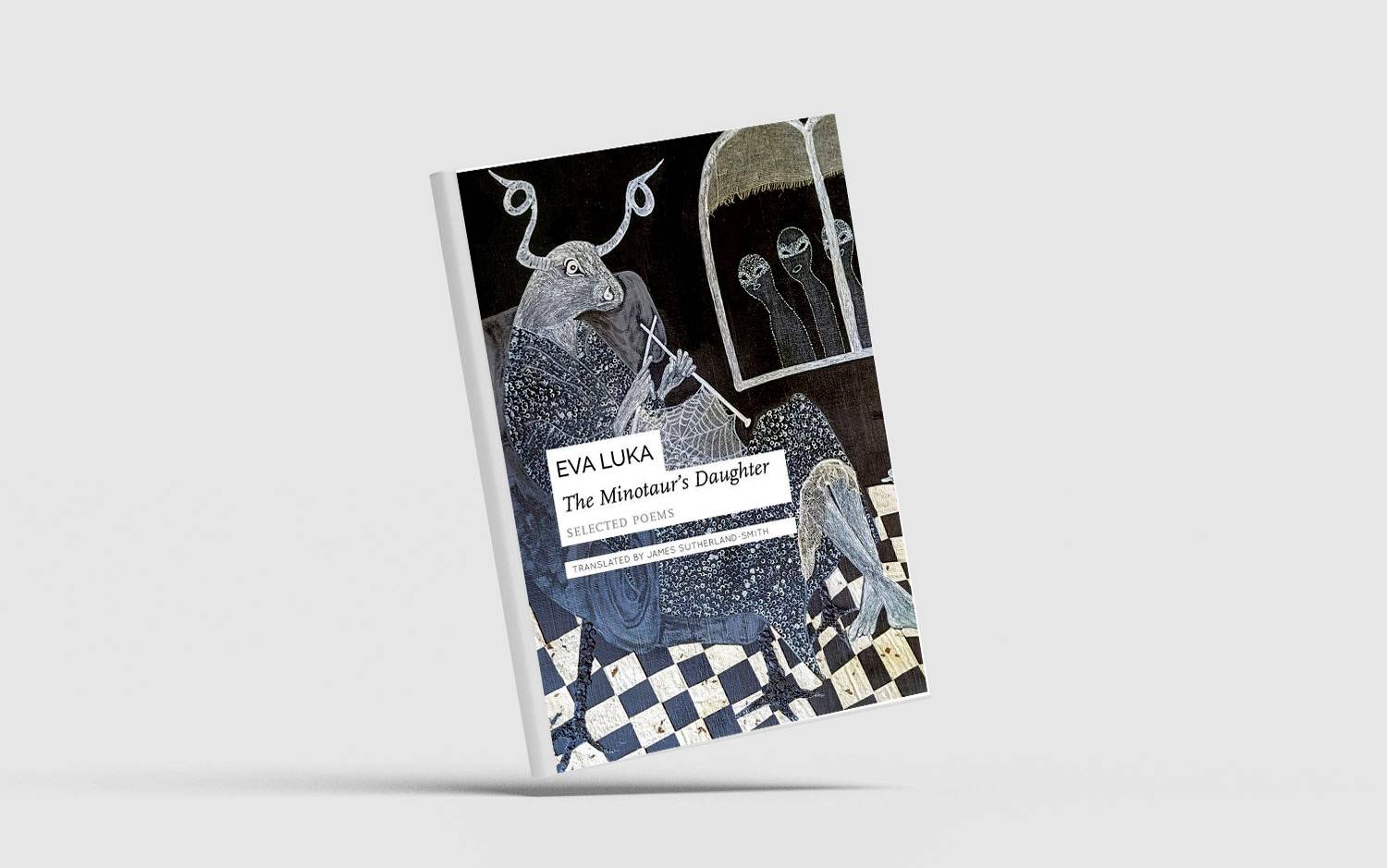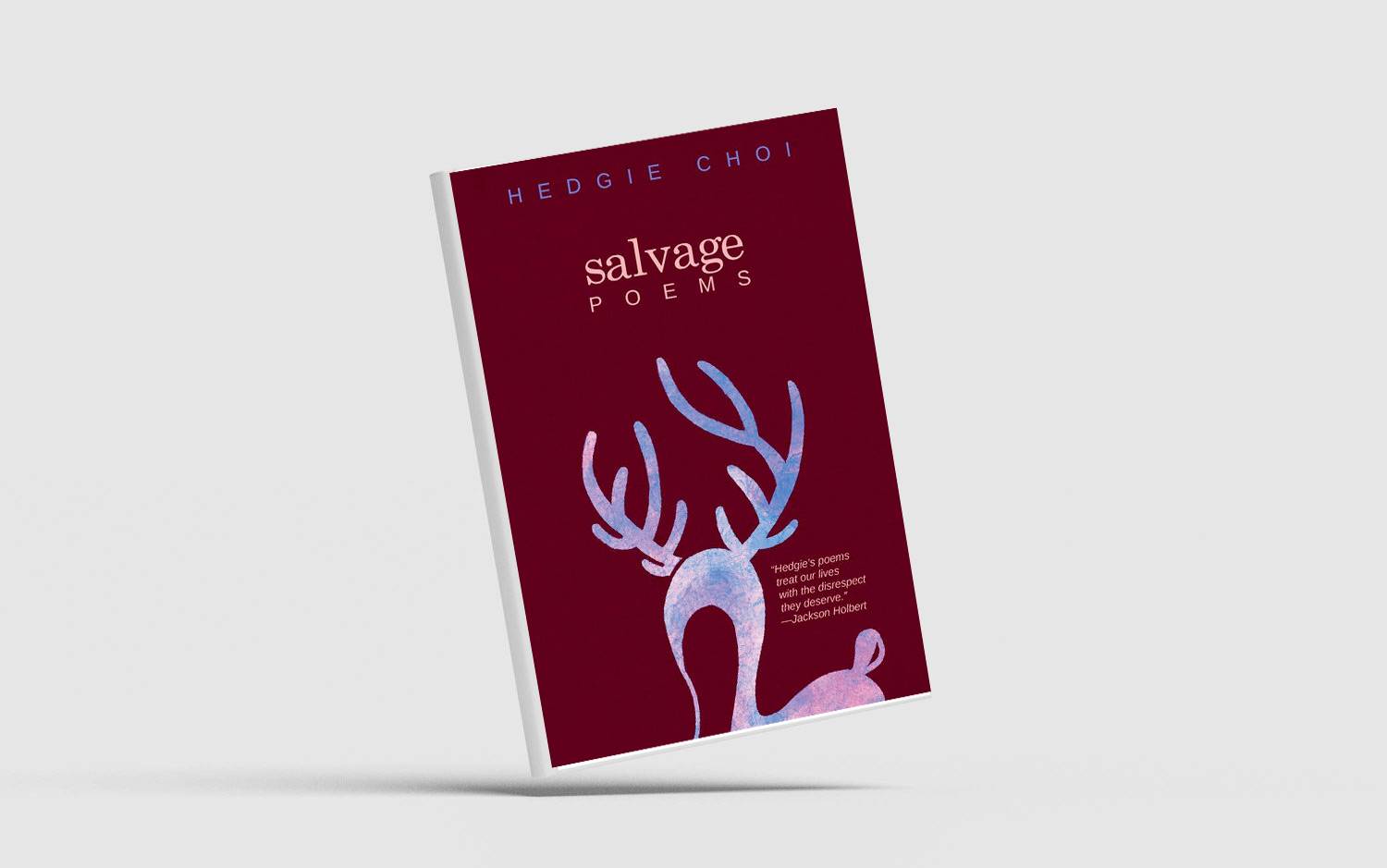وظيفة النقد ليستْ بعيدة عن وظيفة القراءة الفاعلة، وحين يمارس الناقد هذه الوظيفة فإنه حتما سيجد نفسه أمام لعبة من الكشوفات المفتوحة، والسرائر التي تتطلب شغف المغامرة والمراودة، ليس لأنّ القراءة متعة لا قيود لها، بل لأنّ فاعلية النقد ستمنح القراءة أفقا لتجاوز مرحلة ما بعد المتعة، وباتجاه أن تكون أسئلة في المعرفة...
في كتابه الجديد (القصيدة المعلقة- في شعر نوري الجراح) الصادر عن دار المتوسط- ميلانو-2018 يضعنا الناقد مفيد نجم عندما سماه بـ(المغامرة) حيث دينامية القراءة، وشعرية ما تُتيحه من معطياتٍ لها تمثّلاتها الفنية- الصياغية، والجمالية- الرؤيوية، والتي تضع التجربة الشعرية العميقة لنوري الجراح وكأنّها شاهدٌ على تحولاتِ القصيدة، وعلى تحولاتِ الواقع، فالقصيدة تستثمرُ طاقة الوعي، وطاقة التحوّل، لكي تصل بالشاعر حدّ التعري، وحدّ الرفض والاحتجاج...
الناقد يدرس في كتابه (تجربة الشاعر نوري الجراح من خلال أعماله الشعرية المكتوبة على مدار ثلاثين عاما) كما يقول الناشر، وهي تجربة أو شهادة على زمنٍ شعري عربي عاصف بالتحولات والصراعات، لكن ما يُميّز هذه التجربة خصوصيتها الجمالية، ورؤيتها الشعرية المفارقة للأحداث والوقائع واليوميات...
ضمّ الكتابُ عتبة تعريفية، ومحورين تناولا فصولاً وموضوعات توزعت بين ثنائية العنوان والمتن، وبين شعرية القيامة السورية، وهي اشتغالات أدرك أهميتها الناقد كإجراءات للمكاشفة، وللتعاطي مع تجربة الشاعر ومع براديغمات قصائده...
الكتابة بوصفها لعبة في المواجهة
المحور الأول (من العنوان إلى المتن) انحنى على مقارباتٍ تمسّ الجانب الدلالي في العنوان، وفي حمولاته، فضلا عن جملة من الفعاليات التي تخصّ (التناص والانزياح والتكرار) والتي برزت أهميتها من خلال جرأة الشاعر وجدّته في توظيفها، وفي كتابة مراثيها وفجائعها...
العنوان عتبة، لكنه حمولة دلالية أيضا، وأنّ له مستوى (إحاليا) إلى ما يمكن أنْ تحفل أعمال الشاعر الجراح والتي عكست عبر عناوينها ومتونها (مراحل تطور التجربة وتناميها، وبشكلٍ يُدلّل فيه على أهمية الوظيفة التي يلعبها العنوان) ص13.
إذ لا يمكن لهذا العنوان أنْ ينفصل عن القصيدة، ولا حتى عن المجموعة، لأنه جزءٌ من حساسية وعي الشاعر، ومن لعبة بنائه للقصيدة، وأنّ ما يُحيل إليه العنوان لا يحمل معه طابعا (خارجيا) بالقدر الذي يساكن من خلاله الشاعر فكرته، وخطابه، وتعالقه مع وقائع الحزن و(النضال) والحلم الذي ينخرط فيها، وهو ما وجده الناقد في ديوان (يوم قابيل والأيام السبعة) وفي (يأس نوح) بوصفها سيرة للملحمة السورية...
في الفصل الثاني حاول الناقد معالجة ثنائية (الآليات والوظيفة) في شعرية الجراح من خلال مقاربة (التناص والعلاقات التناصية) حيث تستدعي هذه المقاربة مجموعة من الانشغالات، والتي تخصّ (مستوى التشكيل البصري، والصورة الاستعارية، أو قصيدة القناع والشخصية والنشيد) ص29. وهي تمثلات لها دلالاتها، ولها وظيفتها الجمالية، وعبر ما تتقنّع به من إحالات أسطورية أو قرآنية، أو مسيحية، وعبر ما تقترحه من رموز يتماهى معها الشاعر بدلالة وضعها في التاريخ، أو في البنية الدرامية، أو في رؤيا (الأنا) الشعري وهي ترى، وتهجس، بوصفها الأنا الرائية، حاملة النشيد، والصليب، والمسكونة بعلاقات تناصية أكثر تعبيرا عن وجود الشاعر، وإشباعاته، واستيهاماته، والتي كثيرا ما نجدها في قصائد الشاعر الطويلة.
في الفصل الثالث يجد الناقد في تقانة (الانزياح) ملمحا أسلوبيا في شعرية الجراح، ولطبيعة تمثلات انشغالاته الشعرية، حيث يجد في انتهاك ما هو مباشر نزوعا نحو المغامرة، ولـ(إقامته روابط وعلاقات متغايرة داخل اللغة ومعها) ص70.
وللكشف عن جدة الطاقة التعبيرية في علاقتها باللغة، أو في علاقتها بالواقع، وبما يحوط الشاعر من عالم اغترابي مسكون بالرعب والخوف والمحو...
عمد الناقد إلى إبراز أهمية الانزياح في تجربة الشاعر من خلال مستويات وظائفه كـ(انزياح دلالي، انزياح الحذف أو انزياح الصمت، المحددات والضمائر والسياق، الانزياح النحوي، الإيجاز بالحذف، التقديم والتأخير) وهي وظائف أو خاصيات أسلوبية استغرقت البناء التصويري والرؤيوي لقصائد الشاعر، ولبيان خصوصية تجربته في المشهد الشعري السبعيني العربي...
التقانة ووظائفية البناء الشعري
من أكثر سمات تجربة الجراح الشعرية هي مهارته في تعالق التقانة مع الوظيفة، وبما يُعطي لهوية القصيدة سمة تجريبية، تدّل على فاعليتها كخطاب، وعلى دلالتها كقيمة اجتماعية وفكرية، ولعل الجانب الوظائفي في كتابته كان أكثر تعبيرا عن تلك المهارة، فهو يجد في التكرار وفي التوظيف الاستعاري مجالين مفتوحين على تقانات وظيفية أخرى، على مستوى استخدام الضمائر، أو على مستوى الاختزال والبياض والتكرار وهي وظائف نصية وإيقاعية مهمة في قصيدة النثر...
قراءة الناقد للتوظيف الاستعاري في تجربة الشاعر تحاول أنْ تستكنه علاقته بالتوصيف الشعري، وباستدعاء هذا التوصيف لصيغ كتابية، ولـ(علاقات داخل النص) ص102. حيث تدخل في تأطير (اللغة المجازية والصورة الاستعارية) الخاص بتلك القصيدة، والتي لا تنفصل عن تجربة الشاعر وتحولاتها، وحركيتها، وعن علاقتها مع طبيعة (المجال الذي تتشكّل فيه الصورة الاستعارية) ص105.
بوصفها رؤيا للعالم، أو بوصفها وعيا لـ(التجربة الوجودية) أو لـ(مستوى بنية الجملة الشعرية) وهي تقانات أدرك الناقد أهميتها في تجربة الشاعر الطويلة...
في الفصل السادس من الكتاب (المكان الدمشقي رمزا وأيقونة) حاول الناقد وضع تجربة الشاعر أمام محنة المكان واغترابه، إذ يتبدى المكان الدمشقي هنا بوصفه حضورا عميقا، مقابل لعبة الغياب التي يعيشها، وهذا التضاد ما بين الحضور والغياب ينعكس على رمزية المكان، وعلى دالته في البنية الشعرية، إذ (إنّ مركزية حضور هذا المكان بدلالاته المختلفة في قصائد الشاعر، هي العلامة الدالة على عمق هذا الارتباط النفسي والروحي والوجداني، حيث يكشف طغيات صورة هذا المكان «التراكم المركّب» عن جوهر هذه التجربة) ص111.
شعرية القيامة
علاقة الشاعر بالواقع الدامي هي المجال الذي وجد فيه الناقد سانحته لمقاربة تجربة الشاعر، في لحظات وعيها (الشقي)، أو في لحظة مواجهتها، حيث يكون توهّج وعي الثورة هو القرين لوعي الشاعر، وحيث تمثلاتها لسيرورة خطابها الشعري، وبما يجعلها دالته في المواجهة، وحقيقته التي يصطنع عبرها أسئلته، وأقنعته، ورؤيته، فالشاعر كما يرى الناقد لم يعشها كقربان أو أضحية، بقدر ما كان يستحضرها كقوة خلّاقة (تُنقذ الحياة من العدم والموت) وتمارس وظيفتها الدرامية عبر وعي الصراع ومرجعياته، وعبر تمثلاتها في المقاربات الدينية والأسطورية والمثيولوجية والوجدانية، وعبر وظائفها في البنيات الاستعارية والمجازية، وتقانات الجملة الاسمية، ذات التقانة التصويرية، والتي يحضر فيها المعنى، بوصفه مجالا تعبيرا عن القيمة الشعرية، وعن رؤية الشاعر لما يستدعيه من دلالات وأفكار وصور، أو لاستنفار مخيّلته، وهي تسوح في عالم التراجيديات الكبرى، تلك التي تتبى صورها في شعرية السيرة والمنفى، وفي غربة الشاعر الواقف عند قسوة العزلة الوحشة، وعند أسئلته الوجودية التي تتكئ على قاموس شعري غامر بالتناصات، وبتقانات الفعل- دالة الزمن لمقاربة راهنية الحدث والواقع والمحنة، حتى يبدو الشاعر وكأنه يعيش قيامته من خلال قيامة القصيدة ذاتها، تلك التي تمارس لعبة الخلق، وتكتب المراثي، وترحل في السفائن، وتُقيم الطقوس بوصفها شهادة على الموت السوري، وعلى الشغف بالحرية والتوق إلى الحياة.
* ناقد عراقي