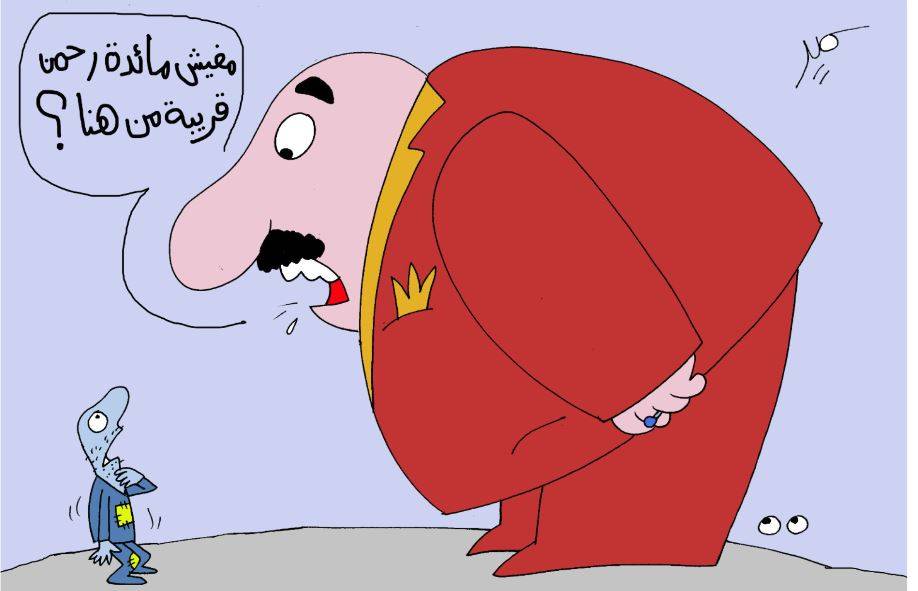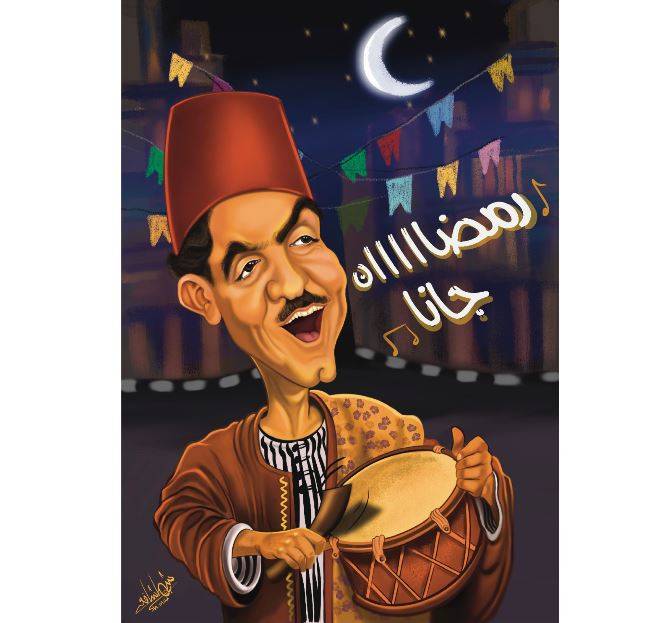هل ثمة جدوى بعد الآن لوجود نقاد في الفنون البصرية؟ وهل وجودهم يسهم في تطوير الفنون؟ وهل حافظ النقد على وظيفته المتمثلة في تقريب العمل الفني من المتلقي؟ ثم ماذا يحتاج النقد الجديد لتكوين لغة بصرية متخصِّصة بمفردات وصيغ وتقنيات خاصة تتجاوز حالات الوصف والتعميم؟ ومن أين نستمد النقد البصري اليوم؟
انطلاقاً من هذه الحيثيات، صدر هذه الأيام عن الهيئة العامة السورية للكتاب «بؤس المعرفة في نقد الفنون البصرية» للفنان الناقد التشكيلي طلال معلا الذي استطاع بفعل الممارسة والبحث أن يجمع بين الشقين التطبيقي والنظري، بين الفعل بالألوان والفعل بالكتابة، بين اللون والكلمة.
يستعرض المؤلف في كتابه الجديد ما وقع على النقد في بلداننا العربية من تغيرات خلال السنوات الأخيرة، واتهامات البعض بأن الناقد «ضلّ طريقه، فبدأ بعرقلة الفنانين وهم ماضون في طريقهم... عرقلة لا تقف عند حد الكتابة، إنما تتجاوز ذلك للعب دور كابح ومعيق، حين يتم إبراز النقاد كموظفين في الصالات والمؤسسات الفنية». النقد من وجهة نظر طلال معلا، ظل حتى الوقت الحاضر، نشاطاً يباشر الناقد عبره الأعمال الإبداعية في مجال الفنون البصرية باختلافاتها وتجدداتها، والغاية من ذلك تقييمها وتقويمها بتحديد مكامن الضعف وعناصر القوة فيها، ويقوم ذلك على عمليات منها الملاحظة الدقيقة والفاحصة، ومنها التفكيك بقصد التبرير للأحكام، ومنها التلميح إلى ما كان ينبغي أن يقوم عليه بناؤها بديلاً للمنجز. وبهذا يكون النقد نافذة نرى من خلالها إعادة بناء الأعمال وفق ملاحظات وإشارات مبنية على تحليل منهجي له آلياته ومصطلحاته الخاصة في نقد الفنون البصرية. يقول الكاتب في معرض رده على تلك التقولات: «تكشف هذه المرارة عن حقيقة لا تزال تسكن الصلة بين الإبداع البصري والإبداع النقدي الموازي، إن لم يكن الأخير متقدماً على الأول في أيامنا هذه مع بروز التوجهات الإبداعية الجديدة، حيث بات من السهل اكتشاف الكثير من الادعاءات، ولعل تصفح تاريخ الكتابات النقدية عن الفنون التشكيلية العربية تاريخياً وحاضراً، ومحاولة حصره ودراسته الدراسة الصحيحة يثبت مدى التراكم المتحقق، والنصوص النوعية المميزة لدى بعض الباحثين والنقاد، جراء الثمار المعنوية التي قدمتها فنوننا على مدى القرن الماضي».
يوضح الكاتب الفنان من خلال فصول كتابه الـ32 زائداً توطئة ومقدمة، أن النقد ممارسة تعتمد المعرفة، وله التأثير المباشر على النهوض بالفنون والتأثير العميق فيها استناداً إلى مقوماتِ التربية الفنية، وما تحمله من دعائم تفيد المبدعين تقنياً وفنياً وشكلاً ومضموناً، وعبر الملاحظة والتوصيف والشرح والتحليل يقود الناقد إلى إصدار انطباعات تحمل الملاحظة الثاقبة والتفسير والقدرة على الغوص في تفسير تركيبة العمل الفني، إلا أن عملية النقد، أو الكتابة النصية البصرية لإيجاد حلول لأية إشكالية تتعلق بجوهر الإبداع، قدر الانخراط النظري في الأنساق المعرفية المولدة للجوهر ذاته من طريق آخر هو الكتابة. حول مثل هذا الجهد يقول لنا معلا: «إذا كانت الفنون بعمومها تحتاج إلى دعم حكومي أو مؤسساتي أو مجتمعي مدني كي تستطيع أن تبلور مشروعها، وتحّول الوعي الاجتماعي إلى قيم جمالية، فإن مظاهر الفنون كما نريد اليوم بقيت مع بدايات القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر باهتة المظهر لاحتياجها للخلفية الفكرية والفلسفية التي لم تستطع أن تحققها تحولات ثورية كتلك التي طالت التغيير الفلسفي في الغرب، كما حدث في انقلابات كالثورة الفرنسية (1798) والثورة الصناعية، والثورة التقنية، التي واكبها تغيير في الوعي، وتغيير في المذاهب والاتجاهات الفنية التي ما زالت تحدد معالم وتيارات الفنون في عالم اليوم». من يواكب عملية النقد، يجد من الضروري وهو يتقصى هذه العلاقة، أن ممارسة النقد تتحقق في شكل حوار بين طرفين يقبل كل منهما بوجود الآخر. وعملية النقد تضعنا أمام شكلين متفارقين من الممارسة. النقد حوار بين منهجين مختلفين، وأن يعترف كل منهج بوجود المنهج الآخر، وهي علاقة قبول واختلاف.
لقد أصبح النقد الفني في أغلب الدول العربية هذه الأيام في عموميته، يحتكم إلى الشخص بدل العمل الفني، وما يفرضه من معاينة دائمة ومن فتنة فنية وجمالية وقيمة معرفية وفلسفية كبرى، تفرض سلطتها على المشاهد، ليكون محصناً ذاته بجملة من التخصصات الأدبية والفنية والتاريخية والأنثروبولوجية، تساعده على الوصول إلى ماهية العمل الفني، وفك شفراته الملغزة من خلال عنصر مهم في القراءة التحليلية أو عتبة أولى، لا تتحقق إلا من خلال إحياء وتنشيط.
ولا شك أن عملية نقد الفنون التشكيلية، كغيرها من الفنون، نشاط ملازم لها، يحاول استنباط الكامن والدفين فيها شكلاً ومضموناً، معيناً على اكتشاف أسرار الجمال والنقص فيما يتناوله من أعمال، وبذلك يخوض مع سائر المتلقين، ومنهم المبدعون، تجربة الاستمتاع والكشف والتحليل وإصدار الأحكام. والناقد من هذه الناحية عليه أن يكون أكثر ثقافة وأدق ملاحظة وتحليلاً من غيره، ما يكفل له إصدار الأحكام المبررة حول ما يشاهده من أعمال فنية. إلا أن هذا لا يلغي ما يطلق عليه النقد التأثري أو الانطباعي القائم على ما نشعر به إزاء العمل الإبداعي تلقائياً، فنظهر إعجابنا أو امتعاضنا إزاءه، وقد نبرر ما نحس به بشكل ما فنقترب إلى النقد التخصصي، ولكن بنكهة مختلفة.
وتتجلى أهمية النقد في كونه مساعداً على الاستنارة والإبانة عن مواطن الرقي الجمالي والفني في الأعمال الإبداعية عامة، والتشكيلية خاصة، علاوة على كونه معيناً على تذوق الفنون التشكيلية باختلاف فروعها، وعاملاً دافعاً إلى بلورة وتجديد الفنون التشكيلية، مساهماً في إرساء قواعد وأسس متينة تساهم في تطويرها والتعريف بسر الجمال فيها، كما يساعد على اكتشاف الهنات والثغرات التي يمكن أن تعتري المنجز الإبداعي.
السؤال الملحّ والمتداول في الأوساط الفنية، هو هل العمل الفني الحديث (المفاهيمي) يحتاج إلى نقد؟ يرى معلا أن ذلك يستدعي من الناقد مجموعة كبيرة من المعارف ليحقق نصه النقدي المطلوب حول الفنان وعمله الفني، وأن غموض الفن، بألعابه الافتراضية، يمنح اللغة طاقات تجاوزية تجعل منها جزءاً من العملية الشعرية والإبداعية ذاتها، والأفكار التي كان يتم تركيبها بطريقة ذهنية محددة باتت اليوم خارج القواعد التي ترتب التجربة البصرية المعاشة في ظل التدفق اللايقيني للصور التي لم يعد بالإمكان رؤيتها بجزئياتها بل بكلياتها التي تقدم حقائق العصر ومواضيعه وقضاياه الإنسانية. يميز الكشف الناقد المبدع، ويدعم رؤيته، ويؤكد اختياراته باستمرار حين تحتوي إرادته الحرة الطروحات البصرية المتنوعة، وتوجهاتها الفلسفية والفكرية التي تشكل قمة العطاء لدى المبدعين، وكأن هذا الكشف جزء لا يتجزأ من كينونة الناقد، الذي يجيد التعبير عن الاستعارات الجمالية، وهو يحولها من عالم الصورة الفنية أو المرئي المادي بتنوع تجلياته إلى عمل بلاغي، متجاوزاً إمكانية إصدار الأحكام وفق المعايير المحددة.
إذن يصير النقد الفني عملية ضرورية ينبغي أن تلازم المنجز في الفنون التشكيلية بغية جعلها في مستوى العصر، وما يحمله من ملامح التجدد الحاصل على الأذواق، وعلى مظاهر الحياة في شتى المجالات. ومهمة الناقد أن يشخص ما هو قيم ويدافع عنه بصرف النظر عن اتجاه التيار أو المذهب الفني أو الأسلوب.
النقد التشكيلي كممارسة تعتمد المعرفة
كتاب للسوري معلا يبحث في تأثيره المباشر على نهضة الفنون


النقد التشكيلي كممارسة تعتمد المعرفة

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة