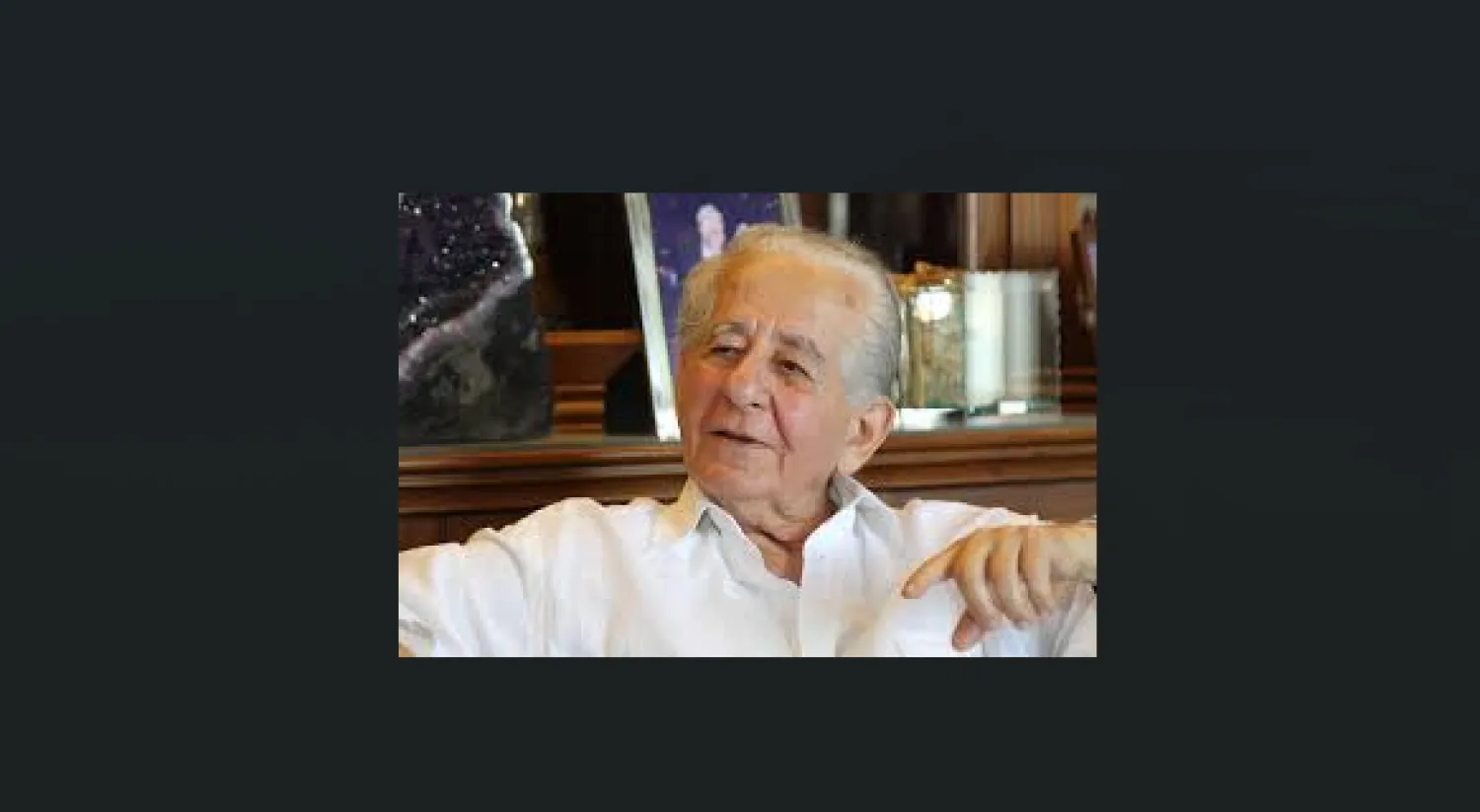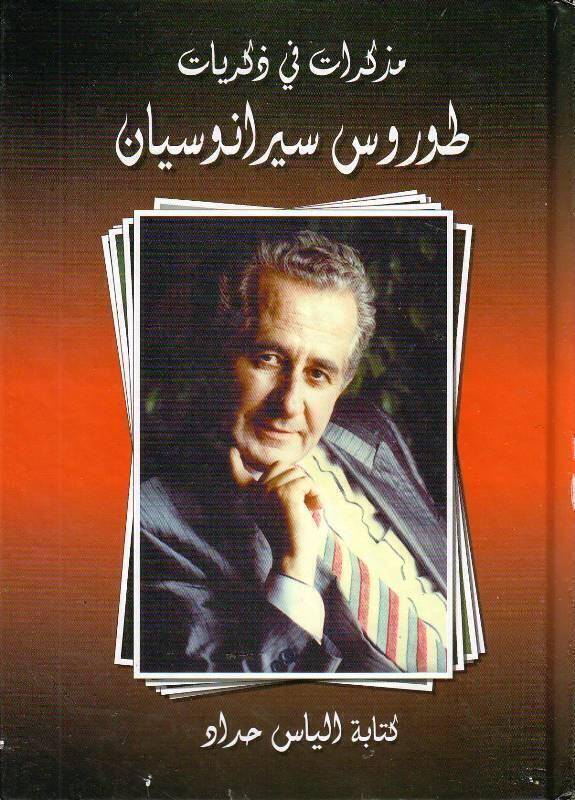في رسالته المؤرخة 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 1917 إلى الرأسمالي اليهودي اللورد ليونيل والتر دي روثشايلد التي تفوح كلماتها القليلة بالعنصريّة وأوهام التفوق العرقي وصلف موظفي الإمبراطوريّة، وعد وزير خارجيّة بريطانيا اللورد آرثر جيمس بلفور (1848 - 1930) - المنحدر من جذور أرستقراطيّة اسكوتلنديّة والعضو البارز في حزب المحافظين الحاكم وقتها - بأن «حكومة صاحب الجلالة ستنظر بعين العطف إلى إقامة كيان قومي لليهود في فلسطين»، وتمنّى عليه أن يبلغ الاتحاد الصهيوني بذلك. ورغم أن الرسالة ليست لها قيمة فعليّة قانونيّة أو إجرائيّة سوى من الناحية الرمزيّة المحضة، فإنها بتبعاتها التاريخيّة، وبجهود الدولة البريطانيّة العظمى، تمخضت عنها واحدة من أكثر التجارب السياسيّة البريطانيّة في عهد الإمبراطوريّة عنصريّة وإجراماً مستمرَين إلى اليوم بعد مرور أكثر من قرن على تلك الرسالة التي وعدت بـ«أراض لا تمتلكها الإمبراطوريّة، لشعب لا يقيم فيها وعلى حساب سكان البلاد الأصليين ودون استشارتهم مع تجريدهم من حقوقهم السياسيّة والوطنيّة».
كانت رسالة بلفور محطة تاريخيّة رئيسية في تاريخ الشرق الأوسط، وفي سياسة الإمبراطوريّة خلال مرحلة الحرب العالميّة الأولى لغاية حرب السويس 1956. واعتبرها اليهود الصهاينة بمثابة شهادة ميلاد رسميّة لقيام كيانهم المصطنع على الأراضي العربيّة. وقد أفاضت المصادر التاريخيّة في وصف الخلفيّات السياسيّة لإقدام السلطات البريطانيّة على إطلاق وعد كهذا، ومن ثم التزامها الكّلي بتنفيذ مفاعيله رغم التكاليف الماليّة والبشريّة والأخلاقيّة الهائلة، مع أن البريطانيين كثيراً ما منحوا وعوداً لأطراف كثيرة في مفاصل تاريخيّة معينة وانتهوا إلى النكث بها فور تحول الأوضاع التي أملتها في حينها - ولعل أقربها وعود الإمبراطوريّة للهاشميين بتأسيس مملكة عربيّة كبيرة في الشرق والتي انتهت هشيماً تذروها رياح الصحراء.
ومع أن كثيراً من التحليلات السياسيّة تلك تبدو مقنعة وذات صلة بسياق تطورات الأحداث فإنها تقصُر تفسيراتها على المرحلي والسياسي تحديداً، دون كبير تدقيق في الخلفيّات الثقافيّة والآيديولوجيّة التي يمكن أن تكون قد أفرزت تلك المناخات الموبوءة بالأنفاس العنصريّة، والخطاب العرقي لتمنح أفراداً يُفترض بهم أنهم نابهون - كاللورد بلفور وغيره - القدرة على ارتكاب جرائم هائلة بحق مجتمعات وشعوب أقدم من الشعب البريطاني بينما هم يشعرون بالفخر والانتشاء الحضاري والديني والقومي بحيث تبدو معها رسالة وعد بلفور العتيدة مجرد قُطبة أخرى في نسيجٍ أسود حالكٍ يغطي كل التاريخ البريطاني الحديث منذ انقشاع العصور الوسطى.
يربط المفكر البريطاني المعروف ستيورات هول التاريخ الشديد الخصوصيّة للمشاعر العنصريّة ووهم التفوق العرقي في بريطانيا بنشوء الرأسماليّة هناك بشكلها الحديث وما تسببت به من أنشطة استعماريّة عبر المسكونة. كانت العنصريّة وقتها نتاج تيار فكري روّجت له مصالح الرأسمال كآيديولوجيّة دفاعيّة عن العوائد الاقتصاديّة لتجارة الرقيق، إذ إن تداخل تلك التجارة مع عمالة العبوديّة في مزارع إنتاج السكر الإنجليزيّة بجزر الكاريبي كما الصناعات التحويليّة الطموحة على البر الإنجليزي أنتجت منظومة متشابكة لتوليد الأرباح على مستويات غير مسبوقة، فكان أن تولى مثقفو تلك المرحلة - والخاضعون بحكم تكوين الاجتماع البشري لطبقة المهيمنين ومصالح النخبة - صياغة ما يسميه بيتر فراير «ميثيولوجيا العرق» من خلال تجميعهم عناصر «خردة قديمة» من أساطير وأوهام دينيّة ومشاعر عنصريّة وقوميّة واكتشافات علميّة غير مكتملة، ومن ثم توظيف تلك الميثيولوجيا كتغطيّة على جرائم ضد البشريّة تصادف أنها تدرّ أرباحاً طائلة.
ورغم أنه لا يمكن نسب نشوء التيارات الفكريّة والاجتماعيّة إلى لحظة محددة في التاريخ، فإن خبراء النظريّة الثقافيّة يعدون كتاب إدوارد لانغ المزارع والقاضي ومالك العبيد عن «تاريخ جامايكا» - 1774 - بمثابة أهم النصوص المؤسسة للنهج العنصري البريطاني التي تبرر تفوق العرق الأبيض، وتتقبل الرّق وتجارة العبيد بوصفهما طبيعة الأشياء رغم أن الكتاب ومؤلفه من دون قيمة فكريّة تذكر. وتتابعت بعد «تاريخ جامايكا» نصوص مهمة أخرى نشرت في كتب أكاديميّة وتاريخيّة لتتحول تلك الفكرة المقيتة مع مرور الوقت إلى منطق مقبول، رصد إدوارد سعيد تمثلاته في نصوص أدبيّة عدة من تلك الفترة لا سيما في فن الرواية (كونراد، وأوستن وغيرهما)، معتبراً أنها عبّرت عن نسق متكامل من «السرد المؤدلج» الذي صار بحكم أهم الآليات التي يحافظ بها الغرب على هيمنته على الآخر (الشرق نموذجاً).
مراكمة الأرباح المحصلة من المستعمرات البريطانيّة عبر البحار ساعدت على تمويل إنشاء تحالف وثيق بين الطبقة الأرستقراطيّة - ذات الامتيازات المستمرة منذ إقطاعات العصور الوسطى - مع البرجوازيين الصاعدين ومحدثي النعمة للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، وهو الأمر الذي جنّب بريطانيا قيام ثورة برجوازيّة تتولى إدارة الدولة كما كان الحال في فرنسا مثلاً.
تحول النظام السياسي البريطاني بأكمله من مؤسسات الدولة إلى الجيش الإمبراطوري المسلّح بأحدث معطيات تكنولوجيا عصره من بنادق ومدافع وبحريّة، مروراً بطبقة المثقفين من صحافيين وأكاديميين وعلماء وأدباء ومعلمين وانتهاء بالمؤسسة الدينيّة التي أرادت «تنوير أولئك التعساء من خلال تنصيرهم أو على الأقل إفساد أديانهم المحليّة» - تحول بمجموعه إلى مجرّد أداة لخدمة الرأسمال حصراً. وحتى الأحزاب البريطانيّة الكبرى من (محافظين وعمال وليبراليين أحرار) فهي تعاقبت على الحكم لخدمة ذات السيّد بتكتيكات مختلفة، ودون مساس بثوابت المشروع الرأسمالي الأساسيّة.
موظفو السلطة الإمبراطوريّة - على اختلاف مواقعهم - سواء الوزراء أو الجواسيس أو الضباط أو المبعوثين الثقافيون أو الدينيون - كانوا في معظمهم بوعيهم أم بلا وعيهم قد عبثت بعقولهم هذه التأثيرات المتقاطعة من الشحن العنصري والآيديولوجي المطعّم بفلسفات القومية اليمينيّة وانحيازات الأساطير الدينيّة المستقاة من نصوص العهد القديم.
وهكذا عندما جلس اللورد بلفور ليوقع رسالته المشؤومة تلك في مكتبه بمقر وزارة الخارجيّة البريطانية - وهو رجل كبُر على نصوص العهد القديم، وتشبع بأفكار الصهيونيّة التي توافقت تطلعاتها الأسطوريّة لإسكان اليهود في أرض الميعاد مع عقيدته الشخصيّة - كانت يمينه يمين الإمبراطوريّة كلّها وتتحدث باسم تراكم لعقود طويلة من التراث المسموم، وإن كان هو شخصيّاً من تحمل المسؤوليّة الرمزيّة لاحقاً عن جرائم دولة إسرائيل العنصريّة التي قامت فعلاً في 1948، وما زالت إلى اليوم نموذجاً منفصلاً عن سياقه الاجتماعي والجغرافي والتاريخي تماماً كأي مشروع بريطاني سياسي من مخلفات مرحلة الإمبراطوريّة التي تقاعدت الآن ولم تعد لها أسنان كثيرة بعد صعود الولايات المتحدة إلى دفة الهيمنة العالميّة.
اللورد بلفور في واقع الأمر لم يبتدع سياسة بلاده نحو المشروع الصهيوني. فالتوجه العام في أروقة الحكومة الإمبراطوريّة ومنذ قبل بداية القرن العشرين كان التعاطف مع المشروع الصهيوني والتحالف معه بل وربما توظيفه لخدمة أغراض الإمبراطورية.
ووفق خرائط اتفاقيات سايكس - بيكو التي سبقت الوعد البلفوري كانت فلسطين، وبالتوافق مع الجانب الفرنسي ستبقى ذات وضع خاص مُلتبس بعكس الأراضي الأخرى التي توافق الطرفان على اقتسامها.
وقد بدا واضحاً من احتفاء تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانيّة الحميم ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ومقالة بوريس جونسون وزير الخارجيّة البريطاني الحالي بمناسبة مرور مائة عام على صدور الوعد - والتي أكد فيها على فخر بريطانيا بدورها في تأسيس (إسرائيل) - أن لا أشياء كثيرة تغيّرت في الطبقات العميقة من نفسيات ومواقف موظفي الدّولة البريطانيّة رغم مرور الزمن.
بلفور ليس اسم علمٍ على وعد أطاح بشعب لمصلحة غزاة غرباء. بلفور اسم حركي للعنة مست روح بريطانيا وعبثت بتكوين عقليات أبنائها ولم تعد بقادرة - فيما يبدو - على الشفاء منها.
الجذور الثقافيّة والآيديولوجيّة لوعد بلفور
عن تراث الإمبراطوريّة البريطانية المرّ

اللورد بلفور - المؤرخ ستيوارت

الجذور الثقافيّة والآيديولوجيّة لوعد بلفور

اللورد بلفور - المؤرخ ستيوارت
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة