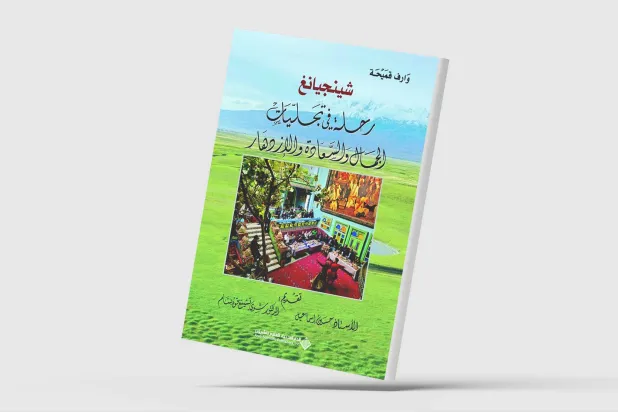افتتح الموسم الباريسي الأدبي الحالي بثماني روايات من القارة السمراء، منها الرواية الثانية للكاتب الجزائري كمال داود، التي اعتبرها بعض المعلقين في الصحافة الأدبية الحدث الأبرز في هذا الموسم المخصص للأدب الفرانكفوني. وقد حظيت هذه الرواية التي صدرت الشهر الماضي عن دار «أكت سود» في باريس، ودار «برزخ» في الجزائر، و«سيريس» في تونس، باهتمام إعلامي واسع، حتى قبل صدورها، خصوصاً أن الكاتب كان قد نال جائزة «غونكور» للرواية الأولى عن روايته: «مورسو: تحقيق مضاد» (وكنا قد كتبنا عنها في مقال سابق) التي واجه فيها كاتباً آخر، ألبير كامو، الذي نال جائزة نوبل للآداب عن روايته: «الغريب» (l'étranger)، ويتجاهل فيها هوية الضحية الجزائري الذي يقتله أحد المستوطنين الفرنسيين (مورسو) على شاطئ جزائري، ليأتي كمال داود ليعطيه اسماً، وهوية، وينسبه إلى عائلة ويعيد إلى ذهن القارئ الرواية الرائجة بعد أن أوقفها على قدميها. في حين اعتبر آخرون أنه لا يمكن أن نطلق عليها صفة رواية فهي أقرب إلى حكاية.
وجاءت روايته الثانية «زبور أو المزامير» (Zabor ou les psaumes) لتزيد من اهتمام بعض الأوساط الفرنسية بالكاتب الذي يتهم في بلده الجزائر بالإسلاموفوبيا، أو معاداته للدين، رغم أنه نشأ في بيئة دينية محافظة، وبانتقاده للغة العربية التي يعتبرها «حبيسة المقدس»، و«لا تعرف التطور». ولكن داود، وعلى الرغم من كل الانتقادات اللاذعة التي تلاحقه في بلده، من قبل الأوساط الدينية والثقافية، آثر أن يبقى في مدينة وهران ويكتب في صحيفتها «وهران»، بالإضافة إلى مراسلته مجلة «لوبوان» الفرنسية.
في روايته الثانية، بقي داود محافظاً على الأجواء الجزائرية منعكسة في الحياة اليومية لسكان القرى. فبطل الرواية الذي تدور كل الأحداث حوله، يعيش في قرية أبو قير (وهذه تسمية المستعمر الفرنسي السابق لهذه القرية تذكر بمعركة أبو قير في مصر بين البحرية البريطانية وأسطول نابليون، ووصفه لها يشابه القرية التي وُلِد فيها، قرية مسرا القريبة من مستغانم، حيث ولد في عام 1970، ثم انتقل بعدها إلى وهران) على أطراف الصحراء غرب الجزائر. زبور، بطل الرواية، يتيم الأم المنطوي على نفسه، كان على خلاف أقرانه مولعاً بالقراءة. وتعلم اللغة الفرنسية بجهده الشخصي من كتب أولاد المستعمر السابق التي تركوها خلفهم بعد رحيلهم من الجزائر. فالرواية كنصّ أدبي تبدو عادية، بأسلوب لغوي بسيط، سهل الهضم، لا يخلو من السلاسة، بلغة فرنسية متقنة، ومفردات منتقاة تتناسب والفكرة العامة التي تدور حول فكرة جديدة تجعل من الكتابة «تعويذة سحرية لإطالة أمد حياة المحتضرين، أو من شارف على الموت لمرض أو لعجز، أو لشيخوخة». هي فكرة تجعل الكتابة تواجه الموت، كدواء سحري، أو وسيلة تخلق معجزات، وتعاند قوانين الطبيعة، والقدر المحتوم.
وهنا القصة الطويلة التي تملأ كراساً بأكمله سرداً تبعد الموت عن المتلقي، حسب الكاتب. إنها على نقيض «ألف ليلة وليلة»، إذ إن القصة تأتي مسلسلاً ليليّاً متقطعاً يؤجل موت القاصة شهرزاد، وليس المتلقي شهريار الملك.
وفي صفحات أخرى من هذه القصة، يخبرنا داود أن القراءة وحدها لا تكفي. الكتابة هي الأساس، وهي التي تنقذ من الموت، في معنى مجازي... «أمة لا تقرأ ولا تكتب نهايتها الموت».
هي رواية بصوت واحد، صوت الكاتب، كتبت بصيغة المتكلم كمحرك رئيسي للأحداث، وكل الشخصيات حوله هي شبه ثانوية، شخصيات عابرة، تخدم الفكرة العامة في معجزة الكتابة، التي فيها الشفاء، ولكن ليس باللغة العربية، وإنما باللغة الفرنسية! لماذا بالفرنسية؟ ثم، لماذا اختيار هذا العنوان «زبور، أو المزامير» الذي يذكِّر بمزامير داود، مع أن الكاتب يشرح في روايته أن اسم «زبور» الأصلي كان إسماعيل، لكن اسم «زبور» جاءه بعد شجار مع أخيه غير الشقيق، عادل، راعي قطيع أغنام أمي حقد عليه، إثر حادث وقع بينهما عندما كانا طفلين، فصدم عادل رأس أخيه إسماعيل، وسقط عادل في جب جاف القعر. اتهم زبور بأنه هو من دفع أخاه ليسقط في الجب، ما جعل الأم أن تحكم على أبيه إبراهيم الذي تزوج منها بعد موت أم إسماعيل، بطرد ابنه من البيت، فيضعه مع عمته العزباء هاجر في منزل منفصل (وهنا لا بد للقارئ أن يلاحظ أوجه التشابه بين قصة إبراهيم الخليل مع زوجته سارة التي تجبره على طرد خليلته هاجر وطفلها إسماعيل كما جاءت في القرآن الكريم) هل هو تشابه في الأسماء مقصود لإسقاطات تاريخية ودينية؟
على أية حال، هذا الارتطام بالرأس جعله يسمع دويا يشبه صوتا يناديه «زااااا بووووور» فيتحول من إسماعيل (المسلم) إلى (زبور) اليهودي. وظل هذا الاسم هو الذي يطلق عليه فيما بعد. وبقي الأخوان متخاصمين طوال سنين طويلة، والأب لا يعير كبير اهتمام بالطفل إسماعيل (زبور) ولا بأبيه العليل الحاج حبيب. منذ دخول زبور المدرسة في قرية معظم قاطنيها أميون، أصابه في هوس القراءة والكتابة، فنراه منطوياً على نفسه لا يعرف من عالمه سوى الانكباب على القصص، وقراءة كل ما يقع تحت يديه، حتى إن أهالي قرية أبو قير كانوا يأتونه بكتب مُزِّقَت بعض صفحاتها، أو بعض المجلات، أو أي شيء يُقرأ، وكان يلتهمها جميعاً. وقد ذاع صيته في هذه القرية، بأن له مقدرة غير عادية على شفاء المرضى، وقهر الموت، عبر كتابة قصة حياتهم. هل هي هبة خارقة؟ أم مجرد شعوذة وتحدي الموت بالمتخيل؟
يقول: «يكفي أن نعطي للموت عظمة يقضقضها، أن نخدعه بقصة طويلة تنهكه حتى نراه ينأى بعيداً... الكتابة هي الحيلة الوحيدة الناجعة في مواجهة الموت... أعتقد أني الوحيد الذي وجد الحل: الكتابة... اخترعت الكتابة كي تحفظ الذاكرة... وإذا كنا لا نريد أن ننسى فهي بطريقة أو بأخرى، رفض للموت.. وإذا كانت الكتابة قد عمت هذا العالم ذلك لأنها وسيلة قوية لقهر الموت، وليس فقط وسيلة حسابية، أو سردية كما ولدت في حضارة ما بين النهرين».
هي مقولة مضادة لمعتقد سائد في قرية محافظة، فالموت حتمي مهما تحصنّا: «يأتيكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة». لكن سكان أبو قير بدأوا يعتقدون به بعد تجارب مختلفة، فأعمار المسنين راحت تطول حتى تخطت المائة عام.
كتابات زبور التي تتحدى الموت (وكأن كمال داود يعتبر كتاباته كـ«المزامير» كما جاء في عنوان الرواية) اعتبرها «كأول تمرد للحبر ضد الموت... منذ زمن وقريتنا في صحة جيدة... لا قبور تُحفَر في مقابر بوغويلة في الهضبة منذ أن بدأت الكتابة، الناس يعيشون بفضل كتاباتي مائة سنة».
لكن زبور كان لديه تحدٍّ كبير، فكان إذا قابل أحدهم ولا يكتب عنه خلال أيام ثلاثة فإنه سيلاقي الموت، وكان عليه أن يشتري كراسات بعدد الأشخاص الذين يقابلهم خلال اليوم، وكان لديه مهلة ثلاثة أيام كي ينقذهم، فكان يشتري في اليوم عشراً أو اثنتي عشرة كراسة، وفي إحدى الأيام اشترى سبعين كراسة بعد أن شاهد عرساً. كان يعطي لحكاياته عناوين غريبة أيضاً، أو عناوين لروايات معروفة كـ«موسم الهجرة إلى الشمال»، و«رصيف الأزهار لم يعد يرد»، و«الطرقات الصاعدة»، و«أضواء آب»... وسواها، حتى إنه ملأ صفحات 5436 كراسة.
في الثامن من شهر أغسطس (آب) من عام 1984 جلس زابور البالغ من العمر أربع عشرة سنة، قبالة جده الحاج حبيب الذي يحتضر وهو يكتب له في كراسته: «الجد شبه جثة هامدة، والكتابة لا تتوقف والجد يردد أنفاسا ضعيفة وصفحات الكراسة كادت تنتهي، كل صفحة تزيد فيه أنفاساً إضافية».
وجاء دور الأب المريض إبراهيم الذي أسرع ابنه عادل الأخ غير الشقيق ليتوسل إلى زبور الذي عانى من ظلم أبيه وإهماله (وهنا الطفل إسماعيل هو الذي ينقذ الأب إبراهيم وليس العكس في القصة التوراتية: إبراهيم هم أن يضحي بابنه ثم أنقذه الملاك بكبش)... ليقع في حيرة تغذيها عمته التي احتضنته بعد موت أمه وهجر أبيه، لأنها تريد أن تنتقم، أسلوب آخر في توظيف عقدة أوديب في قتل الأب، أو عدم الرغبة بإحيائه، فالكتابة وإن أحيت فهي أيضاً تميت.
زبور أو المزامير رواية سيرة شبه ذاتية متخيلة، تخلط المقدس بالمتخيل، ونلمس فيها حنيناً للغة المستعمر وإضفاء صبغة قدسية عليها أعلى من المقدس الديني، ما دام زبور نجح في إطالة إعمار سكان القرية بالكتابة بهذه اللغة.
«زبور»... الكتابة كحيلة وحيدة في مواجهة الموت
رواية ثانية لكمال داود الفائز بـ«غونكور» الفرنسية

كمال داود - غلاف الرواية

«زبور»... الكتابة كحيلة وحيدة في مواجهة الموت

كمال داود - غلاف الرواية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة