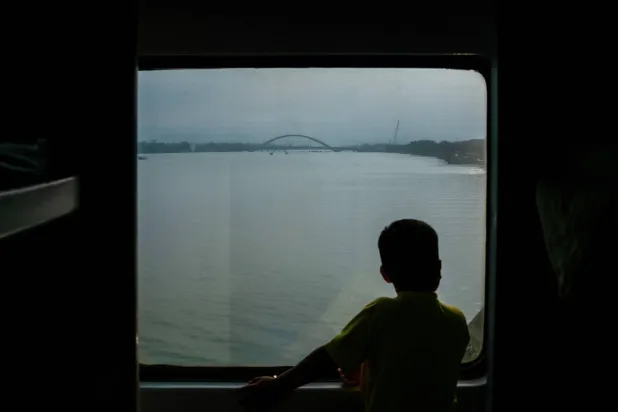باتت مئات من تماسيح المياه المالحة، التي كانت تشارف الانقراض، تسبح راهناً في نهر قريب من مدينة داروين في شمال أستراليا، وتعلّم سكان هذه المنطقة كيفية التعايش مع هذه الحيوانات المفترسة «شديدة الخطورة».
ويقول غراهام ويب، وهو مدير برنامج حفظ، من حديقته الاستوائية: «لا يمكن ترويض التماسيح».
وقبل أن تبدأ الحكومة الأسترالية في توفير حماية لتماسيح المياه المالحة في سبعينات القرن العشرين، كان 98 في المائة من التماسيح البرية قد اختفت من الإقليم الشمالي، بسبب الطلب المرتفع على جلودها.
وتشير السلطات إلى أنّ أستراليا تضمّ راهناً أكثر من 100 ألف تمساح، يصل طول الواحد منها إلى 6 أمتار، ووزنه إلى طنّ، وتصطاد فرائسها على طول السواحل وفي الأنهر والأراضي الرطبة في أقصى شمال البلاد.
ويقول ويب لوكالة «فرانس برس»: «إن ارتفاع أعداد التماسيح يمثل نجاحاً كبيراً».
لكنّ حماية هذه الحيوانات لم تكن سوى الخطوة الأولى. ويقول ويب: «لحماية أي نوع مفترس، ينبغي رفع أعداده، وإذا نجح الأمر يعاود هجماته على البشر فيصبح الجميع راغباً في التخلص منه».
وأوضح تشارلي مانوليس، وهو خبير في التماسيح لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أنّ الناس كان عليهم في ثمانينات القرن الفائت إدراك قيمة هذه الحيوانات ليتمكّنوا من التعايش معها.
وقد ساهمت حملة مرتبطة بالسلامة، تضمّنت رفع لافتات على طول الأنهر ونقل حيوانات مفترسة خارج المناطق المكتظة بالسكان، في التوصل إلى تعايش سلمي أكثر مع السكان.
ونُفّذت عملية جمع، حظيت بموافقة السلطات، للبيض البري في الإقليم الشمالي.
وحصل ملاك الأراضي، وعدد كبير منهم من السكان الأصليين، على مكافآت لقاء البيض البري الذي جُمع من أراضيهم لتوفيرها لمزارع تربية التماسيح التي تزوّد قطاع تصنيع الجلود.
وسنوياً، يجمَع من الطبيعة نحو 70 ألف بيضة، و1400 تمساح. ويقول ويب: «بفضل التماسيح يتم توفير وظائف لعدد كبير من الأشخاص»، وخصوصاً في مجال تربية هذه الحيوانات والسياحة.
وتشير التقديرات إلى أن تربية التماسيح تدرّ أكثر من 100 مليون دولار أسترالي (نحو 66 مليون دولار) سنوياً على الإقليم الذي يعد أكبر منتج للجلود في أستراليا.
والجلود التي تُنتّج مطلوبة بشكل كبير من ماركات للمنتجات الفاخرة كـ«إرميس» و«لوي فويتون».
وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تفادي ذبح تماسيح المياه المالحة، بحسب تشارلي مانوليس.
وتقول جيس غريلز (32 عاماً)، وهي تقود قارباً في نهر اصطناعي تابع لمتنزه كروكوديلوس، وهو موقع سياحي قرب داروين: «كنت أعمل في مجال التعدين، ثم أصبحت أمّاً، والآن أعمل حارسة تماسيح».
ويشكل المتنزه، الذي أسسه غراهام ويب، «جنّة للتماسيح التي تتسبب بمشكلات»، وهي حيوانات سُحبت من البرية لأنّها تمثل خطراً على السكان، أو لأنها تميل إلى مهاجمة المواشي.
وتوضح غريلز، وهي تعلّق قطعة من اللحم على عصا طويلة: «لا يمكن تدريب التمساح، لكن يمكن نقله إلى مكان لا يتسبب فيه بمشكلات».
وتضرب الماء بهذا الطعام، ثم تتركه فوق السطح، فيظهر ببطء تمساح يُعرف باسم «آكل المواشي». وفجأة، يقفز الحيوان عمودياً ثم يفتح فكّيه، قبل أن يغلقهما على الطعام ويعاود الغوص في المياه.
ويبعث هذا المشهد برسالة واضحة للزوار؛ كونوا حذرين من الأماكن التي تعيش فيها هذه الحيوانات وتصطاد فرائسها.
وتقول غريلز: «على الزائر أن يفترض دائماً وجود تمساح في المياه».
ومع تزايد أعداد التماسيح وارتفاع عدد الكبيرة منها، من المرجح أن تتزايد الهجمات، رغم أنّ حدوثها نادر، على قول مانوليس.
ويؤكد أن التغلب على خوف متأصل منذ «مليون عام» مع مواصلة برنامج حماية هذا النوع، هو تحدٍّ كبير.
ويضيف: «لنكن واقعيين، إنّ الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) لا يعتمد التمساح كصورة لشعاره، بل الباندا».
وتعدّ غريلز أنّ احتمال معاينة هذه الحيوانات المفترسة من قرب يساهم في تعزيز حمايتها، وتقول: «إذا احترمتموها واحترمتم أراضيها، فلا أعتقد أنها مرعبة إلى هذا الحدّ».