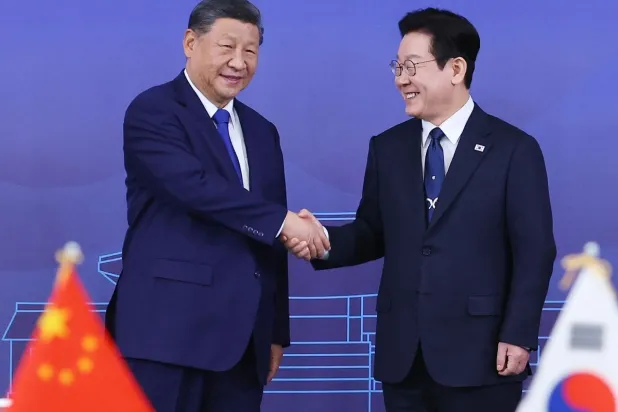مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية في العراق، وهي السادسة بعد سقوط النظام السابق في العراق في أبريل (نيسان) 2003، تتصاعد الخلافات والمخاوف، سواءً بين المكوّنات العراقية (العرقية والمذهبية) أو بين الكتل والأحزاب السياسية. وفي حين اغتيل مرشحٌ سنّي للانتخابات المقبلة، وسط شكوك حول الجهات المتورِّطة، فإن ستّة من النواب الشيعة في البرلمان العراقي، تقدموا - لأول مرة بعد هيمنة الشيعة على منصب رئيس الوزراء - بشكوى ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (المرشح الشيعي للمنصب). وبين هذا وذاك، تستمر عمليات الاستبعاد والطعون وردّ الطعون في مشهد سياسي يعكس القلق والمخاوف من المستقبل، لا سيما في ضوء التغييرات الحاصلة في المنطقة. وأيضاً مع ما يتوقّع أن يشهده العراق لجهة طبيعة الحكومة المقبلة التي ستتشكل بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرّر إجراؤها في الحادي عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

حادثة الاغتيال راح ضحيتها صفاء المشهداني، عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات المقبلة عن تحالف «السيادة»، الذي يتزعّمه رجل الأعمال السنّي خميس الخنجر المثير للجدل شيعياً. وقد أثارت الحادثة شكوك مراقبين في قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين الحماية الكافية للمرشحين رغم عددهم الكبير - (7668) مرشحاً يتنافسون على 329 مقعدا برلمانياً -، أو لجهة ما يمكن تسميته «شرف الخصومة» بين القوى المتنافسة. المنطقة التي وقعت فيها حادثة الاغتيال تثير هي الأخرى قلقاً وهواجس؛ كونها إحدى المناطق الساخنة (منطقة الطارمية شمالي بغداد) ذات الغالبية السنّية التي تحاول القوى المسلّحة الشيعية تثبيت «مراكز نفوذ سياسي» لها فيها، مع محاولة تحويلها «نسخة ثانية» من منطقة جرف الصخر (جنوبي بغداد) في محافظة بابل. إذ كانت الأخيرة منطقة ذات غالبية سنّية، لكنها وقعت تحت سيطرة الفصائل الشيعية المسلحة، وجرى تهجير سكانها تحت ذرائع مختلفة... أهمها وجود الجماعات المسلحة فيها («القاعدة» سابقاً، و«داعش» حالياً) وهو نفس ما ينطبق اليوم على منطقة الطارمية.
«اغتيال سياسي» ومطامع جغرافية
من هنا، وكون الحادث الذي راح ضحيته المشهداني وقع في منطقة تتصارع عليها قوى مختلفة سنية وشيعيّة؛ رُجِّحت إلى حد كبير فرضية «الاغتيال السياسي» المرتبط بالصراع على النفوذ والمصالح، لا سيما في ظل اتساع المنافسة بين تحالفات سنّية وشيعية داخل المناطق المختلطة وخارجها، قبل أن يعلن القضاء العراقي اتهام أشخاص من المنطقة نفسها بتدبير وتنفيذ عملية الاغتيال لـ«أغراض انتخابية». وللعلم، يُعد المشهداني من أبرز الوجوه الصاعدة في تحالف «السيادة» الذي يمثل مكوّناً سنّياً واسعاً في العراق. ولقد عُرف بنشاطه في ملف الأراضي الزراعية واستثماراتها، وهو ملف شائك في مناطق «حزام بغداد»؛ إذ يتقاطع النفوذ السياسي مع المصالح الاقتصادية لجماعات شيعية مسلحة.
وكان آخر ما نشره المشهداني على صفحته في «فيسبوك» إعلانه متابعة قرارات مجلس المحافظة القاضية بوقف تخصيص الأراضي الزراعية شمال بغداد، مؤكداً أن «الأرض حق لأهلها»، وأنه «لن يسمح بالمساس بها أو انتزاعها». وتفيد مصادر سياسية بأن هذه المواقف، ربما، وضعته في مواجهة غير مباشرة مع جماعات نافذة تتحكّم بمشاريع استثمارية ومصالح عقارية في تلك المناطق.
ومن ثم، يرى مراقبون سياسيون أن هذه الجريمة، التي تُعدّ أول اغتيال سياسي لمرشح في الانتخابات المقبلة، قد تدشن «تطليخ الانتخابات بالدم»، وقد تمثل تحولاً خطيراً في طبيعة التنافس السياسي داخل العراق، حيث يزداد التوتّر مع اقتراب موعد الاقتراع في بلد لم يتعافَ بعد من آثار النزاعات الطائفية وتفشّي السلاح غير الشرعي.
تصفية أصوات الاعتدال
من ناحية ثانية، يرجّح محلّلون أن تكون الجريمة محاولة «لتصفية صوت معتدل»، أو لتوجيه رسالة مفادها أن بعض المناطق ما زالت غير آمنة، وبالتالي، غير مؤهلة لإجراء انتخابات حرة. وفي هذا السياق، يقول المحلل الأمني مخلد حازم لـ«الشرق الأوسط» إن «اغتيال المشهداني قد يكون رسالة داخلية وخارجية، تفيد بأن البيئة الانتخابية في العراق غير مستقرة، وأن بعض القوى لا تزال ترى في صناديق الاقتراع تهديداً لمكاسبها السياسية والمالية».
وحقاً، تشهد الساحة السياسية العراقية احتقاناً متزايداً مع اقتراب موعد الانتخابات، وسط انقسامات حادة داخل التحالفات التقليدية، وتزايد الانتقادات بشأن «هيمنة السلاح المنفلت»، ووجود أطراف تحاول توظيف العنف السياسي أداةً لإعادة رسم خريطة النفوذ.
خيبات أمل
بعد 23 سنة من إسقاط نظام صدام حسين (2003)، تعدّدت الحكومات العراقية. وكانت البداية حكومة «مجلس الحكم» بإشراف الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، تلتها حكومات إياد علاوي المؤقتة وإبراهيم الجعفري الانتقالية و«الحكومات الخمس» المشكّلة بعد إجراء أول انتخابات برلمانية (2005). ومع هذا، تبدو مخيّبة للآمال الحصيلة النهائية لما عُدَّ تغييراً جذرياً من «نظام شمولي» إلى «نظام برلماني» ليبرالي... تتوزّع السلطات فيه طبقاً للدستور.
إن الآمال التي بناها العراقيون على التغيير، بعدما أطاحت الدبابة الأميركية حكم صدام حسين، بدت مختلفة عن الآمال التي بنتها الطبقة السياسية على هذا التغيير. وهذا التغيير وإن كان جذريّاً على مستوى بنية الدولة، فهو لم يقدّم البديل الذي راهن عليه المواطن العراقي.
والطبقة السياسية التقليدية، التي تزامن دخولها مع دخول الأميركيين إلى العراق، وكان بعض رموزها يأملون في أن يقودوا التغيير المنشود، لم يكن أمامهم سوى تقاسم السلطة والنفوذ عبر المحاصصة الطائفية والعرقية. وتبدأ هذه المحاصصة، من توزيع مناصب الرئاسات السيادية الثلاث نزولاً إلى التنافس على مناصب بسيطة كنائب مدير قسم بإحدى دوائر الدولة، كما حصل مع إحدى مديريات الزراعة قرب الدورة ببغداد قبل شهرين. وهو ما فجّر صراعاً دموياً بين أجنحة الفصائل المسلحة» استدعى من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن يتهم علناً - لأول مرة - إحدى الفصائل (كتائب حزب الله) بأنها هي من تقف خلف العملية.
حالة استقطاب حاد
وبالتزامن مع معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن الظاهرة الأكثر بروزاً هي الاستقطاب الحاد سواء لجهة المخاوف من الآخر المختلف عرقياً ومذهبياً، أو المخاوف بين المكوّنات نفسها طالما أن الهدف في النهاية للجميع هو الاستحواذ على السلطة، وما يرتبط بها من مال ونفوذ.
وعليه، فإن طريقة توظيف هذا المال والنفوذ تحوّلت إلى أعرض عنوان لأي انتخابات برلمانية يجري فيها استدعاء الشعارات الطائفية واللعب على الغرائز في مسعى للبقاء في دائرة الضوء من بوابة الدفاع عن المذهب والعقيدة... والآن في الانتخابات الأخيرة (نسخة 2025) الدفاع عن العشيرة.
هنا تبدو الديمقراطية العراقية، بعد مرور 23 سنة على تغيير نظام صدام حسين، وكأنها صُمِّمت لتكون تطبيقاتها على أرض الواقع بـ«الذكاء الاصطناعي»... لا بما هو حقيقي، ويمثل حاجة الناس الحقيقية بعد هذا التغيير.
إذ ما تعتبره الطبقة السياسية العراقية الحاكمة امتيازاً لها كونها تطبِّق الديمقراطية، لم يكن صدام حسين يُعدّه مثلبة عندما لم ينكر أن نظامه ديكتاتوري. لكن الفارق بين الطرفين أن تلك الديكتاتورية كانت حقيقية ولها مخرجاتها على أرض الواقع بما في ذلك عمليات القتل والإعدام وسواها، بينما ديمقراطية ما بعد 2003 ديمقراطية الكلام المسموح باتجاه واحد فقط لا باتجاهين.
انتهاك «الخط الأحمر»
منصب رئيس الوزراء يُعدّ الأهم بالنسبة للشيعة الذين يبررون ذلك بكونهم «الأكثر عدداً» في العراق؛ ما يجعل المنصب التنفيذي الأول في البلاد (رئاسة الوزراء) من نصيبهم.
لكن إقدام عدد من النواب الشيعة على تقديم شكوى ضد رئيس الوزراء الشيعي - لأول مرة منذ سقوط النظام السابق وبدء تشكيل الحكومات ذات الغالبية الشيعية - يُعتبر أمراً في غاية الخطورة. ففي تطوّر لافت على صعيد الأزمة التي تعيشها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات البرلمانية، تقدّم 6 من النواب الشيعة بشكوى ضد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وكانت رئاسة الادعاء في العراق أحالت الشكوى التي تقدّم بها النواب الستة إلى المحكمة المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة عن عدد من المخالفات القانونية طبقاً لنصّ الشكوى.
النواب الستة، وهم يوسف الكلابي، وياسر الحسيني، وفالح الخزعلي، وعلاء الحيدري، وهيثم الفهد ومحمد نوري، ينتمون إلى كتل شيعية مختلفة، ولكن طبقاً للمراقبين السياسيين، فإن اقتصار الشكوى على نواب شيعة فقط دون المكوّنات الأخرى (العرب السنة والكرد والتركمان) وفي مخالفات قانونية مثلما نصّت الشكوى، واقع يؤكد أن الشكوى تعبر عن انقسام واضح داخل «الإطار التنسيقي»، بجانب كونها أول «شكوى شيعية» ضد «رئيس وزراء شيعي»... وهذا بصرف النظر عن النتائج التي ستنتهي إليها!

بين السوداني والمالكي
حول ما إذا كانت شكوى النواب الشيعة الستة ستؤثر على ائتلاف السوداني (الإعمار والتنمية)، أو حظوظه شخصياً على صعيد سعيه لولاية ثانية، يقول الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست كل شكوى تقدّم إلى القضاء شكوى منتجة، حيث إن الشكوى المنتجة تعتمد على الأدلة والقرائن والوثائق».
وأردف التميمي: «هذه الشكوى التي تستهدف رئيس الوزراء وائتلافه تفتقد في الحقيقة إلى الأدلة». ثم أوضح أن «من بين القضايا التي أثارتها الشكوى موضوع التعيين بالوكالة في دوائر الدولة ومؤسساتها، بينما في كل الحكومات السابقة وليس هذه الحكومة فقط تجري عملية التعيين بالوكالة، كما أن قانون الخدمة المدنية أجاز التعيين بالوكالة، ويضاف إلى ذلك أن الحكومة الحالية هي في الأشهر الأخيرة من ولايتها... وبالتالي، فإن التعيين بالوكالة هو لغرض تمشية الأمور في البلد».
وتابع التميمي: «هناك اتهامات لشخصيات ضمن ائتلاف السوداني، لكنها تفتقر إلى السياقات القانونية الصحيحة، حيث تبدو الاتهامات عامة... عدا عن هذا النوع من الشكاوى يأتي مع اقتراب موعد الانتخابات، والهدف منها محاولة التأثير في الناخبين لا أكثر من ذلك، وهذا جزء من التأثير السياسي».
التنافس على العشائر
السوداني من جهته، وفي سياق دعم حملته الانتخابية، دعا الأسبوع الماضي خلال تجمع جماهيري في محافظة كربلاء إلى أن تكون المنافسة في الانتخابات البرلمانية مهنية بعيداً عن «التشويه والتزييف». وفي الوقت نفسه، وأيضاً من محافظة كربلاء حذّر رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي وأمام مجاميع من شيوخ العشائر في المحافظة مما سماه «تمرير المشاريع المشبوهة»، رافضاً قبولها «مهما تلونت بالكلمات المعسولة».
هذا التنافر بين أبرز زعيمين شيعيين، رئيس وزراء أسبق ورئيس وزراء حالي كانا ينتميان إلى حزب واحد «الدعوة»، يعكس جزءاً من إشكالية دخول العشيرة وبقوة على خط الحملات الانتخابية مرة والنزاعات الوظيفية مرة أخرى. ومعه يرى محللون سياسيون أن الاستعانة بشيوخ القبائل لتمرير الرسائل، ومنها الإشارات الحمّالة الأوجه، قد تعبّر عن ضعف المنظومة السياسية والقيَمية التي عملت على بنائها الطبقة السياسية في العراق بعد نحو عقدين من زمن التغيير. لكن الخبير القانوني الدكتور سيف السعدي، في لقاء مع «الشرق الأوسط» رأى، من جهته، أن استدعاء العشيرة ليس كله سلبياً، بل له «إيجابيات وسلبيات»، خصوصاً إذا ارتبط «فض النزاعات العشائرية والمشاكل الاجتماعية، حسب الحالة والمنطقة، وأحياناً على اسم العشيرة أيضاً».
تشهد الساحة السياسية العراقية احتقاناً متزايداً مع اقتراب موعد الانتخابات وسط انقسامات حادة داخل التحالفات التقليدية
«الرسائل المشفّرة»
وفي سياق الرسائل، ومنها «المشفرة»، التي تبادلها السوداني والمالكي أمام شيوخ العشائر؛ بهدف جلب أكبر عدد من المؤيدين والناخبين من أبناء العشيرة، قال السوداني لمجموعة من شيوخ ووجهاء مناطق اللطيفية واليوسفية والمحمودية ونخبها الأكاديمية والمثقفة إن «التنافس يجب أن يكون بالبرامج والمشاريع... وليس بالترهيب والترغيب وشراء الذمم، فهذا الأسلوب لا يبني دولة».
في المقابل، وسط ما يجري تداوله في الأوساط السياسية عن احتمالية وقوع حوادث واستهدافات، سواءً خارجية كـ«ضربة إسرائيلية للفصائل المسلحة» أو داخلية كـ«عمليات تفجير واغتيالات واستهدافات» يمكن أن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات - وهو ما يعني استمرار سلطة الحكومة في وقت تتوقف الدورة البرلمانية ما يصب في صالح السوداني -، قال المالكي: «لقد دفعنا تضحيات عالية حينما كان الإصرار على الوقوف في طوابير طويلة أمام صناديق الاقتراع، قالوا: لن نسمح لها. قلنا: ستكون». وتابع رئيس الوزراء الأسبق: «... واليوم أيضاً نقولها، ونقول للذين يتحرّكون في الظلام لكي يقوموا بشيء من التحريك والتحركات في بعض المحافظات حتى يُقال: لا نستطيع أن نجري الانتخابات... سنجريها حتى لو صنعتم ما صنعتم؛ لأننا لا نبيع العراق».
ما للأعراف والتقاليد ... وما عليها
عودة إلى الدكتور السعدي، فإنه يقول: «في كثير من الحالات، من إيجابيات الأعراف والتقاليد إيجادها حلولاً يعجز القانون عن حسمها، وفي هذا دليل على قوة سطوة العشيرة مقابل تراجع قوة سلطة القانون، بسبب المجاملات أو الخوف من تطبيق القانون. أما لجهة السلبيات، فإنها كثيرة، بينها المغالاة في المبالغ المالية، فضلاً عن زيادة العنصرية والتمايز الاجتماعي والفروق الاجتماعية بين عشيرة وأخرى».
وفيما يتعلق بالانتخابات يقول السعدي إن «دراسة لمعرفة تأثير العشيرة على الناخب، بيّنت نتيجتها أن الوعي الانتخابي في المناطق العشائرية أكبر مما هو عليه في مناطق المدينة، والسبب يعود لتأثير شيخ العشيرة والواجهات والمخاتير على قناعة الناخبين بعيداً عن الشعارات والبرامج الانتخابية». ولكن في المقابل، من السلبيات «حالات مثل نشر الصور، والمناطق المتفق عليها، فضلاً عن انقسام العشيرة إلى فرق وأفراد بين هذا المرشح أو ذاك ما يزيد حالة الانقسام، وكذلك العشيرة تفرض مرشحاً من أبنائها بغض النظر عن الكفاءة والبرنامج الذي يريد تقديمه، أي ترفع شعار (سيئ تعرفه أفضل من شخص جيد لا تعرفه)».