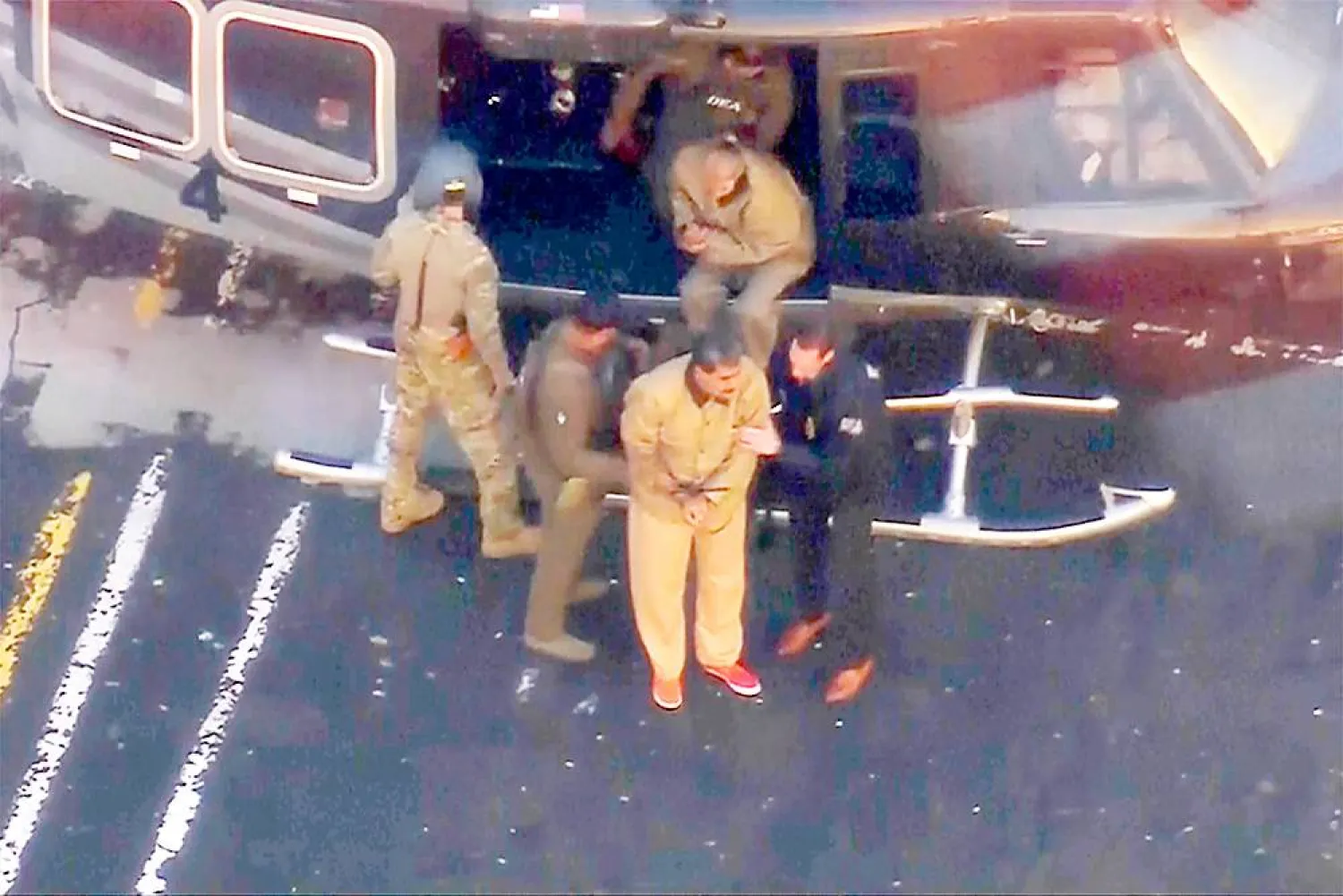الانتكاسة الصحية الحالية للبابا فرنسيس (خورخي برغوليو)، رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، ليست الانتكاسة الأولى التي يتعرّض لها وتمنعه عن مزاولة أنشطته الحَبرية كالمعتاد؛ ذلك أنه عانى صعوبات تنفّسية منذ شبابه بعد استئصال النصف الأعلى من إحدى رئتيه عندما كان لا يزال يافعاً. إلا أن هذه هي المرة الأولى التي ترتسم فيها علامات الخطر على حياة هذا الحَبر، وهو الأول من خارج أوروبا منذ القرن الثامن، والأول من إرسالية اليسوعية (الجيزويت) التي اختمرت في رحمها معظم الحركات «الثورية» داخل الكنيسة الكاثوليكية. وكانت آخرها حركة «لاهوت التحرّر» التي قمعها أسلافه بقسوة، خاصة على عهد البابا البولندي المحافظ يوحنا بولس الثاني (كارول فويتيوا).
الأعباء كثيرة... والضغط شديد
قبل أيام من وعكته الأخيرة كان فرنسيس يهمّ بمغادرة مقر إقامته المتواضع في دير القديسة مارتا، داخل الحرم الفاتيكاني، عندما سأله أحد مستشاريه المقربين عن صحته، فأجاب: «الأعباء كثيرة والضغط شديد».
تلك الإجابة كانت بمثابة اعتراف متواضع على لسان البابا الذي سيحتفل بعد أيام بمرور 12 سنة على تبوئه كرسي بطرس، بأنه ربما دخل الشوط الأخير من حَبريّة تذكّر التاريخ الكنسي بحَبريّة البابا يوحنا الثالث والعشرين؛ لما حملته من رياح التغيير التي هزّت شجرة الكنيسة العصيّة على التحولات العميقة، وجدّدت الآمال بأن ثمة كنيسة أخرى ممكنة في القرن الحادي والعشرين.
جدير بالذكر، أنه منذ تأسيس الكنيسة لم يجرؤ أي حَبر أعظم على اختيار اسم فرنسيس لقباً رسمياً له. وبالتالي، فإن اختيار برغوليو - وهذا هو اسم الأصلي للبابا الحالي - لهذا الاسم يحمل دلالة عميقة من حيث ارتباطه بالقديس الإيطالي الشهير فرنسيس الأسيزي، المعروف بانشقاقه عن الكنيسة في القرن الثالث عشر عندما هجر أسرته الثريّة وأعاد ثيابه الفاخرة إلى والده كي يكرّس حياته لخدمة الفقراء.
تواضع رافض للبهارج
ومنذ اليوم الأول لانتخاب فرنسيس بابا للفاتيكان، رفض البابا الجديد الإقامة في المقر البابوي مفضّلاً البقاء في دير القديسة مارتا المتواضع، ومتخلياً عن بهرجة الملابس والحليّ والأحذية القرمزية التقليدية. واختار التنقل في سيارة متواضعة، واعتاد مخاطبة المؤمنين بلغة بسيطة كتلك التي يستخدمها عادة المبشّرون العلمانيون الذين تحظر الكنيسة نشاطهم. وإلى جانب هذا أصرّ دائماً على إظهار بُعده الإنساني العميق عندما كان يطلب من الشعب أن يتضرّع لأجله قبل أن يبادر هو إلى منحه البركة الرسولية.
أيضاً، منذ وصوله إلى سدة البابوية، أعلن البابا فرنسيس عن إطلاق برنامج إصلاحي واسع سرعان ما أطلق صفارات الإنذار في الدوائر الكنسية المحافظة والأوساط السياسية اليمينية في إيطاليا وخارجها، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتمتع التيار المتشدّد في الكنيسة الكاثوليكية بنفوذ واسع وموارد مالية وتحالفات وثيقة مع التيارات المحافظة في الكنائس الأخرى.
وهكذا، لم يشهد بابا في التاريخ الحديث معارضة كالمعارضة الداخلية التي واجهها فرنسيس - ولا يزال -، حتى قيل إن شعبيته خارج الكنيسة الكاثوليكية أكبر بكثير من شعبيته داخلها.
بل لقد أعرب فرنسيس مراراً أمام معاونيه عن «مرارة عميقة» بسبب المكائد التي تحيكها الدوائر المحافظة المتشددة في الكنيسة، والتي أدّت إلى عرقلة الكثير من بنود برنامجه الإصلاحي الذي تعثرّ في شقه الاقتصادي والمالي، لكنه نجح في إحداث تغيير ملموس على صعيد استراتيجية التواصل ومكافحة التحرّش الجنسي الذي سبّب له الكثير من الحرج خلال زياراته إلى الخارج.
ولكن على الرغم من تراجع منسوب التفاؤل الكبير الذي رافق وصوله إلى السدة البابوية، استطاع فرنسيس الحفاظ على الزخم الإصلاحي الذي وعد به. إذ قام بتعيين عدد كبير من أنصار برنامجه الإصلاحي في مراكز حساسة، خاصة في وزارة الخارجية والمجلس الاستشاري الواسع النفوذ، وفي مناصب استراتيجية لإدارة أموال الكنيسة. كذلك، واصل تعيين كرادلة جدد حتى أصبحوا يشكلون الأكثرية في المَجمَع الذي من المفترض أن ينتخب خلفه بعد رحيله.

لا مهادنة من المحافظين
غير أن الأصوات المحافظة - وهي شديدة التنظيم - لم تهادن، بل واصلت حملاتها ضد البابا، معتبرة أن تصرّفاته «تخالف السلوك المطلوب من رأس الكنيسة الكاثوليكية». ولكن، قبل بضعة أشهر، عندما صرّح فرنسيس بأن الإجهاض في حالات التشوّه الوراثي أو المرض هو أقرب ما يكون إلى الممارسات النازية للحفاظ على النقاء العرقي، صدرت إحدى الصحف الإيطالية المحافظة بعنوان رئيسي ساخر يقول: «صار عندنا بابا».
أيضاً، كان البابا قد قال يومها في تلك التصريحات إن الأسرة لا يمكن أن تقوم سوى على رجل وامرأة؛ الأمر الذي أثار ارتياحاً في الأوساط الكنسية المتشدّدة التي كانت انتقدت بشدة تصريحاته حول المثليين وموقف الكنيسة منهم. وبهذا الشأن يقول أحد المقربين منه: «إنه رأس الكنيسة الكاثوليكية، وليس زعيم منظمة تقدمية. هو منفتح في الشأن الاجتماعي لكن في المعتقد هو محافظ أكثر من سلفه بينيدكتوس السادس عشر، ويخطئ من يعتقد أن البابا يمكن أن يوافق على الإجهاض أو على الزواج بين شخصين من الجنس نفسه».
من جهة ثانية، يقول معاونون للبابا إنه يملك قدرة كبيرة على استيعاب الضغوط التي يتعرّض لها، مع أنه نادراً ما يفصح عنها. ولكنه كلّما أتيحت له فرصة لمخاطبة أعضاء «الكوريا» - مجلس إدارة الكنيسة - ينتقد قلة الوفاء والولاء، ويهاجم بشدة «منطق المكائد المختلّ ودسائس المجموعات الصغيرة»، كما قال في خطبة الميلاد الأخير أمام موظفي الفاتيكان بعدما كانت بعض الأوساط قد وصفته بـ«الزنديق». ويقول أحد مستشاريه: «إن هذه الانتقادات تترك أثراً عميقاً في نفسه؛ إذ لم تشهد الكنيسة أبداً مثل هذا التمرد المحافظ ضد البابا. المحافظون كانوا دائماً بجانب الحَبر الأعظم، وما يحصل مع برغوليو لا سابقة له».
التيار «الرجعي»
التيار «الرجعي» (المحافظ المتشدد) في الكنيسة الكاثوليكية يقوده الكاردينال ريمون بورك، الذي منذ سنوات يجنّد أنصاره ليتفرّغوا من أجل عرقلة جهود فرنسيس الإصلاحية.
وبالفعل خاض بورك معركة طويلة ضد مساعي فرنسيس لمعالجة الفساد المالي في الفاتيكان. لكن بعد سنوات من الفوضى والفضائح، نجح البابا في مواءمة قواعد الكنيسة المالية وأجهزتها الرقابية أسوة ببقية الدول، كما أكَّدت أخيراً الهيئة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال. وللعلم، كان مصرف الفاتيكان، الذي يدير كتلة نقدية تناهز 6 مليارات يورو، قد قرر إقفال خمسة آلاف حساب مشبوه في السنوات العشر المنصرمة، وتراجع العجز في ميزانية الفاتيكان بنسبة 65 في المائة بعد إخضاعها لهيئة رقابية جديدة. في حين أُحيل عدد من كبار المسؤولين السابقين عن مالية الكنيسة إلى المحاكمة، وعلى رأسهم وزير المال السابق الأسترالي جورج بيل الذي يمثل حالياً أمام قضاء بلاده.
عودة إلى التيار «الرجعي»، قرّر البابا البولندي المحافظ يوحنا بولس الثاني، أواخر القرن الفائت، الذي عانى في شبابه قمع النظام الموالي للاتحاد السوفياتي، إزالة الجدار الفاصل بين الشرق والغرب وإسقاط الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية، ونجح في تلك المهمة التي كادت تكلفه حياته.
ثم جاء الألماني بينيدكتوس السادس عشر (جوزيف راتسينغر) ليعيد إلى الكنيسة الكاثوليكية نقاء العقيدة الذي كانت فقدته في العقود الأخيرة، لكنه كان أضعف من القدرة على مواجهة التيار المناهض للإصلاح والعودة إلى الجذور، فقرر الاستقالة والانكفاء في المقر البابوي الصيفي حتى وفاته.
وعندما وصل برغوليو إلى كرسي البابوية بعد مسيرة طويلة في الأرجنتين، أخذ على عاتقه إزالة الحواجز المخفية بين الجنوب والشمال، أي بين الفقراء والأغنياء، ورفع لواء الدفاع عن المهاجرين عندما احتفل بأول قداس له على شاطئ جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي كانت تتكسّر على صخورها قوارب المهاجرين الوافدين من أفريقيا. لا، بل كان الصليب الذي حمله في ذلك القداس مصنوعاً من أخشاب تلك القوارب التي حملت مئات الضحايا الذين كانوا يتدفقون على السواحل الأوروبية هرباً من البؤس والقمع والعذاب.
مواقف فرنسيس وتصريحاته المتكررة المدافعة عن المهاجرين ألّبت عليه الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، في إيطاليا أولاً، ثم في الخارج. وكانت انتقاداته الأخيرة لسياسة الإدارة الأميركية الجديدة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين موضع تجاذب وتصريحات قاسية بين واشنطن والفاتيكان. ولشدة حرصه على الدفاع عن الفقراء والمهاجرين قرر فرنسيس أواخر العام الفائت تعيين الكاردينال كونراد كراجوسكي رئيساً لمكتب الصدقات، وهو المعروف بزهده وتقشفه الشديد، وبأنه يعرف بالاسم جميع الأشخاص المشرّدين الذين يعيشون من غير مأوى في ضواحي الفاتيكان. منذ وصوله إلى سدّة البابوية أعلن عن إطلاق برنامج إصلاحي واسع سرعان ما أطلق صفارات الإنذار في عدد من الدوائر والأوساط اليمينية