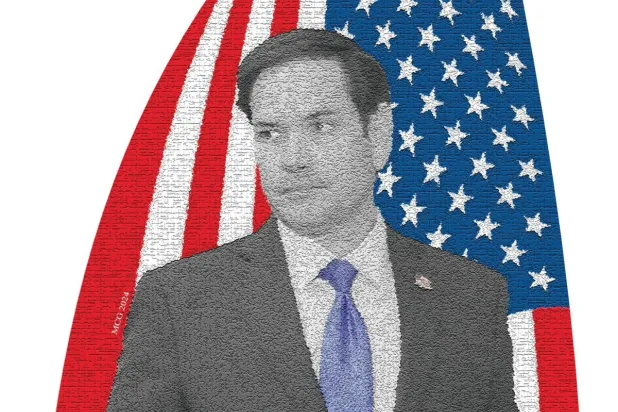خطت تشاد خطوة محفوفة بالمخاوف والحذر، على طريق العودة إلى النظام الدستوري، والممارسة السياسية، وذلك بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإعلان فوز رئيس المرحلة الانتقالية، محمد إدريس ديبي، من الجولة الأولى للاقتراع. وتأتي هذه الخطوة التي عدّها بعض المتابعين «شكلية» لتنهي فترة انتقالية استمرت 3 سنوات، قادها مجلس عسكري برئاسة ديبي، إثر مقتل والده الرئيس السابق إدريس ديبي، في عام 2021. في تشاد، مَن ينظر إلى هذا الاستحقاق على أنه عبور إلى «نقطة تحول سلمية» ونجاح في «اختبار الديمقراطية»، ولو نسبياً، في مقابل آخرين يرون أن الأمر لم يخرج عن «ممارسة شكلية، تحكّمت فيها العصبيات، لتمدد لحكم عائلة ديبي» الذي امتد لأكثر من 3 عقود مع ديبي الأب (1990 - 2021). ويقود جبهة المشككين في الاستحقاق الرئاسي التشادي حزب المعارضة زاعماً وجود مخالفات في عمليات الاقتراع.

وسط التوترات السياسية والأمنية على امتداد منطقة الساحل في أفريقيا ودول الجوار، يرى مراقبون أن العودة إلى النظام الدستوري في تشاد تتطلب استقراراً سياسياً حقيقياً في ضوء معطيات تتعلق بالتحديات الداخلية، لا سيما إشكالية الوفاق الوطني التي لم تكتمل والمعضلة الاقتصادية، بجانب تأثيرات المشهد الإقليمي وحالة التنافس الدولي في الساحل الأفريقي.
لقد صادق المجلس الدستوري في تشاد، نهاية الأسبوع الماضي، على نتائج الانتخابات الرئاسية بتأكيد فوز محمد ديبي، حاصلاً على 61.03 في المائة من إجمالي الأصوات، ومتغلباً على أقرب منافسيه ورئيس وزرائه السابق سيكسيه ماسرا، ورئيس الوزراء الأسبق باهيمي باداكي الذي حلّ ثالثاً بأقل من 10 في المائة.
أبرز التحديات أمام الرئيس ديبي الابن، بحسب محللين، كان إضفاء الطابع المدني والدستوري على نظام حكمه مستقبلاً، ولذا خاض الانتخابات ممثلاً ائتلافاً سياسياً مدنياً باسم «تشاد المتحدة»، في مواجهة غير مسبوقة مع رئيس وزرائه ماسرا، الذي ترشح باسم «ائتلاف العدالة والمساواة»، بعدما عاد إلى البلاد قبل 6 أشهر من الانتخابات، بجانب 8 مرشحين آخرين بينهم امرأة، معظمهم ينتمي إلى منطقة جنوب تشاد.
مواجهة التشكيك
مسألة القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية تبقى تحدياً حقيقياً لديبي في ظل تشكيك المعارضة التي قاطعت الانتخابات، واعتراض ماسرا على نتائجها، وإعلانه على «فيسبوك» أنه «تقدّم بطلب إلى المجلس الدستوري لإلغاء نتائج الاقتراع في الانتخابات»، كما حث أنصاره على الاحتجاج. غير أن رئيس حزب «حركة الخلاص التشادية» عمر المهدي بشارة، دعا التشاديين إلى «إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتجنيب المصالح الشخصية»، وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القوى الغربية لن تترك بلاده تنعم بالاستقرار».
في أي حال، لدى النظر إلى تجارب الانتخابات السابقة في تشاد، يتبيّن أن الرئيس الراحل إدريس ديبي نجح في الصمود أمام قوى المعارضة الداخلية بالفوز 6 مرات في استحقاقات انتخابية خلال 3 عقود، مع أن تجربة الممارسة السياسية التشادية تشير إلى ضعف المعارضة السياسية وانقسامها وعجزها عن بلوغ السلطة إلا عبر الصدام المسلح.
وهذه المرة يفاقم مخاوف الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، أن 7 مرشحين في هذه الانتخابات ينتسبون إلى الجنوب، وهي من المناطق التي تواجه توترات متصاعدة عمّقت الانقسامات القائمة على أساس الهوية، مع انتشار الجماعات المتمردة.
إذ تنتشر في تشاد جماعات من المعارضة المسلحة، أبرزها جماعة «اتحاد قوى المقاومة» التي سعت مراراً للوصول إلى العاصمة ندجامينا من أجل الإطاحة بالنظام، إلى جانب جبهة «التغيير والوفاق»، ومجلس «القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية» و«اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية»، وتتباين هذه الجماعات، وفق أهدافها، وعلى أسس عرقية.
الدبلوماسي بوزارة الخارجية التشادية محمد علي، يرى أن محمد ديبي (ديبي «الابن»)، فاز في الانتخابات مدعوماً بتحالف «تشاد المتحدة» الذي ضم نحو 235 حزباً سياسياً و1500 جمعية مدنية. وكان تكلم خلال حملته الانتخابية عن نجاحه في الوفاء بتعهده بإجراء الانتخابات في الأجل المحدّد لها، بعكس بلدان أفريقية أخرى.
المصالحة الداخلية
ورغم ما شهدته الفترة الانتقالية من حملات معارضة ضد المجلس العسكري الانتقالي، يرى البعض أن ديبي «أعاد هندسة الفترة الانتقالية، بطريقة تضمن له أن يظل محوراً لمعادلة الحكم». وفي مقال بعنوان «الفوضى في تشاد» لويزلي ألكسندر هيل، الخبير في شؤون أفريقيا والصين، نُشر بموقع «ناشونال إنتريست» في مارس (آذار) الماضي، اعتبر الخبير أن ما تشهده تشاد من توتر وأحداث عنف منذ الإعلان عن جدول الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) الماضي، يدخل ضمن ما يُسمى بـ«الانقلاب الذاتي»، حيث يستولي رئيس الدولة على المزيد من السلطة من داخل جهاز الدولة نفسه.
في المقابل، ديبي كان قد أجرى خلال الفترة الانتقالية «حواراً وطنياً» لمعالجة التوترات السياسية الداخلية، عُقدت جولته الأولى في دولة قطر، وانتهت باتفاق سلام مع المعارضة المسلحة في أغسطس (آب) 2022 يقضي بوقف إطلاق النار، وعُقدت الجولة الثانية في ندجامينا خلال أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، وانتهت بـ«خارطة طريق» مهّدت للانتخابات المنقضية.
الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة الخبير في الشأن الأفريقي، كان قد قال لـ«الشرق الأوسط» إن المهمة الأساسية أمام الرئيس التشادي الجديد تنطوي على «استكمال المصالحة الوطنية الداخلية، وإنهاء صراعات النخبة الحاكمة، والسيطرة على خلافات القبائل نتيجة لسيطرة إثنية الزغاوة على الحكم لأكثر من 30 سنة».
وللعلم، تتسم التركيبة الديموغرافية لتشاد بالتنوّع القبلي والإثني؛ إذ تضم أكثر من مائتي مجموعة إثنية تمتد جذورها في دول الجوار المحيط بتشاد، أبرزها: السارا، والزغاوة، والتبو، والمساليت، والقبائل العربية. وبينما يرى متابعون أن تشكيك المشككين في الاستحقاق سيظل عائقاً أمام الرئيس الجديد، قلّل المحلل التشادي صالح يونس، من هذه المسألة، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ديبي الابن شخصية توافقية، ويدعمه ظهير شعبي مُسلم، والإسلام ديانة معظم التشاديين، فضلاً عن الدعم الغربي له، خصوصاً من فرنسا».
إلا أن الدكتور عبد الرحمن توقف عند ما أسماه «البُعد القبلي الهجيني» للرئيس الجديد؛ فهو ينتمي لقبائل الزغاوة من جهة الأب، ويحمل انتماء لقبائل التبو من جهة الأم؛ الأمر الذي يمكن استثماره على الصعيد الشعبي لتحقيق الوفاق الداخلي.
الجوار المضطرب
من جهة أخرى، يفرض الموقع «الجيوسياسي» لتشاد تحديات أمنية واقتصادية وسياسية، تنعكس اضطراباً يجمع شمالاً تهديدات جماعات المعارضة المسلحة المتمركزة في الجنوب الليبي، وغرباً أعمال جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، فضلاً عن حالة انعدام الاستقرار جنوباً بجمهورية أفريقيا الوسطى، وتداعيات الحرب السودانية شرقاً، ومنها فرار مئات الآلاف من السودانيين لأراضيها. ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استقبلت تشاد أكثر من 550 ألف لاجئ سوداني بحلول فبراير (شباط) الماضي، لتتصدر قائمة الدول المستقبلة للاجئين السودانيين الفارين من الحرب السودانية القائمة منذ أكثر من سنة.
محمد ديبي، على ما يبدو، يسعى للسير على نهج والده، بتحويل تلك المخاطر لصالحه، والظهور كلاعب إقليمي يُعتمد عليه في بناء الاستقرار السياسي والأمني في محيط يعج بالأزمات الأمنية والسياسية. وهو هنا أيضا يستند إلى قدرات الجيش التشادي، المصنف من أفضل جيوش منطقة الساحل، ويحتل الترتيب الخامس عشر أفريقياً، وفق تصنيف موقع «غلوبال فاير» العالمي لعام 2023.
وحقاً، لعبت تشاد أدواراً ناشطة في صراعات منطقة الساحل الأفريقي خلال العقد الماضي، عبر مشاركتها عام 2013 في الحرب على الجماعات الإرهابية في شمال مالي مع القوات الفرنسية، وتدخلها في الحرب على «بوكو حرام»، والمشاركة في قوة حفظ السلام الأفريقية بجمهورية أفريقيا الوسطى، ودعوتها لتدخل عسكري دولي في ليبيا.
وهنا، رأى الدبلوماسي التشادي، محمد علي، أن تشاد تقف في مواجهة تأثيرات أزمات جواره (ليبيا والسودان والنيجر)، واستشهد بـ«الأعباء الاقتصادية الكبيرة على بلاده نتيجة استقبال أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني خلال الحرب الحالية، بالإضافة لنحو 3 ملايين آخرين كانوا موجودين من قبل».
وفي الوقت عينه يبقى تحدي مكافحة الإرهاب من التحديات الأمنية أمام الرئيس المنتخَب، إذ بات على حكومته خوض المواجهة بمقاربة وطنية، بعد إعلان تشاد وموريتانيا عن حل ائتلاف دول الساحل لمكافحة الإرهاب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إثر انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

التنافس الدولي
في سياق موازٍ، لا يمكن فصل تشاد عن مشهد التنافس الدولي في منطقة الساحل الأفريقي. فخلال الفترة الأخيرة أجبرت سلطات مالي وبوركينا فاسو والنيجر كلاً من فرنسا والولايات المتحدة على سحب قواتها من أراضيها، في مقابل تقارب مع روسيا بهدف محاربة الجماعات الإرهابية على تلك الأراضي. وفي حين لا تزال فرنسا بقواعد عسكرية في تشاد، بنتيجة دعم باريس المستمر للأنظمة التشادية من بعد الاستقلال (1960)، كان لافتاً خلال مظاهرات المعارضة، في مايو (أيار) 2022، التي نظمتها قوى معارضة وطلاب جامعات نددت بالوجود الفرنسي في تشاد، أن المتظاهرين رفعوا العلم الروسي.
ولذا تعتبر القوى الغربية أن فوز ديبي يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على وجودها في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً الوجود العسكري الفرنسي، والشيء بالنسبة لأميركا، رغم إعلانها أخيراً سحب قواتها من تشاد والنيجر.
في المقابل، عكست زيارة الرئيس ديبي إلى موسكو، يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، إدراكاً منه لتزايد المشاعر المعادية للوجود الفرنسي في بلاده، خصوصاً مع تأكيده أن مباحثاته مع الرئيس الروسي جاءت «بصفته رئيس دولة مستقلة، ولتعزيز وتقوية العلاقات مع روسيا».
ولكن، بينما يعتبر الدبلوماسي التشادي محمد علي أن «العلاقات مع روسيا لا تعني الانفصال عن الغرب، لاحتفاظ بلاده بمصالح استراتيجية مع القوى الدولية»، توقّع رئيس حزب «حركة الخلاص التشادية» بشارة «صراعاً واسعاً بين الغرب بقيادة أميركا والاتحاد الأوروبي، ودول (بريكس) بقيادة روسيا، في منطقة الساحل الأفريقي بداية من تشاد». ورأى بشارة أن «الصراع الدائر بين الوجود الفرنسي والنفوذ الروسي الصاعد في دول الجوار سيكون له تأثيرات كبيرة في الأزمة السياسية ببلده».
يرى البعض أن ديبي
«أعاد هندسة الفترة الانتقالية
بطريقة تضمن له
أن يظل محوراً
لمعادلة الحكم»

محطات الصراع في تشاد منذ الاستقلال
بعد استقلال تشاد عن الاحتلال الفرنسي في عام 1960 عانت البلاد اضطرابات وصراعات داخلية عديدة، كما واجهت الأنظمة الحاكمة فيها حركات تمرد مسلحة، لعل أشهرها في فترة الرئيس الراحل إدريس ديبي. ولكثرة ما واجهه ديبي «الأب» من حركات تمرد ومحاولات انقلاب، لُقب بـ«الناجي العظيم». وفيما يلي رصد بأهم محطات وفصول الصراع في تشاد منذ استقلاله حتى الآن: - أغسطس (آب) 1960، حصلت تشاد على استقلالها من فرنسا، واختار البرلمان التشادي فرنسوا تومبالباي، أول رئيس للبلاد بعد اعتماد نظام انتخابي جديد. وأجريت انتخابات رئاسية بعدها بسنتين، فاز فيها تومبالباي. - عام 1965، عانت تشاد فترة اضطراب إثر اندلاع حرب أهلية داخلية، وتدخلت قوات عسكرية فرنسية عام 1968، لإخماد التمرد في شمال تشاد. - عام 1973، سيطرت القوات الليبية على إقليم «أوزو» الحدودي في شمال تشاد، واستعادت تشاد هذا الإقليم، عبر التحكيم الدولي، بقرار من المحكمة الدولية في لاهاي (هولندا) قضى بأحقية تشاد في الإقليم عام 1994، وأخْلَت القوات الليبية الإقليم بعدها. - عام 1975، شهدت تشاد انقلاباً عسكرياً انتهى بمقتل الرئيس تومبالباي، ليتولى الجنرال فيليكس مالوم رئاسة البلاد إثر خروجه من السجن. - عام 1979، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس مالوم، ورئيس وزرائه حسين حبري، ووصلت المواجهات إلى العاصمة ندجامينا، وانتهت باستقالة مالوم، وتولى محمد شواد من «الحركة الشعبية لتحرير تشاد» رئاسة البلاد. - عام 1980، اندلعت الحرب الأهلية التشادية مرة أخرى، بين قوات حسين حبري مدعوماً من فرنسا، وغوكوني عويدي مدعوماً من ليبيا، وانتهت بسيطرة حبري على رئاسة تشاد، إثر احتلاله العاصمة ندجامينا. - في عام 1989، نظم الجنرال إدريس ديبي عملية انقلابية ضد نظام الرئيس حبري، ونجح في دخول العاصمة والاستيلاء على السلطة. - في عام 1998، واجه الرئيس إدريس ديبي، محاولة تمرد من «الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة». وعام 2008، تكررت محاولة التمرد، ونجح المسلحون في دخول العاصمة واحتلال القصر الرئاسي قبل أن ينسحبوا في أعقاب تدخل الجيش. - في عام 2013، شن نظام إدريس ديبي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضة والنخبة السياسية بعد الكشف عن مخطط لاستهداف الرئيس. - في عام 2013، أعلنت القوات التشادية مشاركتها في الحرب على «الجماعات الإرهابية» في شمال مالي. وفي عام 2015، صدَّق البرلمان التشادي على إرسال قوات لمحاربة جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا والكاميرون. - في عام 2005، أعلن الرئيس إدريس ديبي دعم «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور بالسودان، بحكم الروابط العائلية والقبلية التي تربط الرئيس التشادي وقادة الحركة. - في عام 2021، لقى الرئيس إدريس ديبي حتفه، في أثناء وجوده في ساحة القتال ضد المتمردين الذين اتجهوا من الجنوب الليبي إلى شمال تشاد، وعُيّن محمد ديبي، نجل الرئيس الراحل، رئيساً مؤقتاً على رأس مجلس عسكري انتقالي مكون من 15 جنرالاً. - في عام 2022، بعد الإعلان عن مد الفترة الانتقالية في تشاد، بناءً على مخرجات «الحوار الوطني» في العاصمة القطرية الدوحة، خرجت مظاهرات واحتجاجات من قوى معارضة، أسفرت عن مواجهات أسقطت نحو 50 شخصاً، واعتقال المئات من المحتجين. – في عام 2023، تعرَّضت القوات العسكرية التشادية لهجوم من مجموعة «مجلس القيادة العسكرية لخلاص الجمهورية»، على الشريط الحدودي الشمالي مع ليبيا.