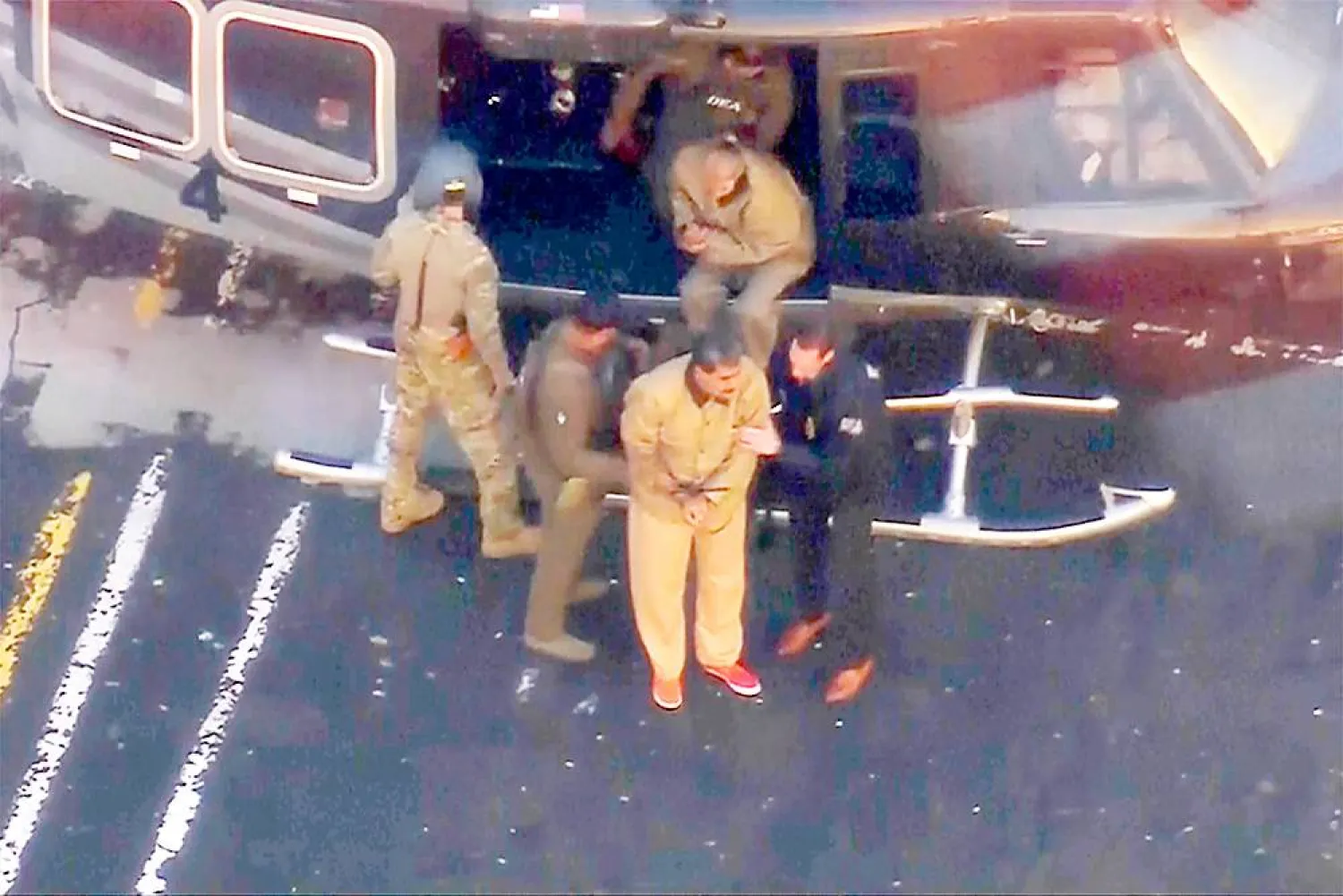نُظّم أخيراً في قصر الرئاسة التونسية بقرطاج لقاء مغاربي مصغّر ضمّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفّي، بمشاركة مسؤولين كبار عن قطاعات الأمن والاقتصاد والشؤون الخارجية. ولقد تباينت ردود الفعل على هذا اللقاء ونتائجه داخل البلدان المشاركة فيه، وكذلك في الرباط ونواكشوط وفي عدد من العواصم الأوروبية والأفريقية والغربية المعنية بالأوضاع في المغرب العربي. وأولت أطراف محلية وإقليمية ودولية اهتماماً لافتاً بالتقارب بين تونس والجزائر عشية تنظيم البلدين انتخابات رئاسية جديدة. وفي حين رأت أطراف عديدة عقد هذا اللقاء المصغّر «تمهيداً لتفعيل مسار الاتحاد المغاربي» المجمّد منذ التسعينات، على خلفية توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، اتهم سياسيون في الرباط القيادة الجزائرية بمحاولة «تأسيس اتحاد مغاربي بديل» يُقصي المغرب، ويبدأ بالدول الثلاث التي شاركت في لقاء تونس، وينفتح لاحقاً على موريتانيا فقط. لكن مصادر حكومية في الدول الثلاث ردّت بالقول إن لقاء قرطاج بحث أساساً التنسيق بين البلدان الثلاثة حول التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة وملفات الهجرة غير النظامية والمياه وتسوية الأزمة الليبية والعلاقات مع الدول الأوروبية.
أبرز سؤال مطروح اليوم، بعد اللقاء التشاوري الثلاثي، التونسي - الجزائري - الليبي، هو عمّا يمكن أن يغيّره هذا اللقاء الذي جمع الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبّون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفّي. وبالأخص، ما إذا كان لقاء قرطاج هذا سيُسهم في إحداث آليات جديدة للشراكة وتسوية أزمات المنطقة، أم تزداد الأوضاع تعقيداً. ولكن، بحسب تصريحات وزيري الخارجية التونسي نبيل عمار والجزائري أحمد عطّاف بعد اللقاء، فإن مبادرته الثلاثية «ليست موجهة ضد أي دولة بما في ذلك الشقيقة المغرب».
ترفيع التنسيق أمني
في تونس، نوّهت تصريحات أعضاء في الحكومة ووسائل الإعلام بالبيان الختامي الذي صدر عن اللقاء، وعدّته «مساهمة في تطوير الشراكة الاقتصادية، وتفعيل القرارات الجماعية القديمة حول معالجة معضلات الأمن والهجرة غير النظامية والتنمية والمياه في المناطق الحدودية، ورفض التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة».
أيضاً أُعلن في تونس وطرابلس عن «مشاورات أمنية» تونسية - ليبية - جزائرية إضافية شملت ملفات المعابر البرّية، بينها بالخصوص معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا الذي كان أغلق قبل نحو شهرين؛ بسبب الاضطرابات الأمنية وصراعات النفوذ على «البوابات والمعابر» بين «لوبيات» مالية وأمنية في غرب ليبيا، والسلطات العسكرية والسياسية في طرابلس.
وفي هذا السياق، لفت الأكاديمي البشير الجويني، وهو دبلوماسي تونسي سابق في ليبيا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى محادثة بين وزيري داخلية كل من تونس وليبيا، كمال الفقي وعماد الطرابلسي، أوصت بالتعجيل بفتح معبر رأس جدير «في أقرب وقت» بحكم أهميته «الاستراتيجية»، وتكفّله بتنقل ما لا يقل عن نصف مليون مسافر شهرياً، و6 ملايين مسافر سنوياً، معظمهم من الليبيين والتونسيين والجزائريين.
إلا أن قرار «فتح المعبر» لم يقع تفعيله فوراً، رغم المباحثات التي أجريت في لقاءٍ بتونس بين الرئيس قيس سعيّد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وأعضاء وفدي البلدين. في المقابل، تزايدت الحركة نسبياً في المعبر الثاني الرابط بين ليبيا وتونس، معبر «الذهيبة - وزّان»، وهو معبر في منطقة صحراوية يحتاج سكان شمال ليبيا ومنطقة العاصمة طرابلس والمسافرون التونسيون إلى قطع مئات الكيلومترات الإضافية لبلوغه. ومعلوم أيضاً أن هناك معبر «الدبداب» الليبي - الجزائري الصحراوي، لكنه مفتوح لنقل السلع فقط.
وفي الوقت ذاته، نشرت وسائل إعلام في البلدان الثلاثة أن من بين النتائج الإيجابية لإحداث «آليات التشاور الثلاثية» التونسية - الجزائرية - الليبية، ترفيع التنسيق في قطاعات مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية، و«اعتراض قوافل المهاجرين القادمين من بلدان جنوب الصحراء» الذين تزايد عددهم بعد تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان، وعدد من دول الساحل والصحراء.
تخوّفات
على صعيد متّصل، أعربت أوساط سياسية وأكاديمية مغاربية عن «تخوّفات» من إنشاء «آلية ثلاثية مغاربية للتشاور» لا تشمل الرباط ونواكشوط؛ إذ نشر بعض الشخصيات، وأيضاً وسائل إعلام مغربية وعربية، مقالات وبرامج تتّهم القيادة الجزائرية بـ«محاولة إقصاء المغرب» الذي يستضيف المقر الدائم للأمانة العامة للاتحاد المغاربي منذ تأسيسه في «قمة مراكش» خلال فبراير (شباط) 1989.

كذلك، صدرت انتقادات للقاء قرطاج الثلاثي من شخصيات ليبية مقرّبة من قائد الجيش في شرق البلاد المشير خليفة حفتر، ومن رئيس حكومة الشرق أسامة حمّاد (في بنغازي) ورئيس حكومة الغرب عبد الحميد الدبيبة (في طرابلس). واعتبر جُلّ هذه الانتقادات أن المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي الليبي»، له صلاحيات «محدودة»، مقارنة برئيسي الحكومة ومجلس النواب المؤقت في المنظومة السياسية الليبية الحالية.
لكن المنفي تفاعل مع هذه الانتقادات على طريقته، فأرسل مستشاره سامي المنفي مبعوثاً إلى العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ونقل إليهما رسالتين خطيتين لتوضيح سياق اللقاء الثلاثي. وبالفعل، عقد سامي المنفي في الرباط مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حاول من خلاله طمأنة «المتخوّفين» من تشكيل «مؤسسات وآلية إقليمية ثلاثية تجمع الجزائر وتونس وليبيا»، قد يكون لها دور في معالجة الأزمة الليبية وأزمات دول الساحل والصحراء الأمنية والاقتصادية، وأيضاً تلعب دوراً في المباحثات مع أوروبا والولايات المتحدة والعواصم العالمية المعنية بملفات الأمن والهجرة والطاقة والمعادن الثمينة، ومستقبل دول منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط سياسياً وأمنياً وجيو - استراتيجياً.
التنسيق مع الجامعة العربية
من جانبه، صرح السفير أحمد بن مصطفى، المدير العام السابق للشؤون العربية في الخارجية التونسية، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأنه لا يتوقع «تغييرات كبيرة ميدانياً» أو «انفراجة في الأزمات الداخلية لتونس والدول المغاربية»، و«لا في علاقات تونس بكل من ليبيا والجزائر». وفسّر موقفه «غير المتفائل» بكون المغرب «لا يدعم» هذا المسار الجزائري - التونسي - الليبي لاعتباره إياه محاولة لإقصاء الرباط. ومن ثم، أشار السفير إلى اتهامات في المغرب للجزائر بأنها تسعى إلى «الاستفادة» من الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية في تونس وليبيا، من أجل «تغيير التوازنات السياسية في المنطقة» لمصلحتها.
كذلك، رأى بن مصطفى أن «من مصلحة الدبلوماسية التونسية التزام قدر أكبر من الحياد في النزاعات الإقليمية»، وتطوير حضورها في مؤتمرات مؤسسات العمل العربي المشترك ومنظمات جامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي وفي الأمم المتحدة، والتأثير في مسارات الصراع العربي – الإسرائيلي، والفلسطيني - الإسرائيلي «عوض البحث عن آليات بديلة أصغر».
ومن ثم لاحظ أن «الحضور العربي والإسلامي والأفريقي لتونس تراجع، بل أصبح ضعيفاً، وهذا ما يجب تداركه عبر مزيد من التطوير للشراكات والتعاون مع كل الدول العربية مشرقاً ومغرباً دون إقصاء».
حل وسط... و«لعبة محاور»
من جهة أخرى، قال عبد الله العبيدي، الدبلوماسي التونسي السابق في ألمانيا وفي المنطقة المغاربية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدبلوماسية التونسية مدعوة للعب دور وسط، وأن تدعم دوماً الحلول الوسطى، وأن تضمن توازناً في علاقاتها مع كل من المغرب والجزائر».
وأردف العبيدي أن الدبلوماسية التونسية تميّزت في عهدي الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1956 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011) بـ«تحقيق توازن» في علاقاتها بالرباط والجزائر، بما في ذلك في المراحل التي اندلعت فيها نزاعات مسلحة بينهما حول الحدود أو حول الصحراء. وعبّر عن موقف مماثل وزير الخارجية الأسبق السفير أحمد ونيس، الذي دعم مبدأ التنسيق الثنائي والثلاثي بين البلدان المغاربية، لكنه أعلن بوضوح أن الاتحاد المغاربي لا يُمكن أن يُقصي أي بلد عضو، وتحديداً المغرب الذي استضاف قمة التأسيس في 1989، كما أنه يستضيف الأمانة العامة للاتحاد منذ 35 سنة. ويتخوّف ونيس، في هذا السياق، من أن تدفع عواصم غربية دولاً في المنطقة نحو «صراعات ثانوية» تؤدي إلى اصطفاف مزيد من الدول العربية والإسلامية والأفريقية حول هذا المحور أو ذاك.
العبيدي يتخوّف، بدوره، من أن تزداد الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وملفات الهجرة في تونس وفي المنطقة المغاربية، تعقيداً، على الرغم من الدعوات للحوار ورفض التدخل الأجنبي الصادرة عن اللقاء الثلاثي. في حين لم يستبعد أحمد بن مصطفى «تعميق الأزمات الحالية»؛ بسبب «هشاشة الجبهة الداخلية في الدول المغاربية وضعف حكوماتها»، بل توقّع دخول تونس ودول المنطقة في مرحلة اللا استقرار في ضوء «استفحال» الأزمات في ليبيا، وتعمّق الخلافات بين الرباط والجزائر.
باريس وروما... وواشنطن وأنقرة
في هذه الأثناء، أشارت أوساط سياسية تونسية ومغاربية إلى تكثيف كل من واشنطن وباريس وروما وأنقرة تحركاتها ومبادراتها لـ«تسوية الأزمات» في ليبيا وتونس والدول المغاربية، وفي منطقة الساحل والصحراء.
وزاد نسق هذه التحركات عشية انعقاد لقاء قرطاج الثلاثي وبعده؛ إذ زارت جورجيا ميلوني، رئيسة الحكومة اليمينية الإيطالية، تونس للمرة الرابعة خلال سنة واحدة، يرافقها وفد يضم وزير الداخلية الإيطالي. وبعد ذلك بأيام، زار تونس وفد عسكري إيطالي برئاسة وزير الدفاع، ثم وفد برئاسة وزير الثقافة. وزارها أيضاً وزير خارجية الحكومة اليمينية في المجر، التي تلتقي مع حكومة ميلوني من حيث مواقفهما المتشددة مع المهاجرين الجدد، ومطالبة تونس وليبيا والجزائر بـ«تعاون أكبر» أمنياً في معالجة معضلة «الهجرة غير النظامية»، وترحيل المهاجرين الآتين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي الوقت عينه، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد، شملت المحاور التي تطرق إليها البيان الختامي للقاء قرطاج الثلاثي. وفهم متابعون في تونس هذه المكالمة بأنها «رسالة سياسية» عن «التفاعل الفرنسي مع التقارب السريع بين تونس وكل من إيطاليا والولايات المتحدة والجزائر»، وذلك في مرحلة تزايد التنسيق الأميركي - التركي - الإيطالي - الجزائري في ليبيا، وفي كامل دول الاتحاد الأفريقي الذي يتولى رئاسته مجدداً الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
كل هذه المعطيات تؤكد أن مبادرة تنظيم لقاء قرطاج حرّكت كثيراً من المياه الراكدة إقليميا ودولياً، وهذا، بينما تتابع واشنطن تفعيل دورها في تونس وليبيا وفي كامل المنطقة عبر آليات عديدة، بينها «المناورات والتدريبات العسكرية المشتركة». وتشمل هذه الأخيرة تدريبات «الأسد أفريقيا 4» التي نُظّمت قبل أيام في تونس والمغرب والسنغال وغانا، وشاركت فيها قوات تونسية مع نحو 7 آلاف عسكري من 20 دولة؛ أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المغربية. أعربت أوساط مغاربية عن «تخوّفات» من إنشاء «آلية ثلاثية مغاربية للتشاور» لا تشمل الرباط ونواكشوط