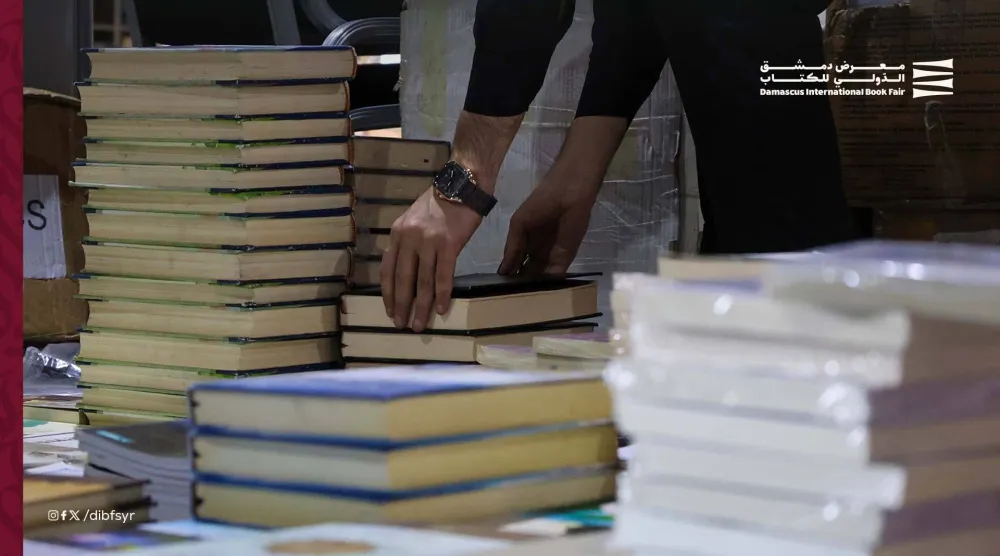دأبت النظم الانقلابية، التي وصلت أخيراً إلى الحكم في دول الساحل الأفريقي، على صب جام غضبها على الوجود العسكري الغربي، المتمركز هناك بداعي «مكافحة الإرهاب». ولقد كان لفرنسا النصيب الأكبر فيه، باعتبارها المستعمرة السابقة، وصاحبة الحضور التاريخي في أفريقيا. لكن، مع الخروج المتتالي للقوات الفرنسية، وتقلص الدور الغربي بشكل عام في دول الساحل الأفريقي، أخذ نفوذ الجماعات الإرهابية يتنامى بوتيرة غير مسبوقة، وفقاً لمراقبين رصدوا حضوراً لافتاً لتنظيم «القاعدة»، في عدة دول بينها مالي وبوركينا فاسو.
تسببت منطقة الساحل الأفريقي (غرب القارة) في وفيات «إرهابية» عام 2022، أكثر من تلك التي شهدتها بلدان جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة، وفق تقرير مؤشر الإرهاب لعام 2023.
وقد لفت التقرير الصادر عن معهد «الاقتصاد والسلام الدولي» إلى أن «الوفيات شكلت ما نسبته 43 في المائة من إجمالي الوفيات المسجلة في العالم». وفي هذا السياق، شكلت مناطق مالي وبوركينا فاسو 73 في المائة من الوفيات الناجمة عن الإرهاب في المنطقة. وأسفرت جهود مكافحة الإرهاب الحكومية في منطقة الساحل عن سقوط ضحايا من المدنيين قدروا بنحو 1058 مدنياً خلال عام 2022، ارتفاعاً من 158 مدنياً خلال 2021، وهو عدد مماثل لهؤلاء الذين سقطوا نتيجة للهجمات الإرهابية. الأمر الذي يؤدي، وفقاً للتقرير، إلى «تصاعد الغضب بين السكان المحليين، وهو ما قد تسعى التنظيمات الإرهابية إلى توظيفه في عمليات تجنيد جديدة، وتأجيج النزاعات المحلية والطائفية، وبث مشاعر مناهضة للنظام». واتسعت الرقعة الجغرافية للنشاط الإرهابي ليمتد من منطقة الساحل إلى غرب أفريقيا الساحلية المجاورة. وسجلت أكبر الزيادات في النشاط الإرهابي في توغو وبنين.
أحمد سلطان، الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، قال في لقاء مع «الشرق الأوسط»: إن منطقة الساحل «بيئة خصبة للجماعات الإرهابية حيث تستغل تلك الجماعات التوترات التاريخية والكبيرة بين المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية، والصراع بين القبائل والعشائر على الموارد الشحيحة في ظل عجز الحكومات عن السيطرة على مساحات ترابية وطنية كبيرة». وأردف: «ثمة عوامل جغرافية مثل سهولة العبور واختراق الحدود بين دول المنطقة، لكن كل تلك العوامل يمكن احتواؤها لو تسنى التوصل إلى حكومات قوية ورشيدة تهتم بمعالجة جذور الأزمة».
عداء للغرب
توترت العلاقات بين النظم العسكرية الجديدة في دول الساحل الأفريقي مع فرنسا، وسارت مظاهرات شعبية لتأييد السلطات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو وأخيراً في النيجر، تندد بفرنسا وسياساتها وهيمنتها وتطالبها بالخروج من البلاد. وفي المقابل، باتت هذه الدول أقرب إلى روسيا، كون شعوبها لا ترى في موسكو «قوة استعمارية تهيمن على مقاديرهم وتتدخل في شؤونهم»، وفق مراقبين، تحدثوا عن تعاون متزايد بين تلك الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو مع مجموعة «فاغنر» الروسية، في حربهم ضد التنظيمات الإرهابية.
كذلك استمدت النظم العسكرية التي تولت السلطة بعد الانقلابات العسكرية قسطاً كبيراً من شرعيتها الشعبية عبر ادعاء امتلاكها القدرة على مواجهة الجماعات الإرهابية. لكن مقابل ذلك، لفرنسا سردية مضادة عبّر عنها سيباستيان لوكورنو، وزير الجيوش الفرنسية في تصريحات سابقة، حين قال إن الانقلابات العسكرية التي شهدتها منطقة الساحل أخيراً ستؤدي إلى «الانهيار».
لوكورنو عدّ انسحاب القوات المسلحة الفرنسية من هذه البلدان إخفاقاً لهذه الدول وليس فشلاً للسياسة الفرنسية هناك. وتابع «النظام (العسكري) في مالي فضّل (فاغنر) على الجيش الفرنسي. رأينا النتيجة: منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوقة من قبل (الجهاديين)». وقال: «طلبهم الرحيل منا كان كافياً ليستأنف الإرهاب نشاطه»، مشيراً إلى «تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب»، منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر (أيلول) 2022. وحذّر من أن «مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته».
حالة مالي
على الرغم من طرد السلطات المالية الانقلابية للقوات الفرنسية ذات الحضور التاريخي مالي ومطالبتها بعثة الأمم المتحدة بالرحيل، الذي بدأ بالفعل، لم ينجح المجلس العسكري في تقليص النفوذ الإرهابي هناك. ووفق مركز الدراسات الاستراتيجية الأفريقية (مقره في الولايات المتحدة)؛ فإنّ جزءاً كبيراً من شمال البلاد بات واقعياً تحت سيطرة مجموعات من المقاتلين المتشددين. وتتجه مالي لتسجيل أكثر من 1000 عملية عنف مرتبطة بالمجموعات المسلحة في 2023، وهو ما سيتفوق على مستوى العنف القياسي المسجّل العام الماضي، ويشكّل زيادة 3 أضعاف تقريباً، مقارنة بتاريخ سيطرة الجيش على الحكم في 2020. ويبرز في هذا السياق النفوذ المتزايد لتنظيم «القاعدة»، حيث تفرض جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة للتنظيم حصاراً على مدينة تمبكتو يكاد يدخل شهره الثاني، من دون تمكن الجيش المالي وقوات «فاغنر» من التعامل معه بنجاعة. وهكذا تعيش المدينة الأثرية الواقعة شمال مالي في عزلة تامة منذ قرر التنظيم بشكل مفاجئ قطع كل الطرق المؤدية إليها مطلع أغسطس (آب) الماضي متسبباً في كارثة إنسانية. وبعدما ظن سكان تمبكتو أن إعلان فرض الحصار كان لمجرد الترهيب؛ فإنه مستمر ويتسع، ولا يقتصر على تمبكتو؛ إذ فرضت الجماعة حصاراً جزئياً على مدينة غاو الرابطة على ضفاف نهر النيجر وتبعد 320 كلم إلى الجنوب الشرقي تمبكتو.
واليوم يستغل التنظيم جبهة أخرى تزداد المعارك فيها بإطراد، بعدما أعلن تحالف «إطار العمل الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية»، وهو تحالف حركات من العرب والطوارق الأزواديين يدعو إلى انفصال شمال مالي، الشهر الماضي، أنه دخل في حالة حرب مع المجلس العسكري الحاكم ومجموعة «فاغنر» المتحالفة معه، وبعدها أعلنت تنسيقية حركات أزواد التعبئة العامة وتشكيل «جيش تحرير أزواد» ودعت سكان الإقليم للتوجه إلى ساحات القتال «لحماية الوطن والدفاع عنه». ولقد أعلنت التنسيقية سيطرتها على مواقع وقواعد عسكرية في الإقليم وإسقاطها مروحيات للجيش في مواجهات هي الأولى من نوعها بين الطرفين من حيث شدتها، منذ انتهاء الصراع الدامي بينهما الذي نشب عام 2012 حول السيادة على إقليم أزواد.
استمدت نظم الانقلابات العسكرية قسطاً كبيراً من شرعيتها شعبياً عبر ادعاء امتلاكها القدرة على مواجهة الجماعات الإرهابية
بوركينا فاسو
أما بوركينا فاسو فقد احتلت المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد أفغانستان في مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023؛ إذ سجلت 310 عمليات إرهابية نجم عنها مقتل 1135 شخصاً، مما يعني زيادة 50 في المائة مقارنة بعام 2021، وإصابة 496 آخرين في عام 2022.
تسببت هجمات جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» (الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي) في 48 في المائة من إجمالي عدد القتلى في بوركينا فاسو عام 2022، وشكلت الوفيات الناجمة عن الإرهاب في بوركينا فاسو 17 في المائة من إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب على مستوى العالم. وراهناً تسيطر جماعة «أنصار الإسلام» المقربة من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، على 40 في المائة من أراضي الدولةن وفق تقديرات الحكومة الأميركية، وتهدد بعملياتها دول الجوار.
وكانت السلطة العسكرية الحاكمة أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حملة لتجنيد 50 ألف متطوع للقتال ضد الجماعات الإرهابية، ونجحت الحملة في تجنيد 90 ألف مواطن، وتتهم هذه المجموعات المتطوعة بارتكاب انتهاكات تستهدف فيها جماعات من السكان على أسس عرقية.
انقلاب النيجر
آخر المحطات الانقلابية في منطقة الساحل كانت هذا العام في النيجر، التي أثار انقلابها اهتماماً دولياً غير مسبوق، علاوة على التلويح الأفريقي من خلال منظمة «إيكواس» بالتدخل العسكري لاستعادة النظام الدستوري، وهو ما أيدته باريس. حالياً تتصاعد الهجمات الإرهابية في النيجر منذ انقلاب يوليو (تموز) الماضي الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم وما عقب ذلك من مواجهة مع فرنسا شبيهة بتلك التي حدثت في مالي وبوركينا فاسو في نتائجها، وأسفرت المواجهة عن تعهد فرنسا بمغادرة قواتها النيجر بعد رفضها الأولي. فلقد أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أخيراً سحب سفير بلاده من العاصمة نيامي ومغادرة الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 جندي والمتمركزين في النيجر بحلول نهاية العام.
آخر الهجمات شهدها هذا الأسبوع، وذكرت وزارة دفاع الحكومة الانتقالية أن عملية إرهابية استهدفت الجيش النيجري خلفت 29 قتيلاً. وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، قُتل ما لا يقلّ عن 17 جندياً نيجرياً وأصيب 20 آخرون بجروح في هجوم إرهابي قرب الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو. ويذكر أن العسكريين الذين نفذوا الانقلاب اتهموا حكم بازوم بأنه تسبب في اضطراب أمن البلاد. وتوصف المنطقة الحدودية بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي بأنها «المثلث الأخطر»، حيث تنشط التنظيمات الإرهابية وتنطلق منها لاستهداف مناطق أخرى.
وفي تتويج لتحالف الأنظمة الانقلابية في مواجهة فرنسا و«إيكواس»، شكل قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الشهر الماضي، اتفاقاً للدفاع المشترك تحت ميثاق عرف بـ«ليبتاكو غورما» يلزم الدول الثلاث بالتعاون، بما في ذلك عسكرياً، في حال وقوع هجوم على أي منها.

آثار الانقلابات
يرى أحمد سلطان أن الانقلابات العسكرية في دول الساحل «أضعفت من قدرات الجيوش - الضعيفة أساساً - بسبب انصراف النخب العسكرية إلى تثبيت حكمهم وسيطرتهم السياسية على دولهم والمواجهة مع القوى الإقليمية والدولية الرافضة للانقلابات العسكرية التي تفرض في الغالب عقوبات تؤثر سلباً على حياة الشعوب الفقيرة».
وأضاف «غياب الدولة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين يدفع الآلاف منهم للانضمام للتنظيمات الإرهابية... وأدى طرد القوات الأجنبية من مالي وبوركينا فاسو وبعدهما النيجر إلى تراجع قدرات مواجهة التنظيمات الإرهابية في ظل الفراغ الذي تركه هذا الانسحاب، الذي استطاعت التنظيمات الإرهابية استغلاله سريعاً في ظل فشل الجيوش المستعينة بقوات فاغنر في المواجهة».
ورأى سلطان أن ما يفاقم الوضع أن «مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الجانب العسكري؛ بل لا بد أن يتواكب مع استراتيجيات اقتصادية تنموية. كذلك فإن تلك الدول التي تعاني من خلافات إثنية وعرقية متجذرة تحتاج استقراراً سياسياً واجتماعياً لا تستطيع البيئات المصاحبة للانقلابات توفيره في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية».
بدوره، يرى عبد الفتاح الفاتحي، مدير «مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن انسحاب القوات الفرنسية والقوات الأممية، بعد الانقلابات على الرغم من كونه يلقى تأييداً شعبياً؛ «فإن الجماعات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة وتنظيم داعش أعدوا الانسحاب فرصة سانحة واستغلوه جيداً في توسيع نفوذهم».
وأضاف الفاتحي أن «قدرات الجيوش في مالي وبوركينا فاسو، لا تستطيع مجاراة تلك الجماعات ذات الخبرة الكبيرة على الأرض التي صارت تمتلك حاضنات شعبية نتيجة لتفشي الفقر وغياب دور الدولة؛ مما أدى إلى نشاط كبير في عمليات التجنيد في المنطقة». ورأى كذلك أن التنظيمات الإرهابية «نجحت في سياسة الإرهاق برفع تكلفة الورقة الأمنية والاقتصادية والسياسية للدولة المركزية في مواجهتهم، وذلك في ظل العزلة الدولية والإقليمية التي عانت الأنظمة منها كنتيجة للانقلابات». واختتم أن الانقلابات «خلفت فراغاً سياسياً وإدارياً وعسكرياً وارتباكاً اجتماعيا».
من جهته، قال المحلل السياسي التشادي إسماعيل طاهر لـ«الشرق الأوسط» إن عدم وجود الفرنسيين أدى إلى «افتقار جيوش منطقة الساحل إلى معلومات استخباراتية فعالة في مواجهة المنظمات الإرهابية، كما أدى إلى الافتقار لبرامج مهمة في مجال التدريب العسكري».
ويرى طاهر أن انسحاب القوات الأممية «ترك فراغاً أمنياً في مالي سيحتاج الجيش لخوض معارك طويلة لملئه وسط تنافس مع القاعدة والأزواديين للسيطرة على القواعد السابقة لـ(مينوسما) والمناطق التي تحيط بها».
أسباب تفوق «القاعدة»
على أية حال، الساحة في منطقة الساحل أساساً ساحة تنافس واقتتال شرس بين تنظيم «داعش» وفروعه في مواجهة تنظيم «القاعدة» وفروعه، لكن المحللين يرون غلبة للأخير في الوقت الحالي. إذ ضاعف متطرفو «داعش» تقريباً الأراضي التي يسيطرون عليها في مالي خلال أقل من سنة، وفق تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس (آب) الماضي. وفي هذا السياق، يرى سلطان أن «تفوق القاعدة على تنظيم داعش في منطقة الساحل ليس مطلقاً ولا نهائياً، وأن التنافس بين التنظيمين سيظل مستمراً، لكن الغلبة الآن لتنظيم القاعدة الذي استطاع تنظيم صفوفه بشكل جيد خلال سنوات عديدة».
لكن سلطان يتوقع أن يحاول «داعش» مستقبلاً قضم رصيد «القاعدة» ومكتسباتها. ويقول: «إن القاعدة تكسب أرضاً بفضل عددها الأكبر، عن طريق ترسيخ وجودها في حاضنة اجتماعية تتمدد بسبب حرص التنظيم على إقناع المواطنين في مناطق نفوذه بأنه يكفل لهم الحماية من داعش ومن هجمات الجيوش. ثم إن المواطنين في منطقة الساحل يرون خطاب القاعدة أكثر اعتدالاً وأقل تشدداً من داعش».
إمارة جديدة
وحول تكتيكات «القاعدة» في مالي، رأى محللون أن «القاعدة استلهمت الأسلوب الذي اتبعته حركة طالبان الأفغانية للهيمنة السريعة على الأرض، كما فعلت طالبان عقب الانسحاب الأميركي، وقاموا من خلال هذا التكتيك باحتلال مواقع القوات الحكومية الأفغانية».
وكما استغلت طالبان الفراغ الأمني الذي خلفه الانسحاب الأميركي؛ فإن المتطرفين في الساحل يستغلون الارتباك الأمني جراء الاضطرابات السياسية التي عمّت المنطقة بعد الانقلابات... وأيضاً يستغلون هشاشة الأوضاع الأمنية الناجمة عن انسحاب القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام الأممية، للسيطرة على مناطق واسعة من البلاد.
هنا استبعد الفاتحي احتمالات «تفكير القاعدة في تأسيس إمارة إسلامية في الساحل حالياً»، لكنه رأى أن ذلك «يبقى رهاناً مستقبلياً يستعجل التنظيم خلق شروط طبيعية له كما فعلت طالبان في أفغانستان وعلى شاكلة ما فعلت (داعش) في سوريا والعراق». ويوافق هنا سلطان على أن «القاعدة» لا تفكر حالياً بإقامة الإمارة لكن يرجح أن لديها مخطط لذلك في المستقبل. وتابع سلطان: «لا يزال من المبكر جداً الحكم على حرب ستطول بين التنظيم والجيش المالي، لا سيما بعد تصعيد القاعدة بحصارها للمدن والقرى».
ومن جانبه، يرى طاهر أن «أقصى ما يمكن لتنظيم القاعدة فعله هو إقامة إمارة في مناطق شمال مالي من خلال التعاون مع الأزواديين في مواجهة الجيش المالي وفي مواجهة تنظيم داعش الذي يسعى بدوره إلى إقامة دولته في الساحل».