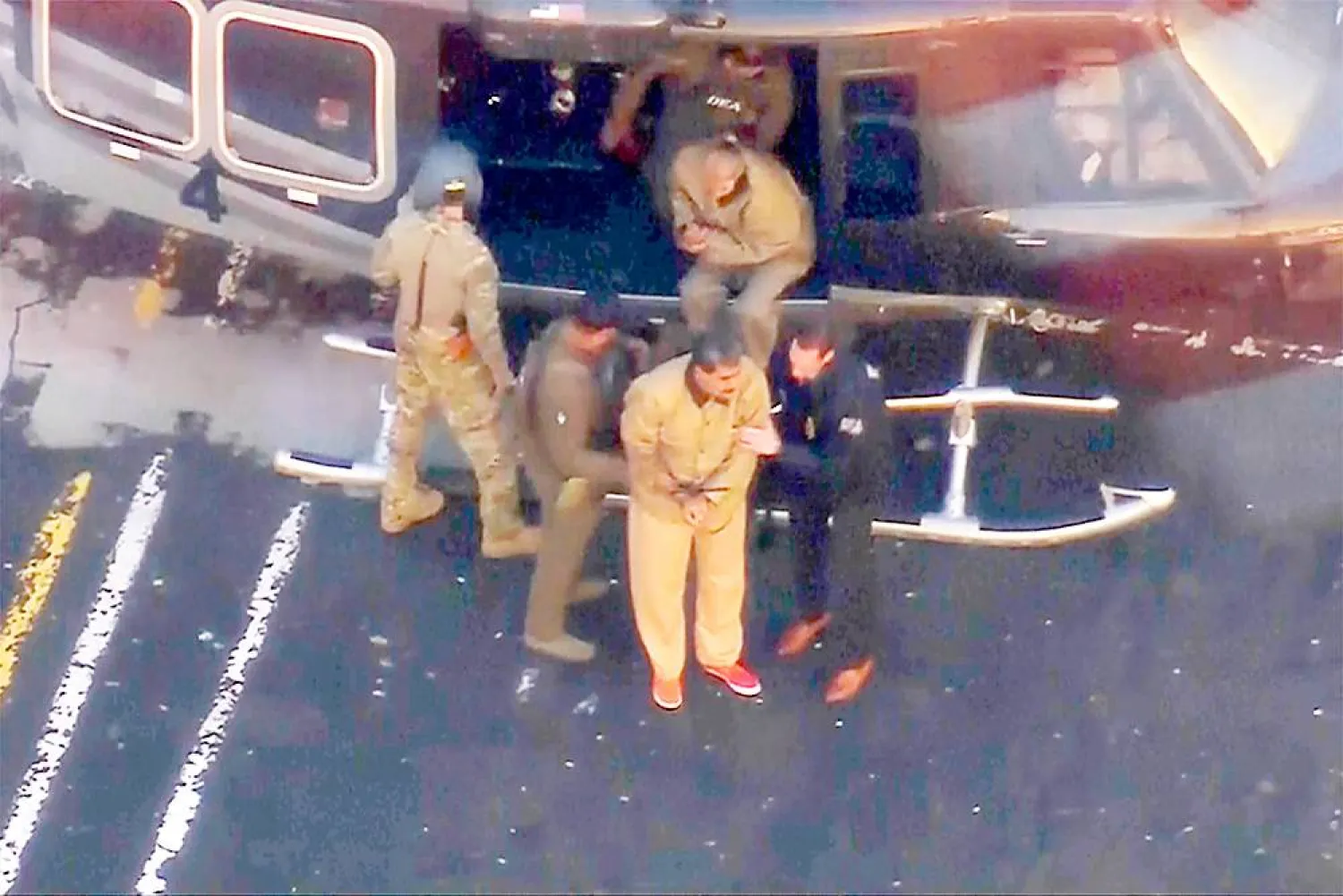احتفلت الهند وباكستان يومي 14 و15 أغسطس (آب) المنقضي، على التوالي، بالذكرى السادسة والسبعين لاستقلالهما عن بريطانيا، إذ بدأت رحلة البلدين في طريق الاستقلال عام 1947. وجدير بالذكر أن جُل منطقة جنوب آسيا عاش في ظل الاستعمار البريطاني لنحو 200 سنة، ولكن في غضون 6 أشهر بين أغسطس (آب) 1947 وفبراير (شباط) 1948، كانت أربع من دول جنوب آسيا قد نالت استقلالها بالفعل عن بريطانيا. أيضاً ما يستحق الإشارة أنه عندما انسحب البريطانيون من شبه القارة الهندية لم يتركوا خلفهم دولة واحدة، بل دولتين شابتين؛ الأولى هي باكستان التي كانت تتشكل من جزأين الغرب والشرق لمسلمي شبه القارة الهندية، ودولة أكبر ذات غالبية هندوسية هي الهند التي اختارت في حينه أن تكون ديمقراطية علمانية.
غير أن عام 1971 شهد انفصال شرق باكستان وولادة بنغلاديش فيه، أما الدولتان الأخريان اللتان حصلتا على الاستقلال فهما ميانمار (بورما) في يناير (كانون الثاني) 1948، وسريلانكا (سيلان) في فبراير من العام نفسه. وفي خضم عملية التقسيم الدموية للهند، ذكر المؤرخ ويليام دالريمبل أن أكثر من 15 مليون شخص شُرّدوا، وقُتل أكثر من مليون آخرين في أعمال عنف طائفية مميتة.مع أكثر من 75 سنة في ظل وجودها المستقل، شهدت الهند وباكستان وبنغلاديش وميانمار وسريلانكا من موجات الصعود والهبوط، وكان أداؤها متبايناً على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تطوّرت هذه الدول بطرق مختلفة، على أثر بنائها هويات متمايزة. وكمثال، في حين ازدهرت الديمقراطية العلمانية في الهند لفترة طويلة، يحكمها، اليوم، التيار القومي الهندوسي عبر صناديق الاقتراع، بينما تناوب على باكستان أنظمة مدنية وعسكرية منذ الاستقلال، وعاشت تحت الحكم العسكري لمدة 33 سنة. من جهتها، حكم ميانمار مجلس عسكري منذ 51 سنة، مع فترة قصيرة من الديمقراطية الخاضعة لقيود. وأما سريلانكا فظلّت خاضعة إلى حد كبير لحكم قادة مدنيين منتخَبين، وكان لها نصيبها من الانقلابات العسكرية عام 1966، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. ومع ذلك يلعب الجيش - الذي يهيمن عليه البوذيون - دوماً دوراً مهماً في الساحة السياسية بالبلاد. وهنا نشير إلى قول المؤرخة الباكستانية عائشة جلال «اللحظة الحاسمة التي لا تشكل بداية ولا نهاية، وهي لحظة التقسيم، لا تزال تؤثر على الكيفية التي تنظر بها شعوب ودول جنوب آسيا في مرحلة ما بعد الاستعمار، إلى ماضيها وحاضرها ومستقبلها».
الهند... الماضي والحاضر

عند الاستقلال، بلغ عدد سكان الهند 340 مليون نسمة، وكان معدل معرفة القراءة والكتابة ضئيلاً على نحو مثير للقلق، وقُدّر بـ12 في المائة. لكن خلال العقود السبعة الماضية، ارتفع عدد السكان إلى ما يقرب من 1.4 مليار نسمة، وكذلك ارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة إلى 77 في المائة. وبعدما كان الناتج المحلي الإجمالي، عام 1947، 30 مليار دولار فقط، فإنه يبلغ، اليوم، 3.76 تريليون دولار، وتمثل الهند، اليوم، خامس أكبر اقتصاد في العالم.
أيضاً في خانة الإيجابيات، كان متوسط العمر المتوقع في الهند 30 سنة، عندما رحل البريطانيون، لكنه الآن 70 سنة، وكانت أمراض الفقر وسوء التغذية متفشية. وعاش 80 في المائة من السكان في براثن الفقر. أما النمو التكنولوجي والصناعي فكان معدوماً، ما دفع كثرة من المؤرخين لتوقع أن الهند لن تبقى على قيد الحياة. ومع ذلك كانت الأسس الديمقراطية في الهند مستقرة منذ العام الأول. وبحلول نهاية الخمسينيات، خضعت الهند لحكم رئيس وزراء واحد هو جواهر لال نهرو. وفي يناير 1950، أصبحت الهند جمهورية، وأصبح الدستور دين الدولة الذي يوفر المساواة للجميع.
وتبعاً للكاتب الصحافي سليل تريباثي، فإن «أحد الإنجازات الكبرى التي حققتها الهند، والتي فاجأت العالم، أنها ظلت منذ استقلالها من عام 1947 إلى عام 2023، دولة ديمقراطية تتمسك بروحها الليبرالية العلمانية». كذلك ظلت دولة موحّدة، على الرغم من تنوعها الكبير، إذ تضم 22 لغة وطنية، ومناطق وديانات وأعراقاً متعددة، بخلاف بلدان أخرى كالاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا وإثيوبيا وباكستان.
وعند إمعان النظر في تاريخ الهند، يبدو أن الستينات والثمانينات من القرن الماضي كانا أصعب عقدين في تاريخ البلاد، وذلك مع اشتعال ثلاث حروب، خسرت الهند إحداها أمام الصين عام 1962، وانتصرت في أخريين عامي 1965 و1971 أمام باكستان. غير أن الحروب جلبت الجفاف، وأجبرت الهند على طلب مساعدات غذائية من الولايات المتحدة. ومن ثم، بعدما تعلمت الدرس، انطلقت على الفور في «الثورة الخضراء»، التي بموجبها تحوّلت الزراعة في الهند إلى نظام صناعي حديث، وأصبحت البلاد مكتفية ذاتياً في إنتاج الغذاء. وأعقب ذلك «الثورة البيضاء» التي شهدت اعتماد الأساليب الحديثة والعلمية لتعزيز إنتاج الحليب. واليوم، تحتل الهند المرتبة الثانية بين أكبر منتجي الحبوب الغذائية، وهي أكبر منتج للحليب عالمياً.
أيضاً، بفضل الحكومات المستقرة على مر السنين، والتركيز على النمو الاقتصادي، تخلّصت الهند من ثقل ماضيها الاستعماري لتبرز بصفتها قوة عظمى على الساحة العالمية. وجاء التقدم الدراماتيكي مع التغييرات التاريخية في التسعينات التي أطاحت بعقود من السيطرة الاشتراكية على الاقتصاد، وحفّزت نمواً لافتاً. وبالفعل، نجح الملايين من الانتقال من الفقر إلى طبقة متوسطة متنامية وطَموح، مع تنامي القطاعات التي تتطلب مهارات عالية. وتحوّلت البلاد إلى مصدر رئيس لسلع مثل البرمجيات واللقاحات.
مع هذا، ينتقد الصحافي الكبير سي. راجا موهان، تحوّل الهند من كيان يؤمن بالتنوّع إلى كيان يقوم على استبداد الغالبية. ويوضح ذلك بالقول: «لقد غيّرت السنوات التسع من حكم حزب بهاراتيا جاناتا، روح الحكم في الهند... وما تعنيه (فكرة الهند)، اليوم. الروح العلمانية الليبرالية في الهند تتوارى عن الأنظار على نحو متزايد، وبدلاً من أن يكون مجتمعها مجتمعاً تعددياً في كل شيء، ويحتفل بتنوعه، أضحى كياناً يقوم على استبداد الغالبية، يخشى أقلياته ويحرص على إخضاعها. إن حكومة (ناريندرا) مودي تعمل على تحويل الهند إلى دولة هندوسية أكثر حزماً وقومية، وحيث توجد أقليات... ينتظر منها أن تكون خاضعة وممتنة».
أيضاً، لا بد من الإشارة إلى أن الديمقراطية لم تحُل دون العنف السياسي والتوتر الإثني، وحتى الأحكام العرفية (حالة الطوارئ)، إذ دُشّن استقلال الهند باغتيال زعيمها الأبرز المهاتما غاندي (1948)، كذلك اغتيل رئيسا حكومتين هما إنديرا غاندي (1984)، وابنها راجيف غاندي (1991)، الأولى على أثر أزمة تتصل بأقلية السيخ، والثاني بسبب الأقلية التاميلية.
سجل أداء باكستان

فيما يتعلق بباكستان، كانت السنوات الـ76 الماضية مفعمة بالتحديات والمكافآت والإنجازات واللحظات المثيرة. واليوم، تحتفل البلاد بالذكرى السادسة والسبعين لاستقلالها في بيئة تشوبها توترات سياسية وهشاشة اقتصادية، ذلك أن باكستان تواجه راهناً تحديات متعددة ومترابطة ظلت، على مر عقود، يغذي ويعزز بعضها البعض في دورة متواصلة. ومنذ عام 1947، تناوب على حكم باكستان أنظمة مدنية وعسكرية، ديمقراطية واستبدادية، وعانت من الاغتيالات والانقلابات، ناهيك عن انفصال شرقها ذي الغالبية البنغالية عن غربها ذي الغالبية البنجابية. ثم إنه عندما نالت باكستان استقلالها من الحكم الاستعماري البريطاني، كان عدد السكان 33 مليون نسمة. أما اليوم فيبلغ نحو 225 مليون نسمة، حتى بعد انفصال بنغلاديش.
وربما لا يعرف كثيرون أن باكستان، إبان العقود القليلة الأولى من استقلالها، كانت «النمر الاقتصادي» في آسيا، وكانت متقدمة بفارق كبير عن الهند، ونموذجاً يُحتذى به لعدد من الدول المتقدمة، اليوم. وخلال ستينات القرن الماضي، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في باكستان أعلى من نظيره في الهند، إذ تسارعت وتيرة النمو في باكستان إلى نحو 6 في المائة، خلال الفترة بين عام 1961 والسبعينات. وبجانب ذلك، حصلت باكستان على دعم بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تبرعات من دول الشرق الأوسط الغنية، إلا أن وتيرة النمو فيها توقفت بعد الانفصال الذي ولَّد دولة بنغلاديش. وراهناً ترزح باكستان تحت وطأة ظروف سياسية دفعتها إلى حافة أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق، كما أنها استنفدت احتياطياتها من النقد الأجنبي.
من جهة أخرى، لا يزال الجيش يحتل مكانة مهمة في باكستان. وهنا يقول الكاتب الباكستاني أمير جمال: «بعد أكثر من سبعة عقود، السلطة الحقيقية في باكستان لا تقع بأيدي مكتب رئيس الوزراء والبرلمان، بل في أيدي العسكريين والأصوليين الدينيين». ويعرب جمال عن اعتقاده بأن باكستان تمر، اليوم، بواحدة من أسوأ الأزمات السياسية والدستورية والاقتصادية في تاريخها. ويشرح: «عملياً، أصبح البرلمان قليل الأهمية، وانقسمت النخبة السياسية على نفسها، في حين يواجه النظام القضائي انهياراً، وتظل آلاف القضايا معلَّقة في المحاكم. وتشمل التحديات الأخرى الأزمة الهيكلية للاقتصاد، وتآكل القدرة المؤسسية للدولة، واستمرار العجز التعليمي، والنمو السكاني غير المنضبط، والتغييرات المناخية. لا ننسى التحديات الأمنية كذلك في ظل الاضطراب في أفغانستان على الحدود الغربية، والعداء مع الهند؛ الجارة الشرقية للبلاد».
وفي الحصيلة، كتبت الدبلوماسية الباكستانية السابقة مليحة لودهي: «المسألة ليست في افتقار باكستان للإنجازات، بل على العكس، إذ كانت الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك الطاقة النووية بين 57 دولة تمتلك أسلحة نووية، وكان لها دور فعال في تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية. إلا أن اللحظة الراهنة تستدعي التأمل والتفكير في المستقبل... فمن ناحية نجت باكستان من كثير من العواصف والأزمات في الماضي، ولم تكن مرونتها موضع شك على الإطلاق، ما مكّنها من التغلب على مشاكلها في ذلك الوقت، إلا أن التحديات الحالية تختلف جوهرياً، إنها النتيجة التراكمية لعقود من سوء الإدارة وإهدار الفرص. وما عاد ممكناً، اليوم، تجاهل هذه المشاكل وتنحيتها جانباً، بل يجب معالجة كل هذه الأمور في وقت واحد، إذا أرادت باكستان المُضي قدماً والشروع في طريق الاستقرارين الاقتصادي والسياسي، والازدهار لشعبها».
سريلانكا... من الازدهار إلى «الدولة الفاشلة»

خلافاً لبلدان أخرى في جنوب آسيا، حيث كان الطريق إلى الاستقلال مليئاً بالعنف، جاء استقلال سريلانكا (سيلان سابقاً) عن البريطانيين سلمياً، من دون إراقة دماء في غضون أشهر قليلة بعد ولادة الهند وباكستان الحديثتين في 4 فبراير (شباط) 1948. وظلت البلاد «دومينيوناً» تابعة للإمبراطورية البريطانية حتى عام 1972، وبعد ذلك حصلت على وضع الجمهورية. ثم جعل دستور عام 1978 رئيس الدولة الرئيس التنفيذي الفعلي.
ورثت حكومة البلاد الأولى اقتصاداً مزدهراً، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، يعتمد بشكل رئيسي على مزارع الشاي. إلا أن حالة السلام الاجتماعي والسياسي لم تطُل بعد ذلك، عندما واجهت الدولة أول تمرد للتاميل عام 1972 من قِبل جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. وهنا يشرح جاياديفا أويانجودا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كولومبو: «لقد أمضت البلاد منذ استقلالها جزءاً كبيراً من تاريخها في حرب مع نفسها، بما في ذلك التمرد الانفصالي للتاميل الذي استمر لعقود وأسفر عن مقتل ما يصل إلى 100.000 شخص، وهذا بجانب موجتي تمرد شيوعيتين مميتتين». ويضيف: «وبحلول عام 2019، انتهت الحرب الأهلية، لكن سريلانكا المستقلة فشلت في لحم المجتمعات العِرقية والدينية المتنوعة لتشكيل دولة تعددية موحدة. والواضح أن الأحزاب السياسية الرئيسية والأُسر الخمس التي أدارت البلاد منذ الاستقلال تتحمل مسؤولية الفشل، علاوة على مسؤوليتها عن انعدام الأمن الاقتصادي والفساد والهدر وسوء الإدارة الذي ساد على نحو متزايد في سريلانكا المستقلة».
وبالفعل، بعد 75 سنة من الاستقلال، لا تزال سريلانكا تعاني حالة صراع دائم وأزمة اقتصادية غير مسبوقة ضربت البلاد بشدة منذ عقود. ولقد أعلنت الحكومة السريلانكية عام 2022 إفلاسها ـ وهذا وضع نادر جداً لأية دولة في العالم - والاقتصاد في حالة يُرثى لها. وتكافح الزراعة الفلاحية والصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل البقاء، بينما أغلق بعضها أبوابها بالفعل. أما قطاع السياحة ففي أدنى مستوياته على الإطلاق. وتعمل الصناعات الكبيرة على خفض عدد الموظفين. وعام 2022، بعد أشهر من الكارثة الاقتصادية، خرج السريلانكيون إلى الشوارع، واحتجّوا على قادة البلاد (آنذاك) بسبب سوء إدارتهم، وأدت التظاهرات التي عمّت البلاد في النهاية إلى الإطاحة بغوتابايا راجاباكسا الذي قدَّم استقالته في المنفى.
ختاماً، رغم تمتع سريلانكا بمؤشرات اجتماعية تُحسَد عليها وقت الاستقلال عام 1948، فهي، اليوم، تُعدّ «دولة فاشلة»، إذ قالت الرئيسة السابقة تشاندريكا باندارانايكه كوماراتونغا، أخيراً، في محاضرة لها: «إن 75 سنة فترة طويلة لتحقق الأمة تقدماً كبيراً. وحتى بعد 450 سنة من التدمير على أيدي الحكام الاستعماريين، كانت سريلانكا عند الاستقلال تمتلك بعض أفضل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية... أما اليوم، بعد 75 سنة، فغدت سريلانكا دولة فاشلة». وفي محاولة لتحديد «الأسباب الجذرية» لهذا الفشل، قالت الرئيسة السابقة (التي خلفت في الزعامة والديها سولومون وسيريمافو باندارانايكه) إنه بينما تعمل البلاد بوصفها اقتصاداً حديثاً وناشئاً مالياً، «صار الفساد المنتشر على كل المستويات إنجيل السياسة السريلانكية... وتسرَّب إلى الركائز الأساسية للحكم الديمقراطي، بما في ذلك القضاء والشرطة والخدمة العامة».
بداية ديمقراطية انتهت لمصلحة الجنرالات

حصلت ميانمار، المعروفة سابقاً باسم بورما، على استقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني يوم 4 يناير (كانون الثاني) 1948، بعد معركة طويلة قادها الجنرال أونغ سان، والد أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل. بدأت البلاد مسيرتها ديمقراطية برلمانية، مثل معظم جيرانها المستقلّين حديثاً في شبه القارة الهندية. لكن مع ذلك، انتهت إلى الديمقراطية التمثيلية عام 1962 عندما استولى الانقلاب العسكري على السلطة وحكموا لمدة 26 سنة.
أوضح شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «برينت»، أن ميانمار عانت، طوال عقود من استقلالها، من الحكم العسكري والحرب الأهلية وسوء الإدارة والفقر على نطاق واسع. كذلك قمع الجيش كل أطياف المعارضة تقريباً، واتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما أثار إدانات دولية واسعة وعقوبات. والمثير للاهتمام بشأن ميانمار أنها تشبه، إلى حد كبير، باكستان من حيث تاريخها السياسي منذ الحرب العالمية الثانية. فمثل باكستان، شهدت ميانمار فترة من الديمقراطية من عام 1948 إلى عام 1962. وبعدها بدأ الجيش ممارسة الحكم عام 1962، وامتد ذلك حتى عام 2011 عندما أُجريت أول انتخابات نزيهة، وفاز حزب أونغ سان سو تشي بالانتخابات. وأردف غوبتا: «الجيش قبِل نوعاً ما بالديمقراطية بسبب الضغوط العالمية».
في عام 2015، فازت أونغ سان سو تشي بالانتخابات مرة أخرى بغالبية أكبر. ومع ذلك، رغم نتائج الانتخابات والدستور الجديد، فإن ميانمار لم ترْقَ حتى لـ«نصف ديمقراطية». وهنا علّق غوبتا قائلاً إن القوات المسلَّحة مُنحت، بموجب الدستور، موقعاً في السياسة الوطنية. وشمل ذلك ضمان 25 في المائة من مقاعد البرلمان الوطني، البالغ عددها 644 مقعداً. أما الرئيسة أونغ سان سو تشي فقد أبعدت عن منصبها بسبب نص دستوري وضعه الجيش (ربما كان موجهاً خصوصاً إليها؛ كونها متزوجة من الباحث البريطاني ألكسندر أريس) ينص على أن أي شخص يتزوج أجنبياً لا يحق له تولي الرئاسة. وفي فبراير 2021، بعد تعرض الحزب الوكيل للجيش، حزب «اتحاد التضامن والتنمية» لنكسة كبرى، نفّذ الجيش انقلاباً جديداً، واعتقل الرئيسة واتهمها بالفساد وجرائم أخرى، وحُكم عليها بالسجن لأكثر من 30 سنة. كما صدرت قرارات بوضع برلمانيين من حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» وأحزاب أخرى، وكثير من الناشطين، قيد الإقامة الجبرية.
في هذا الصدد، قال البروفيسور أميت أتشايارا، مؤلف كتاب «الأمة المأساوية بورما - كيف ولماذا فشلت الديمقراطية»، شارحاً: «أحبطت الطريق إلى الديمقراطية والتنمية مراراً وتكراراً من قِبل الجيش المفترس والمجتمع الدولي اللامبالي. وأدى الانقلاب إلى اضطرابات اقتصادية، الأمر الذي محا المكاسب المتواضعة التي تحققت في الحد من الفقر على مدى العقد الماضي. وانكمش الاقتصاد بنحو 20 في المائة عام 2021. واليوم، يواجه الملايين الجوع، كما فرّ عشرات الآلاف إلى أجزاء أخرى من ميانمار أو عبر الحدود. وبسبب الانقلاب، تحولت ميانمار إلى دولة فاشلة». أما الناشط الحقوقي كياو وين الميانماري فقال «إن استقلال ميانمار يشبه جسداً بلا روح». وبعد مرور 75 سنة على استقلال ميانمار، لا تزال الأقليات «تناضل من أجل حرياتها... إنه جسد نتمتع فيه بالحرية اسماً، لكن ليست لدينا أي حريات ذات معنى حقيقي. لقد واجه مسلمو الروهينجيا التطهير العِرقي، ولم يحصلوا حتى على أي من حقوق المواطنة».