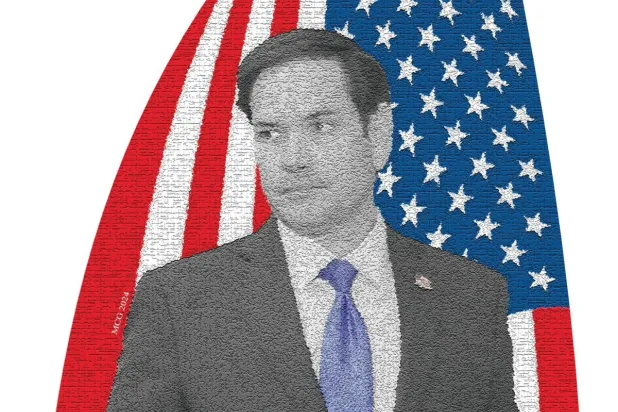بعد مرور نحو 31 سنة، جاء قرار مجلس الأمن الدولي برفع حظر التسلح عن الصومال ليعيد للبلد القابع في القرن الأفريقي «حريته» في تعزيز قدرات جيشه، أملاً بأن يسهم ذلك في «دحر الإرهاب»، وربما تحرير البلاد من قبضة «حركة الشباب» المتطرفة الموالية لتنظيم «القاعدة»، التي ما زالت تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي. القرار الذي أعلنه مجلس الأمن، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة نص على «رفع حظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار 733 الصادر عام 1992، بصيغته المعدلة». ودعا حكومة الصومال إلى «اتخاذ تدابير عدة. بينها؛ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأسلحة والذخائر، وتعزيز مزيد من التأهيل المهني والتدريب، وبناء القدرات لجميع مؤسسات الأمن والشرطة الصومالية». كذلك دعا مجلس الأمن «الحكومة الصومالية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان منع إعادة بيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المستوردة لتستخدمها قوات معينة، وكذلك شركات الأمن الخاصة المرخصة، أو نقلها أو إتاحتها للاستخدام لأي جهة».
فور إعلان القرار الأممي الذي سعى الصومال طويلاً لتحقيقه، توالت بيانات الترحيب المحلي والدولي. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن «مقديشو أصبحت الآن حرة في شراء أي نوع من الأسلحة»، وأكد أن «الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تشكل تهديداً لشعبنا وللعالم». وأشارت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إلى أن القرار «جاء في لحظة حاسمة، خصوصاً مع حرب الحكومة للقضاء على (حركة الشباب) التي تحاربها منذ 16 سنة». ووصفت الحكومة الصومالية القرار بأنه «خطوة مهمة إلى الأمام».
أما على الصعيد الدولي فاعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة أن «القرار سيؤثر إيجابياً على مستقبل البلاد»، كما رحّبت الخارجية التركية بالقرار الذي وصفته بـ«التاريخي»، ورحّب أيضاً البرلمان العربي بالقرار، معرباً عن أمله أن «يساعد في دحر الإرهاب». وكانت الأمم المتحدة قد فرضت حظراً على توريد الأسلحة للصومال إبان الحرب الأهلية عام 1992، بهدف وقف تدفق الأسلحة إلى الفصائل المتحاربة في أعقاب سقوط الحكومة المركزية الصومالية عام 1991. ومنذ عام 2012، يسعى الصومال لرفع حظر الأسلحة.
جهد سياسي كبير
وفي إطار المساعي الرامية إلى رفع الحظر، وصلت إلى العاصمة مقديشو عام 2022 لجنة من مجلس الأمن لمناقشة معوّقات رفع حظر الأسلحة، وتم الاتفاق على إنشاء عملية من 10 خطوات للتوصل إلى رفع كامل لحظر الأسلحة. وكانت الحكومة الصومالية قد بذلت جهداً سياسياً كبيراً لإقناع 15 عضواً في مجلس الأمن بأهمية القرار. وبدأت هذه الجهود تحقق تغييراً في الموقف الدولي، ففي مارس (آذار) الماضي، أشادت الولايات المتحدة الأميركية بما وصفته «خطوات مهمة» من جانب الرئيس الصومالي للوفاء بمعايير رفع حظر الأسلحة المفروض على بلاده. وأشار السفير الأميركي لدى الصومال، لاري أندريه، إلى أن «الحد من التسلح يساعد الصومال على تسهيل متطلبات مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عنه».
من ناحية ثانية، كان رئيس وزراء الصومال، حمزة بري، قد طالب في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» في أبريل (نيسان) الماضي برفع حظر التسلح لمواجهة «الإرهاب»، معتبراً الإبقاء عليه «مسألة غريبة»، بجانب كونه «عقبة أمام تسلم القوات الوطنية المسؤولية الأمنية، حتى يتمكن الصومال من استعادة استقراره».
وحقاً، يشير قرار رفع حظر التسلح إلى «الثقة الدولية في الحكومة الصومالية، بينما تواصل ترسيخ وجودها في البلاد»، وفق عمر محمود، الباحث المتخصص في شؤون شرق أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية». لكن محمود، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، يرجح أن «يكون تأثير قرار رفع حظر التسلح رمزياً أكثر من كونه عملياً، ولا سيما أن الصومال كان قادراً على استيراد معظم الأسلحة من قبل من خلال عملية الإخطار... إضافة إلى أن الصومال لا يزال يفتقر إلى التمويل اللازم لإجراء صفقات شراء كبيرة للأسلحة».
في الواقع، نجحت مساعي الصومال طوال السنوات الماضية في تخفيف القيود المفروضة على الحكومة الصومالية طوال سنوات الحظر، إذ لم يطبق القرار بشكل كامل على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، وظل باستطاعة الحكومة شراء السلاح بعد إخطار اللجنة الأممية المشرفة على تنفيذ العقوبات، وإن كانت الأخيرة عادة ما تعترض على صفقات الأسلحة الثقيلة.

الحرب على الإرهاب
للعلم، لا يتعلق الأمر بتنفيذ صفقات أسلحة فقط، إذ أرجعت الدكتورة نرمين توفيق، الباحثة في الشؤون الأفريقية والمنسّقة العامة لمركز «فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية» خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، صدور القرار في هذا التوقيت إلى قرب مغادرة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أتميس) الصومال. إذ من المقرر أن تغادر البلاد العام المقبل، «ما يستدعي تعزيز بنية الجيش الصومالي، ولا سيما أنه سيكون المسؤول عن حفظ الأمن في البلاد»، على حد قولها.
وتشير توفيق إلى أن «الجيش الصومالي ظل لفترة طويلة محدود القدرات، وقرار التسليح مرتبط بلا شك بقرب مغادرة قوات أتميس (الأفريقية لحفظ السلام)». وتلفت إلى أن «قرار حظر التسلح عام 1992 كان مع بداية الحرب الأهلية في الصومال، وسعى أكثر من تيار سياسي للسيطرة على البلاد، مع وجود ما كان يسمى بأمراء الحرب، إضافة إلى تصنيف الصومال من قبل الولايات المتحدة عام 2001 كدولة راعية للإرهاب».
ما يستحق الذكر أنه دعماً لجهود الصومال في استعادة الأمن والاستقرار، ومحاربة «الإرهاب»، تنتشر على أرضه قوات «أتميس»، لكن على هذه القوات الانسحاب تدريجياً، ونقل أنشطتها إلى القوات الصومالية بنهاية عام 2024. وهذا أمر تحاول الحكومة الصومالية تأجيله، ولقد ناشدت في سبتمبر (أيلول) الماضي مجلس الأمن الدولي إرجاء سحب قوة الاتحاد الأفريقي لمدة 3 أشهر، بعد تعرضها لما وصفته الحكومة بـ«نكسات كبيرة» خلال الحرب على «حركة الشباب» المتطرفة.
أيضاً من المقرر أن تقلص «أتميس» عدد أفرادها من 17626 إلى 14626 عنصراً بحلول نهاية العام الحالي. وما يذكر أن «أتميس» تضم نحو 20 ألف جندي، وهي ذات تفويض معزز لمحاربة «حركة الشباب» المتطرفة. وكانت هذه القوات قد حلّت محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي شكّلت عام 2007، بموجب قرار من مجلس الأمن صدر في أبريل (نيسان) 2022. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت «أتميس» استكمال المرحلة الأولى من خفض قواتها في الصومال.
مواجهة «حركة الشباب»
قرار رفع حظر التسلح عن الصومال تزامن مع قرار ثانٍ بـ«فرض حظر على الأسلحة الموجهة لحركة (الشباب)، يمنع الجماعات المتطرفة التي تستهدف تقويض الأمن والسلم في الصومال من شراء أسلحة ومعدات عسكرية». وكان القضاء على «حركة الشباب» هو التعهد الذي قطعه على نفسه الرئيس حسن شيخ محمود مع بداية ولايته الأولى عام 2012، لكنه لم يستطع الوفاء بتعهداته في فترة الرئاسة الأولى.
مع هذا، عاد شيخ محمود وجدد التعهد ذاته مع عودته للحكم مجدداً في مايو (أيار) 2022، حين أعلن في سبتمبر من العام نفسه عن استراتيجية للقضاء على الحركة «المتطرفة» تعتمد 4 محاور، من بينها العمليات العسكرية. إلا أن خبراء يرون أن حملة الحكومة الصومالية ضد «الشباب» تباطأت في الأشهر الأخيرة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الصومال على الحد من تمدد الحركات المتطرفة. ومنذ أغسطس (آب) 2022، يخوض الجيش الصومالي، مدعوماً بقوات من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، حرباً ضد «حركة الشباب»، لكن الحكومة الصومالية قالت إنها «واجهت انتكاسات عدة في الحرب، خصوصاً بعد هجوم شنته «الشباب» على الجيش بمنطقة غلغدود.
وحسب تقرير، نشره معهد الأبحاث الأمني «هيرال» خلال فبراير (شباط) الماضي، فإن «حظر الأسلحة فشل في منع (حركة الشباب) من استيراد أسلحة لا يسمح للحكومة الصومالية بشرائها». وأشار التقرير إلى «محدودية قدرات الصومال، وحاجته إلى موافقة الأمم المتحدة لشراء أسلحة ضرورية من أجل كسر شوكة الإرهاب، في حين تشتري (حركة الشباب) السلاح بشكل غير قانوني، ما يشكل عقبة أمام جهود الحكومة لاجتثاث الإرهاب».

نجحت مساعي الصومال في تخفيف القيود المفروضة على الحكومة طوال سنوات الحظر الماضية
لا حل سحرياً
الباحث عمر محمود يرفض اعتبار قرار رفع حظر التسلح «حلاً سحرياً». ويقول إن «حرب الحكومة الصومالية ضد (حركة الشباب) توقفت لأسباب عدة، ليس من بينها الأسلحة»، ويوضح أن «بعض تلك الأسباب والديناميكيات الأساسية المرتبطة بالمظالم المحلية والنزاعات السياسية ستستمر في الصومال، بغضّ النظر عن استيراد مزيد من الأسلحة من عدمه». وتتفق معه الباحثة نرمين توفيق، فتقول إن مواجهة حركة «الشباب» الإرهابية «ليست بالمهمة السهلة». وتضيف أنه «رغم أن الحركة لم تنفذ عمليات إرهابية كبيرة كتلك التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، فإن عملياتها لا تزال مستمرة، وسط استمرار جهود الدولة لمواجهتها والحد من قدراتها».
تاريخياً، أسست «حركة الشباب» في الصومال عام 2006. ويعود أصلها إلى «الاتحاد الإسلامي»، وهو جماعة متشددة بلغت ذروتها في التسعينات من القرن الماضي، بعد سقوط نظام محمد سياد بري عام 1991، وكانت تمول جزئياً من زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن. وإثر غزو إثيوبيا للصومال عام 2006 تشكلت الحركة، ويذكر تقرير نشره «مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية» عام 2011 أن «تدخل إثيوبيا الذي جاء بناء على طلب من الحكومة الصومالية الانتقالية كان السبب وراء تطرف (حركة الشباب)، وتحوّلها إلى أقوى فصيل مسلح راديكالي في البلاد».
وبالفعل، نمت الحركة وصنفتها واشنطن كتنظيم إرهابي عام 2008. وعام 2011، طُرد مقاتلو «الشباب» من مقديشو، لكنهم ظلوا منتشرين في مناطق ريفية واسعة، ومنها كانوا يشنون هجمات على أهداف مدنية وأمنية. وعام 2012، أعلنت الحركة الولاء رسمياً لتنظيم «القاعدة»، ومن ثم نفذت هجمات عدة في الصومال، ومارست القرصنة والخطف وابتزاز المزارعين، إضافة إلى التهريب.
ولكن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا مبعوث الاتحاد الأفريقي في الصومال محمد الأمين سويف إلى تقديم الدعم الدولي لقوات الحكومة الصومالية في حربها ضد «حركة الشباب» على جبهات عدة في البلاد. وقال إن «الجيش الصومالي لا يحتاج إلى التدريب فحسب، بل يحتاج إلى الأسلحة والمعدات والمهارات للضباط».
مخاوف «الأفغنة»
وحول ما إذا كانت الحلول العسكرية قادرة على مواجهة التنظيمات «الإرهابية»، ومن بينها «حركة الشباب»، يرى الباحث محمود أن «الجيش وتسليحه هو جزء من الحل، ولكنه جزء فقط... ومن أجل إضعاف (حركة الشباب) يتعين على الحكومة الصومالية معالجة الأسباب الكامنة التي أدت لظهورها من الأساس، إضافة إلى أن تظهر للشعب الصومالي أنها الرهان الأفضل على المدى الطويل مقارنة بالجماعات المسلحة الأخرى، وهو أمر كافح الصومال سنوات طويلة لتحقيقه».
ويؤكد الباحث في «مجموعة الأزمات الدولية» أن «مواجهة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية نوع من الصراعات عادة ما لا يُحسَم عن طريق القتال فحسب... وفي مرحلة ما سيتوجب على الحكومة الصومالية إشراك تلك التنظيمات (مثل الحركة) في الحوار بهدف وضع حد للعنف».
من جانبها، تخشى الدكتورة توفيق مما وصفته بـ«أفغنة الصومال» مع خروج قوات الاتحاد الأفريقي من البلاد، على غرار ما حدث بعد خروج القوات الأميركية من أفغانستان، وما تبعه من عودة حركة «طالبان» للسيطرة على البلاد، متسائلة عن «قدرات الجيش على حفظ الأمن في البلاد». ووسط التفاؤل بما قد يحدثه قرار رفع حظر التسلح من تأثير على القدرات العسكرية للصومال، يظل مستقبل البلاد محفوفاً بالمخاطر، وتختتم توفيق بأنه «لا يمكن لأحد التنبؤ بمستقبل الصومال عقب انسحاب قوات (أتميس)، ولا أحد يعرف شكل المشهد عام 2024، وهل سيقع الصومال فريسة في يد التنظيمات الإرهابية، أم أن الجيش والحكومة الحالية سيكونان قادرين على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد». نجحت مساعي الصومال في تخفيف القيود المفروضة على الحكومة طوال سنوات الحظر الماضية
حول الدعم العسكري الدولي للصومال في حربه ضد «الإرهاب»

> بصفته من دول القرن الأفريقي، اكتسب الصومال أهمية لدى قوى دولية عدة دفعت إلى دعم مقديشو عسكرياً، سواء في حربها ضد التنظيمات المتطرفة، أم حتى ضد القراصنة في البحر الأحمر. اليوم، يوجد في الصومال، وفق دراسة نشرها «معهد بروكينغز» الأميركي في مايو (أيار) 2022، نحو 3 قواعد عسكرية أميركية وإماراتية وتركية. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عقدت «المجموعة الخماسية» بشأن الصومال - التي تضم قطر وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة، أربعة اجتماعات؛ كان آخِرها في أنقرة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي كل اجتماع جدَّد مسؤولو الدول الخمس دعمهم للصومال وحربه على «حركة الشباب»، وناقشوا سبل تعزيز المساعدات الأمنية لاستعادة الاستقرار في البلاد، واستعداد الصومال لسحب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس». أما «أتميس»، التي يشكل «الاتحاد الأوروبي» أكبر مانحيها، فقوام عسكريّيها من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، وفق «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، الذي يشير، في تقرير نشره في يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن «أتميس لعبت دوراً أساسياً في ضمان أمن مقديشو والمدن الأخرى». وقبل «أتميس»، لعبت بعثة «أميصوم» أيضاً دوراً بارزاً في الصومال، و«قادت القتال ضد حركة الشباب، في الوقت الذي عجز فيه الجيش الصومالي عن تأدية هذا الدور، ولا سيما مع تورطه في فترة سابقة في نزاعات بين العشائر المختلفة»، وفق المعهد الأميركي. من جهة أخرى، فإن الدعم الدولي، وتحديداً الأميركي، أسهم في إنشاء وتدريب وتمويل «لواء دنب»، الذي تحمّل العبء الأكبر في محاربة «حركة الشباب». وشُكّل «لواء دنب» للاستفادة من نجاحات «أميصوم»، ودرّبته واشنطن وشركة «بانكروفت غلوبال» للتدريب العسكري عام 2012. إلا أن الدور الأميركي لا يقتصر على تدريب «لواء دنب»، ففي عام 2022 قدّمت واشنطن مساعدات عسكرية بقيمة 9 ملايين دولار للجيش الصومالي؛ لدعمه في الحرب ضد «حركة الشباب»، وتراوحت، من ثم، علاقة واشنطن بمقديشو بين البعد والتوغل. وبعد التدخل العسكري الأميركي في الصومال، إبان الحرب الأهلية في الفترة بين عاميْ 1992 و1993، وحادثة «سقوط طائرة بلاك هوك» التي خلفت 18 قتيلاً أميركياً ومئات الصوماليين، ابتعدت واشنطن بعض الشيء عن الصومال، لكن هذا التحفظ في العلاقات تغيَّر مع بداية الألفية الثانية، وأصبحت واشنطن من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الدولية للصومال، وإن ظلت المساعدات العسكرية عنصراً رئيساً. ووفقاً لتقرير من «خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي»، فإن واشنطن قدَّمت مساعدات أمنية مباشرة للصومال بأكثر من 500 مليون دولار، خلال الفترة بين 2010 و2020، كما أنفقت نحو 2.5 مليار دولار على المساعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي «أميصوم»، وخليفتها «أتميس». وبعدها، عام 2017، علّقت واشنطن دعمها للجيش الصومالي قبل أن تستأنفه جزئياً عام 2019، لكن الرئيس السابق دونالد ترمب سحب كل القوات الأميركية من الصومال عام 2020، قبل أن يعيدها الرئيس الحالي جو بايدن عام 2022، عقب عملية كبيرة نفّذتها «حركة الشباب».