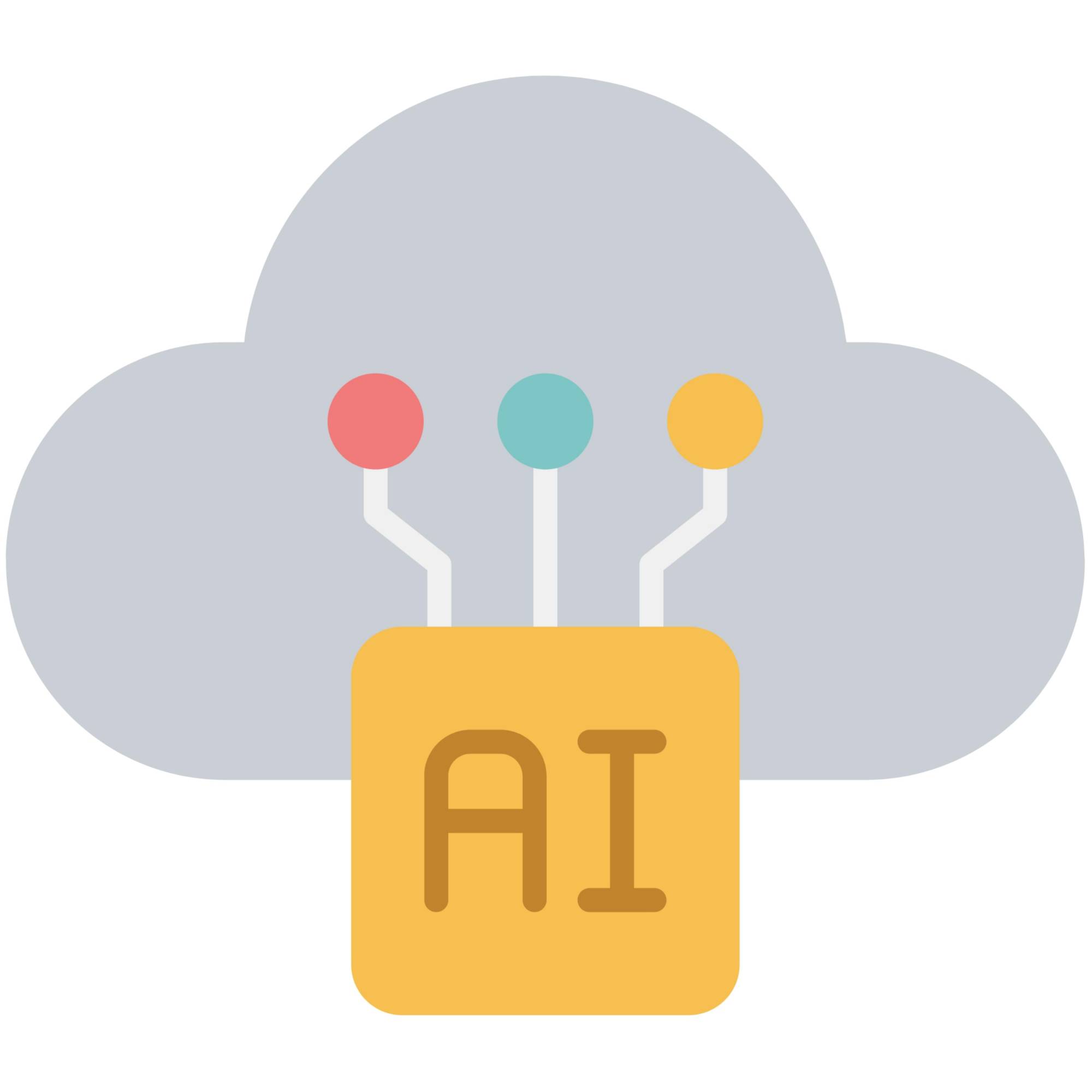في عالم لينفا وانغ المثالي... البشر يشبهون الخفافيش
البشر والخفافيش
لا يتخيّل وانغ، عالم الكيمياء الحيوية وخبير الأمراض حيوانية المنشأ، البشر ينفضون أجنحتهم في السماء أو يستخدمون الصدى لتحديد موقع أفضل شطيرة برغر في المدينة، وهو لا يقصد «أن يعيش البشر كالخفافيش»، بل أن يستلهموا من فيسيولوجيتها الغريبة جوانبَ لتحسين وإطالة حياتهم. يقول وانغ: «قد لا يبدو الأمر واضحاً عليها، ولكنّ الخفافيش هي الثديات الأكثر صحّة على وجه الأرض».
قد يبدو هذا الأمر صعب الإقناع نظراً إلى سجلّ الخفافيش الحديث والطويل؛ ففي العقود الثلاثة الماضية، من عام 1994، عندما انتقل «فيروس هيندرا (Hendra virus)» إلى البشر، وحتّى 2019، عند تفشّي «سارس كوف2»، كانت الخفافيش منشأً لنحو 5 أوبئة قاتلة انتقلت إلى البشر من الحياة البريّة.
لكنّ الخفافيش نفسها نادراً ما تمرض، حيث إنّ فيروسات مثل «إيبولا (Ebola)»، و«نيباه (Nipah)»، و«ماربورغ (Marburg)» والفيروسات التاجية بأنواعها، لا تؤثر فيها على الإطلاق، حتّى إنّها قادرة على النجاة من داء الكلب، الذي تصل نسبة الوفاة منه إلى 100 في المائة بين البشر إذا لم يعالَج.

آليات مطورة لتحدي الموت
تشرح إيمّا تيلينغ، عالمة الأحياء المختصة في الخفافيش من «كلية دبلن الجامعية» وتعمل مع وانغ، أنّ «الخفافيش طوّرت آليات للحدّ من ضرر المرض».
تذهب قدرة هذه المخلوقات على تحدّي الموت أبعد من ذلك بكثير. يُمضي بعض الأنواع الآكلة للرحيق منها سنوات في رفع مستوى السكر في دمها إلى الدرجة التي تتسبب في غيبوبة سكرية للبشر، ومع ذلك، لا يظهر عليها ما يشير إلى إصابتها بالسكري. وتشير الأبحاث إلى أنّ بعضها الآخر يعيش حتّى 41 عاماً في العراء؛ أي أطول بعشر مرّات من العمر المتوقّع للثديات التي تماثلها حجماً، ومن دون التعرض للإصابة بالسرطان أو تدنّي مستوى الخصوبة.
وقد حصل وانغ وتيلينغ وزملاؤهما أخيراً على منحة بقيمة 13 مليون دولار من «مجلس البحوث الأوروبي» لمحاولة تكوين فهمٍ أفضل لهذه القدرات الخفاشية وكيف يمكنها أن تساعد المخلوقات الأخرى.
ابتكار «الإنسان ـ الخفاش»
بدأ فريق وانغ باختبار بعض أفكاره بإخضاع «خفّاش - فأر (bat - mouse)» سليم ومقاوم للأمراض، إلى هندسة جينية. لا يزال وانغ وفريقه على بعد سنواتٍ من ابتكار «الإنسان الخفّاش»، ولكنّهم واثقون بأنّ هذه الأفكار ستكون يوماً ما مصدراً لعلاجات جديدة للبشر لمحاربة السكريّ، وكبح الأمراض المُعدية، وحتّى لإطالة أمد الحياة.
عملياً؛ يبدو الطيران، أو على الأقلّ تأثيره المتطوّر على جسد الخفّاش، العامل الرئيسي في تفوّق صحّة هذه المخلوقات. ويعدّ الطيران من خيارات التنقّل الأكثر مشقّة على مستوى استهلاك الطاقة، فعندما تحلّق الخفافيش؛ يرتفع مستوى التمثيل الغذائي لديها 15 أو 16 مرّة أكثر ممّا هو عليه في أوقات راحتها، ويعلو نبض قلبها إلى ما فوق الألف ضربة في الدقيقة، وتتجاوز درجة حرارة جسمها 40 درجة مئوية تدفع بها إلى حالة من الحمّى المرضية.
وإذا تخيّلنا أيّ نوعٍ آخر من الثديات في هذا الوضع، فلا شكّ في أنّ جسده سيكون منهكاً من الالتهاب الحادّ.
للتعامل مع هذا النوع الهدّام من الحركة، طوّرت الخفافيش دفاعين أساسيين: الأول هو مهارتها العالية في الحفاظ على هدوئها الجسدي؛ إذ حتّى عندما تُدفع هذه المخلوقات إلى أقصى درجات الإجهاد، فإن أجسامها تحافظ على درجة حرارة معقولة. ولعلّ السبب في ذلك هو افتقار الخفافيش إلى بعض الآليات الجزيئية التي تشغّل هذه الأنظمة.
بمعنى آخر، تعاني الخفافيش من ضرر أقلّ بعد تعرّض أجسامها للضغوط. وعند وقوع الضرر، تملك الخفافيش حيلة أخرى: تبدو خلاياها ذات كفاءة على نحو لا يُصدّق في الصيانة والإصلاح السريع لحمضها النووي المتضرّر.
تخفيف الأضرار الجسديةويشير وانغ وتيلينغ إلى أنّ هذه الاستراتيجيات تساهم أيضاً في تخفيف أضرار جسدية أخرى. يحدث السرطان لدى البشر بعد ظهور أخطاء في أجزاء محدّدة من الرمز الجيني. وعلى المستوى الجزيئي، يعدّ التقدّم في السنّ النتيجة الأساسية لمراكمة الخسائر والمشكلات الخلوية على مدار السنوات.
أما لدى الخفافيش، فالضغط هو الضغط، مما يعني أنّ الأسباب الرئيسية لهذه المشكلات الصحية المزمنة قد يحلها الطيران وكل الإجهاد المرتبط به. بمعنى آخر، فإنّ الحلول التي تسمح لجسد الخفّاش بالطيران بسلاسة في الجوّ قد تساعد في حلّ مشكلاته الصحية على امتداد سنوات حياته. فبينما يتراجع أداء البشر في تصحيح الأضرار مع التقدّم في السنّ، تشهد قدرات الخفافيش تحسناً مطرداً، على حدّ تعبير تيلينغ.
درء عدوى الأمراض
قد تساعد هذه المعلومات في شرح سبب حسن استضافة الخفافيش مسبّبات الأمراض التي تقتل البشر.
ولدى الإنسان، فإن أعلى أخطار الأمراض المُعدية تحدث بسبب استجابة الجسم البشري المفرطة للالتهابات. وهذه الاستجابة تشكّل خطراً أكبر من أيّ ضررٍ قد يسبّبه مسبّب المرض المعدي نفسه لخلايا الجسم البشري. تشبه دفاعاتنا القنابل المثبّتة على أبواب منازلنا، أي إنّها قادرة على القضاء على المحتلّين، ولكن بتكلفة عالية جداً لجسدنا.
في المقابل؛ تملك الخفافيش عتبة حماية مرتفعة قبل اشتعال الالتهاب؛ إلى درجة أنّ كثيراً من الفيروسات تبدو قابلة لسكن خلاياها من دون التسبّب في تلك الدرجة من الدمار.
خلال التجارب المخبرية، حقن العلماء الخفافيش بفيروسات كثيرة حتّى فاضت أنسجتها (وصلت إلى 10 ملايين وحدة من فيروس «إيبولا» في الملّيمتر الواحد من المحلول، و10 ملايين وحدة من فيروس «كورونا» في الغرام بالرئة)، ومع ذلك، لم يستطع الباحثون رصد مشكلات خطرة في صحّة الخفافيش. ويعدّ توني تشاونتز، الخبير في مناعة الخفافيش من جامعة ولاية كولورادو، أنّ الخفافيش وفيروساتها حقّقت حالةً من «الانفراج المناعي (an immunological detente)».
ولكنّ هذه المستويات الهائلة من الفيروسات ليست الحالة المفضّلة للخفافيش طبعاً، حيث إنّ أجسادها بارعة جداً في كبح تكاثر الفيروسات بشكلٍ استباقي. يعود هذا الأمر في جزءٍ منه إلى أنّ بعض أنواع الخفافيش تملك «أجزاءً في نظامها الدفاعي» دائمة النشاط، وفق وانغ، الذي يسمّيها «جهوزية المعركة». إذن؛ عندما يظهر مسبّب مرضٍ ما، يتصادم مع مضيف سبق أن جهّز نفسه ببروتينات قويّة وحاضرة لعرقلة دورة حياة الفيروس، وبالتّالي، منع الجرثومة من الخروج عن السيطرة.
عدوى عابرة للخفاش مدمرة للإنسان
الفكرة هنا هي أنّ الفيروسات طوّرت نفسها لترقى إلى مستوى حيل الخفافيش، وارتقت لتصبح أقوى خلال محاولاتها الاختراق والتكاثر، ومن ثمّ الانتشار بين خلايا الخفّاش المحصّنة. هذا الهجوم بمقياس الخفافيش، وفق كارا بروك، العالمة البيئية المختصة في الأمراض، قد يكون مفرطاً لدى البشر الذي يفتقرون إلى هذا المستوى من الدفاعات، وقد يساعد هذا الأمر في شرح الضرر الذي تسبّبه لنا الفيروسات التي تنشأ في الخفافيش. باختصار، العدوى التي تمرّ مرور الكرام لدى الخفّاش قد تشعل فوضى عارمة لدى الإنسان.
يقترح وانغ في واحدة من أفكاره للتعامل مع هذا النوع من التفاوت في ضيافة مسببات المرض، أن تُستخدم أدوية تخفّف قليلاً من حدّة استجاباتنا المناعية؛ أي أن نصبح أشبه قليلاً بالخفّاش. وأضاف أنّ هذه الخطوة من شأنها أيضاً أن تخفّض خطر المناعة الذاتية، وحتّى أن تؤخّر الشيخوخة أو بضعة أنواع من الأمراض الأيضية المزمنة. يذكر أنّ «الخفاش - الفأر» الذي هندسه هو وفريقه للتعبير عن جينة معيّنة تكبح الالتهاب في الخفاش، هو من تجاربه، وأظهر في النتائج قوّة أكبر في مواجهة الإنفلونزا، و«سارس كوف2»، وحتّى النقرس.
* «ذي أتلانتيك أونلاين»
- خدمات «تريبيون ميديا» «الإنسان الخفّاش» سيشكل مصدراً لعلاجات جديدة لمحاربة السكريّ وكبح الأمراض المُعدية